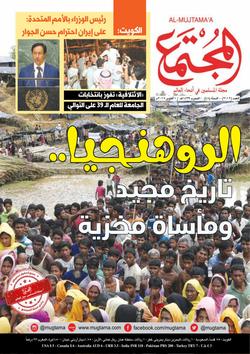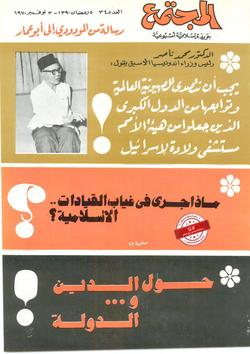العنوان التقدم العلمي والتغير السياسي.. أضواء على الملامح السياسية لعقد التسعينيات
الكاتب عبد الله موسى
تاريخ النشر الثلاثاء 06-ديسمبر-1988
مشاهدات 26
نشر في العدد 894
نشر في الصفحة 38
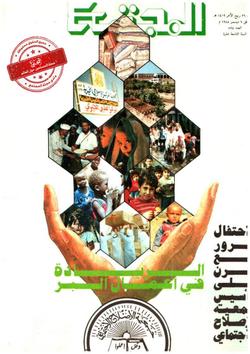
الثلاثاء 06-ديسمبر-1988
- الدولار الأمريكي يستخدم لسحق شعوب العالم الثالث
شهدت الساحة الدولية في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في العلاقات بين القوى السياسية العظمي، يكاد يكون المسلمون الضحية الأولى فيها. ومن الخطأ أن نتفرج على الأحداث دون تحليل لأسبابها الماضية والحاضرة واستشفاف غدها المقبل. هذا البحث يفسر الوفاق الدولي والوحدة الأوروبية ويعطي لمحة مستقبلية للعقد القادم. فالذي يفشل في إدراك المتغيرات وفهم طبيعتها يفشل في صراع البقاء.
عالمنا الذي يتحرك بسرعة هائلة في هذا الزمن حيث تتسارع الأزمان وتختصر المسافات وتتقارب البلاد، يعيش ثورات علمية كل يوم خاصة في عالم الإلكترونيات هذا العالم الذي ترك بصماته واضحة في البنية التكنولوجية للغرب وأخذ يختصر مسافات البحث والاكتشاف والتقدم العلمي لينجز في أسابيع أعمالًا كانت تأخذ أعوامًا.. ما أثر هذه الثورات العلمية على التوجهات السياسية العالمية وخارطة التحالفات الدولية.
إن تقدم صناعة الإلكترونيات واختراع رقائق السيليكون ثم الدوائر المتكاملة والموصلات الفائقة بعد ذلك، قد أشعل الثورة الثالثة في تاريخ البشرية بعد الثورة الزراعية في بدايات التاريخ البشري ثم الثورة الصناعية التي نبت جذرها في الأندلس مع المضخات المائية والتي أثمرت الآلة البخارية في أوروبا فيما بعد. هذه الثورة قد جعلت الأشياء أصغر حجمًا والاتصالات أسرع وأقوى كما جعلت وسائل المواصلات أفضل وأكثر أمانًا وراحة، وكان أهم آثارها في عالم الحاسوب الذي اختصر المسافات الزمنية للتفكير البشري ووفر الجهد البشري كي يقفز بالإبداع في سرعة الحساب ومعالجة المعلومات ثم التصميم الهندسي بواسطة الحاسوب، من سرعة السلحفاة إلى سرعة الطائرة النفاثة!
لقد أصبح العالم بحق «قرية عالمية» صغيرة وواحدة مترابطة الأطراف على رغم تباعد مسافاتها واختلاف بنيتها السكانية والسياسية والاقتصادية. إن مثل هذا الترابط يبرز من المسلسلات والبرامج التلفزيونية الأمريكية وتأثيرها الثقافي السلبي ونمط الطعام السريع والجينز والموسيقى الغربية، إلى انهيار بورصات العالم على شاشات الحاسوب في طوكيو وسيدني ولندن وزيورخ بمجرد أن تنهار على الشاشات التلفزيونية للبورصة الأمريكية في «وول ستريت» في نيويورك.
إن صورة العالم اليوم تهزم حتى أشد الخيالات تحمسًا في الخمسينيات لما يمكن أن تكون عليه الصورة الدولية في عقد التسعينات فقد قفز العالم مع الموجة الثالثة قفزات تاريخية هائلة، تنافس في ثوريتها اكتشاف العجلة أضعافًا مضاعفة، إن الإنجاز المادي المدني الذي تقطعه البشرية الآن في عام، لم تكن تبلغه في عهودها السابقة في عقد أو قرن كامل. وأن إنجازات المدنية في عقودها الخمسة الأخيرة يفوق أضعافًا مضاعفة ما حققته خلال خمسة آلاف سابقة من عمر الوجود الإنساني على وجه هذه الأرض.
إنجاز هائل.. لكنه غريب:
إن المسافات العلمية الهائلة التي قطعها الغرب وخاصة مع انتشار الحاسوب الشخصي الذي طرح إلى الأسواق الأمريكية في عام ۱۹۸۱ ودخوله إلى كل مكان من المصانع والمكاتب إلى البيوت، رغم أهميتها في حياة البشرية إلا أنها تبقى غربية. وهكذا تحاول الأنظمة الغربية أن تبقيها مصبوغة بالصبغة السياسية الغربية دون تعميمها دوليًا حتى لا يسقط عامل التنافس التاريخي بين الأمم.
فهي تحول بين الدول الأخرى وبين المعرفة الإلكترونية وتجاهد لتسبق في هذا المضمار سبقًا لا يستطيع أحد غيرها أن يدركها فيه، حتى أن أمريكا تخشى منافسة حلفائها الغربيين مثل اليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في هذا المضمار.
ورغم أن هذا التقدم قد ساعد الغرب لتكون حياته أكثر سرعة ويسرًا إلا أن الجانب القاتم لهذه الصورة المشرقة يبرز في العالم الثالث حيث يبدو هذا العالم عاجزًا حتى عن اللحاق بركب الثورة الزراعية لتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي فضلًا عن لحاقه بركب الثورة الثانية: الثورة الصناعية!
فإن التقدم العلمي الأخير والاختراعات التي قدمها الغربي في العشر سنوات الأخيرة في مجالات السبق والإبداع العلمي تعدل كل ما سبق أن قدمه الغرب من قبل من إسهامات وإبداعات علمية.. لكنها بقيت داخل حدود بلاده في أغلب الأحيان.
إن الغرب قد دخل مرحلة الثورة الإلكترونية وقطع فيها شوطًا كبيرًا سبق فيه كل القوى المنافسة الأخرى في العالم وأقواها: المعسكر الشرقي وبسبب هذه الثورة أصبح العالم الثالث مهددًا بأمية أشد خطورة من أمية القراءة والكتابة، هي «الأمية الإلكترونية».
الهوة تزداد اتساعًا:
ومع ازدياد التقدم الغربي العلمي وإدراك الغرب لحقيقة هذه الثورة الجديدة وأثرها في التاريخ والتي لم يدركها بعد جزء كبير من دول العالم الثالث، تجد أن الهوة التي تفصل دول الشمال عن الجنوب قد اتسعت بصورة أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقدين من الزمان.
ومن المعروف أن الهوة الكبيرة التي تفصل بين الشمال والجنوب وهي العبارة المهذبة التي يستبدلها البعض لمصطلح الدول المتقدمة والدول النامية تتركز أساسًا على ثلاثة أسباب رئيسة:
- التقنية أو التكنولوجيا: التي يفتقدها العالم الثالث وتحول بينه وبين التطور الحقيقي البناء، إما لضعف الإمكانات أو قلة الطاقات ونزف الأدمغة، أو لسوء التخطيط وفساد الإدارة.
- الديون: والتي ترهق كاهل معظم دول هذه الشريحة، وتمتص أي فوائض مالية يمكن أن تسهم في تقدمها واستقلالها ومن المضحك المبكي أن هذه القروض التي قدمها الغرب من خلال دوله ومؤسساته الاقتصادية وقصد بها في الأصل معونة هذه الدول، قد صارت بسبب الربا الفاحش قيودًا تعوق تقدم هذه الدول وانطلاقها.
- النظام الأساسي: والذي يكمن في طبيعة الأنظمة الحاكمة في العالم الثالث من ناحية تركيبتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كجزء من عاداتها وتقاليدها الموروثة كما يعود إلى قلة خبرة ذوي النفوذ إضافة إلى الارتباط الاقتصادي الوثيق بالغرب، وانعدام التخطيط وعدم وجود استراتيجية ثابتة للبناء على المدى الطويل بسبب كثرة التقلبات السياسية والاقتصادية. كما يشمل أسلوب الإدارة ونوعيته.
وقد دفع الإدراك الغربي لهذه المسألة بالإضافة إلى تخوفه من بروز قوى عالمية جديدة تهدد قيادته التاريخية الحالية من الأمم الأخرى دفعه ذلك إلى محاولة تجاهل آمال وآلام العالم الثالث، وتعطيل دور المحافل والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والتي بدأ الغرب يتجاهلها فأمريكا لم تسدد ما عليها من التزامات مادية للأمم المتحدة مما يهددها بالإفلاس إضافة إلى انسحابها من منظمة اليونسكو للتأثير على سياستها التي بدا أنها خرجت عن الخط الغربي العام المؤيد للصهيونية.
وبدا أن الغرب قد أخذ يستبدل المحافل الدولية العامة بمحافل أخرى خاصة مثل الأخلاق العسكرية والاقتصادية والسياسية «الناتو –القمة السباعية –لقاءات العملاقين» لتنفيذ سياساته الخاصة بعيدًا عن الأجواء الدولية والتي يكون فيها القرار متوازن المصالح ولفائدة معظم الأطراف بما فيها العالم الثالث. وقد تركز هذا الاتجاه في سياسة «نيكسون –كيسنجر» التي تركت بصماتها التاريخية غائرة في السياسات والتوجهات الأمريكية للعقدين السبعيني والثمانيني خاصة بعد الانفتاح على الاتحاد السوفياتي والصين.
والغرب الذي بدأ يركز كثيرًا على السبق في مجال التقنية العالية HI – TECH والإلكترونيات وإيجاد مصادر بديلة للطاقة إضافة إلى تحسين المتوفر منها قد استوعب المتغيرات العصرية وأصبح يحث الخطى إلى القرن الحادي والعشرين والغرب اليوم لا تهمه الهوة السحيقة بينه وبين دول الجنوب المتخلف بل إنه يعمل على توسيعها بعد أن أدرك أن هذا العالم كاد أن يلحقه في مجال الثورة الصناعية وحقق تفوقًا في بعض المجالات بسبب رخص اليد العاملة وعامل التنافس بين الأمم خاصة في دول شرق آسيا القريبة من اليابان، مثل كوريا وتايوان وهونغ كونغ.
وهكذا أخذ الغرب يركز على مسألة البحث والتطوير في كافة قطاعاته الصناعية حتى غدا هذا البند يأخذ حيزًا كبيرًا من ميزانيات الشركات الصناعية الكبيرة والعريقة التي أحست أن سبقها بل وجودها يعتمد على البحث والتطوير.
RESEARCH & DEVELOPEMENT
وشجعت الحكومات الغربية وبالأخص الولايات المتحدة هذا التوجه ودعمته بقوة، لإدراكها أن السبق التكنولوجي يعني استمرار السيادة والقوة بل والبقاء كذلك.
الاتجاهات الكبرى
وفي كتابه الاتجاهات الكبرى MEGA TRENDS يجسد ح. نیزیت NAISBITT j. الإدراك الغربي لهذه التغيرات وأثرها العالمي الذي يتحدد بناء عليه استراتيجية الغد للعالم الغربي. ويحدد هذه المتغيرات فيما يلي:
- تحول المجتمع من مجتمع صناعة إلى مجتمع معلومات.
- من تكنولوجيا قهرية إلى التكنولوجيا العالية. «يعني بأثر التقنية في العلاقات الإنسانية».
- من اقتصاد وطني إلى اقتصاد عالمي.
- من التكيف على المدى القصير إلى التكيف على المدى الطويل.
- التحول من المركزية إلى اللامركزية «في السياسة والاقتصاد والثقافة».
- من المساعدة المؤسسية إلى مساعدة النفس.
«العناية الذاتية والتعليم الذاتي بدل المدارس والمصحات».
- من التمثيل إلى المشاركة.
FROM REPRESENTATION
TO PARICIPATION
«في السياسة والمنظمات الجماعية».
- من الهرم المؤسسي المستقل إلى الشبكات المترابطة. «في الأطر التنظيمية وتعني مشاركة المعلومات والموارد والأفكار»
- انتقال الشغل السكاني والفاعلية الإنسانية من الشمال إلى الجنوب، والجنوب الغربي.
- من الآراء البسيطة المحدودة إلى الخيارات الواسعة.
إن معظم هذه التغيرات في الاتجاهات الإنسانية والاجتماعية في الغرب والعالم تأتي نتيجة طبيعية للتطورات الحاصلة نتيجة النظم السياسية والاقتصادية والأفكار الاجتماعية التي تسود المجتمعات مضافًا إليها تأثير التقنية الصناعية على هذه الوحدات الدولية التي ارتبطت فيما بينها بشبكات المواصلات والاتصالات ومؤسسات الاقتصاد والصناعة والإعلام، ولا ينسى دور الاستعمار الحديث في خلق الكيانات السياسية في كثير من مناطق العالم ودوره الضخم في تشكيل سياستها واقتصادها وبنيتها الثقافية وما مارسه الغرب من تخريب لهذه الثقافات باسم تمدين الشعوب المتخلفة في نظره وأثر ذلك على ركاكة بنائها الاجتماعي الحاضر ومسخ الهوية الثقافية والحضارية لكثير من هذه الشعوب.
القلق العربي الأساسي:
إلا أن أهم ما يقلق الغرب في هذه التغيرات في الاتجاهات العالمية هو انتقال الثقل السكاني والفاعلية الإنسانية إلى الجنوب والجنوب الغربي وهو ما يقصد به دول العالم الثالث وأمريكا الجنوبية. وهو أمر بات يهدد السيادة الغربية على العالم، وبات الغرب يفكر ويعد العدة لمواجهته في التسعينات والقرن القادم القرن الحادي والعشرين «البند التاسع في التحولات». أحد الأساليب هو تشجيع ودعم خطط تحديد النسل في العالم الثالث، أسلوب آخر هو حظر التكنولوجيا المتقدمة على العالم الغربي، أسلوب ثالث يعتمد على تشديد قيد الديون حول دول العالم الثالث وحرمانها من تأسيس البنية التحتية اللازمة لتقدمها ونمائها، وتعطيل خطط التنمية فيها، أسلوب رابع هو إثارة الاضطرابات والقلاقل السياسية والاقتصادية وتعكير صفر الاستقرار فيها، وخطط وأساليب أخرى كثيرة بعضها بادٍ وكثير منها خاف.
بل إن الاتحاد السوفياتي قد أشار مرة إلى أن مرض الإيدز هو اختراع أمريكي لتقليص سكان القارة الأفريقية، مستودع ثروات العالم المخبوءة لكنه ارتد في نحور مخترعيه أولًا لفشلهم في السيطرة على عينات التجارب التي كانت من المسجونين المحكومين بالإعدام في أمريكا بعد إطلاق سراحهم ليموتوا ببطء. لكن المرض سرعان ما انتشر في أوساط الشاذين جنسيًا حيث كانوا الفئة الأولى التي اختلط بهم هؤلاء السجناء الأربع!
الاتحاد السوفياتي: البريسترويكا لماذا؟
أمام هذه التحولات نظر زعماء الاتحاد السوفياتي «الشباب الخمسينيون» حولهم ومنهم ميخائيل غورباتشوف وهم يحاولون استيعاب المتغيرات العالمية بسبب الآثار الصاعقة للتقدم التكنولوجي الغربي على الصناعة ونمط الحياة العصرية فوجدوا أنهم يخسرون مع الزمن.
الاقتصاد الاشتراكي لم يثبت نجاحًا لكن الاقتصاد الرأسمالي يعاني من مشاكل جمة كذلك. الشيوعية تعاني من مشاكل عديدة في العالم حتى في أقطارها الأصلية، ولكن العالم الغربي له أوقاته العصيبة كذلك.
إلا أن المحصلة النهائية لجرد الحساب بعد التنافس المستمر بين المعسكرين الشرقي والغربي والذي بدأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتقسيم برلين عام ١٩٤٥ هذه المحصلة الآن هي لصالح الغرب.
فشل في الاقتصاد:
فأمريكا تتمتع بنفوذ اقتصادي عالمي قوي، يدعم تحركها السياسي في بؤر النزاع والتوتر العالمية. كما أنها تلف العالم بسلسلة طويلة من الديون تشمل دولًا في المعسكر الشرقي المحسوبة على الشيوعية كما أن لها إعلامًا عالميًا قويًا ومؤثرًا يتمثل في مؤسسات عالمية ناجحة وفاعلة استفادت من الاستعمار الإنجليزي الذي نشر هذه اللغة في كل أرجاء المعمورة بينما المعسكر الشرقي عاطل من هذه الزينة.. وقد استفادت بشكل أكبر من تكنولوجيا الإعلام ووسائل الاتصالات والمواصلات في تحقيق أكبر هيمنة إعلامية ممكنة.
إن الدولار الأمريكي يلعب دورًا اقتصاديًا عالميًا أصخم بكثير من الدور الذي يلعبه الروبل الروسي.. وأن مجلة أمريكية واحدة توزع في العالم أضعاف ما توزعه أي مجلة سوفياتية معروفة في العالم.. وشركة أمريكية عالمية واحدة تحقق ما تعجز عنه المؤسسات السوفياتية جميعًا داخليًا وخارجيًا ألم تكن شركة التلفون والتلغراف الدولية ITT سببًا في سقوط سلفادور اللندي الشيوعي في تشيلي. إن هذه الشركة دفعت رشوة للعسكريين بقيادة الجنرال بيتوشيه ليقوم بالانقلاب حتى تحمي مصالحها الدولية من التأميم.
أما تقنيًا فبالرغم من أن التقنية الشرقية المرتبطة بأساليب خاصة في التصنيع واختيار المواد والتصميم قد أظهرت تفوقًا في بعض الجوانب المثيلة لدى المعسكر الغربي، إلا أنها ظلت دونه بمسافات واسعة خاصة في الحجم والمتانة والكفاءة.
فشل في الزراعة:
أما في الزراعة فقد بقي المعسكر الغربي متفوقًا بصورة عامة وفي الأحوال الطبيعية، ما لم تكن هناك تقلبات مناخية شديدة أو كوارث طبيعية متفوقًا على المعسكر الشرقي الذي كان يعاني دائمًا من صعوبات جمة في توفير موارد أساسية كالقمح مثلًا، بل إن الاتحاد السوفياتي كان يشتري القمح من أمريكا ليعطيه للدول الخليفة له کالهند مثلًا وبقي الغرب باستمرار يحقق فائضًا كبيرًا في السلع والخدمات الأساسية والكمالية، في حين كان المعسكر الشرقي متعثرًا في كفاية الأساسيات، حتى غدت طوابير التموين سمة من سمات الاشتراكية.
أما الأفكار فقد ظل المعسكران في تنافس في إبداعها وتحقيقها، رغم اختلاف الأسلوب وطرق التطبيق العلمي والعملي والصناعي
بل إن التقنية الإعلامية ساهمت في نشر نمط الحياة الأمريكية لجعله المثل الأعلى في العالم أجمع عن طريق الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى الغربية حتى صار بنطال الجينز وسندويتش الهامبرغر من دلالات الحياة العصرية في كثير من بلاد العالم بل وفي الاتحاد السوفياتي نفسه وفي نظر فئات شبابه الصاعد في موسكو مع أنها رمز أمريكي أصيل.
أما حلفاء أمريكا من الدول الاقتصادية السبع فهم أغنياء ومتقدمون صناعيًا اليابان –ألمانيا –بريطانيا -فرنسا –إيطاليا –كندا، ومعظم أموال العالم المستثمرة ملك أيديهم أو مخزونة في بنوكهم، أما العالم الشرقي فلا يملك إلا القليل جدًا مقارنة بالقوة الاقتصادية الغربية، مع أن النظرية الماركسية تفترض أن العالم الاشتراكي متقدم على الرأسمالي وتالٍ له ومتفوق عليه وهي فرضية تحطمت على أرض الواقع الصلبة.
ولم تكن التكنولوجيا وحدها هي المسافة الفاصلة بين المعسكرين بل كان هناك أسس النظام الاقتصادي ومؤسساته، كما كان هناك أسلوب الإدارة.
مواجهة النجاح الأمريكي:
وكان على السوفيات أن يواجهوا النجاح الأمريكي بواقعية ويدرسوا أسبابه ليواجهوه فيما بعد. أما الآن فلا بد من كسب الوقت بشيء من الوفاق وتحطيم بعض الأنياب الصاروخية النووية، لعل الوفاق يمنح للمعسكر الشرقي ما فشل في تحقيقه باتباع سياسة التحدي فربما نجح التفوق السلمي أي استغلال فترة الوفاق والانفتاح في تحقيق نوع من السبق للمعسكر الشرقي.
وكانت سياسة الوفاق هي نتيجة منطقية للدراسة الواقعية التي قام بها المعسكر الشرقي لفهم أسباب نجاح المعسكر الأمريكي وفشل المعسكر الروسي. إن المعسكر الشرقي قد خسر كثيرًا بسبب التزامه العقائدي المتزمت بالنظرية الشيوعية على عكس العالم الغربي الذي بدا أنه أكثر انفتاحًا على العالم وتفاعلًا مع الأحداث وأكثر مرونة.
إن الاتحاد السوفياتي سيركز جهوده في الفترة القادمة على عدة أمور منها:
- الإصلاح الاقتصادي والذي ربما يصل إلى حد اقتباس أساليب ومبادئ اقتصادية غربية بما فيها أسلوب الانفتاح العالمي.
- الانفتاح الإعلامي والذي سيحاول فيه الاتحاد السوفياتي مضاعفة جهوده الإعلامية لجذب اهتمام العالم إليه وجذب أنظار أبنائه إلى العالم.
- مضاعفة الجهد في استكشاف أسرار التقنية العالية وتصنيع الحاسوب ومحاولة نشره في الداخل ليشمل كافة القطاعات. «في إحصائية أمريكية تبين أن هناك حاسوبًا شخصيًا لكل أربعين أمريكيًا بينما هذا الرقم أقل بكثير في الاتحاد السوفياتي».
- تنوير المجتمع السوفياتي وإعادة تثقيفه فيما يتعلق بالبناء الداخلي والعلاقات الدولية الخارجية.
- تشجيع القطاع الخاص برعاية الدولة.
- ربط بقية المعسكر الشرقي بعجلة البريسترويكا.
- مزيد من الانفتاح الدولي وتمتين العلاقات الدولية وتوظيفها لخدمة وتنشيط الاقتصاد السوفياتي.
ويبدو أن الاتحاد السوفياتي قد رسم لنفسه سياسة صارمة فيما يتعلق بمبدأ الوفاق، وأنه جاد في تحقيقه لئلا يخسر فرصة السبق العالمي وتحقيق «التفوق السلمي»، ولو كان ذلك على حساب بعض القضايا الأخرى كالنزاعات الإقليمية ومنها قضية الشرق الأوسط التي بدا أن الاتحاد السوفياتي يتخذ فيها موقفًا غير محايد إطلاقًا، وأن كفة الميزان الشيوعي تميل بكل جلاء نحو اليهود وإسرائيل. فقضية الوفاق الدولي تمثل له قضية صراع بقاء.
والاتحاد السوفياتي يدرك في هذا ما أخطأ العثمانيون قديمًا في إدراكه، فالقوة العسكرية وحدها لا تضمن التفوق والسيادة العالمية، بل لا بد من ضمان التفوق العلمي كذلك وازدهار الصناعة والزراعة ونماء التجارة، وهي أمور لم يفطن لها العثمانيون في سابق عهودهم فتدهورت أحوالهم كثيرًا قبل أن تتآمر قوى الشر من یهود وغربيين عليهم حتى سقطت الخلافة، وهي مقومات يفتقد إليها الاتحاد السوفياتي على نحو يضمن له المنافسة على السيادة العالمية.
الصين خارج اللعبة الدولية الكبرى:
وحين كان الانفتاح الجديد مؤخرًا بين الاتحاد السوفياتي والصين، كانت أمريكا تستحوذ على شرف العلاقة مع دولة الألف مليون وهو شرف كان يفتقد إليه الرفاق الشيوعيون في موسكو، وقد كان رائد هذه الخطوة الأمريكية هو هنري كيسنجر الذي أراد أن يضم الصين إلى اللعبة الدولية ليسهل التحكم في هذا المارد كي لا يخرج من قمقمه، وقد كان...
فبعد انضمام الصين إلى الأمم المتحدة وبعد انفتاحها على الغرب وتحديدًا أمريكا وجدت الصين نفسها مضطرة إلى الاندماج في المحيط الدولي والتقيد بكثير من قوانينه الكثيرة والمعقدة بأقل القليل من الاستعداد السياسي والاقتصادي والفكري.
وأدركت الصين من اتصالها مع الغرب تخلفها التكنولوجي وفقرها الاقتصادي برغم عظمة إنجازاتها في تحقيق الكفاية لكثير من مواطنيها باتباعها لنهج المساواة والتقشف فالصين رغم قوتها العسكرية وبرغم دخولها النادي النووي إلا أنها تفتقر إلى كثير من مقومات السبق والسيادة العالميتين والتي لها شروط أخرى تختلف كثيرًا عن مقومات وشروط البقاء كأمة مستقلة ذات سيادة!!
فالتقنية الغربية لها الكثير من المزايا التي لا تتوفر في الحكمة الصينية القديمة وتوجيهات «ماوتسي تونج» والرفاق الحزبيون. فحضارة الغرب قد صبغت العالم الحديث بصبغتها الفكرية والثقافية سواء شاءت القوى الأخرى أم أبت وإذا أرادت أي قوة مخالفة أن تتحداها فلا بد لها أن تأتي بأحد أمرين:
- قوة تكنولوجية عالية تغلب وتسبق القوة التكنولوجية الغربية في السلم والحرب، وهو أمر غير يسير على الإطلاق حتى على القوى الشيوعية ويحتاج إلى جهد بشري جبار وضخم في كل مجال.
- منهج فكري شديد الرقي وذو طابع قوي غلاب يعلو على المناهج الفكرية والثقافية الحالية. وهو أمر لا تستطيع القوى الشيوعية أن تحققه لهبوط منهجها وفقره فكريًا، رغم أنه إذا قورن بمنهج الغرب الفكري طمسه.
وهذا الأمر لا يأتي إلا بمنهاج فطري قريب من النفس البشرية وطبيعة تركيبتها، بحيث يكون قادرًا على ربط البشر بالله ثم الكون ثم البشر بعضهم البعض من خلال نظم متقنة التركيب وغير متناقضة أو متضادة مع الإنسان أو بعضها البعض، وتجمع إلى مقومات الفطرية والأصالة صفات التطور لملاءمة نمو البشرية ورقيها في الفكر والعلم، وهي صفات لا أجد أنها تتوفر لغير الإسلام كدين، ويفتقد إليها المسلمون اليوم في منهاج حياتهم.
وأمريكا تدرك أن الصين تفتقد إلى مقومات السيادة العالمية، وأن الورقة الكبرى التي يراهن عليها الصينيون هي العاملان السكاني والجغرافي، فأما العامل السكاني فهو التفوق في العدد البشري الذي يناهز الألف مليون وأما العامل الجغرافي فهو موقعها في شرق آسيا والقريب من اليابان وجنوب شرق آسيا والتي تحوي أعظم تجمع بشري في الكرة الأرضية، والصين فيه قوة عسكرية غالبة. ولهذا حاولت أمريكا استرضاء الصين ثم اختراقها اقتصاديًا ثم ثقافيًا لترويج النمط الغربي فيها على أساس أنه نمط الرفاهية التي يفتقدها أهل الصين بحكم التقشف.
والصين بحاجة أيضًا إلى الوفاق لتستفيد من تقنية الغرب وتطور تكنولوجيا العصر خاصة لدى جارتها اليابان، وهو أمر مرهون برضا السيد الغربي في أمريكا.
وحيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جوانب قصور الصين في مجالات عدة بحكم انفتاحها السياسي والاقتصادي، رغم بعض النكسات المؤقتة في العلاقات الثنائية، فإنها استثنتها من التنسيق عالي المستوى حول الشؤون الدولية ولقاءات القمة لتجعله خاصًا بالسوفيات وحدهم. وهذا يعني أن الصين حسب قوانين لعبة الوفاق الدولي قد أضحت خارج اللعبة الدولية، وإن بقيت ضمن إطارها الواسع.
أوروبا المتحدة: الشريك الجديد:
وإذا ما اتحد الأوروبيون اقتصاديًا بالكامل ووحدوا عملاتهم في عام ١٩٩٢ كما هو مقرر، ثم تلا ذلك توحيد الشرطة والجيش، فإن الوحدة السياسية تصبح سهلة المنال بين دول أوروبا التي مزقها الصراع على القوة والسيادة فيما بينها.. عندئذ تصبح أوروبا الموحدة القوة السياسية والاقتصادية الثالثة عالميًا فتصبح شريكًا بديلًا عن الصين في الوفاق الدولي إذا قدر له إن يعيش عقدًا من الزمان وأمريكا تدعم الخطوات الوحدوية الأوروبية بقوة، فهذا سيجعلها في مواجهة رأي أوروبي واحد لا عدة آراء متناقضة، كما أنه سيخفف من حدة مواجهة أوروبا للولايات المتحدة وبخاصة فرنسا على صعيد الحكم وألمانيا على صعيد الشعب! كما أنه سيسهل عليها توجيه القوة الأوروبية الموحدة توجيهًا مركزيًا ويوفر عليها الكثير من الجهد والتنسيق. كما سيخفف من عبثها العسكري في عقد التسعينات لتستغل فائض الميزانية العسكرية في البحث والتطوير استعدادًا للقرن الحادي والعشرين، وإيجاد مراكز عالمية جديدة لقواعدها العسكرية تعزز بها سيطرتها العالمية.
خلاصة البحث
هكذا نرى أن التفوق التقني الغربي قد حقق له اقتحام عالم الثورة الثالثة «الثورة الإلكترونية» بعد الثورتين الزراعية والصناعية.. ويعتبر استخدام الحاسوب الشخصي أكثر ثورية في تاريخ البشرية من اكتشاف النار.
وأن إدراك الغرب لحقيقة تفوقه، ثم إدراك القوى الأخرى كالسوفيات والصين قد دفعها إلى قبول الوفاق الدولي كمخرج من أزمتها أملًا في تحقيق «التفوق السلمي» أي أن تكسب بالسلام ما عجزت عن كسبه بالتحدي والمواجهة بأنواعها والحرب نوع منها.
وأن العالم الثالث والذي كاد يلحق بالغرب في السبعينيات ولاحت له آمال التطور ولحاق ركب الثورة الصناعية، يهدده اليوم شبح الأمية الإلكترونية وبخاصة في شرق وجنوب آسيا وأفريقيا.
وتعتبر فترة التسعينيات مرحلة تاريخية حرجة ودقيقة في تاريخ البشرية خاصة إذا ما استمر فيض الاكتشافات العلمية الغربي في دفعه إلى الأمام لا لتزداد الهوة بين الشمال والجنوب فحسب؛ بل بين الشرق والغرب كذلك.
غير أن هناك نقاطًا جديرة بالاعتبار لأنها ذات أثر بالغ في أسس الحياة الغربية واستمرارها وهي: إلى أي مدى سيستطيع المجتمع الغربي الاستمرار في تقبل صدمات الإنجازات الثورية للتكنولوجيا خاصة مع مشاكله العديدة ومن أهمها:
- النمو السكاني البطيء «لا يتعدى ٢% من المعدل الغربي العام».
- ضعف وركاكة الفكر والثقافة الغربيين.
- انحدار مستوى التعليم والثقافة العامة.
- التفسخ الاجتماعي بسبب ضعف الأخلاق والقيم الدينية
- الخمر والمخدرات
- الأمراض الجنسية وأفتكها الإيدز
- ركاكة النظام الاقتصادي العالمي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، وآثاره السلبية في الفرد والمجتمع.
وهي مشاكل كبيرة في حجمها وفي أبعادها الإنسانية والتي قد تؤدي إلى الانهيار الكامل لهذه المجتمعات إذا ما تضافرت جميعًا لتبلغ الذروة في وقت واحد وهو أمر ممكن وغير بعيد كما يبقى شبح الحرب النووية ولو كانت محدودة وبرغم سياسة الوفاق، فهي ليست أكثر من فرصة يحاول استغلالها كل طرف لصالحه، وإذا حدثت فلن ينجو الغرب ولا الحضارة ككل منها أبدًا وقد يدمر منجزاتها ويعيدها إلى ما قبل القرون الوسطى في وسائلها للحياة والبقاء.
وإذ يقف المسلمون بين حجري الرحى دون دور عالمي ملموس ومؤثر فإنهم مهددون أكثر من غيرهم في عقد التسعينات، وذلك لتضافر القوى العالمية ضد العالم الثالث «أو الجنوب» الذي يشكل المسلمون أغلبية فيه.
وإن المسلمين يملكون عنصر التفوق في المنهج الرباني للإسلام كعقيدة وأصل للحكم في الأرض إذا ما أعادوا تقديمه للبشرية من جديد في مرحلة تحول كبير في حياتها ووجودها الإنساني والتاريخي على هذا الكوكب، وذلك بعد فشل المناهج الأرضية البشرية في علاج المشاكل الإنسانية «رغم تفوقها المبدع في علاج مشاكل التكنولوجيا» وربما كان هذا وحده سببًا ليس في تفوقهم فحسب بل ربما في استمرارهم في البقاء.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل