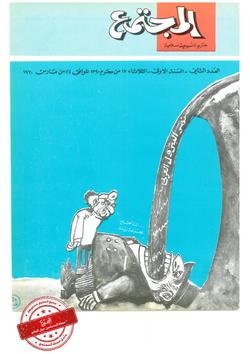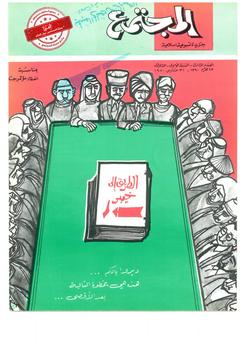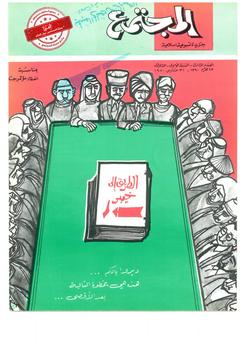العنوان التهديد الإسلامي حقيقة أم خيال- الخطر الإسلامي: قضايا اختلاف المفاهيم (الحلقة السادسة)
الكاتب البروفيسور جون أسبوزيتو
تاريخ النشر الثلاثاء 16-فبراير-1993
مشاهدات 13
نشر في العدد 1038
نشر في الصفحة 28
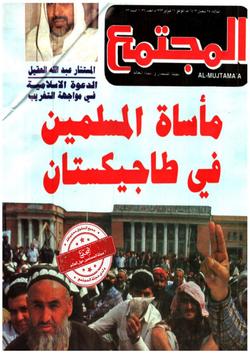
الثلاثاء 16-فبراير-1993
ترجمة وإعداد: المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث-واشنطن
- إن مخاوف الغرب وكراهيته الشديدة لا تغذيهما تقارير أجهزة الإعلام
في هذه الحلقة يستعرض جون أسبوزيتو اهتمام الغرب أو خوفه من الانبعاث الإسلامي واعتباره مصدر خطر كما يسلط الضوء على الفهم الغربي المشوش والتناول الساذج الذي يؤدي إلى التصادم في وجهات النظر، كما يوضح أن العلمانيين «من مسئولين حكوميين ومحللين سياسيين والجماهير من عامة الناس» في الغرب عندما يواجهون المسلمين يصفونهم مباشرة بالأصوليين.
كما أنه يحدد العوامل التي وقفت عقبة أمام تحليلات مجموعة من كتاب الغرب للبعد الإسلامي والديناميكية في المجتمع الإسلامي.
إن الطرق التي نفهم بها طبيعة الدين والعلاقة بين الدين والسياسة والمجتمع تحدد بصورة كبيرة توقعاتنا وأحكامنا، لماذا كان يتم التقليل من شأن استمرارية وأهمية عملية البعث الإسلامي، ولماذا ينظر باستمرار ويحذر إلى هذه العملية باعتبار أنها مصدر خطر؟ لقد مضى أكثر من عشر سنوات منذ قيام الثورة الإيرانية واهتمام الغرب إن لم يكن خوفه من الانبعاث الإسلامي أو الأصولية، وإذا كان الإسلام لم يتم تناوله بصورة واضحة أو لأن الماضي اتسم بانعدام الوعي عن حقيقة الإسلام، فإن كثيرين قد لاحظوا في السنوات الأخيرة أن البعث الإسلامي والسياسات الإسلامية قد أصبحت تحظَى باهتمام كبير.
ورغم الاهتمام الكبير والتغطية الإعلامية وسيل المطبوعات والتي يبدو وكأنها لن تتوقف فإن فهم وتفهم الإسلام والحركات الإسلامية مازال محدودًا وانتقائيًّا، ومن خلال المعطيات المتاحة، وأعداد الخبراء الأكاديميين والمحليين الرسميين، لماذا أصبحت الثورة الايرانية (78/۱۹۷۹) مصدر الانتباه بالنسبة لأحداث كانت تقع منذ السبعينات في ليبيا ومصر وباكستان والسودان وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي ورغم حقيقة الاكتشاف المتأخر للانبعاث الإسلامي، لماذا يواصل معظم المحليين السياسيين في التقليل من شأنه وأهميته ويفشلون في تقدير قوته ونموه المضطرد في دول مثل الجزائر وتونس والأردن وبالمقابل لماذا كان هناك ميل وإصرار على تقليل أهمية الإسلام والنشاط الإسلامي وحصره في إطار التطرف الديني، والإرهاب أن العنف والإرهاب والظلم مسائل موجودة في العالم الإسلامي كما في بقية أنحاء العالم الأخرى، وهذه المسائل كانت ولا تزال تجد مبررات لها باسم الإسلام كما باسم المسيحية واليهودية والإيديولوجيات العلمانية مثل الديمقراطية والشيوعية.
وفي عمق الفهم الغربي المشوش والتناول الساذج والمبالغة في التخوف من الإسلام يكمن التصادم في وجهات النظر أن تصوير العرب والمسلمين بأنهم «بدو» يعيشون في الصحراء مع الجمال ويمارسون تعدد الزوجات ومجتمع الحريم، وشيوخ النفط الأثرياء، قد تغير وحلت محله صورة أخرى هي صورة الملالي الملتحين وهم يحملون البنادق والأصوليين المعادين للغرب.
إن مخاوف الغرب وكراهيته الشديدة لا تغذيهما تقارير أجهزة الإعلام والأحداث الأخيرة فقط ولكن أيضًا النظرة المختلفة للحياة والتي تتعارض مع نظرة الحركيين الإسلاميين للحياة أن اللغة العصرية المرحلة ما بعد الوعي العلماني وأنماط التفكير الحديثة قد شوهت طريقة الفهم والقياس لذلك فإن الفهم العصري للدين باعتباره نظامًا للاعتقاد الشخصي يجعل من الإسلام دينًا ذا نظرة شمولية، مع تداخل الدين مع السياسة والمجتمع، يبدو غير طبيعي، مع تباعده من طرق الحياة العصرية، وهكذا يصبح الإسلام في نظر هؤلاء غير مكتمل، وغير عقلاني وإرهابي ويشكل خطرًا.
إن أكثر شيء غائب عن الأذهان هو أن كل أديان العالم في الأصل وحسب ما يقوله التاريخ كانت شاملة كأساليب للحياة، ورغم اختلاف العلاقة بين الدين والسياسة من مجتمع لآخر، فإن الدين يعتبر طريقة للحياة لها أثرها القوي على المجتمع وعلى الأفراد طريق التوراة وطريق الإسلام المستقيم وطريق الوسط البوذي، والطريق الصحيح «دارما» الهندوسي وكل هذه الطرق توضح الموجهات الصحية وطريقة الأكل والتعامل مع الثروة، ومراحل الحياة المختلفة «الميلاد الزواج، والوفاة» والطقوس والعبادات إن المفهوم العصري للدين له جذوره التي تمتد إلى ما قبل مرحلة الوعي والنهضة الفكرية في الغرب، وأصبح التعريف المقيد والمحدد للدين متداولًا ومعمولًا به كمعنى للدين متعارفًا عليه من قبل كثيرين من المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء في الغرب وفي غياب الحس التاريخي، يدرك قليلون أن مصطلح «دين» كما هو معروف وشائع اليوم بأنه مصطلح عصري وغربي في الأصل وبنفس القدر كان الغرب هو الذي أطلق المسميات والأوصاف على الأنظمة الدينية أو ما يعرف بـ «Isms» وانضمت إلى المسيحية واليهودية المسميات الدينية الجديدة كالهندوسية والبوذية والمحمدية، وهكذا فإن طبيعة وفعالية التقاليد الدينية الأخرى قد تم تصنيفها، ودراستها وإصدار أراء حولها من منظور عصري يتماشى مع مرحلة ما بعد التطور العلمي، ومن منطلق علماني، يفصل بين الكنيسة والدولة.
وكما ينسى كثيرون أو يجهلون حقيقة أن مفهومنا الخاص بالدين مبنِيِّ على أسس حديثة، لذلك فإن هناك اتجاهًا لنسيان أن المفهوم الغربي في الفصل بين الدين والدولة هو مفهوم حديث نسبيًّا، وتاريخيًا حدث تعتيم للمعتقدات الإبراهيمية «اليهودية والمسيحية والإسلام» منذ الفتوحات المسيحية والممالك اليهودية الأولى والإمبريالية المسيحية، ومع استمرار الإمبراطوريات المسيحية والحروب الصليبية، ورغم أن الكنيسة والدولة ظلتا مستقلتين عن بعضهما، فإنهما لم يكونا منفصلين دائمًا عن بعضهما، وهكذا فإن المفاهيم الحديثة عن الدين كنظام للحياة الشخصية والفصل بين الكنيسة والدولة قد تم القبول بها والتعامل معها بطريقة أخفت وغطت على معتقدات وممارسات الماضي وأصبحت تمثل لدي الكثيرين الحقيقة الثابتة والمستمرة، ونتيجة لذلك ومن منطلق علماني حديث فإن - الخلط بين الدين والسياسة يعتبر أمرًا غير عادي وخطيرًا ومتطرفًا.
وهكذا فإن العلمانيين «من مسؤولين حكوميين ومحليين سياسيين والجماهير من - عامة الناس» في الغرب عندما يواجهون المسلمين، أفرادا وجماعات، يتحدثون عن الإسلام كطريقة ومنهج متكامل للحياة فإنهم يصفونهم مباشرة بالأصوليين من مفهوم أنهم يتصفون بالتخلف ويشكلون عقبة أمام التطور والتغيير متعصبون خطِرون أن تصرفات دول عديدة وبعض الصفوة من العلمانيين في العالم - الإسلامي مشابهة لبعضها، إن صور الملالي - المتشددين وأعمال العنف التي يرتكبها بعض الأفراد والمجموعات تؤخذ كدليل لخطورة الخلط بين الدين والسياسة.
إن النظر إلى الإسلام والأحداث التي تقع داخل العالم الإسلامي من منظار العنف والإرهاب قد أدى إلى الإخفاق في رؤية حجم وعمق الإسلام المعاصر فقد تجاوز البعض على وجه التحديد النظر إلى الثورة الهادئة التي حدثت في عدد من دول العالم الإسلامي حيث أخدت حركة التجديد الإسلامي صورة مؤسسية، وكما ذكرنا من قبل، فإن حركة التجديد الإسلامي لم تعد حركة هامشية محدودة في القلة، بل أصبحت جزءًا مؤسسيًّا ضمن التيار العام لحياة المسلمين ما هو تفسير هذا الميل الدائم نحو تشويه طبيعة التجديد الإسلامي وتصويره كخطر؟
العلمنة والتحديث
إن المعطيات والمسلمات العلمانية والتي تتحكم في نظمنا الأكاديمية ونظرتنا للحياة - نظرتنا الغربية العلمانية للعالم من حولنا - كانت عقبة رئيسية أمام فهمنا للسياسة الإسلامية لهذا ساهمت في تشكيل نظرتنا للتقليل من شأن الإسلام وتصويره بالأصولية والتقليل من شأن الأصولية وتصويرها بالتطرف الديني. وخلال معظم حقبة الستينات فإن الحكمة الشائعة وسط كثيرين من خبراء التنمية وعلماء اللاهوت والتي يمكن اختصارها هنا كانت كما يقول المثل القديم «كل يوم وبكل الطرق كل شيء يسير نحو العلمانية والتحديث أكثر وأكثر» وارتبطت تعريفات التحديث بتطور الغرب وعلمنة المجتمع ومؤسساته ومنظماته ومحرِّكيه وعكَس الدين والفكر اللاهوتي نفس المسلمات عندما تحدث علماء اللاهوت عن ضرورة تحرير النصوص الدينية من الخرافة، وعن تطوير التعاليم المسيحية لتواكب العصر، وعن انتصار المدينة العلمانية «كما حددها أوغسطين بمدينة الله»، وظهرت مدرسة في التفكير الديني عرفت باسم «النظرية اللاهوتية لموت الإله» وأصبحت العقيدة الدينية في أحسن الأحوال مسألة خاصة.
كما أن درجة التقدم الفكري والجدية في الإسلام الأكاديمي أصبحت تقاس دائمًا وتساوى بالعلمانية الليبرالية والنسبية التي أصبحت تتناقض مع الدين، ورغم اعترافهم بفائدة الذهاب إلى الكنيسة والمعبد اليهودي فإن معظم السياسيين كانوا يتفادون النقاش حول معتقداتهم أو المسائل الدينية.
إن القبول بالمفهوم الواعي الفصل الكنيسة عن الدولة، وبالنماذج العلمانية الغربية للتطور قد وضع الدين جانبًا مع المعتقدات التقليدية التي لها قيمة كبيرة عند فهم الماضي ولكنها غير ملائمة وتعتبر عقبة أمام التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحديث، إن كلًا من نظرية التنمية أو العلاقات الدولية لم تعتبر الدين عنصر تغيير في التحليل السياسي.
لقد تجاهل فصل الدين عن الدول حقيقة، إن معظم التقاليد الدينية قد نشأت وتطورت خلال إطار تاريخي وسياسي واجتماعي واقتصادي وتتضح هذه الحقيقة بجلاء في التاريخ الإسلامي وبصورة أكثر وضوحًا في اعتقاد كثير من المسلمين ومن المفارقات أن بعض المحللين أصبحوا مثل رجال الدين المحافظين في كل أنحاء العالم حيث أصبحوا يعالجون المعتقدات والممارسات الدينية كلٌّ على حدة كحقائق مجردة أكثر من كونها نتاجًا للعقيدة والتاريخ أو بصورة أدق نتاج العقيدة عبر التاريخ.
إن التقاليد الدينية والتي تتميز بأنها محافظة وتقليدية، تعتبر نتاج عملية تغيير ديناميكية تنتقل فيها كلمة الوحي من خلال تفسير بشري أو خطاب يجيء كاستجابة لأمر ما في إطار تاريخي - اجتماعي معين إن محاولة تعريف الدين في مرحلة ما بعد الوعي الفكري الحديث باعتبار أنه نظام اعتقاد شخصي أكثر من كونِهِ طريقة للحياة قد عرقلت بصورة خطيرة قدرتنا على فهم طبيعة الإسلام وعدد من الأديان العالمية الأخرى، لقد فرض هذا الفهم تغليفًا مزيفًا للدين، بدلًا من كشف الطبيعة الديناميكية الداخلية للأديان، وانطلاقًا من هذا المفهوم فإن الدين الذي يمزج الدين بالسياسة يبدو متخلفًا ينزع نحو التطرف وبالتالي يكون مصدر خطر.
لقد اعتبر الإسلام عمومًا في الغرب «وبين العديد من المسلمين العلمانيين» كظاهرة متخلفة وجامدة من ناحية تعليمية واجتماعية – ثقافية، وبالتالي ضد التحديث، وعزز هذا الفهم ما كان سائدًا من اتجاهات لتحليل مثل تلك المفاهيم باعتبار أنها إغلاق لباب الاجتهاد الديني أو الإصلاح في القرن العاشر الميلادي، كان هناك العديد من الخبراء المدرسين في مجال الدراسات الميدانية بواسطة أساتذة «مؤرخين وعلماء اجتماع» ذوي خبرة قليلة في الدين الإسلامي، وفي التاريخ والعلوم السياسية حيث كان الإسلام يعالج أساسًا كموروث ثقافي وحقبة تاريخية تدرس لعلاقتها بالماضي أكثر من الحاضر، وكانت الدراسات الإسلامية موجهة من ناحية نصية وتاريخية وبتركيز قليل على العلوم الاجتماعية وبأقل اهتمام بعلاقته بالعصر الحديث، وكانت تغطية الفترة الحديثة أي القرن التاسع عشر والقرن الحالي تنحصر في الكتب الدراسية في فقرة واحدة كانت تعتبر أقصر الفقرات في المواد الدراسية، وكانت أهمية المسائل وضرورتها تحدَّد بطريقة غير مباشرة من خلال الحلقات الدراسية «الكورسات» والتحليلات الخاصة بالإسلام المعاصر، وعلى وجه التحديد التحديث الإسلامي والذي توقف في عام ۱۹۳۸
والعامل الثاني الذي وقف عقبة أمام تحليلاتنا للبُعد الإسلامي والديناميكية في المجتمع الإسلامي هو التقوقع الصفوي العلماني. إن تركيز النظر على الأنظمة والصفوة يعكس انحيازًا مما يؤثر على فهم طبيعة الحركات الشعبية عمومًا والحركات الإسلامية على وجه التحديد، ومثل هذه النظرة
تعزز فكرة أن الدين منطقة مقفولة لرجال الدين التقليديين «الملالي» والعلماء والجماهير من غير المتعلمين والأمِّيين ويعتقد قلة من العلماء في الشرق الأوسط أو المجتمعات الإسلامية الأخرى أن من الضروري والمفيد التعرف والالتقاء برجال الدين وزيارة مؤسساتهم الدينية للوقوف على بعض الأفكار والمعلومات الخاصة بدورهم القيادي في المجتمع لقد كان العلماء يُنظر إليهم دائمًا بأنهم عديمو الجدوى والفائدة وذوو أهمية هامشية وكان معظم المفكرين الغربيين ومعهم لفيف من المفكرين الإسلاميين من ذوى الثقافة الغربية يدرسون ويعملون في ارتياح شديد مع شاكلتهم من الصفوة الغربية في مجتمعات حديثة وحضرية، كما أن معظم المفكرين الغربيين كانوا ينظرون إلى المجتمعات الإسلامية من خلال المعيار الحديث النظرية النمو القائمة على أسس علمانية غربية، في مبادئها ودراسة المجتمعات حسب توجيهات الصفوة التي تنزل إليهم من أعلى. ونتيجة لذلك فإن المحللين الأكاديميين والرسميين وأجهزة الإعلام قد انزلقوا في نفس الخطأ بتركيزهم النظر إلى الشريحة الصغيرة والقوية من الصفوة العلمانيين في المجتمع وبمساواتهم بين العلمنة والتقدم، وبين الدين والتخلف والمحافظة، وبالاعتقاد بأن التحديث والتغريب توأمان بالضرورة. وتبعًا لذلك فإن الخيارات المتاحة لحدوث تطور سياسي واجتماعي للمجتمعات المسلمة كان ينظر إليها من منظور المقارنة والمفاضلة الشد والجذب بين التقاليد والحداثة، والماضي والمستقبل والمدرسة «المعهد أو الكلية الدينية» والجامعة والحجاب واللباس الغربي أو القيم الغربية.
إن تحليلات إدوارد سعيد الانتقادية عن الشرق، ورغم أنها كانت في وقت ما جارحة إلا أنها كانت عميقة في تحديدها لأوجه القصور والانحياز الذي اتسم به الأكاديميون والمفكرون في الماضي. وهكذا ظهرت أنماط فكرية مشرقية حديثة على أيدي أولئك الذين يقارنون ويساوون بين التجديدية والأصولية أو الحركات الإسلامية كلها مع الحركات الثورية. وفشل هؤلاء في النظر إلى الأغلبية الكبيرة من الإسلاميين الملتزمين بالإسلام وينتمون في ذات الوقت إلى التيار العام للمجتمع الإسلامي.
وهكذا فإن الأكاديميين والحكومة وأجهزة الإعلام تناولوا ظاهرة العنف من الأطراف والحواشي وفشلوا في رؤية الغابة لتركيزهم النظر على بعض الأشجار، فهم لم يدرسوا بعناية الحركات السياسية وغير السياسية المعتدلة، وقد قوي هذا الاتجاه «والقصور» مع حقائق ومعطيات الأسواق المفتوحة فدور النشر والصحف ومكاتب الاستشارات وأجهزة الإعلام، كلها تبحث عن المواضيع اللافتة للنظر والانتباه وكلها تؤكد الأساليب النمطية والمخاوف من التطرف والإرهاب، انظر لترى كم مرة ترِدُ الإشارة إلى أي منظمة إسلامية مقرونة بصفات مثل «الأصولية»، و«المحافظة» و«التشدد» وبالنسبة لأولئك الذين يؤيدون الليبرالية العلمانية أو التقاليد اليهودية. المسيحية الليبرالية، فإن أي إقحام للدين في السياسة يُنظر إليه دائمًا بأنه خطر وأصولي. إن هذا المفهوم قد تعزَّز مع تدنِّي معرفتنا بالجماعات الدينية وانحصارها في أولئك الذين يمثلون الأقلية الراديكالية، قارن بين نشاطات «جماعة التبليغ» و«منظمات الجهاد» المتعددة. فالمجموعة الأولى جماعة تبشيرية إسلامية ضخمة تضم الملايين من الأعضاء وهي منظمة غير سياسية، بينما المجموعة الثانية تضم منظمات راديكالية متطرفة لا يتجاوز عدد أفرادها المئات وتقوم من وقت لآخر بأعمال عنف والتي تكون عنيفة للغاية أحيانًا، ولكنها تودي فقط بحياة قليلين، وقارن أيضًا بين الدراسات المفيدة والتقارير الإعلامية عن الحركات الإسلامية المعتدلة مثل حركة الإخوان المسلمين في مصر، والجماعة الإسلامية في باكستان وجمعية الإصلاح في الكويت وحركة النهضة في تونس خلال السنوات العشرة الماضية، وبين الحركات الإسلامية الراديكالية، ومع وجود قيادات إسلامية كبيرة وحركات إسلامية كبيرة في عدد من الدول الإسلامية فإن معرفتنا بأفكارهم وبمنظماتهم وبرامج الحركات الإسلامية ظلت محدودة بصورة تثير الدهشة .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل