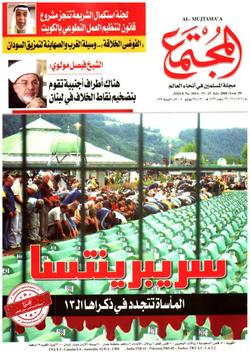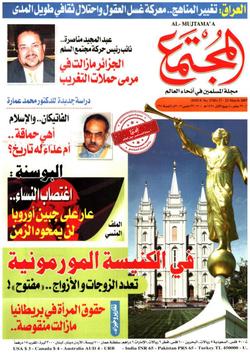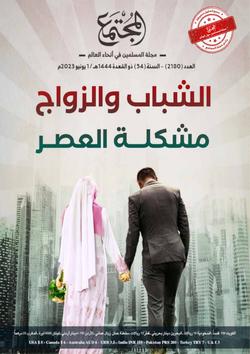العنوان التوازن الفريد داخل الأسرة المسلمة
الكاتب ا. د. عماد الدين خليل
تاريخ النشر السبت 19-مارس-2005
مشاهدات 21
نشر في العدد 1643
نشر في الصفحة 66
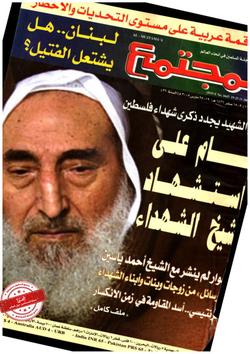
السبت 19-مارس-2005
يمكن اعتبار ظاهرة «التوازن» ملمحًا من أهم ملامح حضارتنا وأكثرها خصوصية وارتباطا بشخصيتها الإسلامية التوازن في سائر الاتجاهات، وعلى الجبهات كافة. إنه بأطرافه المتقابلة وثنائياته المتوافقة بمثابة السدى واللحمة في النسيج.. هذا التوازن الذي يتصادى هنا وهناك، في النظرية والتطبيق على السواء... إنه في صميم فكر الإسلام وفي قلب صيرورته الحضارية.
إن القرآن الكريم يقولها بوضوح، ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ﴾ (البقرة: 143) والوسطية هنا ليست موقعا جغرافيًا، ولكنها موقف عقدي، وإستراتيجية عمل ورؤية نافذة لموقع الإنسان المؤمن في الكون والعالم. إنها القدرة الدائمة على التحقق بالتوازن، وعدم الجنوح صوب اليمين أو الشمال، ومن خلال هذه القدرة يتحقق مفهوم الشهادة على الناس، لأنها تطل عليهم من موقع الإشراف المتوازن الذي لا يميل ولا يجور.
ورغم أن هذا التوازن قد تعرض على المستوى التاريخي، للتأرجح بين الحين والحين، إلا أنه في إطار التجربة الإسلامية يظل بين سائر التجارب الأخرى في العالم، أكثرها وضوحًا وتألقًا. إنها الحضارة التي قدرت، انطلاقا من رؤيتها هذه، على أن تجمع في كل متناسق واحد الوحي والوجود والإيمان والعقل، والظاهر والباطن والحضور والغياب والمادة والروح، والقدر والاختيار والضرورة والجمال والطبيعة وما وراءها والتراب والحركة، والمنفعة والقيمة والفردية والجماعية والعدل والحرية، واليقين والتجريب، والوحدة والتنوع والإشباع والتزهد، والمتعة والانضباط، والثبات والتطور والدنيا والآخرة والأرض والسماء والفناء والخلود. ونريد أن نقف قليلًا عند واحدة من توازنات الحضارة الإسلامية، وهي الوحدة والتنوع. فلقد قدم التاريخ الإسلامي في نسيج فعالياته الحضارية نموذجًا حيويًا على التناغم بين هذين القطبين اللذين ارتطما وتناقضا في الحضارات الأخرى، ووجدا في الإطار الإسلامي فرصتهما الضائعة للتلاؤم والانسجام. فالحضارة الإسلامية هي - من ناحية - حضارة الوحدة التي تنبثق عن قاسم مشترك أعظم من الأسس والثوابت والخطوط العريضة بغض النظر عن موقع الفعالية في الزمن والمكان، وعن نمطها وتخصصها. وهي -من ناحية أخرى -حضارة الوحدات المتنوعة بين بيئة ثقافية وأخرى في إطار عالم الإسلام نفسه، بحكم التراكمات التاريخية التي تمنح خصوصيات معينة لكل بيئة تجعلها تتغاير وتتنوع فيما بينها في حشود من الممارسات والمفردات.
إنها جدلية التوافق بين الخاص والعام، تلك التي أكدها القرآن الكريم في الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ﴾ (الحجرات: ١٣).
وهو يتحدث عما يمكن تسميته بالأممية الإسلامية التي تعترف بالتمايز بين الجماعات والشعوب والأمم، ولكنها تسعى لأن تجمعها في الوقت نفسه على صعيد الإنسانية وهي محاولة تختلف في أساسها عن الأممية الشيوعية التي سعت - ابتداء.
وبحكم قوانين التنظير الصارمة إلى إلغاء التنوع ومصادرته وإلى تحقيق وحدة قسرية ما لبثت أن تأكد زيفها وعدم القدرة على تنفيذها تاريخيا بمجرد إلقاء نظرة على خريطة الاتحاد السوفييتي «المنحل» حتى قبل حركة «البرسترويكا» والرفض المتصاعد الذي جوبهت به الأممية الشيوعية من قبل حشود الأقوام والشعوب التي تنتمي إلى بينات ثقافية متنوعة. إن مقارنة هذا بما شهده التاريخ الإسلامي من تبلور كيانات ثقافية إقليمية متغايرة في إطار وحدة الثقافة الإسلامية وثوابتها وأسسها الواحدة وأهدافها المشتركة توضح مدى مصداقية المعالجة الإسلامية لهذه الثنائية كواحدة من حشود الثنائيات التي عولجت بنفس القدرة من الواقعية في الرؤية والمرونة في العمل.
لقد شهد عالم الإسلام أنشطة معرفية متمايزة وثقافات شتى على مستوى الأعراق التي صاغتها.. عربية وتركية وفارسية وهندية وصينية ومغولية وزنجية وإسبانية.. الخ. كما شهدت أنماطًا ثقافية على مستوى البينات والأقاليم عراقية وشامية ومصرية ومغربية وتركستانية وصينية وهندية وإفريقية وأوروبية شرقية وإسبانية وبحر متوسطية.. إلخ..
وكانت كل جماعة ثقافية تمارس نشاطها المعرفي بحرية وتعبر من خلاله عن خصائصها، وتؤكد ذاتها، ولكن في إطار الأسس والثوابت الإسلامية.. بدءًا من قضية اللغة والأدب وانتهاء بالعادات والتقاليد، مرورًا بصيغ النشاط الفكري والثقافي بأنماطه المختلفة. ولم يقل أحد إن هذا خروج عن مطالب الإسلام التوحيدية، كما أن أحدًا لم يسع إلى مصادرة حرية التغاير هذه. وفي المقابل فإن أيًّا من هذه المتغيرات لم يتحول إلا في حالات شاذة. إلى أداة مضادة لهدم التوجهات الوحدوية الأساسية لهذا الدين إننا إذا استعرضنا في الذهن منظومة الكيانات السياسية في التاريخ الإسلامي، أو ما أطلق عليه اسم «الدويلات الإسلامية» التي تجاوزت في عددها العشرات من مثل الأدارسة والأغالبة والمرابطين والموحدين والحفصيين، والطولونيين والإخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك في مصر والشام.. إلخ.. فإننا سنجد من وراء التمزق السياسي أو بموازاته، تغايرًا في التعبير الثقافي ولكن في دائرة الإسلام، وسنجد كذلك حماسًا لم يفتر عما كان عليه أيام وحدة الدولة الإسلامية، لتحقيق المزيد من المكاسب لهذا الدين وعالمه: نشرًا للإسلام في بينات جديدة. إنها – باختصار - وكما أطلق عليها المستشرق المعروف «فون غرونباوم» في كتاب أشرف على تحريره بالعنوان نفسه: حضارة الوحدة والتنوع.