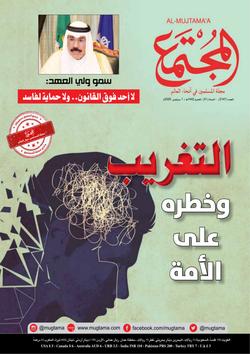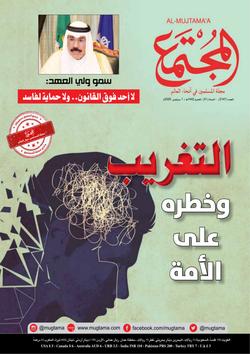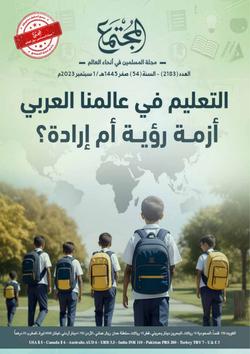العنوان السينما العربية والتغريب.. واقع الصناعة وأبعاد التأثير
الكاتب د. مصطفى جمعة
تاريخ النشر الثلاثاء 01-سبتمبر-2020
مشاهدات 18
نشر في العدد 2147
نشر في الصفحة 30
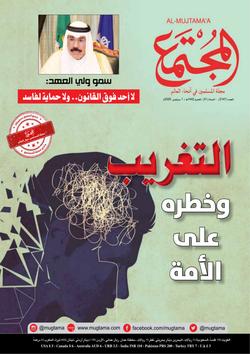
الثلاثاء 01-سبتمبر-2020
- السينما
تأتي ضمن منظومة الصناعات الثقافية التي تستقطب ملايين الكوادر وهي حاملة للهويات
الثقافية ومروجة لقيمها.
- العالم
العربي اضطر لفتح أسواقه السينمائية للاستيراد الأجنبي وهو ما أحدث غزوًا ثقافيًا
وتغريبيًا.
- التغريب
بالسينما العربية كامن في جذورها بحكم أن صانعيها الأوائل كانوا من الأجانب.
تُعد
السينما من أعظم المؤثرات في الثقافة والوعي وتشكيل التحيزات والترويج للأفكار،
نظرًا لأنها وسيلة شديدة الجاذبية عظيمة التشويق متعددة الجماليات، فهي تجمع الصوت
والصورة، والحركة والموسيقى، والقصة الشيقة والأحداث المتتابعة، والشخصيات
المثيرة، وهو ما جعلها ذات رصيد جماهيري هائل.
وعندما
نتناول قضية التغريب في السينما العربية، فإننا نناقش واقعًا معيشًا، ليس وليد
اليوم، وإنما يمتد بجذوره منذ السنوات الأولى لصناعة السينما، وحتى استواء عودها
وتكوين قاعدة إنتاجية تشمل معاهد متخصصة، وأستوديوهات وشركات منتجة، ورصيدًا ضخمًا
من التراكم الإبداعي والإنتاجي، شكّل في مجموعه ملامح السينما العربية سواء في مصر
بوصفها «هوليوود الشرق» كما يطلق عليها، أو في بقية الدول العربية مع مراعاة
التفاوت في حجم الإنتاج السينمائي، ومستوى جودته.
يُعرف
التغريب اصطلاحًا بأنه حالات التعلق والانبهار والإعجاب والتقليد والمحاكاة
للثقافة الغربية؛ والأخذ بالقيم والنظم وأساليب الحياة الغربية؛ بحيث يصبح الفرد
أو الجماعة أو المجتمع المسلم غريبًا في ميوله وعواطفه وعاداته وأساليب حياته
وذوقه العام وتوجهاته في الحياة؛ ينظر نظرة إعجاب وإكبار إلى الثقافة الغربية وما
تشتمل عليه من قيم ونظم ونظريات وأساليب حياة؛ ويرى في الأخذ بها الطريقة المثلى لتقدم
جماعته أو أمته الإسلامية (1).[1]
فالتغريب
ليس تأثيرًا فكريًا فحسب، وإنما يمتد ليشكل التوجهات والسلوكيات ويصنع تحيزات
بعينها، تُعلي من ثقافة الغرب وممارساته الحياتية، بجانب الترويج لأنماط الحياة
والملابس والتقاليد والعادات، ليصبح تقليد الغرب واقعًا معيشًا في المجتمع وبمرور
الزمن وتتابع السنوات تنشأ أجيال تهجر ثقافتها وقيم الإسلام، وتحيا حياة تشابه
الغرب في مجتمع الشرق.
ذلك
الدور الذي قامت به السينما في عالمنا العربي بشكل واضح، وبدا واضحًا مع انتشار
الأفلام الأجنبية المستوردة التي لا تزال تحتل المساحة الأكبر في دور السينما
العربية، وكما يشير «جان الكسان» فإن اكتساح الأفلام الأمريكية في الدرجة الأولى،
ثم الآسيوية والأوروبية بعدها؛ إنما هو عائد إلى ضخامة الإنتاج العالمي، وعدم قدرة
صناعة السينما العربية على منافسة الأجنبي، نظرًا لمحدودية تكلفتها، وضعف تقنياتها،
وقلة إنتاجها، والأفلام الأجنبية جزء من تركة الاستعمار الغربي في بلادنا، التي لا
تزال مستمرة، إن لم تكن قد زادت بجانب سيطرة القطاع الخاص في غالبية البلدان
العربية على دور السينما وشركات الإنتاج (2).
وهي
تتعامل بمنطق رأسمالي تجاري بوصفه الغاية الأولى فوق أي قيم أو سلوكيات أو مضامين
راقية، فلا يسعها إلا أن تستورد أفلامًا تروّج للحياة الغربية بكل ما فيها من
سلوكيات سلبية، ودغدغة لمشاعر المشاهدين وغرائزهم، وإن تصدت هذه الشركات للإنتاج
فإنها لا تضع نصب عينيها التشويق والإثارة لتحقيق أكبر ربحية لنكتشف أن الأمر لم يعد
تغريبًا مقتصرًا على الحياة الغربية وإنما اتسع ليشمل مؤثرات من شرقي آسيا من خلال
انتشار الأفلام الهندية والصينية والكورية وغيرها، وما زلنا نتذكر أفلام بروس لي
الصينية «1940- 1973م»، التي انتشرت في الستينيات والسبعينيات التي حملت التوليفة
المعروفة «الإثارة والحب والمعارك»، وقد صنع على غرارها فيلم الكاراتيه المصري
«الأبطال» «1974م» من بطولة أحمد رمزي، وجاءت أيضا سلسلة الأفلام الهندية «أميتاب
باتشان» «1969- 2017م»، التي زادت على 100 فيلم، وقد أضافت على التوليفة السابقة
الغناء والرقص والموسيقى الهندية الصاخبة، وحملت إلينا فيما حملت سلوكيات
المجتمعات الآسيوية، وعرّفت الجمهور بالبوذية وشعائرها.
توازى
هذا مع الأفلام الأمريكية التي اعتمدت على حروب العصابات، مثل سلسلة أفلام روكي» «1974-
1990م»، والتمجيد للبطل الأمريكي وأنماط الحياة الأمريكية، واحتقار المنافس
السوفييتي، إبان فترة اشتعال الحرب الباردة في نهاية القرن العشرين، وبالطبع كانت
الأفلام المعروضة للجماهير العربية أفلامًا تجارية في المقام الأول، وهناك أفلام
أجنبية راقية عميقة المضمون، جيدة الطرح، وهذه لا تجد حظها في قاعات السينما
العربية، وربما تعرض في بعض القنوات التلفازية العربية.
وتكمن
المشكلة في تدني حجم الإنتاج السينمائي العربي على الخريطة السينمائية العالمية،
فلا تزال السينما العربية لا تجد الدعم المادي والمعنوي المناسبين، ويكفي أن نقرأ
تقرير «يونسكو» عن حجم الإنتاج السينمائي في العالم لنعرف موقعنا؛ فالهند وفق
الإحصاءات الأخيرة، تحتل المركز الأول عالميًّا، من خلال ما تنتجه مدينة بوليوود
السينمائية بحوالي 1091 فيلمًا سينمائيًا طويلًا في العام، مقابل 872 فيلمًا
أنتجتها صناعة السينما في نيجيريا «نوليوود»، بينما أنتجت هوليود بالولايات
المتحدة الأمريكية 485 فيلما طويلًا، وفيما عدا هذه البلدان الثلاثة، فإن 8 بلدان
أخرى تنتج أكثر من 100 فیلم سنويًا، وهي اليابان «417»، والصين «330» وفرنسا «203»، وألمانيا «١٤٧» وإسبانيا «150»،
وإيطاليا «116»، وكوريا الجنوبية «110»، والمملكة المتحدة «104».
وذكر
التقرير أن السينما تأتي ضمن منظومة الصناعات الإبداعية والثقافية التي تستقطب
ملايين الكوادر، كما أنها حاملة للهويات الثقافية ومروجة لقيمها، وهي في الوقت
نفسه تفتح الأبواب أمام الحوار والتفاهم المتبادل بين الشعوب، فضلًا عن تحقيق
النمو الاقتصادي والتنمية (3).[2]
وكما
نرى، فإن القائمة تخلو من الدول العربية، فلا توجد دولة عربية تنتج 100 فيلم في
السنة الواحدة، بما يجعل العالم العربي مضطرًا لفتح أسواقه السينمائية للاستيراد
الأجنبي، وهو ما يعني غزوا ثقافيًا وتغريبيًا بشكل دائم لما يبثه الفيلم الواحد من
آثار ورسائل وأفكار مباشرة أو غير مباشرة، ولعل المثال على ذلك أفلام الجريمة، فقد
ذكرت دراسة ميدانية لوزارة الإعلام الكويتية تحت عنوان دور وسائل الإعلام في نشر
العنف والجريمة بين الشباب، أن الأفلام الأجنبية البوليسية تحتل المركز الأول في
المشاهدة وأن 13% من أفراد العينة البحثية يتقمصون شخصية البطل بشكل كبير، وأن 22%
يمكنهم إلى حد ما تقمص الشخصيات، وقد فضل 89% أن ينال المجرم عقابه، في حين فضل
11% إفلات المجرم من العقاب.
وأظهرت
الدراسة أن تأثير مشاهد العنف على الشباب قد يكون لحظيًا أو يمتد ليخزن في العقل
الباطن ويظهر على المشاهد بعد فترة، وعادة ما يكون مدمرًا لنفسه أو لغيره حيث يشعر
70% بالانسجام مع تلك المشاهد وهناك 37.5% يصابون بالخوف والفزع و27% يرون أحلامًا
مزعجة (4)[3]،
والأمر ينطبق أيضًا على أفلام الأكشن والرعب.
جذور
التغريب السينمائي
أما
التغريب في السينما العربية فهو كامن في جذورها، ومنذ نشأتها، بحكم أن صانعي
السينما الأوائل في مصر على سبيل المثال كانوا من الأجانب، وهؤلاء بثوا رؤى
وأفكارًا تنسجم مع توجهاتهم الخاصة، فمؤسس أول شركة للإنتاج السينمائي وأيضًا أول
أستوديو سينمائي بالإسكندرية هو «توجو مزراحي»، وهو يهودي الديانة، وينتمي لعائلة
يهودية مصرية ثرية، وذلك خلال عامي 1929، 1930م، وكان فيلم «الهاوية» هو باكورة
إنتاجه، وعرض في سينما بلفي بالإسكندرية ثم في سينمات القاهرة عام 1931م، واستمر
شخصًا مؤثرًا، ويعد من أهم صناع السينما المصرية حتى العام 1948م، قبل أن يهاجر
إلى إيطاليا ويستقر بها (5).
وكان
كثير من الأجانب يعملون ككوادر فنية في السينما المصرية، خاصة الإيطاليين، علي
مستوى الإخراج والمونتاج والتصوير، وأيضًا في العملية الإنتاجية، وشايعهم
السينمائيون المصريون الذين تأثروا بهم مباشرة، أو تعلموا في الغرب، وعادوا مشبعين
بالسينما الغربية بكل ما فيها، من نزعات تغريبية، تقدم الغرب بوصفه نموذجًا في
الرقي والتقدم العلمي والإنساني والاجتماعي.
وقد
أكثر صناع السينما في مصر، خلال الثلاثينيات والأربعينيات، في الاقتباس من السينما
العالمية مثل يوسف وهبي «1898- 1982م»، وأنور وجدي «1904- 1955م»، فتم تمصير
الكثير من القصص العالمية، وتقديمها إلى الجمهور المصري، ومن أبرز هذه الأفلام
فيلم «أمير الانتقام» لأنور وجدي «1950م»، وهو مقتبس من رواية «الكونت دي مونت
كريستو» للكاتب الفرنسي «ألكسندر دوماس»، وأعيد تقديمه عام 1963م من بطولة فريد
شوقي باسم «أمير الدهاء»، وما الاقتباس إلا شكل غير مباشر لترسيخ القيم الغربية
وتصوراتها.
مظاهر
تغريبية
لقد
أضحى كثير من الأفلام المصرية نسخًا من الأفلام الأجنبية، خاصة الأفلام الغنائية،
وكما تشير «موسوعة السينما العالمية»، فإن الأفلام الموسيقية لفريد الأطرش، ومحمد
عبد الوهاب، وأم كلثوم ثم عبد الحليم حافظ، جاءت تقليدًا لمثيلاتها في السينما
الغربية، وإن كانت لا تنافسها على المستوى الفني والتقني (6)[4]،
وقس على ذلك كثيرًا من الموضوعات التي درج صناع السينما المصرية -وأيضًا العربية
بعد ذلك- على تقديمها، حيث تم تصوير الحياة الحديثة بأنها الحياة الغربية بما فيها
من مباهج، فكثرت مشاهد الرقص المصحوبة بالأغاني، وغلبت الأفلام الرومانسية،
والإسراف في قصص الحب والغرام، ولقاءات العشاق، وإن حاولوا تمصيرها من خلال لقاءات
على أسطح المنازل أو على شاطئ البحر أو النيل وفي الحقول، وكأن الحياة لا شيء فيها
إلا الركض خلف الحبيب، والفوز بقلبه، ناهيك عن مشاهد العلاقات الحميمية والقبلات
التي لم يخل منها فيلم إلا نادرًا.
وكانت
الخمر جزءًا لا يتجزأ من مشاهد الأفلام يشربها البطل إذا كان مأزومًا نفسيًا،
فيلوذ بها هاربًا من أزمته النفسية كما يعب منها البطل أيضًا إذا كان سعيدًا مبتهجًا،
وكأن شرب الخمر سلوك مألوف لدى الشعب المصري.
على
صعيد آخر، سعت السينما إلى تقديم الفتاة النموذجية بأنها الفتاة المتبرجة، التي
تخرج للتعليم والعمل وتحرص على اختيار شريك حياتها، أما الحجاب فلا تظهر به إلا
العجائز أو النساء الريفيات، وكأن التحضر مرتهن بخلعه، وهو من الرسائل المبطنة
التي حملتها السينما العربية والمثال على ذلك فيلم «الباب المفتوح» «1963م» من
بطولة فاتن حمامة، وصالح سليم، فالفتاة المثقفة المناضلة هي التي ترفض الزواج
التقليدي، وتصر على التعليم الجامعي، وتتمسك بمن أحبت.
أما
شخصية المسلم المتدين، فقد جاءت منزوية، وإن ظهرت في بعض الأفلام، فهي تبدو في
شخصية الشيخ «حسن البارودي» الذي ينافق العمدة، ويبيح له تطليق زوجة من زوجها، ثم
زواج العمدة منها قسرًا، ويقنع زوجها المسكين بقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ﴾ (النساء: 59)، وذلك في فيلم «الزوجة
الثانية» «1967م»، أو في صور التعلق بالأضرحة والتبرك بها من جانب العامة البسطاء
الذين يتبركون بزيت قنديل السيدة زينب في القاهرة، ويتداوون به، ثم يأتي طبيب
العيون خريج ألمانيا فيواجه هذا الدجل، كما في فيلم «قنديل أم هاشم» «1963م»، وكأن
العلم الحديث يعادي الدين، بدون التفرقة بين الممارسات البدعية الخطأ، ومفهوم
الإسلام الصحيح الذي يدعو للعلم والتقدم فربط التدين بخرافات البدع والتبرك
بالمقامات.
ودومًا
ما حفلت الأفلام المصرية بشخصية الدرويش المنعزل عن مشكلات الحياة الدنيا الذي
ينطق بهرطقات ينهيها بترديد كلمة «حي.. حي»، مثلما نراه في فيلم «عنتر ولبلب» «1952م»،
الذي يحمل دلالة سياسية تتمثل في الصراع بين ابن البلد الذكي اللماح «محمود شكوكو»،
وسطوة المستعمر وتجبره بالقوة المفرطة «سراج منير»، وكلما اشتد الصراع، نرى
الدرويش يهرطق، ثم ينزوي مختفيًا، والأمر نفسه نجده في فيلم «اللص والكلاب» «1962م»،
عن رواية لنجيب محفوظ، وفيها صراع بين اللص المغرر به من طرف أحد الصحفيين
الماركسيين، ودفعه إلى استحلال مال الأغنياء، ثم وشى به وأدخله السجن، وخرج اللص
لينتقم منه، ونرى الدرويش غائبًا عن الصراع في الدنيا، في خلوة دائمة بالزاوية غير
منتبه إلى شكوى اللص، ولا يجيب عن تساؤلاته هل كان على صواب عندما سرق أو عندما
قتل انتقامًا!
إن
السينما أداة عظيمة التأثير، ولا بد من استثمارها في بث القيم والأخلاق الفضيلة
والتعبير عن هوية المجتمع، ومناقشة مشكلاته وأزماته، وأيضًا تطلعاته وأحلامه، ولا
بد من وضع خطط وطنية، تدعم صناعة السينما لتكون سينما تصوغ هويتنا الثقافية
النابعة من الإسلام والعروبة، ولا تتركها عرضة لتقلبات السوق، وأهواء المنتجين
الراكضين خلف الأرباح، ولا لتكون ساحة مستباحة للأفلام الأجنبية بكل ما تحمله من
تغريب، وانمحاء للهوية وتغييب الذات الوطنية وقضاياها الحياتية.
[1] (1) التغريب والغزو الصهيوني،
عمر التومي الشيباني مجلة الثقافة العربية طرابلس، ليبيا، ع. 10، 1982، ص 162.
(2) السينما
في الوطن العربي جان الكسان، سلسلة عالم المعرفة 1982، ص٨، ٩.
[2] (3) موقع اليونسكو «منظمة الأمم
المتحدة للثقافة والعلوم»، http://www.unesco.org/new/
ar/culture/themes/dynamic-content-single-view/news/nollywood_
rivals_bollywood_in_filmvideo_ /production
[3] (4) موقع وكالة الأنباء
الكويتية «كونا» https://www.kuna.net.kw/Article
PrintPage. Aspxsid=1206511&language=ar
(5) من
ذاكرة السينما: توجو مزراحي، مجلة ذاكرة مصر، مكتبة الإسكندرية، أكتوبر 2015، ص
57.
[4] السينما العربية، في موسوعة تاريخ السينما في العالم، ترجمة: أحمد يوسف،
المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 2010، ج 3، ص 565، 566.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل