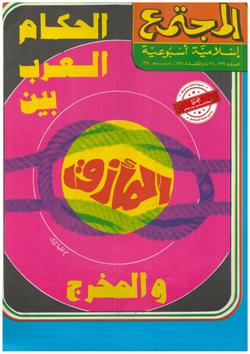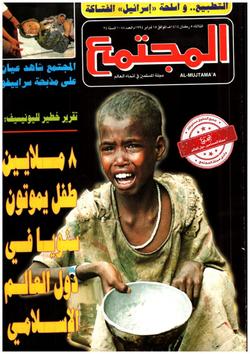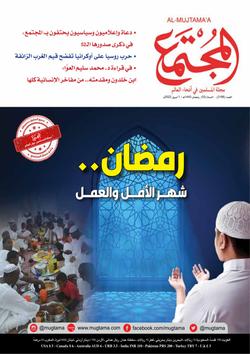العنوان الفرقة بين المسلمين.. أسبابها وعلاجها (5)
الكاتب د. محمد عبد الغفار الشريف
تاريخ النشر الثلاثاء 20-أكتوبر-1981
مشاهدات 18
نشر في العدد 547
نشر في الصفحة 33
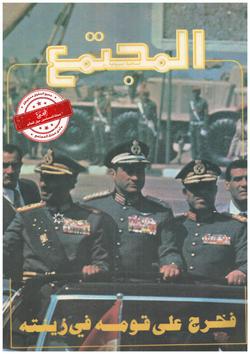
الثلاثاء 20-أكتوبر-1981
- علم الأصول عمود الاجتهاد وأساسه الذي يبنى عليه.
- أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علماً
- والإجماع حجة في الشريعة باتفاق علماء الأمة لم يشذ في ذلك إلا فئة قليلة من الناس.
وعدنا في الحلقة الماضية أننا سنتكلم في هذه الحلقة عن المفتي وشروطه وآدابه. وها نحن أولاء نفي بوعدنا إن شاء الله تعالى - قبل أن نبدأ بالتكلم عن شروط المفتي وآدابه ينبغي علينا أن نعرفه، فمن هو المفتي؟ المفتي اسم فاعل على وزن مفعل، مشتق من الإفتاء بمعنى الإبانة، يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه له، ويقال: أفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكمها.[1]
هذا هو تعريف المفتي في اللغة، أما في الاصطلاح : فالمفتي: هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله.
وقيل هو المخبر عن الله بحكمه، وقيل: هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه. [2]
منزلة المفتي في المجتمع المسلم
قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦). والعبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا بشرطين الإخلاص وموافقة الشرع.
أما الإخلاص فهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه نبي مرسل، ولا ملك مقرب، وأما موافقة الشرع فتتم بمعرفة أحكام الشرع في كل أمر من أمور الحياة، ولما كان ذلك لا يتسنى لكل إنسان من البشر لاختلاف الناس في ملكاتهم وقدراتهم، ولانشغالهم بأمور معيشتهم برزت أهمية وظيفة المفتي في المجتمع المسلم... فهو الموقع عن الله عز وجل، وهو الذي يبين للناس أحكام الله تعالى في أمور معيشتهم وفيما يقع بينهم. قال الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ١٢٢)
شروط المفتي
۱ - الإسلام.
٢ - التكليف - أي العقل والبلوغ.
3- العدالة.
قال ابن حمدان الحنبلي - رحمه الله تعالى[3]: أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع، لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه فاعتبر إسلامه وتكليفه لتحصل الثقة بقوله ويبني عليه كالشهادة والرواية.
ثم قال: والعدل من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق، وترك الحرام والمكروه والكذب مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم بجلب نفع ودفع ضرر ١٠هـ
1 - الاجتهاد:[4]
اشترط جمهور الأصوليين في المفتي أن يكون مجتهدا، لأنه يخبر بحكم الله عن دليل، ولكن ذهب بعض العلماء -تيسيرا على الأمة - إلى أن المفتي يكفي أن يكون متبحرا في مذهب إمامه، فاهما لكلامه، عالمًا لراجحه من مرجوحه، خبيرا بالمرجوع عنه من المرجوع إليه.
والذي نميل إليه -والله أعلم - رأي الجمهور، وهو اشتراط الاجتهاد في المفتي، بينما المقلد لا يعتبر مفتيًا، وإنما هو ناقل ينقل مذهب إمامه إلى الناس.
ولما كثرت دندنة الناس في هذه الأيام حول الاجتهاد، وادعى كل أخرم أنه مجتهد الأمة الذي قد جمع الله فيه ما لم يجمعه فيمن قبله ولا فيمن بعده، رأينا من الواجب علينا أن نذكر هنا شروط المجتهد، وما يحتاج إليه من آلات، ليتبين الزيف من الصحيح
سوف ترى إذا انجلى الغبار *** أفرس تحتك أم حمار
فعلاوة على الشروط الثلاثة السابقة التي ذكرناها للمفتي، يحتاج المجتهد إلى:
1 - العلم بكتاب الله تعالى
إذ هو أصل الأصول، ومرجع كل دليل، والواجب الذي يلزم المجتهد معرفته من كتاب الله ما يتعلق بالأحكام. قال الغزالي وغيره: والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدر خمسمائة آية. وقال غيرهم من الأصوليين وليس هذا التقدير بمعتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي، كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها فقل إنه يوجد في القرآن الكريم آية إلا ويستنبط منها شيء، وقد سلك هذا المسلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام فألف كتابه أدلة الأحكام لبيان ذلك. [5]
فلا بد للمجتهد إذن أن يعرف آيات الكتاب جميعها معرفة إجمالية، ويعرف آيات الأحكام معرفة تفصيلية. ولا يلزم المجتهد حفظ هذه الآيات عن ظهر قلب، وإنما يكفيه أن يعرف مواقع الحكم من فطانه ليحتج به عند الحاجة.
٢ - العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم[6]
والسنة تعتبر المصدر الثاني للتشريع، وهي الشارحة لكتاب الله عز وجل، والمبينة لمجمله المفصلة لعمومه وهي وحي من الله تعالى، قال تعالى ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم ٣-٤)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي أي من السنن التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع.. إلخ ويشترط على المجتهد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام وحقيقة ذلك ومجازه، وأمره ونهيه، ومجمله ومبنيه ومحكمه ومتشابهه، وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده، وناسخه ومنسوخه والمستثنى والمستثنى منه وصحيح السنة من ذلك وسقيمها، وتواترها وآحادها، ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها، وأن يعرف ترتيب السنة على الكتاب، وترتيب الكتاب على السنة حتى لو وجد حديثًا لا يوافق ظاهره الكتاب يهتدي إلى وجه محمله، فإن السنة بيان للكتاب لا تخالفه. [7]
3- العلم بلغة العرب
ويجب على المجتهد أن يكون عارفًا باللغة العربية على نحو يستطيع به فهم خطاب العرب، ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعبير، إما بالفطرة وإما بالتعلم بأن يتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف وأدب وبديع ومعان وبيان.. إلخ.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته[8]: وأن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها، ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن تخاطب بالعام مرادًا به ظاهره وبالعام يراد به الخاص ويعرف بالسياق، وبالكلام ينبئ أوله عن آخره وآخره عن أوله، وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ، كما تعرف بالإشارة وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد، ثم قال: فمن جهل هذا من لسانها - وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة - فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل ولم يثبته معرفة كانت موافقة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. هذا قوله رحمه الله تعالى، وهو الحق الذي لا محيص عنه.
وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى [9]: أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه، والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه.
4- العلم بأصول الفقه
لقد عرفنا علم الأصول في الحلقة الأولى من المقال - بأنه العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
يتبين لنا من التعريف أن هذا العلم من أهم العلوم الشرعية التي يجب على المجتهد أن يكون عالما بها. قال الأمام الرازي رحمه الله- في المحصول-: إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه.
إذ بهذا العلم يعرف المجتهد أدلة الشرع وترتيبها في الرجوع إليها، وطرق استنباط الأحكام منها، وأوجه دلالات الألفاظ على معانيها، وقوة هذه الدلالات، وما يقدم منها وما يؤخر، وقواعد الترجيح بين الأدلة إلى غير ذلك مما يبحثه علم أصول الفقه. وعليه أن يطيل النفس في تحصيل هذا العلم حتى يصير متمكنا منه بما تبلغ به طاقته، لأن هذا العلم هو عمود الاجتهاد وأساسه الذي يبنى عليه.
5 - العلم بمواقع الإجماع
والإجماع يعرف في الاصطلاح بأنه اتفاق المجتهدين من الأمة المحمدية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور الشرعية.
والإجماع حجة في الشريعة باتفاق علماء الأمة لم يشذ في ذلك إلا فئة قليلة من الناس. قال في المسودة[10]: والإجماع متى انعقد بشروطه كان دليلا قطعيا على حكم المسألة المجمع عليها، وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين لا تجوز معها المخالفة أو النقض10 هـ
والعلم بمواقع الإجماع شرط لصحة الاجتهاد، وليس شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد، لأنه كما قرر الجمهور من علماء الأصول أنه لا يجوز للمجتهد خرق الإجماع، وأن كل فتوى خرق بها صاحبها الإجماع فهي فتوى باطلة.
هذا وقد اشترط بعض علماء الأصول العلم بمواقع الخلاف بين الفقهاء، ولكنه ليس بشرط عند الجمهور، ولكن يستحب للمجتهد أن يطلع على مواقع الخلاف، وعلى أدلة كل فريق ليحكم فيها على بصيرة.
٦ - معرفة مقاصد الشرع
تقوم الشريعة الإسلامية على مقاصد وعلل تتحقق بها مصالح الناس. لذا يجب على المجتهد أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة. محيطا بعلل الأحكام ليستطيع استنباط الأحكام التي لم ترد بها النصوص من لوازم صحة الحكم مراعاة مصالح الناس، ويتم ذلك بالاطلاع على عادات الناس وأعرافهم التي لا تخالف الأحكام الشرعية - لأن مراعاتها مراعاة للقواعد الشرعية العامة.
- يجب على المفتي أن يتجنب التحايل لتحليل الحرام وتحريم الحلال لأنه مكر وخديعة.
7- أن تكون لدى المجتهد ملكة الاستنباط «أو أن يكون فقيه النفس»
بأن يكون ذكيا متوقد الذهن نفاذ البصيرة حسن الفهم، له عقلية فقهية قادرة على الاستنباط، لأنه كم ممن قرأ فنون العربية والعلوم التي تهيئ للاجتهاد ثم تراه جامدا حامل الفكر لا يعلم إلا ما يلقى إليه، فإذا خاطبته وجدت فهمه متحجرا تكلمه شرقا فيكلمك غربا، فمثل هذا لا يعول عليه ولا يركن إليه.
وبعد فهذه هي الشروط المتفق عليها بين العلماء التي إذا توفرت في الإنسان المسلم المكلف جاز له الاجتهاد في دين الله تعالى، وهناك شروط اخرى مختلف فيها غضضنا الطرف عنها، يستطيع الراغب أن يطلع عليها في كتب الأصول المختلفة.
و بالانتهاء من الحديث عن شروط الاجتهاد نكون قد انهينا الكلام عن شروط المفتي. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجنبنا مراكب الخطل والشطط.
آداب المفتي:
1- النية الصالحة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إلي» متفق عليه.
٢ - التقوى والورع
قال تعالى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ﴾ (البقرة:282). وقال سبحانه وتعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (النحل :١١٦). فيجب عليه أن يبتعد عن التساهل في الفتوى، وأن يتجنب التحايل لتحليل الحرام وتحريم الحلال لأنه مكر وخديعة وهما محرمان.
3- حسن الخلق
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن من أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا» رواه الترمذي وقال حديث حسن
فينبغي له أن يستقبل الناس بوجه طلق، وألا يضجر من المستفتي، وخصوصا وأن أكثر المستفتين يكون من العوام الذين يجهلون آداب الاستفتاء.
4- التأني في الفتوى
وفي الأثر «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار».
5 - مشاورة ذوي الدين والعلم والرأي قال تعالى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ۳۸) وكان من شأن عمر رضي الله عنه أنه إذا نزلت به مسالة أن يستشير أصحابه، حتى إنه كان يشاور ابن عباس رضي الله عنهما - وهو إذ ذاك أحدث القوم سنا –
6- التواضع ورؤية نفسه أنه ليس أهلا للفتيا، ف عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال[11]: ماافتيت حتى شهد لي سبعون من أهل العلم أني أهل لذلك.
وعن عمير بن سعيد رحمه الله تعالى قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: أئت عبيدة فاسأله فأتيت عبيدة فقال أئت علقمة فقلت علقمة أرسلني إليك، فقال أئت مسروقا فاسأله، فأتيت مسروقا فسألته فقال: أئت علقمة فاسأله فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك. فقال أئت عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرههه ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته فقال: كان يقال: أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما.
7- العمل بما يقول
قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف2-3)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: بلى كنت أمر بالمعروف ولا أتيه وأنهي عن المنكر وأتيه» متفق عليه.
8- حسن المظهر
قال عمر: «أحب إلي أن أنظر القارىء أبيض الثياب» أي ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. [12]
9- مراعاة العرف والعادة ومعرفة أحوال الناس
العرف هو ما اعتاده جمهور الناس وألفوه من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا على إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره. وقد اعتبر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم العرف الصحيح وجعلوه أصلًا من الأصول التي تبنى عليها الفتاوى والأحكام، ووردت عنه فيه كلمات جرت مجرى المبادئ والقواعد الكلية كقولهم «العادة محكمة» والمعروف عرفا كالمشروط شرطًا.
۱۰ - مراعاة حال المستفتي فينبغي للمفتي أن ينظر في حال المستفتي: هل هذا السؤال فيه نتيجة شبهة عرضت له يريد إزالتها، أو أن ذلك نتيجة ترف فكري وفراغ جعلاه يتأمل في أشياء ليس هو من أهلها. فإن كان الأول وجب على المفتي أن يقبل على مستفتيه ويتلطف به، ويحاول بقدر طاقته أن يزيل ما اشتبه عليه، وإن كان الثاني فينبغي له أن يمتنع عن إجابته، بل ينبغي له أن ينكر عليه سؤاله ويوجهه نحو ما ينفعه. [13]
هذه هي بعض آداب المفتي، وما ينبغي له أن يراعيه من أمور حال الفتوى. فنسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
[1] القاموس المحيط ومعجم مقاييس اللغة نقلا عن مجلة البحوث الإسلامية العدد الأول سنة ١٣٩٥ هـ
[2] صفة الفتوى والمفتي والمستفتى لابن حمدان ص 4
[3] نفس المصدر ص ۱۳.
[4] الاجتهاد في اللغة: بذل الجهد يعني الطاقة في عمل شاق، وإنما قيد بكونه شاقا، لأن الاجتهاد مختص به في عرف اللغة إذ يقال اجتهد الرجل في حمل الرحى ونحوها من الأشياء الثقيلة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة ونحوها من الأشياء الخفيفة.
وفي الاصطلاح: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه
[5] المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل ابن بدران ص ۱۸۰
[6] السنة في اصطلاح الأصوليين ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
[7] صفة الفتوى ص ١٦، عقد الجيد للدهلوي ص 4
[8] الموافقات / للشاطبي / ١١٧/٤
[9] المستصفى 2/ 352
[10] الوجيز / د زيدان ص ١٤٩
[11] الفقيه والمتفقه 2/ 154
[12] الأحكام / للقرافي ص ۲۷۱
[13] المفتي في الشريعة الإسلامية / للربيعة مجلة البحوث الإسلامية 1/ 157