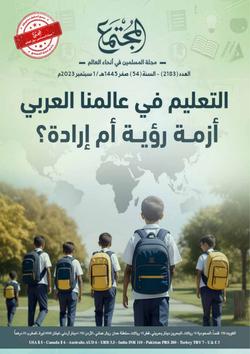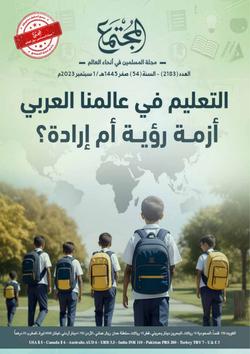العنوان المجتمع التربوي (العدد 1256)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-يوليو-1997
مشاهدات 14
نشر في العدد 1256
نشر في الصفحة 56
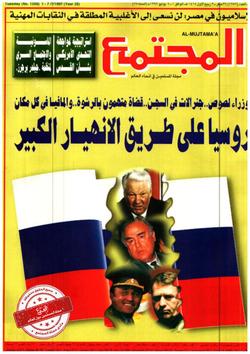
الثلاثاء 01-يوليو-1997
وقفة تربوية
جهاز الحكمة
اتساع حركة الترجمة في عصر الدولة العباسية أدخل على الدولة الإسلامية معتقدات باطلة تلقفها الجهلة وألبسوها ثوبًا إسلاميًا
يقول الله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ﴾ (البقرة: ٢٦٩) يقول الإمام «مجاهد الحكمة: الإصابة في القول والفعل» (تفسير ابن عطية ٤٥٦/٢) ويقول سيد قطب «أوتي القصد والاعتدال، فلا يفحش ولا يتعدى الحدود، وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور، وأوتي البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال.. وذلك خير كثير متنوع الألوان» (الظلال: ۳۱۲/۱).
إذن، فالحكمة جهاز يودعه الله تعالى في عقول بعض عباده، هدية منه سبحانه بسبب تقرب ذلك العبد له، وقوة إخلاصه في العبادة، ووصوله درجة الإحسان في السر والعلن، يستطيع بذلك الجهاز تقليل نسبة الخطأ إلى درجة تكاد تنعدم فيه، لأنه يقوم ما سيقول أو يفعل قبل الإقدام، فإذا ما رأى أن فيه نسبة الضرر أكثر من النفع امتنع فكان خيرًا له، لذلك فإن «الحكمة» كلمة مشتقة من مادة «حكم» والتي تدل على المنع للإصلاح، وسمي اللجام حكمة - بفتح الحاء والكاف- وما أجمل تعليق الشيخ أحمد الشرباصي على هذه الآية بقوله «التفسير الذي ترتضيه النفس لفضيلة الحكمة، هو أنها فضيلة تمنع صاحبها من الجهل في القول والعمل، وتصده عن سوء التصرف والمعاملة، وتحذره رذيلة الاندفاع والعجل، وتعلمه أن يضع كل شيء في موضعه» موسوعة أخلاق القرآن 3/88.
أبو خلاد
الضوابط الشرعية لانتقاء النقول (1 من 3)
بقلم: عبد الحميد جاسم البلالي
في منتصف عمر الدولة العباسية، وتحديدًا في عهد المامون بدأت حركة الترجمة من الكتب الإغريقية واليونانية والفارسية والهندية إلى اللغة العربية، وكانت النية في حركة الترجمة، هي الاستفادة من علوم الآخرين تماشيًا مع المقولة النبوية الحكمة ضالة المؤمن، ولكن اتساع حركة الترجمة أدخلت على الدولة الإسلامية الكثير من المعتقدات المخالفة لشريعتنا، والكثير من الرهبانية التي لم يكتبها الله علينا، والكثير من طرق تربية النفس عند الأديان الأخرى، فتلقفها الجهلة من الناس وبعض الزنادقة، وأشباه العلماء، وألبسوها ثوبًا إسلاميًا، وجعلوها جزءًا من الدين، بل زادوا على ذلك بإسناد هذه الأعمال المخالفة لبعض أعلام المسلمين في جميع العصور، وملؤوا كتب التراجم والرجال بها، وخفي هذا الأمر حتى على بعض ثقات العلماء، فاختلط الحابل بالنابل، وأصبح من المتعذر على غير صاحب العلم التفريق بين الصحيح والسقيم من الأخبار والنقول، ولأهمية هذا الأمر وأثره في صياغة الشخصية الإسلامية تأتي هذه الدراسة السريعة لتكون ضوابط شرعية يستعين بها القارئ المسلم عند استخدامه للنقول من كتب التراث.
الضوابط الشرعية: تنقسم هذه الضوابط الشرعية عند أستخدام النقول إلى ستة أقسام:
1- عدم مصادمته لنص من الكتاب أو السنة.
2- عدم مصادمته الحقائق العقل.
3- عدم مصادمته لهدى النبي صلي الله عليه وسلم.
4- عدم مشابهته لتلبيسات الجن التي تتلبس بلباس الكرامة.
5- ما يشعر فيه إهانة للمترجم له.
٦- ما يدل على اليأس من تذكير الناس.
القسم الأول: مصادمته لنص من الكتاب والسنة.
وأمثلة ذلك كثيرة، خاصة في كتب التفسير ومنه ما جاء في تفسير قصة الملكين هاروت وماروت، اللذين جاء ذكرهما في سورة البقرة بأنهما ملكان عصيا الله، فعاقبهما الرب.. إلى آخر هذا النوع من التفسير، والذي يخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى عن الملائكة: ﴿لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾
(التحريم: 6) أو كتفسيرهم المعصية إبليس كما جاء في سورة الكهف ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ﴾ (الكهف: 50)
وتجد في التفسير الإشاري للصوفية الذين يقولون «للقرآن ظاهر وباطن» الكثير من هذه المخالفات، وكذلك تجد الكثير من هذه الأمور عند تفسير الباطنية، ومن ذلك ما جاء في ترجمة التابعي الجليل مطرف بن الشخير في سير أعلام النبلاء قوله «لقد كان خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة» (۱) وهو مخالف بلا شك لما جاء في كتاب الله تعالى من الحث على طلب الجنة ومخالف لما جاء في السنة المطهرة في أحاديث كثيرة صحيحة يدعو الرسول صلي الله عليه وسلم فيها ربه الجنة ومنها حديث «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» (۲)
وقوله «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة» (۳) وغيرها من الأحاديث.
القسم الثاني: مصادمته الصريح العقل الضابط الشرعي الثاني عند أستخدام النقول هو عدم مصادمته الحقائق العقل، وتكاد تكون مثل هذه النقول هي الأكثر في كتب الرقائق.
أ- ختم القرآن: ومن أمثلة ذلك ماجاء به صاحب المستطرف، حيث قال «ختم بعضهم في اليوم والليلة ثماني ختمات، أربعًا بالليل وأربعاً في النهار، وروي أن مجاهدًا رحمه الله كان يختم القرآن في شهر رمضان فيما بين المغرب والعشاء وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمنهم عثمان بن عفان، وتميم الداري وسعيد بن جبير رضي الله عنهم» (٤).
قراءة مثل هذه الروايات لا تدفع الإنسان لبذل المزيد من الجهد والتقرب إلى الله والمنافسة كما يتصور البعض بل تدفعه للإحباط واليأس من نفسه عندما يقارن قدراته وقدراتهم، فيرضى بما يقدم من العمل، ولا يسعى للمزيد، ذلك لأن مثل هذه الروايات تناقض العقل، حيث يحتاج المرء القراءة ۳۰ جزءًا «القرآن كاملًا » إلى ٧٥ ساعات إذا أعتبرنا أنه ينهي الجزء الواحد في ربع ساعة وهذا يعني أن الإنسان يستطيع أن يختم مرتين فقط خلال النهار أو الليل، هذا إذا أفترضنا أنه لا يذهب إلى حمام ولا يأكل الطعام، ولا يصلي الصلوات الخمس في المساجد ولا يقضي أي حاجة من حوائج الدنيا، فكيف يقال إنهم كانوا يختمون في ركعة أو بين المغرب والعشاء؟ وكيف أنطلت مثل هذه الروايات على قطاع كبير من الكتاب والوعاظ والدعاة حتى كثر الأستشهاد بمثل هذه الروايات غير المعقولة، والتي تناقض العقل الصريح، ومن أمثلة هذه الروايات ما أورده الإمام ابن الجوزي في كتابه سلوة الأحزان حيث قال روي عن زكريا الناقد- رحمه الله- كان يقول: اشتريت من الله عز وجل جارية من الحور العين بأربعين ألف ختمة، فلما كان آخر الختمة الآخرة سمعت الخطاب من الحوراء وهي تقول: أنا التي اشتريتني يا صاحبي بأربعين ألف ختمة، ففرحت بذلك، وقلت : اللهم إن كنت قبلتني فأقبضني، فمات من وقته وساعته رحمه الله» (٥).
والمروي عنه هو زكريا بن يحيي بن عبد الملك مات عام ٢٨٥ هـ .. ولكشف منافاة هذه الرواية للعقل السليم، نقول إن في السنة الواحدة ٣٦٠ يومًا، فإن في ١٠٠ عام ٣٦ ألف يوم، وحتى نكمل ٤٥ ألف يوم فإننا نحتاج إلى 9 سنين إضافية فيكون المجموع ۱۰۹ سنين تقابلها ٤٥ ألف يوم فإذا أعتبرنا أنه يختم منذ مولده يوميًا كل يوم ختمة واحده فإنه يحتاج من العمر ١٠٩ سنين لإكمال ٤٥ ألف ختمة، أما إذا أعتبرنا أنه بدأ يختم بعد بلوغه العاشرة من العمر، فإن ذلك يعني أن يحتاج إلى ١١٩ سنة حتى يبلغ ٤٥ ألف ختمة.
ب - صلاة النافلة: وكثرت كذلك روايات عدد الركعات التي كانوا يقومون بها إلى درجة خروجها عن الإطار المعقول، ومن أمثلة ذلك ما أورده الإمام ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة في ترجمة معاذة العدوية زوجة التابعي صلة بن أشيم أنها «كانت تصلي في كل يوم وليلة ستمائة ركعة، وتقرأ جزءها من الليل تقوم به، وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور» (٦) وحتى نستوعب هذه الرواية فإننا نضع ثلاثة أحتمالات.
- الأول: أن نفترض أن كل ركعتين تستغرقان ربع ساعة، فيكون في الساعة الواحدة 8 ركعات فيكون في ٢٤ ساعة كاملة دون أنقطاع ٨x٢٤ = ١٩٢ ركعة.
- الثاني: أن نفترض أن كل ركعتين تستغرقان دقيقة، فيكون في الساعة الواحدة ١٦ ركعة فيكون في ٢٤ ساعة كاملة دون أنقطاع ١٦x٢٤ = ٣٨٤ ركعة.
- الثالث: أن نفترض كل ركعتين تستغرقان . دقائق، فيكون في الساعة الواحدة ٢٤ ركعة، وفي ٢٤ ساعة ٢٤x٢٤ = ٥٧٦ ركعة، وهو أقربها.
هذه الYحتمالات الثلاثة كلها نفترض فيها أنها لا تأكل أبدأ ولا تتكلم مع أحد، ولا تقضي حاجة ولا تنام ولا تصلي الصلوات الخمس، وهذا كله مستحيل، فإذا أفترضنا أقل الأحتمالات بأن نومها وطعامها وقضاء حاجتها، واقتطعنا صلوات الفروض الخمسة، وجعلنا كل ذلك ٤ ساعات، فإن ۲۰ ساعة، لا يمكن أن تكفي لستمائة ركعة.
ويمكن أن نطبق نفس الإحتمالات على رواية ابن الجوزي في كتاب سلوة الأحزان فيما يرويه عن التابعي عامر بن قيس، حيث قال «كان قد فرض على نفسه في كل يوم ألف ركعة، فإذا صلى العصر جلس، وكان قد أنتفخت ساقاه من كثرة القيام فيقول: يانفس سوف يذب عنك هذا» (۷).
وكذلك ما أورده الذهبي في سير الأعلام عن ابن الصحابي سعد بن تميم، بلال بن سعد بأنه «كان من العبادة على شيء لم نسمع أحدًا قوي عليه، كان له كل يوم ألف ركعة» (۸).
جـــ- إجراء الكرامات للكرامة أسباب وشروط، ولا يمكن أن نقبل كل رواية فيها أمر خارق للعادة على أنها كرامة لفلان أو علان وننقل ههنا إجابة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ففيها الغناء إن شاء الله عن قضية الكرامات.
السؤال الرابع من الفتوى رقم ۹۰۲۷
هل للأولياء كرامة، وهل لهم ان يتصرفوا في عالم الملكوت في السموات والأرض، وهل يشفعون وهم في البرزخ لأهل الدنيا أم لا؟
«الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين
حيًا أو ميتًا إكراماً له فيدفع به عنه ضرًا أو يحقق له نفعًا أو ينصر به حقًا، وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد، كما أن النبي لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه بل كل ذلك إلى الله وحده قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (العنكبوت: 50) ، ولا يملك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت السموات والأرض إلا بقدر ما اتاهم الله من الأسباب كسائر البشر من زرع وبناء وتجارة ونحو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر بإذن الله تعالى ولا يملكون أن يشفعوا وهم في البرزخ لأحد من الخلق أحياء وأمواتًا قال الله تعالى : ﴿ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ ﴾ (الزمر: 44) وقال: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الزخرف: 86) قال: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ (سورة البقرة: 255) ، ومن أعتقد في أنهم يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب فهو كافر لقول الله عز وجل: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة المائدة: 140) (۹) وقوله ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ ﴾ (النمل: 65) (۱۰) وقوله سبحانه أمراً نبيه صلي الله عليه وسلم بما يزيل اللبس ويوضح الحق: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: 188) (۱۱), (۱۲).
الهوامش
۱ - سير أعلام النبلاء ١٩٤/٤.
۲- جزء من حديث رواه ابن ماجة بإسناد صحيح- الصحيحة ١٥٤٢.
3- رواه الطبراني بإسناد صحيح ص: (٥٩٢).
4- المستطرف ۳۰ ط- الحياة.
5- سلوة الأحزان ص ٦٩ وصفوة الصفوة ٤١٤/٢.
٦- صفة الصفوة ٢٢/٤.
7- سلوة الأحزان ٩٤.
8- سير أعلام النبلاء ٩١/٥.
9- المائدة : ٢٠.
١٠- النمل : ٦٥.
۱۱- الأعراف: ۱۸۸.
۱۲- فتاوى اللجنة الدائمة - ج ٣٨٨/١.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل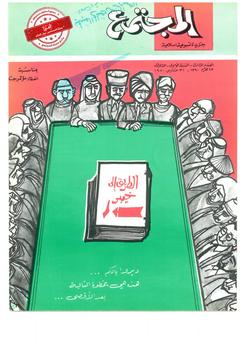
د. حمد المطر رئيس «اللجنة التعليمية» بمجلس الأمة الكويتي لـ«المجتمع»: انتقلنا إلى مرحلة الإصلاح التعليمي
نشر في العدد 2183
43
الجمعة 01-سبتمبر-2023