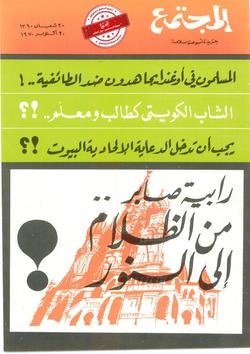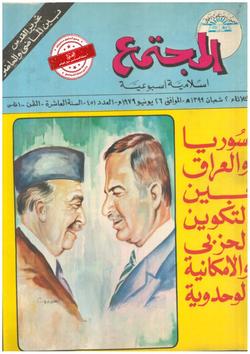العنوان المجتمع الثقافي (1124)
الكاتب مبارك عبد الله
تاريخ النشر الثلاثاء 08-نوفمبر-1994
مشاهدات 10
نشر في العدد 1124
نشر في الصفحة 54
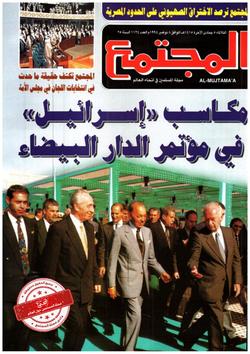
الثلاثاء 08-نوفمبر-1994
ومضة
تشتاق النفس بين الحين والآخر إلى لحظات من الخلوة ترتاح فيها من مشاغل الحياة وهمومها ومعاناتها اليومية.. تنظر إلى الكائنات أو تتأمل في الطبيعة.. تفكر بهدوء في ملكوت الله الواسع، تفكيرًا صافيًا طليقًا. لا تعكره كدورة الأحقاد والضغائن ولا يحد انطلاقته ويكبل حريته قيود أسرة، ولا ضغط من ظروف، أو رؤية ضيقة محدودة بحدود أمر واقع.
لعلها تحس بشيء من الأنس، بعيدًا عن دوامة العمل وتراكم المشاكل وتتابع المسئوليات مقتنصة الفرصة لقراءة كتاب ينمي المعرفة ويصقل الثقافة، أو قصيدة توقظ المشاعر وتعبئ الوجدان أو أنشودة تشنف السمع وترطب النفس وتحيي ما خمد فيها من لواعج وأشواق.
أو عساها تثمر حلًا لمشكلات الإنسان وتصادف إجابات لتساؤلاته الكثيرة، وتسهم في انفراج الأزمات الَّتي يعاني من صعوباتها في حياته الاجتماعية والاقتصادية وتلقي بظلالها الكثيفة على حالته النفسية، فيكون القلق والخوف من المستقبل، ويصبح الأمن من الحاجات الماسة لأنه قاعدة الاستقرار وأساس الطمأنينة.
هل يفسر هذا الشوق لتلك اللحظات ما قرأناه في السيرة من أن النبي r حببت إليه الخلوة قبيل البعثة فكان يمضي الأيام والليالي ذوات العدد في غار حراء يتأمل ويبحث ويفكر حتى جاءه الوحي وهو على تلك الحال... وكذلك ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة من ذكر الله- بعيدًا عن أعين الناس- حتى تفيض العين وتصفو النفس وتشف الروح ويرق القلب ويبرأ مما أصابه من أدران ونكت سوداء.
وأخيرًا، هل يكون ذلك سبيلًا إلى مراجعة النفس ومعرفة العيوب وتصحيح المسار... وعند نجاح التجربة يكون أحدنا قد حقق لنفسه من الأشواق والأمنيات، ما لا يستطيع تحقيقه وهو في خضم الأحداث وتيارها الَّذي لا يتوقف.
اللسان العربي
علوم البلاغة: ٢- البيان
بقلم: عبد الوارث سعيد (*)
بعد «المعاني»، يأتي «علم البيان»، وهو بمكانة القلب من فن البلاغة والجمال اللغوي؛ حيث إن مباحثه جميعًا أدخل في عالم الجمال والإمتاع وافسح لمواهب الإبداع، إنه يضع بين يدي محبي الجمال اللغوي والموهوبين فيه طاقات متنوعة يمكنهم بها "إيراد المعنى الواحد بأساليب متفاوتة في القوة والوضوح"، طبقًا لما يقتضيه المقامُ، فالغاية هي البيان، كما تدل التسمية.
مباحثُ «البيانِ» الرئيسية هي: التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية والذي يجمع بينها أنها لا تقدم لك المعنى مباشرة، وإنما تضع بينك وبينه ستارًا يحفز عقلك وخيالك على التفكير والتحليق طلبًا لكشف المستور، فإن ظفرت به كان أوقع في النفس وأحلى في المذاق وبقدر ما تتعدد الستور فيحلق الخيال مسافات أبعد ليقتنص المعنى بعد جهد يكون سمو المعنى ومتعة الظفر به شريطة ألا يصل التظليل إلى حد الإظلام والغموض بحيث يصاب العقل والخيال بالكلل أو يعود من طوافه صفر اليدين فهذا الإخفاء المتعمد الَّذي يختبئ خلفه «البيان» هو ميدان الإبداع الفني الَّذي تتبارى فيه الملكاتُ.
التشبيه العادي هو أدنى درجات البيان إثارة وتأثيرًا لأن كل مكوناته مذكورة «المشبه + أداة التشبيه + المشبه به + وجه الشبه» ومقصودة مبذول لا يحتاج إلى تأمل:
العلم كالنور يكشف لنا الأشياء المستورة. لكن حذف الأداة، وحذف «وجه الشبه» - على وجه الخصوص- يكسب التشبيه قوة وجمالًا: العلم نور.
فإن جعلته مركبًا؛ بحيث يكون وجه الشبه جملة عناصر متداخلة كان الاهتداء إليه بعد طول تأمل أجمل وقعًا. تأمل قوله تعالى:
﴿مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ (إبراهيم: ۱۸) وإذا تركت التصريح في التشبيه إلى التلميح والتضمين كان أبعد جمالًا وتأمل قول الشاعر:
من يَهُن يسهُل الهوانُ عليه *** ما لجُرحٍ بميتٍ إيلام
«تشبیه ضمنی»
وأجمل منه قول الآخر يكشف زيف المبالغين في المدح والتزلف وهم طلاب مصالح لا غير:
إذا أمرؤ مدح امرًأ لنواله ... فأطال فيه فقد أراد هجاءَهُ
لو لم يقدِّر فيه بُعْدَ المُسْتقَى ... عند الورود لَمَا أطال رشاءَهُ
«الرشاء: حبل الدلو الَّذي يستقي به من البئر البعيد الماء»
الاستعارة:
هي درجة أرقى من التشبيه؛ إذ فيها يكتفى بأحد ركني التشبيه ويدعى أن الكلام كأنه حقيقة «وإن كان لا بُدَّ من وجود قرينة تمنع أن يكون المعنى الأصلي مقصودًا حقيقة، وإلا خرجنا من دائرة البلاغة بالمرة تأمل الآيات البينات التاليات:
۱- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (الأنفال: 24)
٢- ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (إبراهيم:1)
3- ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ﴾ (البقرة: 256)
الاستعارة الَّتي يصرح فيها ب المشبه به. كالأمثلة السابقة- تسمى «تصريحية». أما إذا حذفنا المشبه به وبقي المشبه فقط، وأسندنا إليه بعض صفات وخصائص المشبه به المحذوف، فإنها تسمى «استعارة مكنية»، وهي أجمل من التصريحية؛ لأنها أكثر إثارة للخيال ولذلك تسمى «تخييلية». تأمل الأمثلة التالية:
نَزَلَنَا دوْحَهُ فَحـنَا علَـيْنَا ... حُنُوَّ المُرْضِعاتِ على الْفَطِيمِ
«حمدونة الأندلسية»
فالدوح- وهو شجر الوادي الَّذي تصفه الشاعرة- شبه بالأم المرضع الَّتي تحنو على فتطمها الَّذي تحس من أعماقها بالحنو عليه لألم الفطام. فـ«الحنو»- أبرز صفات الأمومة. حين أسند إلى الدوحة حفز العقل والخيال على البحث عن المشبه به، فيتخيل «الدوح»، ذا الظلال الوارفة والنسيم العليل والماء النمير كان على من حلوا به كالأم الحانية على فطيمها.
ولنتأمل هذه الأمثلة القرآنية، ولننقب عمَّا فيها من استعارات «مكنية»، محاولين بشباك الخيال اقتناص ما في كل منها من جمال إنها آيات من الكتاب المعجز الحكيم:
﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ (الأنبياء:18)
﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ (آل عمران: 187).
﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ﴾ (الأعراف: 154).
وكلما تمادينا في ذكر ما يناسب المشبه به، من صفات كان ذلك «ترشيحًا» أي: تصفية وتقوية لها. تأمل:
«لما اندثرت الرسالات السابقة جف عود البشرية وصوح فرعها وانقطع ثمرها، فلما بزغ الإسلام لان عودها وأخضر فرعها وتكاتف ظلها وطعمت البشرية ثمرها المبارك».
ولنا مع «البيان» وقفة أخرى قادمة إن شاء..
(*) مدرس بجامعة الكويت
واحة الشعر
شعر: د. سمير أحمد الكفراوي
قراءت
إليها وقد تسربلت بما ورثته من ذلة وانكسار... وملء عينيها نداء جدتها «وامعتصماه»... إلى فتاة البوسنة...
وراحلة إلى المجهول
ألمحُ وجهها الآن
وفوق جبينها الذهبي مكتوب «بلا وطن»
ودمعُ العينِ منهمرُ
وآلاف من الأحلام تركض في حناياها.
***
أنا أختاه لا أدري
لمن تُجْبَى مزارعنا؟!
ولا أدري
من تهدي بيارقنا...؟!
فقد مَلَّتْ من الشكوى حناجرُنا...
وَجَاءَ الكُلُ
يسبقهمْ حُداءُ الذُلِّ فارتابت قلوبهمُ.
وضاعت منهم الألحانُ والأحلامُ
في ليلِ الخرافات
فلم يتبينوا الدَّربا، ولم يتبينوا الصُّحبا
***
فمعذرةٌ إذا خانتك نَخْوَتُنَا
ومعذرةٌ إذا عميت قلوب
ملؤها الصلَّفُ
فما غزلت لعزتنا
غداة العهد
أكفانا
فكلُّ قماشنا الأبيض
صنعنا منه أعلامًا نراقصها
صباح... مساء
قرآنا في كتاب الكون
«أن الحق لا يعلو بغير السيف والقوة وإن غنى المراؤون بأن السلمَ مذهبنا.. وإن الحرب تهلكةُ بلا أفياء»..
فكل قماشنا الأبيض صنعنا منه أعلاما نراقصها صباح.. مساء
قرآنا في كتاب الكون
أن الحق لا يعلو بغير السيف والقوة
وإن غنى المراؤون بأن السلم مذهبنا.. وإن الحرب تهلكة بلا أفياء.
ووالينا- أدام الله إيوانه-
أقرَّ بأن أمتَنا
تروم فتاتَ مَنْ عبثوا بماضيها
وحاضرها
وما دامت غلال القمح عندهم
فلا أحلامُ نملكها
ولا أوطانُ نعرفها
أجل أختاه
لا أحلام نملكها
ولا أوطان نعرفها
***
فيا شِعْرُ
أجِبني أيُّها الموعودُ في قبرِ النفاياتِ
وقدرًا نعايشه
ويا حلمًا نراقصه
بفجر بلادنا الآتي
لمن أروى عذاباتي؟!
أأرويها لِمنْ ناموا على الأوهام
من أبناء أمتنا؟!
أأحكيها لمن لا هَمَّ عندهمُ
سوى دُفٍ وتصديَهِ
بلا استحياء؟!
ويا شِعْرُ
إذا ما عافنا المجدُ
وضم رفاتنا اللحدُ
وفارقنا الحياة الضنكَ
في أرض الثرى المأجورْ
فكن لي وقتها كفنًا
يواري جُرحى العربيَّ
والأحلامَ والوطنا...
***
إصدارات
عطاء متجدد في مجلة الأدب الإسلامي
الرياض: خاص
تواصل مجلة الأدب الإسلامي الَّتي تصدرها رابطة الأدب الإسلامي العالمية مسيرتها الظافرة الحافلة بالعطاء والتجدد فتقدم في عددها الثالث العديد من الدراسات والنصوص الأدبية الَّتي تكشف طبيعة الأدب الإسلامي ومنهجه وتصوره، وتمديدها إلى البراعم الأدبية الواعدة فتساندها بالرعاية والنقد والتوجيه وتضيف إلى ما تنشره عن الأدب الإسلامي في اللغة العربية نصوصًا ودراسات من الأدب الإسلامي في اللغات مثل التركية والأفغانية.
ومن أهم الدراسات في العدد الثالث ما كتبه الدكتور محمد رجب البيومي حول منهج الأدب الإسلامي في السيرة الذاتية، ويعنى الكاتب في دراسته بتسجيل الملاحظات الَّتي سجلها النقاد من مآخذ السيرة على السيرة الذاتية لأن منهج الأدب الإسلامي يحتم تجنبها ويفتح مجال التصويب عن بصيرة واعية وبرهان مقنع، بحيث تسمو السيرة الذاتية بالأفكار وتنساق مع الروح المؤمنة في التصوير والتحليل، ويعرض الكاتب لنماذج من التراث تدل على الطابع الإنساني الكريم الَّذي يجب أن يحتذيه من يبدع السيرة الذاتية في ضوء الإسلام.
ويكتب الدكتور عبد الباسط بدر عن أدب الرحلة الَّذي أنبته الإسلام، ويشير إلى أن تراثنا في حاجة موضوعية إلى إبراز كنوزه المكنونة ويتحدث عن مكانة الرحلة في حياة العرب منذ القدم وبخاصة دورها بوصفها موردًا اقتصاديًا ويتناول الكاتب أبرز الرحلات الَّتي قام بها الرحالة المشهورون مثل: ابن جبير وابن بطوطة.
ويتناول الدكتور صابر عبد الدايم أهم الملامح الفنية في الحديث النبوي، ويرى أن هذه الملامح ليست صنعة لفظية، وليست خيالًا تصويريًا، ولكن المعنى والمبنى يمتزجان في الحديث الشريف والفكر والأسلوب يتعانقان فيه، ليقدما للبشرية المنهج الإسلامي السعيد المنبثق من هدي القرآن العظيم.
وقد كان لقاء العدد مع الشاعر محمد التهامي الَّذي تناول قضايا عديدة، وقال إن الغموض في الشعر سينتهي وتعود القصيدة تاجًا للإبداع الفني.
وعرضت المجلة للندوة التاسعة لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في مدينة بنارس «وراناس» بالهند، ونقلت ما قاله سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي فيها، حيث طالب بعدم التركيز على أدب الصنعة والتكلف، وقال: أعيدوا للكلمة جمالها، كما نشرت المجلة توصيات الندوة حول الاستعانة بالحديث النبوي الشريف في المناهج الدراسية المقررة وغيرها.
ويكتب الدكتور محمد هريدي عن الأدب التركي في موكب الحضارة الإسلامية، حيث لم يتوقف دور الأتراك عن النفوذ العسكري بل تعداه إلى الثقافة والفكر الإسلامي وفي مكتبة الأدب الإسلامي تقدم المجلة عرضًا لكتابين أولهما: القصة القرآنية من تأليف فتحي رضوان، والثاني القرآن ونظرية الفن من تأليف الدكتور حسين على محمد.
ويحلل الدكتور حسن الأمراني رواية «السنوات الرهيبة» الَّتي كتبها الروائي التتري المسلم جنكيز ضاغجي عام ١٩٥٦ في عز الهيمنة الشيوعية وقبضتها الحديدية، وهي رواية تصور في شجاعة نادرة وصدق بالغ مأساة الشعب المسلم في شبه جزيرة القرم الَّتي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي المنهار وتنتقد أسلوب التعامل الشيوعي مع الأقليات الَّتي استطاع أن يعد إليها جبروته، ويخلص الأمراني إلى أن الخصوصية في هذه الرواية تتمثل في أساسين هما: الدين واللغة.
ويعرض الدكتور محمد أمان صافي لثلاث من القمم في الأدب الأفغاني وهم: خوش حال خان، وعبد الرحمن بابا، وأحمد شاه الدراني، ويقدم تعريفًا موجزًا لكل منهم مع نماذج من شعره.
وتنشر المجلة من التراث الحديث مقالة العلامة محمود محمد شاكر اختارتها من كتابه «أباطيل وأسمار» تدور حول دوران المصطلحات الكنسية في الشعر الحديث مثل: الخطيئة، الفداء، الصلب، الخلاص، ولها دلالتها عند النصارى الَّتي تختلف بالضرورة عن دلالتها عندنا نحن المسلمين.
ويدرس الدكتور سعد أبو الرضا ديوان «الزحف المقدس» للشاعر الراحل عمر بهاء الأميري. وهناك مقالتان: الفرار إلى التراث للدكتور حسن الهويمل، والقرآن والنقد الأدبي الإسلامي للدكتور عبده زايد، بالإضافة إلى أخبار الأدب الإسلامي.
والعدد الثالث حافل بمجموعة من القصائد والقصص والمسرحيات لأدباءنا الإسلاميين في شتى أقطار العالم الإسلامي.
إن مجلة الأدب الإسلامي تخطو خطوات واثقة وتحتاج إلى الدعم والمساندة حتى يترسخ الأدب الإسلامي إبداعًا ودراسة، ويسود الساحة الثقافية الراهنة.
عنوان المراسلات: الرياض- ص. ب
٥٥٤٤٦- الرمز ١١٥٣٤
القاهرة: ص.ب ٩٦ رمسيس
عمان: ص. ب ٩٥٠٣٦١
وجدة المغرب ص. ب ۲۳۸
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل