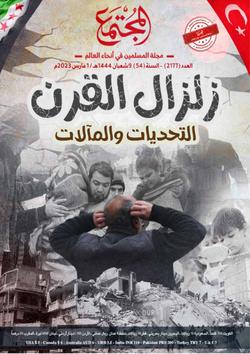العنوان المقاربة الغربية لقضايا المرأة العربية..
الكاتب د. فاطمة حافظ
تاريخ النشر السبت 01-سبتمبر-2018
مشاهدات 85
نشر في العدد 2123
نشر في الصفحة 12
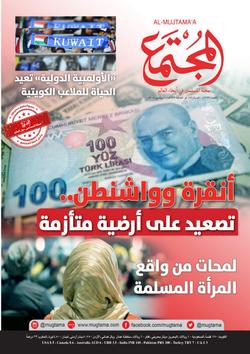
السبت 01-سبتمبر-2018
المقاربة الغربية لقضايا المرأة العربية..
التناول الغربي كرس صورة نمطية حول المرأة العربية بأنها مقهورة بسبب السياسات الذكورية التي أوجدها الإسلام
الغربيون يرون أن إدماج النساء بالمجال السياسي يساعد في تفكيك بنى العنف بسبب طبيعتهن المسالمة
التمكين استهدف تحقيق مصالح الدولة وتقديم صورة غير دقيقة عن وضعية النساء أمام المجتمع الدولي
رؤية نقدية
شغلت قضية المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية مساحات واسعة من النقاشات الغربية حول الإسلام، وبخاصة بعد أحداث سبتمبر التي طرحت التساؤلات حول ماهية الإسلام وطبيعة المجتمعات المسلمة، وكيف يمكن التعاطي مع المكون الحضاري الإسلامي الذي يستبطن ويشرعن لقيم العنف والإرهاب باسم الدين، وهي القيم التي تقف على النقيض مع الغرب ومنظومته الحضارية الحاملة لقيم التسامح مع الآخر والحرية والمساواة، حسب تصورهم.
د. فاطمة حافظ
حاصلة على الدكتوراه في التاريخ ومختصة بالقضايا النسوية
عبر التناول الغربي -المعرفي والإعلامي على حد سواء- تكرست صورة نمطية حول المرأة العربية قوامها أنها إنسان مقهور بفعل السياسات الذكورية التي أوجدها الإسلام، والمتمثلة في الحجاب والتعدد والتمييز في الإرث، والعنف الأسري.. التي تأثرت بها المجتمعات والثقافات المحلية، وأفضت في نهاية المطاف إلى تدني وضعية المرأة واحتلالها منزلة أدنى من الرجل داخل المجتمع العربي.
الإلحاح في إنتاج هذه الصورة النمطية أوجد مسوغاً اعتبره الغرب أخلاقياً للتدخل والضغط على الحكومات العربية من أجل تعديل أوضاع المرأة العربية والنهوض بأوضاعها قياماً بواجبه في نصرة المستضعفين والمهمشين، لكن سبباً آخر أكثر جوهرية يقف خلف هذا الاهتمام؛ ألا وهو الرغبة في خلخلة البنية المجتمعية المستبطنة للعنف والتطرف بإشراك النساء في المجال العام، حيث يفترض واضعو السياسات الغربية أن تواجد النساء بأعداد كبيرة في المجالات المختلفة كفيل بالقضاء على التطرف الإسلامي وجعل المجتمع الإسلامي أكثر انفتاحاً وتقبلاً للأفكار الحديثة، هذا من جانب، كما أن إدماجهن في المجال السياسي بأعداد كبيرة يمكنه المساعدة في تفكيك بنى العنف بسبب طبيعتهن المسالمة التي لا تميل لخوض النزاعات وإثارة الأزمات، من جانب آخر.
وبصفة عامة، يمكننا التمييز بين مرحلتين من مراحل الاهتمام الغربي بقضايا المرأة العربية؛ وهما مرحلة فرض سياسة التمكين، ومرحلة إعادة الهيكلة الاجتماعية عبر التشريعات بغرض إعادة تموضع موقع المرأة في المجتمع.
مرحلة التمكين:
وقد افتتحت رسمياً في الربع الأخير من القرن الماضي وقادتها منظمة الأمم المتحدة التي اعتمدت إستراتيجية لدعم وتمكين المرأة واعتبرتها أحد الأهداف الإنمائية الدولية، ويقصد بالتمكين «السياسات العامة أو الإجراءات (الحكومية) الهادفة إلى دعم مشاركة النساء سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو غيرها وصولاً إلى مشاركتهن في عملية صنع القرار»، وخلال المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة التي رعتها المنظمة الدولية، بات تمكين المرأة أحد المطالب الرئيسة التي ينبغي للحكومات إحراز تقدم بشأنها، وأصبح من مهام المنظمة الدولية ملاحظة مدى التقدم الذي تحققه الحكومات التي ترفع تقارير بصفة دورية بهذا الشأن.
وقد واجه العالم العربي ضغوطاً دولية جدية لتعديل أوضاع النساء في أعقاب مؤتمر بكين للمرأة (عام 1995م)، واستجابت لها بعض البلدان كمصر وتونس اللتين شرعتا في تخصيص بعض المناصب العليا للنساء، وفي أعقاب حوادث سبتمبر أضحى الضغط مباشراً وصريحاً؛ حيث تعرضت الدول الخليجية إلى ضغوط ضخمة -وبخاصة من الإدارة الأمريكية- التي ألحت على تعديل وضعية النساء في المجتمعات التي ينتمي إليها منفذو الهجمات، وعلى هذا تمت سلسلة من الإجراءات الحكومية، مثل: سن التشريعات التي تدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، وإنشاء بعض المؤسسات لتقف خلف عملية التمكين كالمجالس والاتحادات القومية للمرأة أو ما شابهها من جمعيات تعمل تحت إشراف الدولة، والتوقيع على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، مع ما يستلزمه ذلك من مراجعة شاملة للقوانين المحلية لبيان مدى توافقها مع الاتفاقية.
وإذا كان مؤيدو التمكين ينظرون إليه بوصفه «عملاً مرحلياً مؤقتاً» غرضه دعم المرأة وإزالة المعوقات التي تحول دون مشاركتها الفعالة الكاملة في المجتمع، ويتباهون بما حققه من نجاحات على صعيد مشاركة المرأة، فإننا يمكن أن نسوق بعض الملاحظات النقدية حول ما يمكن أن يفضي إليه على المدى البعيد:
أولاً: ينتمي التمكين إلى ما يسمى السياسات الفوقية التي تنتهجها الدولة بغرض تحقيق أهداف معينة وسريعة، وهو غير مصمم لكي يشتبك مع البنية التحتية العميقة (الأفكار، العادات، التقاليد) التي تنتج التمييز ضد المرأة، وهو ما يعني استمرار إنتاجها للصورة المجتمعية السلبية بشأن المرأة، وهو ما يحد كثيراً من إمكانيات نجاح التمكين.
ثانياً: يستهدف التمكين في المقام الأول تحقيق مصالح وأهداف الدولة، وغالباً ما يكون القصد منه تقديم صورة غير دقيقة عن وضعية النساء أمام المجتمع الدولي، ومن ثم فهو لا يروم حقيقة إلى تحسين شروط المعيشة بالنسبة للنساء أو تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر توافقاً للنساء، ومن جهة ثانية؛ فإن المكتسبات المتحققة عبر الدعم الرسمي مكتسبات غير ثابتة؛ فقد يحدث أن يفتر الدعم الرسمي لسبب أو لآخر وربما توقف، وهنا تصبح التداعيات كارثية إذ تتهاوى معدلات تمثيل النساء، وهو ما يؤشر بوضوح أننا أمام مكتسبات وقتية مهددة وليس مكتسبات مستدامة راسخة.
ثالثاً: لم تستفد جموع النساء في العالم العربي من سياسة التمكين؛ فبينما حصدت المنجزات والمكاسب نساء النخبة ممن وقع الاختيار عليهن في المناصب الوزارية أو النيابية، أو مراكز صنع القرار في الهيئات الحكومية، لم تستفد من هذه المكتسبات نساء الطبقات الوسطى والدنيا، اللواتي لم يطرأ تحسن ملحوظ على أوضاعهن المعيشية والوظيفية جراء تلك السياسة.
رابعاً: من شأن هذه السياسة -في نهاية المطاف- أن تؤثر سلباً بما تكرسه من ثقافة التواكل والتبعية لدى النساء، حيث اعتادت الجماعات النسائية الناشطة الاكتفاء برفع أصواتها لأولي الأمر بالشكوى وانتظار منح الدولة وعطاياها للنساء دون القيام بجهد حقيقي فاعل في المجتمع.
مرحلة إعادة هيكلة البنية الاجتماعية:
وهي مرحلة تالية نسبياً لمرحلة التمكين، وفيها تقوم النخبة المثقفة الموالية للغرب بتقديم مشروعات قوانين غايتها المساس بالتوازنات الاجتماعية السائدة بين الرجال والنساء، والتدخل لتحقيق مكاسب قانونية للنساء إعمالاً لـ«مبدأ المساواة» الغربي، وقد طرح منذ بدايات القرن عدد من قوانين الأحوال الشخصية التي يمكن وصفها بالعلمانية، ويمكن أن نضرب مثالاً بمحاولات المغرب عام 1999 – 2000م طرح قانون مدونة الأحوال الشخصية يتبنى الدعوة إلى منع التعدد ويحظر الطلاق ويدعو إلى المساواة في الإرث، وقد رحبت به الجمعيات الحقوقية والنسوية واعتبرته انتصاراً للمرأة، إلا أن الدولة اضطرت لسحبه على خلفية تظاهرات شعبية ضخمة رافضة له.
ويعد تقرير «الحريات الفردية والمساواة» الذي قدمته في يونيو الماضي لجنة تشكلت بقرار من الرئيس التونسي حلقة أخرى من حلقات فرض مبدأ المساواة وتبني النموذج الغربي، وقد عمد التقرير الواقع في 233 صفحة إلى تغيير نظام الأسرة الإسلامي وذلك بإلغائه (المهر، العدة، القوامة، وواجب إنفاق الزوج على الأسرة، الحضانة)، وفي المقابل من ذلك، دعا إلى ضرورة إشراك الزوجين في الإنفاق على الأسرة، والمساواة في الإرث بين الرجال والنساء، كما دعا إلى إلغاء عقوبة اللواط والزنا وشرب الخمر، وعلى حين لاقى التقرير انتقادات حادة في تونس قوبل بحفاوة دولية؛ إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن تونس وضعت «تقريراً مميزاً» وأعلنت الخارجية الفرنسية عن ترحيبها به.
وبصفة عامة، يثير التقرير ملاحظات بعضها يتعلق بدور القانون في المجتمع؛ إذ المفترض أن القانون يناط به تحقيق العدالة وعدم تجاوز أحد حقوق الآخرين، بينما القانون كما يراه واضعو التقرير يراد له أن يكون أداة لتغير البنية الاجتماعية، وخلق واقع مجتمعي جديد، والبعض الآخر يتعلق بمبدأ المساواة، ونحن نميل إلى أن هناك نوعين من المساواة؛ أحدهما مساواة شكلية تقتضي التساوي التام بين الرجال والنساء، وهي مساواة تضر بالنساء أكثر مما تفيد؛ لأنها تكلف الزوجة بالإنفاق على الأسرة، وتحرمها المهر والنفقة وميراثها الذي يكون أكبر من الرجل في بعض الحالات، والأخرى مساواة جوهرية تستند إلى مبدأ العدل؛ فتفترض أنه طالما أن النساء غير مكلفات بالإنفاق على أسرهن، فإن نصف الميراث يضعها على قدم المساواة مع شقيقها المكلف بالإنفاق على الأسرة.