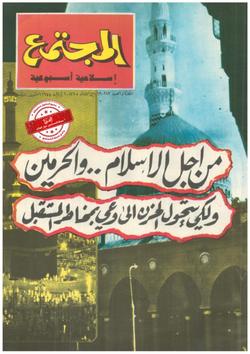العنوان جذور العنف العنصري في المجتمع الأمريكي
الكاتب عبدالوارث سعيد
تاريخ النشر الأحد 17-مايو-1992
مشاهدات 49
نشر في العدد 1001
نشر في الصفحة 16
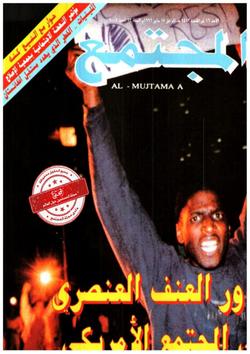
الأحد 17-مايو-1992
في
مايو 1983 عقد في بريطانيا مؤتمر عن التعددية العرقية في الولايات
المتحدة وبريطانيا، شارك فيه العشرات من المعنيين بهذه المشكلة باحثين وتنفيذيين،
وكان الاهتمام مركزًا على السياسة: كيف عولجت قضايا المساواة في المعاملة في
مجالات القانون والتوظيف والإسكان والتعليم؟ وكيف يجب أن تعالج؟ وإلى أي مدى أصبحت
المجموعات العرقية والاجتماعية جزءًا من نظام الدولة؟ وما هي السياسات التي
اتخذت لدمجهم فيها»([1]).
وكان
ذلك استجابة لتزايد التعدد والتباين العرقي في البلدين، بل في العالم الغربي كله،
ولتزايد المشكلات الناجمة عن هذا الوضع، خاصة مع الهزات الاقتصادية، مع فشل
السياسة العامة في تحويل قوانين المساواة ومخططات الدمج العرقي إلى واقع يجسد وحدة
التركيبة السكانية ويحقق الانسجام بين مكوناتها.
ومن بين
القضايا المهمة التي تناولها المشاركون في المؤتمر قضية «العنف
العنصري» وتقف الولايات المتحدة بحكم عوامل عدة- نموذجًا بارزًا في مدى
شيوع هذه الظاهرة وخطورة آثارها عليها، وذلك رغم الخطوات الواسعة التي اتخذتها
الدولة هناك في مجال التخفيف من حدة التمييز العنصري، وهي خطوات لما تنجح كثير من
الدول في العالم في اتخاذ بعضها.
في
دراسة تحليلية بعنوان «العنف العنصري في الولايات المتحدة» ذكر الباحث دونالد ل.
هوروفيتس Donald L.
Horowitz أستاذ القانون
والعلوم السياسية في جامعة «ديوك» أن «الولايات المتحدة عرفت، في القرن العشرين
ثلاثة أشكال من العنف العنصري فمن ثمانينيات القرن الماضي حتى ثلاثينيات القرن
الحالي كان «القتل المعجل» بدون محاكمة حقيقية Lynching
هو الصورة الشائعة من العنف الموجه ضد السود في
الولايات الجنوبية، ومن مطلع القرن حتى 1930 وبشكل متقطع حتى منتصف القرن، وقع ضرب
آخر من العنف تميز بهجوم مجموعات من غوغاء معظمها كذلك في الولايات الشمالية، فقد
اتخذت شكلًا آخر، هجمات للسود على ممتلكات البيض ورموز السلطة العامة، وقد تزامنت
أشكال العنف الثلاثة هذه مع مراحل ثلاث في علاقة البيض بالسود هي على التوالي
«إعادة فرض سيادة البيض» بعد إلغاء الرق واحتلال الجنوب: هجرة السود الواسعة
النطاق إلى الشمال طمعًا في التحسن الاقتصادي والمزيد من الحرية، ثم نمو حركة
جماعية تسعى إلى المساواة الكاملة»([2]).
فإذا
انتقلنا من التصنيف العام لظاهرة العنف العنصري إلى شهادة الأرقام على بعض ملامح
الظاهرة لوجدنا الباحث نفسه يقول: «طبقًا لأفضل الإحصاءات المتاحة، لقي
حوالي 4589 ضحية مصرعهم عن طريق «القتل المعجل» في الفترة
من 1882 – 1931. أما العقد الأخير من القرن الماضي فقد كان عقدًا قاسيًا
حيث بلغ المتوسط السنوي 154 ضحية. وفي العشرينيات من هذا القرن
وقع 95% من حالات القتل المعجل في الجنوب، وكان 90% من
الضحايا على مستوى القطر من السود»([3]).
أما
طريقة تنفيذ القتل فكانت تبدأ عادة باتهام الضحية الأسود بارتكاب جريمة ما ضد أحد
البيض أو خرق أعراف التمييز العنصري غالبًا كإهانة أحد البيض، وكان
الغالب أن تكون التهمة زائفة، لكن كان المتبع عقد محاكمة صورية يجريها الغوغاء قبل
تنفيذ الحكم ليشاركوا بعدها بوحشية في تمزيق الضحية([4]).
دور
الشرطة
من بين
بحوث المؤتمر المذكور بحث عن «ما بعد الاضطرابات: الشرطة والأقليات في
الولايات المتحدة 1970– 1980» للأستاذ لورنس وشيرمان Lowrence W. Sherman الأستاذ المشارك في علم الإجرام في جامعة
ميرلاند ومدير البحوث في مؤسسة الشرطة في واشنطن د. س.
يقول
البحث: إن تاريخ سلوك الشرطة تجاه الأقليات من أي نوع في هذا البلد ليس سارًّا([5]). وليس الأمر مجرد تصرف عارض وإنما هو ثمرة
لتوجه وقناعة مستقرة، يقول: يبدو واضحًا أن التوجهات العنصرية كانت سائدة بين
الشرطة كما هي في أي مكان في المجتمع الأمريكي ففي استطلاع أجري
عام 1949 وجد أن 76% من شرطة إنديانا معادون بقوة للزنوج،
وأن 44% منهم يعتقدون أن الزنوج بطبيعتهم «بيولوجيًا» من
نوعية أدنى.
كما
وجدت لجنة الجريمة في عهد الرئيس جونسون عام 1966 أن توجهات مماثلة
موجودة بين ضباط الشرطة في بوسطن وواشنطن د. س، وشيكاغو. كما أثبت
الاستطلاع أن تلك التوجهات كانت تترجم إلى سلوك تمييزي، كذلك وجدت لجنة الجريمة من
خلال ملاحظات منتظمة لمواجهات بين الشرطة ونحن 10,000 مواطن، أن الشرطة
كانت تميل إلى القبض على السود أكثر من البيض، رغم تماثل الأحوال والمخالفات
تقريبًا([6]).
ويضيف: إن
أخطر اتهام للشرطة بالسلوك العنصري هو ميلهم إلى قتل السود أكثر من البيض وهي تهمة
تصدقها الإحصاءات، فنصف حالات القتل المسجلة رسميًّا منذ أواخر الستينيات والناتجة
عن التدخل القانوني للشرطة، كانت من السود أو أبناء أمريكا اللاتينية الذين يشكلون
اقل من 20% من السكان. وكثير من حالات القتل هذه تنتج عن حوادث لا
تعد جرائم خطيرة كنزاع مع أحد الجيران مثلًا...»([7]).
ورغم أن
البحث يرى أن قدرًا من التحسن قد طرأ، عبر السبعينيات، على سلوك الشرطة تجاه
الأقليات، فانخفضت حوادث قتل الشرطة للسود، فإن بعض حوادث القتل العنيفة قد تثير
الاضطرابات، كالتي تفجرت في ميامي عام 1980 نتيجة تبرئة المحلفين لعدد
من ضباط الشرطة اتهموا بضرب رجل أسود حتى الموت بعد استسلامه واقتيادهم إياه إلى
الحبس.. وآخرين بعد القبض عليهم، ومنهم شخص أسود مضطرب عقليًّا([8])، وهي مع حادثة رودني كينج الأخيرة التي فجرت
الاضطرابات الدامية في لوس أنجلوس تشير إلى عمق المشكلة وبقاء محركاتها مستقرة تحت
غطاء التحسينات الجزئية في ظروف الأقليات أو في سلوك الشرطة.
وإذا
كان من السهل تفهم استعداد الأقليات، خاصة السود، للجوء إلى العنف تجاه البيض، أو
الأقليات الأخرى، وذلك نتيجة الظروف القاسية اقتصاديًّا، والمذلة اجتماعيًّا
وإنسانيًّا، تلك التي توارثوها ولا يزالون يعيشون فيها، فليس هناك أي مبرر مقبول
لتوجهات العنف لدى الشرطة والتحيز الظالم لدى القضاء ضد هؤلاء المظلومين، قد يكون
في مجتمع السود من العيوب الاجتماعية ما يلامون عليه، كالكسل وشيوع الجريمة، من
جنس ومخدرات، وارتفاع نسبة التسرب من التعليم ونسبة المواليد من سفاح، لكن القسط
الأكبر من اللوم يجب أن يوجه إلى الحكومة والإدارة والمؤسسات القانونية
والاجتماعية، وخاصة الهيئات الدينية لأن المنتسبين إليها.. لم يعملوا بقدر كاف من
الجدية والإخلاص لحل مشكلات تلك الأقليات النفسية والاجتماعية والاقتصادية حلًّا
شاملًا وجذريًّا، ليس فقط من أجل صالح تلك الأقليات المظلومة، بل لصالح الشعب
الأمريكي كله، بيضًا وملونين، ولصالح البشرية التي تتضرر من ضياع تلك الطاقات المهدرة
في زرع الشر أو في مقاومته، وإذا كان المنعمون من البيض يظنون أنفسهم بمنجاة مما
يعانيه غيرهم فهم واهمون، لأن واقع الأحداث يؤكد أن الطوفان حين يكتسح لا يحابي
أحدًا، فإذا كان واضحًا أن السود وأمثالهم ضحايا الفقر والتمييز العنصري والتعليم
السيئ والاستغلال، وكلها مما جنته أيدي البيض من المسؤولين.. فالمواطن الأبيض
نفسه- كما قال «وليم ريان» أستاذ علم النفس في كلية بوسطن، والخبير
في المشكلات الاجتماعية في كتابه القيم «لوم الضحايا»- هو أيضًا ضحية،
وإن لم يعِ ذلك لأنه قد تلقى تعليمًا وتوجيهًا سيئين عن طريق «أيديولوجية» أو
أسطورة، ومجموعة من المزيفات التي تحظى بالتصديق الرسمي مع طائفة من
الأباطيل المحترمة، فهذه الأيديولوجية التي أشربتها كل خلية في مخه جعلته لا
يرى عملية تحول الإنسان إلى ضحية في صورتها الكاملة([9]).
وأخيرًا
إذا كان داء العنصرية قد هز بعنف ذلك المجتمع الأمريكي ذا الإمكانات والركائز
القوية في السياسة والاقتصاد، فإن ذلك نذير يصرخ بكل المجتمعات المبتلاة بهذا
الداء بصورة أو بأخرى أن تفيق وتتدارك الأمر قبل حلول الكارثة ﴿فَٱعتَبِرُواْ
يَٰأُوْلِي ٱلأَبصَٰرِ﴾ (الحشر:2).
وأولى
الناس بالبراءة من هذا الداء المسلمون الذين هداهم ربهم إلى التي هي أقوم فهم إخوة
في الله ترى في اختلاف الأجناس والألوان والألسنة آيات لله وعوامل تبعث على
التعارف والتآلف لا على التنابذ والتفاخر، وإذا كان غير المسلمين لم تتح لهم هذه
النعمة، فما الذي يدفع من اتضحت أمامهم الطريق إلى أن يتقحموا النار على بصيرة؟! ﴿فَإِنْ
أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ (فصلت:13).
_________
([1]) Nathan Giazer and ken young (eds); Ethnie Puraliam and Public
public Policy (Leximgton Books, 1983) p..3..
([2]) ibid.
p. 188.
([3]) ibid.
p. 189.
([4]) ibid.
([5]) Ibid.,
p 212.
([6]) ibid,
pp 213- 214.
([7]) Ibid.
214.
([8]) Ibid.
p. 217.
([9]) William
Ryan Blaming the Victim (Victim Books, 1971), p.xl Xii.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل