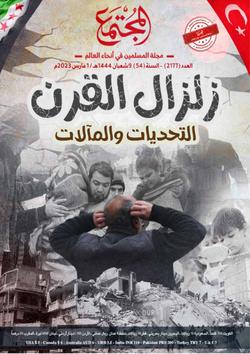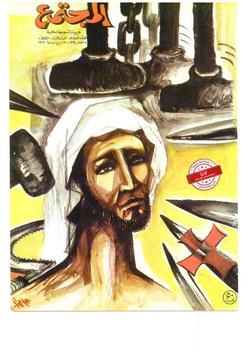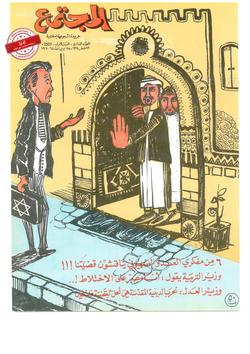العنوان تحرير النزاع حول الحريات وحقوق الإنسان في الإسلام
الكاتب المستشار سالم البهنساوي
تاريخ النشر الثلاثاء 05-يوليو-1994
مشاهدات 40
نشر في العدد 1106
نشر في الصفحة 42
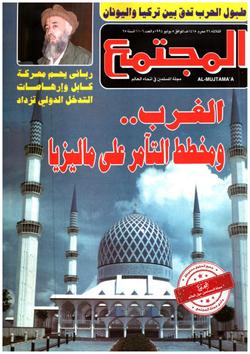
الثلاثاء 05-يوليو-1994
الفوارق في الإسلام بين الذكر والأنثى ليس سببها الذكورة والأنوثة بدليل المساواة بين الأبوين في الميراث
الإسلام جفف منابع الرق بأن ألغاها جميعًا فيما عدا رق الحروب الذي أخضعه للمعاملة بالمثل
ينشر بين فترة وأخرى ما يتضمن أن الإسلام لا يعترف بحقوق الإنسان والحريات كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويرجع السبب في هذا المفهوم إلى أنه توجد للحريات في الإسلام ضوابط تختلف عما يوجد في القوانين البشرية شرقًا أو غربًا.
ونود أن نحرر النزاع في هذه المسالة ونحدد المفاهيم حتى توضع الأمور في نصابها الصحيح.
أولاً- المساواة في الإسلام:
۱- الأصل العام في الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة فيما تماثلا فيه من الحقوق والاستثناء هو التمييز ولا يرجع ذلك إلى الذكورة والأنوثة مطلقًا.
قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (سورة البقرة: ۲۲۸) وإذا كانت الدرجة القوامة للرجال فقد جعلها القرآن الكريم في الحياة الزوجية، قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ ﴾ (سورة النساء: ٣٤).
والتفضيل هنا للفوارق في الخلقة والتكوين ولإلزام الرجل بأعباء النفقات للزوجة والأولاد.
كما نص الحديث النبوي على نوع آخر من القوامة خارج الأسرة وهو رئاسة الدولة فقصرها على الرجال في الحديث الشريف «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وكان عند الحكم بسبب تولي ابنة كسرى حكم بلاد الفرس.
۲- الفوارق في الميراث ليس سببها الذكورة والأنوثة إطلاقًا بدليل المساواة بين الأبوين في قول الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (سورة النساء: ۱۱).
3- الأصل العام هو المساواة بين الناس جميعًا، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ﴾ (سورة النساء: ۱)، وقال النبي: «كلكم لآدم وآدم من تراب»، وقال: «الناس سواسية كأسنان المشط».
أما الأحكام الخاصة بالرقيق فهي حماية لهم وليست تمييزًا لغيرهم في العبادات والعقوبات فكون عقوبة الأمة «العبدة» في جريمة الزنا على النصف من عقوبة المرأة الحرة، هو رعاية بها لظروفها التي قد تكون من دوافع زناها، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (سورة النساء: 25).
ولكن الأصل العام هو المساواة بين الحر والعبد في التكليف وفي العقوبات هذا هو الأصل في القرآن والسنة وأما فهم البعض في عصر ما فليس ملزمًا وليس تشريعيًا.
٤ - إن وجود أحكام للرق في الشريعة الإسلامية لا يعني شرعية الرق، فالإسلام يعالج الواقع الجاهلي العالمي الذي كان موجودًا في عصر نزول القرآن الكريم، حيث كان الرق نظامًا اقتصاديًا مشروعًا، وكان القانون الروماني يميز بين الناس بين الحرية والرق، وكان من أسباب الرق البيع والديون والميراث والحروب.
فحسم الإسلام ذلك وألغى الرق بجميع صوره، وأبقى فقط رق الحروب وأخضعه لقاعدة المعاملة بالمثل، قال الله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ (سورة محمد: ٤)، قال البيضاوي في تفسير هذه الآية، الاسترقاق منسوخ بهذا النص أو مخصوص بحرب بدر فالإسلام جفف منابع الرق بأن ألغاها جميعًا فيما عدا رق الحروب الذي أخضعه لمبدأ يخضع للمعاملة بالمثل، بل خول ولي الأمر أن يمن على الأسرى بغير مقابل، إذا لم يكن للمسلمين أسرى لدى العدو ووجدت الدولة أن المصلحة العامة تقتضي إطلاق سراح الأسرى بغير مقابل.
ويتمثل تجفيف منابع الرق في أن منع النبي أسباب الرق الأخرى كالخطف أو شراء الأحرار وبيعهم أو استرقاق المدين عند عجزه عن سداد الدين، وهو ما كان سائدًا في العالم آنذاك.
ونتيجة لهذه السياسة منع النبي استرقاق الدائنين لسلمان الفارسي عندما عجز عن سداد الدين فقال لهم: ليس لكم عليه سبيل، اقتسموا أمواله قسمة غرماء.
5- أما الموروث من الأرقاء سواء بسبب الحروب أو التملك بالميراث، فقد وضع له الإسلام نظامًا يقضي عليه بالتدرج، بعد أن جفف منابعه فوضع نظام الكفارات ويقضي بتحرير الرقيق عند ارتكاب خطأ يوجب هذه الكفارة من ذلك: القتل الخطأ والظهار وهو نوع من الطلاق يزعم الرجل فيه أن زوجته حرام عليه كأمه، وكذا أنواع أخرى من اليمين، كما جعل في بيت المال «خزينة الدولة» بندًا لتحرير العبيد وهو بند ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (سورة التوبة: ٦٠)، الوارد ضمن مصارف الزكاة.
كما أمر الله كل من يملك عبدًا أو أمة أن يستجيب لطلب المكاتبة إذا رغب فيه الرقيق والمكاتبة في تحريره بمقابل من مال أو عمل بل وأمر بمساعدة الدولة لغير القادر على هذا المقابل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم﴾ (سورة النور: ۳۳).
كما أنه من وسائل تحرير الرقيق موضوع الإماء فمن كانت له أمة عبدة، وعاشرها معاشرة الزوجة فإن من يولد منها للرجل يكون حرًا ولا يخضع للرق كما تصبح هي حرة بوفاة سيدها، قال النبي أعتقها ولدها، كما نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا ييمن ولا يومين ولا يورثن ويستمتع بها سيدها ما دام حيًا فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني والبيهقي.
والإسلام يوجب المساواة في العقوبات والمشاعر الإنسانية وذلك كله إلى أن يتم تحرير العبيد عن طريق المن ابتغاء مرضاة الله أو عن طريق الكفارات أو عن طريق المكاتبة.
قال صلى الله عليه وسلم: «من جدع أنف عبده جدعناه ونهى تسميتهم بالعبيد فقال: لا يقل أحدكم عبدي بل فتاي وفتاتي».
وأمر بنوع خاص من الحقوق للرقيق، فقال صلى الله عليه وسلم: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم» «صحيح الجامع الصغير ٢٣٦/١»
6- أما الفوارق بين المسلم وغير المسلم فهذه تخضع للأصل العام للعقيدة ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: 256).
وأما بالنسبة للتشريعات المدنية فقد حدد الإسلام نوعين من الفوارق هما:
أ - تحريم زواج المسلم بالمشركات وهن من ليس لهن دين سماوي، حيث لا يوجد لها دين يعصمها من الخيانة.
ب - تحريم زواج المسلمة بغير المسلم مطلقًا حيث إن الأولاد ينسبون إلى الأب والإسلام جاء لتحذير البشرية من الانحرافات السابقة.
أما في غير ذلك فالتشريعات يتساوى فيها المسلم مع غير المسلم أي في المعاملات والعقوبات وما يوجد لدى بعض الفقهاء من أقوال بأن المسلم لا يقتل في غير المسلم، إنما هو فهم خاص وغير صحيح للحديث النبوي: «لا يقتل مؤمن بكافر»، ذلك أن للحديث النبوي بقية هي: «ولاذو عهد في عهده»، ولهذا نقل الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أن هذا الحديث يدل على أن الكافر هنا هو الكافر المحارب بدليل أنه ساوى بين المسلم وبين الكافر المعاهد في ألا يقتلا عند قتلهما الكافر أي المحارب.
لهذا انتهت جميع تشريعات القوانين الجنائية الإسلامية إلى المساواة بين المسلم وغير المسلم في العقوبات ومنها عقوبة القتل، وهذه القاعدة وهي أن المحارب غير معصوم الدم في مواجهة المسلم أي مواطني الدولة وكذا المعاهدين أي المتحالفين معها، قد توصلت إليها الدول الحديثة بعد اثني عشر قرنًا من تشريع الإسلام لها بالحديث النبوي سالف الذكر.
ثانيًا- الخلاف حول مفهوم المساواة والحقوق:
لقد تضمن المقال أن المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان في الإعلان لحقوق الإنسان يختلف كلية عن المفهوم الديني الإسلامي لها ويجب أن يكون لدى الكتاب الإسلاميين الشجاعة لإنكار الحقوق الإنسانية المتعارضة مع حق الله تعالى.
إن تفسير نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من النصوص الخاصة بعدم التفرقة بين الرجل والمرأة يجب أن يقيد بأسباب وضع هذه النصوص.
فقد ورثت القوانين الأوروبية عن القانون الروماني التمييز الصارخ بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات حيث تنص القوانين الأوروبية على استحقاق المرأة نصف أجر الرجل عن ذات العمل، وتمنعها من الاحتفاظ باسم عائلتها عند الزواج فيجب أن تنتسب إلى عائلة زوجها، وأيضًا تمنع هذه القوانين المرأة من التصرف في أموالها الخاصة حتى تثبت أن هذا المال ليس موهوبًا منها لزوجها عند الزواج وليس من الأموال المشتركة بين الزوجين لهذا نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم التمييز بين الرجل والمرأة بسبب الدين أو الجنس.
ولقد اعترضت بعض الدول الكبرى على صياغة هذه المادة لأنها تعتبر تدخلًا في الشئون الداخلية للدول، ولهذا اتفقت هذه الدول على علاج هذه المشكلة في صياغة المادة ٢٢ التي تضمنت ما يأتي:
«يراعى في التشريعات للدول الأطراف في الميثاق أن تتجه في المساواة بين الزوجين في الحقوق والمسئوليات»، فأصبح النص كتوصية وليس إلزامًا والمساواة فيه ليست مطلقة وكاملة.
ومع هذا فظلت الأسباب الثلاثة السابقة للتفرقة بين الرجل والمرأة متوارثة في تشريعات أوروبية حتى اضطرت الأمم المتحدة لإصدار القرار رقم ٤٠١٠/ ١٩٧٤م بجعل عام ١٩٧٥م هو السنة الدولية للمرأة لحث الدول على أن تراعى في تشريعاتها تجنب المظالم والفوارق المشار إليها..
ومع هذا فلو فهمت جدلًا نصوص الإعلان العالمي أو غيرها على أنها المساواة الحسابية المخاطئة.
فإن أحكام العقيدة الإسلامية وكذا التشريعات القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية تعتبر من النظام العام في الدول الإسلامية ولا يقدم عليها أي تشريع أجنبي مهما كان، وإن كانت الدول الحديثة جميعها تعتبر المقومات الأساسية لمجتمعاتها من النظام العام ولا يجوز المساس بها، فإنه أولى بالمسلمين أن يدركوا أن ما أنزله الله على رسوله ليسود بين الناس إنما هو العدل الذي لا بديل عنه.
ثالثًا- مفهوم الحريات الأساسية:
تضمن المقال أن المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان يختلف كلية عنه في الشريعة الإسلامية، لأن الحقوق في الإعلان العالمي نتاج للعلمانية الفرنسية التي انبثق عنها إعلان الحقوق الصادر سنة ۱۷۸۹م والذي اعترفت بالحقوق الجميع المواطنين وبحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبالشعب مصدرًا لجميع السلطات وتم استبعاد حق الله تمامًا خاصة فيما يتعلق بالعبادات وحق الإنسان المطلق في أن يعبد الله أو لا يعبده أو يبتدع دينًا خاصًا به.
والجواب على ذلك وبإيجاز شديد هو:
1- أن الحريات العامة الواردة في هذا الإعلان وغيره ليست مطلقة، فالنظم الديمقراطية تضع قيودًا على الحريات في مجالات أهمها:
أ- حماية عقيدة الشعب.
ب- حماية أمن الدولة.
ج- حماية الأفراد من الطعن فيهم.
أما النظام الشيوعي فقد قيد الحريات كلها وجعلها لمساندة النظام الشيوعي حسبما نصت عليه المادة ١٢٦ من الدستور السوفيتي.
فكيف بنا كمسلمين نريد أن نفهم الحقوق والحريات بغير ما يفهمه أصحاب المبادئ العلمانية يمينًا ويسارًا حيث وضعوا قيودًا لحماية مبادئهم؟ فهل تصبح القيود الواردة في الشريعة الإسلامية على الحريات بدعة وضلالة تجب محاربتها؟
إننا لسنا في حاجة إلى أن نقول للمسلمين إن القيود الواردة في الشريعة الإسلامية هي لصالح الفرد والمجتمع، وقد أثبت علماء أوروبا ذلك فيما يتعلق بتحريم الزنا وسائر الفواحش وفيما يتعلق بغير ذلك من المحرمات.
2- إن العلمانية التي انبثق عنها النظام الديمقراطي والذي يجعل الشعب هو مصدر السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية حيث إن نواب الشعب يختصون بوضع التشريعات بالأغلبية وكذا يختصون باختيار الحاكم ومحاسبته وعزله.
هذه الديمقراطية لا يُعد الأخذ بها كفرًا وضلالًا في ظل أي نظام إسلامي إذا ما تضمنت قواعده الأساسية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعات.
فالخلاف الجوهري بين الشريعة والديمقراطية ينحصر في حرية النواب في اختيار أي تشريعات ولو خالف الأحكام القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية وهذه تصحيح بالقيد سالف الذكر.
والجدير بالذكر أن النظم الرأسمالية تضع قيدًا في النظام الأساسي يحول دون إصدار تشريعات تلغي النظام الرأسمالي وتتبنى الشيوعية وكذلك البلاد التي تتبني الشيوعية قد تضمنت تشريعاتها الأساسية ما يحمي نظامها الاجتماعي على نحو ما سلف ذكره عن الدستور السوفيتي «مادة ١٢٥ و١٢٦».
أما اختيار الحاكم ومحاسبته وعزله فالشريعة الإسلامية تجعل ذلك للأمة ويغير القيود الواردة في النظام الديمقراطي حيث يعطى رئيس الدولة من المسئولية بدرجات متفاوتة، فالنظام الجمهوري يعطيه من المسئولية السياسية، والنظام الملكي يعطيه من المسئولية السياسية والجنائية طبقًا لقاعدة «حيث لا سلطة لا مسئولية».
بل إن النظم الجمهورية تضع قيودًا على المساءلة الجنائية وكلا النظامين يخول رئيس الدولة حق العفو عن الجرائم وهذه يبطلها الإسلام إذا تعلقت بالجرائم الكبيرة وهي الحدود والقصاص.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل