العنوان تكنولوجيا المعلومات.. برمجيات «المصدر» المفتوح
الكاتب د. عمر عبد العزيز مشوح
تاريخ النشر السبت 18-أغسطس-2007
مشاهدات 84
نشر في العدد 1765
نشر في الصفحة 58
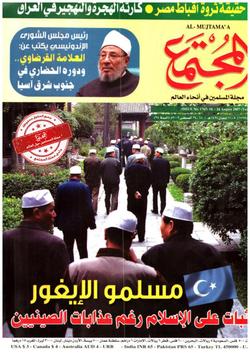
السبت 18-أغسطس-2007
يعبر مصطلح «المصدر المفتوح» أو ما يسمى Open Source عن البرمجيات التي يمكن رؤية الشفرة البرمجية «الكود البرمجي» الخاص بها ويمكن التعديل عليه والتعامل معه بحرية كاملة من أجل تطويره أو تعديله. وقد تحدثت موسوعة ويكيبيديا عن المصدر المفتوح، ووصفتها بأنها البرمجيات التي تحقق الشروط التالية:
- حرية إعادة توزيع البرنامج.
- توافر النص المصدري للبرنامج، وحرية توزيع النص المصدري.
- حرية إنتاج برمجيات مشتقة أو معدلة من البرنامج الأصلي، وحرية توزيعها تحت نفس الترخيص للبرمجيات الأصلية.
- من الممكن أن يمنع الترخيص توزيع النص المصدري للنسخ المعدلة، بشرط السماح بتوزيع الملفات التي تحتوي على التعديلات بجانب النص الأصلي.
- عدم وجود أي تمييز في الترخيص لأي مجموعة أو أشخاص..
- عدم وجود أي تحديد لمجالات استخدام البرنامج.
- الحقوق الموجودة في الترخيص يجب أن تعطى لكل من يتم توزيع البرنامج إليه.
هذه هي الميزات الأساسية لأي ترخيص، من الممكن أن يطلق عليه ترخيص مفتوح المصدر.
استطاعت هذه البرمجيات أن تكسر احتكار الشركات البرمجية العملاقة أمثال مايكروسوفت وأوراكل وجميع الشركات التي تأخذ مقابلًا للبرمجيات التي تصدرها، وبدون أن تكشف الكود البرمجي الخاص بها. ولذلك أصبحت المنافسة قوية بين هذه البرمجيات ذات المصدر المفتوح وبين البرمجيات المغلقة «التي يتم استخدامها بدون معرفة الكود البرمجي» والتي يتم دفع مقابل مادي للتراخيص الخاصة بها. ومن أهم مميزات برمجيات المصدر المفتوح أنها قوية من الناحية البرمجية وقليلة الأخطاء والمشاكل بعكس البرمجيات المغلقة، والسبب في ذلك يعود إلى أن برمجيات المصدر المفتوح يتعامل معها ويعدل عليها الآلاف من المبرمجين، وذلك في حالة حدوث خطأ أو مشكلة يتم توفير الحل له في أسرع وقت لأن المصدر البرمجي مفتوح ومتاح للجميع، وهذا ما لا توفره البرمجيات المغلقة والتي تتحكم فيها الشركات، ويقع المستخدم تحت رحمة هذه الشركات حتى يتم حل المشكلة التي يواجهها. من أشهر تطبيقات أو أمثلة برمجيات المصدر المفتوح مثالان هما أقوى دليل على نجاح برمجيات المصدر المفتوح وأن المستقبل لها.
المثال الأول: هو نظام التشغيل لينيكس Linux:
ففي نهاية عام ١٩٩٠ م قام لينوس تورفالدس الطالب في جامعة هلسنكي في فنلندا بالإعلان عن مشروع يعمل عليه، وقد اختار لينوس أن يضع مشروعه تحت ترخيص برامج المصدر المفتوح، مما أتاح إمكانية الاطلاع على النص المصدري لهذا النظام، والعمل على تعديله وتطويره، نتيجة لذلك، شارك الآلاف من المبرمجين المتطوعين حول العالم في المشروع، وقد أصبح نظام التشغيل «لينيكس» من أقوى أنظمة التشغيل وينافس بقوة نظام تشغيل «ويندوز»، بل وأقوى منه في كثير من الخصائص.
المثال الثاني: هو برنامج المتصفح فايرفوكس FireFox:
الذي طورته شركة موزيلا، وأصبح هذا المتصفح منتشرًا بشكل كبير، وبدأ ينافس برنامج «الإكسبلورر» الذي تنتجه مايكروسوفت والذي يعاني منه كثير من المستخدمين؛ بسبب كثرة مشاكله وثغراته الأمنية.
وقد اتجه الكثير من الدول نحو تغيير أنظمة التشغيل الخاصة بها والبرامج والتطبيقات التي تستخدمها، والاتجاه إلى البرمجيات ذات المصدر المفتوح، بعد أن أثبتت التجارب أنها أقوى من ناحية الثبات ومن الناحية الأمنية التي هي أخطر مشكلة تواجهها التطبيقات المغلقة، وأنظمة التشغيل ذات التراخيص التجارية. إذًا لا بد من الاتجاه نحو برمجيات المصدر المفتوح من قبل الحكومات والقطاع الخاص ومن قبل المبرمجين أيضًا، وذلك لكسر احتكار الشركات البرمجية العملاقة التي تهيمن على سوق البرمجيات وتربط مصير المستخدم بمصير منتجاتها وتطويرها.
ومضة لتصحيح المسار:
النظرة المادية البحتة التي تتعامل بها شركات البرمجة العربية هي التي أغلقت مجال الإبداع والتطوير في برمجيات المصدر المفتوح في العالم العربي.. حيث غاب التشجيع والدعم والمبادرة.. وسادت النظرة المادية والاحتكار.. أما المبرمج العربي فمازال رهينة منتج «النسخ» و «اللصق».




