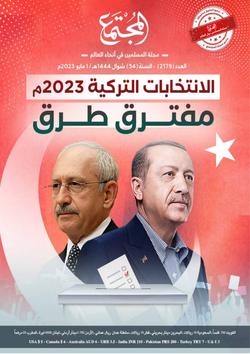العنوان تنبيهات للدعاة في المجال التاريخي
الكاتب د. يوسف القرضاوي
تاريخ النشر الثلاثاء 31-مايو-1977
مشاهدات 50
نشر في العدد 352
نشر في الصفحة 28
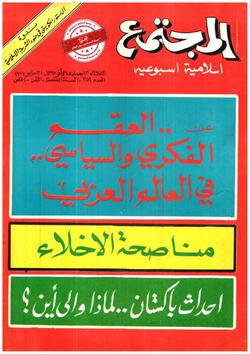
الثلاثاء 31-مايو-1977
وأود أن ينتبه الداعية الذي يطالع التاريخ، ويقتبس منه إلى الأمور الآتية:
1- ألا يجعل أكبر همه وعي جزئيات التاريخ وتفصيلاته، فهذه لا يمكن أن تحصر ولو أمكن أن تحصر لكانت فائدة الداعية منها جد قليلة.
إنما المهم رؤوس العبر، ومواقع العظمة في التاريخ.
وبعبارة أخرى: المهم هو المغزى الأخلاقي للتاريخ واتجاهات الأحداث فيه، وحصادها الناطق المعبر بلسان الحال.
ب- أن يكون ذا وعي يقظ للوقائع التاريخية التي تخدم موضوعه، وتعمق فكرته وتقدم لها الشواهد الحية. وليس من اللازم أن يجد هذه الوقائع في كتب التاريخ المتخصصة، بل كثيرًا ما يلتقطها بحسه الواعي من مصادر قد لا يلتفت إليها كثيرًا رجال التاريخ فقد يلتقطها من القرآن فيما قصه علينا بالحق ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ (يوسف: 111)، وقد يلتقطها من كتب الحديث والآثار، وخصوصًا فيما يتعلق بعصر الراشدين والقرون الأولى، وقد يلتقطها من بعض كتب الأحكام مثل الخراج والأموال، وقد يلتقطها من كتب الأدب، أو كتب الحسبة، أو كتب الرحلات، أو كتب الفتاوى وغيرها.
جـ- أن يعني بسير الرجال، ومواقف الأبطال، وبخاصة العلماء والدعاة، والصالحون. وفي تاريخنا ثروة من السير تتمثل فيها الأسوة الحسنة، والقدوة الصالحة، وتبرز الشخصية المسلمة مجسدة في مواقف وأعمال كما نلمس ذلك في كتب الطبقات والتراجم، سواء ما كان منها عامًا كوفيات الأعيان، والوافي بالوفيات، وما كان منها خاصًا بفئة معينة كرجال الحديث مثلًا، كما تجد ذلك في طبقات ابن سعد، وتهذيب التهذيب أو الزهاد والصالحين مثل حلية الأولياء وصفة الصفوة، أو الفقهاء مثلًا كالمجتهدين من الأئمة، أو اتباع مذهب معين مثل طبقات الحنفية أو الشافعية وغيرهم من علماء المذاهب المتبوعة، وهكذا طبقات الأطباء والحكماء واللغويين والنحاة... إلخ.
فالذي نركز عليه هنا: إن التاريخ ليس للملوك ولا لرجال السياسة وحدهم فكم من أفراد وفئات أخرى تسهم في صنع التاريخ، وتترك «بصماتها» في حياة الناس أكثر من السلاطين والأمراء والزعماء السياسيين.
وقد نجد حياة هؤلاء الطافين على سطح التاريخ فقيرة أو مقفرة من القدوة على حين نجد حياة الآخرين خصبة وثرية من المثل العليا، والمعاني الطيبة، وهذا ما لم يغفله تاريخنا الإسلامي والحمد لله.
د- أن يهتم بربط الحوادث والوقائع - خصوصًا في تاريخنا الإسلامي - بأسبابها وعللها المعنوية والأخلاقية؛ فالذي يطالع تاريخنا بدقة ويتأمل سيره بعمق، يجد أن المد والجزر، والامتداد والانكماش، والنصر والهزيمة والازدهار والذبول، والغنى والفقر، كلها ترتبط بمقدار صلة الأمة بالإسلام أو انفصالها عنه، وقربها من تعاليمه أو بعدها عنها، وحسبنا أن نظرة علجي إلى عصر الراشدين أو عصر عمر بن عبد العزيز أو عصر الرشيد أو نور الدين أو صلاح الدين لنرى تمسكًا بالدين أو رجعة إليه، ونرى ثمارها عزًّا وازدهارًا، والعكس بالعكس في عصور أو فترات أخرى.
هـ- أن يكون محور التاريخ هو الإسلام نفسه دعوة ورسالة، وأثره في تربية الأجيال وتكوين الأمة المسلمة، وإقامة الدولة الإسلامية وبناء الحضارة الإسلامية، والثقافة الإسلامية، وتأثيره في العالم كله، وقدرته على الانتشار عند القوة، والمقاومة عند الضعف، واستطاعته التأثير في غالبيه ليعتنقوه عن رضا واختيار - كما فعل مع السلاجقة والتتار، واختزانه كل العناصر والطاقات اللازمة لإمداد أمته بروح الجهاد لإثبات الذات أو لاستعادتها.
وهنا يجب أن نركز على عدة حقائق تاريخية قد يغفلها مغفلون عمدًا أو سهوًا:
1- يجب إبراز الجاهلية العالمية والعربية - التي كان يتردى فيها العالم عامة والعرب خاصة - على حقيقتها بلا إفراط ولا تفريط.
ذلك أن النزعات التبشيرية والاستشراقية تريد أن تلبس هذه الجاهلية لبوسًا حسنًا، مضخمة ما كان لها من حسنات، متغاضية عما عجت به من مثالب، وقد طرب لذلك القوميون، وخصوصًا من العرب، فحرصوا على عرض الجاهلية العربية مبرأة من كل عيب، وإذا عرضوا الشيء من عيوبها مسوه برفق: كما يبدو ذلك في دراسة التاريخ والأدب وما سمي «المجتمع العربي» وغير ذلك، متجاهلين ما كانوا عليه من فساد العقائد، والأخلاق، والأنظمة، والتقاليد. وصدق الله حين قال ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ([1]) (الجمعة: 2).
ورضي الله عن عمر الذي قال: «إنما تنقض عرا الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»؛ وذلك لأنه لا يعرف ماذا قدمه الإسلام من هداية وإصلاح.
2- ينبغي الاهتمام بحركات الإصلاح والتجديد في تاريخ الإسلام وبرجال التجديد الذين يبثهم الله بين حين وآخر في هذه الأمة ليجددوا لها دينها، أيًّا كان لون هؤلاء الرجال واتجاههم، فقد يكون منهم الخلفاء كعمر بن عبد العزيز، أو السلاطين والأمراء كنور الدين وصلاح الدين أو الفقهاء والدعاة كالشافعي والغزالي وابن تيمية وابن عبد الوهاب، وقد يكون المجدد فردًا، وقد يكون جماعة أو مدرسة إصلاحية يبرز بها اتجاه في الإصلاح له سماته وخصائصه.
3- كما يجب الالتفات إلى دور الإسلام ورجاله وأثره في حركات المقاومة والتحرير التي ظهرت في العالم الإسلامي منذ وطئته جيوش الاستعمار فرغم المكر الصليبي، ومحاولات التحذير وذر الرماد في عيون المسلمين، لم يسلم الاستعمار من المقاومة الباسلة في كل بلد دخله وأريقت الدماء وسقط الشهداء تلو الشهداء، ولم تزل المقاومة على مر الزمن حتى كان التحرير وكان الإسلام وعلماؤه ودعاته، وراء هذا الجهاد للاستعمار، بريطانيًا كان أو فرنسيًا أو إيطاليًا أو إسبانيًا أو غير ذلك وقد شهد بذلك مؤرخون غربيون مثل برنارد لويس([2]) وغيره.
وأضيف إلى التنبيهات السابقة للدعاة في مجال الثقافة التاريخية - تحذيرات يجب على الداعية ألا يغفل عنها:
أولًا- ليس كل ما تحويه كتب التاريخ صحيحًا مائة في المائة، فكم حوت مراجع التاريخ من مبالغات وتشويهات وتحريفات تكذبها الحقائق الثابتة بالاستقراء أو بالموازنة بالأدلة الناصعة في مصادر أخرى، وكم لعبت الأهواء والعصبيات السياسية والدينية والمذهبية دورها في كتابة التاريخ، وفي رواية وقائعه وتلوين أحداثه، وتصوير أبطاله إيجابًا أو سلبًا، وخصوصًا إذا علمنا أن - التاريخ يكتبه - عادة المنتصرون الغالبون، والغلبة لها بريق وأضواء كثيرًا ما تعشي أعين المؤرخين عن سوءات الغالبين، في حين تضخم أخطاء المغلوبين، وتطمس فضائلهم عن قصد أو غفلة.
وإذا نظرنا إلى تاريخنا الإسلامي الذي يتعلق بأمثل عصور الإسلام وأفضلها وهو تاريخ العصور الأولى التي انتشر فيها الإسلام في الآفاق، وانتشرت معه لغته وفقهه، واتسع فيها تعلم كتابه وسنة نبيه، وهو تاريخ عصر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الذين أثنى عليهم الله ورسوله، وهم الذين حفظوا القرآن والحديث وبلغوهما إلى الأجيال اللاحقة من بعدهم - إذا نظرنا إلى هذا التاريخ وجدناه قد ظلم وشوه في كتب التاريخ أي ظلم وتشويه، ثم يجيء المعاصرون ليأخذوا من تلك الكتب بعجرها وبجرها، ويقولون: نحن لم نحد عن الطريقة العلمية، فمصدرنا الواقدي أو الطبري أو ابن الأثير ... إلخ ... جزء كذا صفحة كذا طبعة كذا.
هكذا يصنع المستشرقون، وهكذا يفعل أساتذة التاريخ في الجامعات، وهكذا يسير الذين يكتبون عن التاريخ في المجلات، وفي غير المجلات.
ولم يكلف هؤلاء أنفسهم أن يدرسوا كيف كتب تاريخ تلك العصور.
لنأخذ أهم هذه المصادر القديمة وأشهرها وهو: تاريخ الطبري.
لقد كانت الفكرة المهيمنة على الطبري عند كتابة تاريخه هي التجميع، دون الانتقاء أو التمحيص للأسانيد أو الوقائع المروية، وعذره في ذلك أمران:
أولهما: إنه يروي الحوادث بسندها إلى من رواها، ويرى أنه إذا ذكر السند فقد برئ من العهدة، ووضعها على عاتق رواته. وقد قيل: من أسند فقد حمل، أي حملك البحث في سنده، وكان هذا مقبولًا في زمنه حيث يستطيع العلماء أن يعرفوا رجال السند، ويحكموا لهم أو عليهم.
ومن هنا قال الطبري في مقدمة تاريخه: فما كان في كتابي هذا مما يستنكره قارئه أو يستشينه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحة، ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا.
بحكم أهدافها وقيمها المستمدة من الإسلام، إسلامية بحكم بواعثها ودوافعها المرتبطة بخدمة الإسلام. إسلامية بحكم العناصر التي أسهمت في بنائها وتشييد أركانها، وهي عناصر تشمل كل الأجناس والشعوب الإسلامية إسلامية بحكم الرقعة التي امتدت إليها وأثرت فيها، وهي رقعة واسعة تشمل العالم الإسلامي كله.
على أن للعرب فضلًا لا ينكر، فهم عصبة الإسلام الأولى، وحملة رسالته الأولون ومبلغو القرآن والسنة إلى العالمين، وفيهم بعث الرسول الخاتم، وبلسانهم نزل الكتاب الخالد، وفي أرضهم حرم الله وحرم رسوله، ولكن هذا شيء وتحريف التاريخ شيء آخر.
وبهذا حمل رواته التبعة، وحمل بالتالي دارس كتابه أن يفتش عنهم في كتب الرجال، ومصادر الجرح والتعديل، وسيجد عددًا منهم ساقطًا بالمرة، وعددًا آخر مختلفًا في توثيقه وتضعيفه، وعددًا آخر من الثقات المقبولين.
فمن الصنف الأول والثاني: محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، قال فيه الإمام مالك وغيره ما قالوا، ومن وثقه لا يقبل كل ما يرويه، والرواة عنه أضعف منه وأوهن.
والواقدي كذبه جماعة من أئمة الحديث، ومن قبله لم يقبله بإطلاق، وهشام بن محمد الكلبي وأبوه، وهما متهمان بالكذب.
وسيف بن عمر التميمي كان يضع الحديث، ويروي الموضوعات عن الأثبات، اتهم بالزندقة، وضعفه غير واحد.
وأبو مخنف لوط بن يحيى تالف محترق.
وغير هؤلاء كثيرون من المجروحين المتروكين عند أئمة الجرح والتعديل من علماء الحديث، وإن كان رجال التاريخ والأخبار يروون عنهم، ويستندون إليهم.
ومن أجل هذا لا يقيم المحققون وزنًا لروايات «الإخباريين» ولا يعتمدون عليها ويعيبون من ينقل عنها في كتب العلم المعتبرة.
ولهذا نجد الإمام النووي يقول في كتاب «الاستيعاب» لفقيه المغرب ومحدثه الإمام ابن عبد البر النمري: إنه من أحسن الكتب المؤلفة في الصحابة وأكثرها فوائد، لولا أنه يذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الإخباريين.
قال السيوطي معقبًا: والغالب عليهم الإكثار والتخليط فيما يروونه([3]).
والعذر الثاني للطبري في عدم تمحيص ما رواه في تاريخه: إن الموضوع لا يترتب عليه حكم شرعي من تحليل، أو تحريم، أو إيجاب، أو غير ذلك، مما يتعلق به علم الفقه كما أنه لا يتصل ببيان كلام الله أو كلام رسوله، كما في علم التفسير، أو علم الحديث ولا غرو إن وجدنا الطبري - الذي كان إمامًا جليل القدر في التفسير والحديث والفقه حتى كان له مذهب متبوع مدة من الزمن - يدقق ويحقق فيها يتصل بهذه العلوم المذكورة، ولكنه يترخص ويتساهل في أمر التاريخ قائلًا في تسويغ ذلك «إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج»
وغفر الله للإمام الطبري، فإن هذا التساهل قد شوه تاريخ فجر الإسلام، وأساء إلى حملة رسالة الإسلام الأولين، وفتح باب الاعتذار نفسه لمن بعده، فأخذوا عنه كما أخذ عمن قبله، وأدوا إلى من بعدهم، كما أدى هو إليهم، ومن ثم نرى أن ابن الأثير وأبا الفداء وابن كثير وغيرهم يعتمدون على الطبري ثم جاء المعاصرون والمستشرقون فاعتمدوا على هؤلاء، واعتبروا ذلك علمًا وتحقيقًا.
ولا غرو إن قام فقيه كبير، وإمام جليل، هو القاضي أبو بكر بن العربي «ت543» بالدفاع عن الصحابة، وتحقيق مواقفهم بعد وفاة الرسول، تحقيقًا علميًا موضوعيًا، وذلك في كتابه القيم: «العواصم من القواصم» الذي أخرج الجزء الخاص منه بالصحابة وحققه وعلق عليه بإفاضة: العلامة السيد محب الدين الخطيب -رحمه الله- وجزاهما عن الإسلام خيرًا.
ثانيًا: كما يتعرض التاريخ للتحريف والتشويه في تدوينه، يتعرض لهما أيضًا في تفسيره. وفي عصرنا هذا نجد الأهواء والعصبيات والتيارات الفكرية تعمل عملها في تفسير التاريخ وتوجيه وقائعه، وقد انعكس هذا على التاريخ الإسلامي أيضًا.
فالمستشرقون - في الغالب - يبحثون في التاريخ، يخدمون به فكرة بيتوها عن محمد ودينه، فمحمد ليس برسول الله، والإسلام ليس بدين الله، وأصحابه ليسوا إلا ثلة من المغامرين المتنافسين على الدنيا.
وإذا كان هذا رأيهم في الصحابة فكيف من بعدهم؟
لا دين عندهم إلا اليهودية والمسيحية والإسلام نسخة محرفة منهما، ولا عبقرية عندهم إلا للغربيين، ولا حضارة كحضارة اليونان والرومان. والمسلمون لا يزيدون على أن يكونوا نقلة لهما... إلخ.
وفي سبيل هذا يغفلون أحداثًا قيمة، ويضخمون أحداثًا تافهة، ويعتمدون أخبارًا ضعيفة أو مكذوبة، يتصيدونها من أي كتاب ولو كان «الأغاني للأصفهاني».
ويوجهون هذا كله توجيهًا مسمومًا يؤيد اعتقادهم السابق عن الإسلام وكتابه ورسوله وأمته.
والماركسيون يفسرون التاريخ - وفقًا لفلسفتهم المعروفة تفسيرًا ماديًا طبقيًا، ويحاولون أن يطبقوا ذاك على نشأة الإسلام وظهوره وانتشاره، ويعتسفون في ذلك كل الاعتساف، ويحملون الأحداث ما لا تحتمل بحال، ويقسمون الصحابة إلى يمين ويسار، ويديرون صراعًا موهومًا بينهما وهكذا. وكثير من كتاب المسلمين أنفسهم، يخلعون على حوادث التاريخ، ومواقف رجاله، ما عرفوه وخبروه من ألاعيب السياسية، ومواقف رجالها في هذا العصر ويتخيلون العلاقة بين عمر وخالد، أو بين عثمان وعلي، أو بين علي وطلحة والزبير، من أمثال العلاقة بين الطامحين والطامعين من رجالات الأحزاب وتجار السياسة في عصرنا ويفسرون المواقف والأحداث تبعًا لهذا التصور الظالم المتجني على هذا الجيل المثالي الذي لم تكتحل عين الدنيا برؤية مثله.
والقوميون من العرب يوجهون التاريخ الإسلامي كله وجهة قومية، فالإسلام في نظرهم انتفاضة عربية أو وثبة من وثبات العبقرية ورسول الإسلام ذاته بطل قومي جادت به أمة العرب على الإنسانية ولا نعب بعد ذلك إذا غدا «أبطال الإسلام» وعلماؤه ورجالاته الكبار على مدار تاريخه أبطالًا «عربًا» ولا غرو أن تسمى الحضارة الإسلامية «حضارة عربية» مع أنها بلا ريب إسلامية.
([1]) سورة الجمعة/ 2.
([2]) في كتابه للغرب والشرق الأوسط- ترجمة نبيل صبحي.
([3]) انظر التدريب على التقريب جـ2 ص207.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلوثيقة «الدليل المنير».. وعلاقتها بانتشار الإسلام في الأندلس
نشر في العدد 2122
37
الأربعاء 01-أغسطس-2018

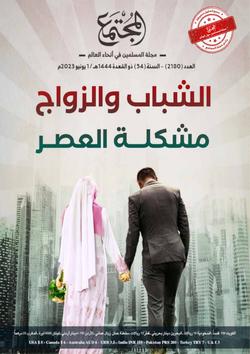
عندما يتم استخدام الدراما لتزييف التاريخ.. مسلسل «رسالة الإمام» نموذجاً!
نشر في العدد 2179
31
الاثنين 01-مايو-2023