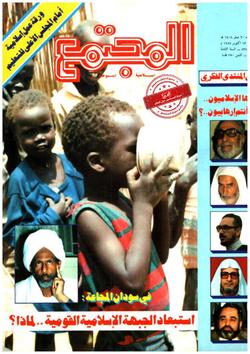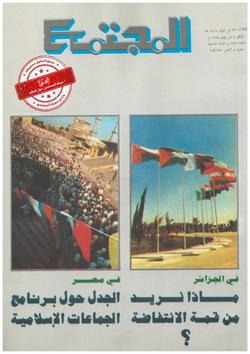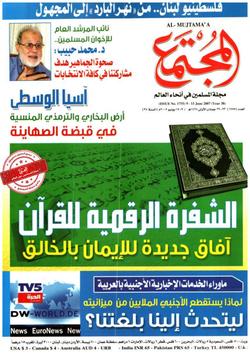العنوان المجتمع التربوي (العدد 1331)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 22-ديسمبر-1998
مشاهدات 12
نشر في العدد 1331
نشر في الصفحة 54
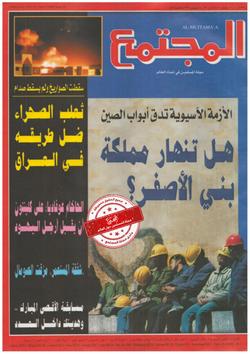
الثلاثاء 22-ديسمبر-1998
حتى يثمر الصوم التقوى.. لا بد من صيام الجوارح
بقلم: جعفر الطلحاوي
لكل عضو في جسد الإنسان صومه الخاص.. ولا يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب.
حتى يمن الله علينا بالتقوى، تلك الثمرة التي كان رسول الله ﷺ يدعو ربه أن يؤتيه إياها فيقول: «اللهم آت نفسي تقواه، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»، لا بد لنا من أن نعقل ونعي أن الهدف من الصوم إنما هو التهذيب للنفس، والتأديب للطبع، وذلك بكف الجوارح عن المحارم، وإمساك سائر الأعضاء عن المحرم أبدًا، انطلاقًا من المحرم مؤقتًا على البطن والفرج في نهار الصائم.
ومن هنا نقرر أن لكل جارحة صومها، ولكل عضو صومه الخاص به، ونعني بالأعضاء والجوارح هنا: «اللسان، والعين، والأذن، واليد، والرجل، والقلب من ورائها كلها- إضافة- إلى البطن والفرج»؛ لأن المسلم إذا أمسك عن الطعام والشراب أو شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة:187)، وفي الوقت نفسه أطلق لسائر الجوارح العنان فوقعت في المحرمات، وانتهكت الحرمات فإنه يحبط أجر صومه، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ٣٣)، وفي الحديث: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر»، أو كما قال ﷺ.
وهاك ما ينبغي أن تصوم عنه كل جارحة حتى يثمر الصوم التقوى.
نبدأ بالقلب لأهميته بين سائر الجوارح، ففي الحديث الصحيح «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»، ولا يستقيم الإيمان لعبد حتى يستقيم قلبه، وكثيرة هي الآثام الباطنة التي تقع من العباد، وقد أمرنا الله – تعالى - بترك كل إثم، ظاهرًا كان أو باطنًا ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ (الأنعام: ١٢٠)، ومن هذه الآثام التي يجب أن نمسك قلوبنا عنها حتى يوم صومنا:
1- الكبر: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر».
2- الأمن من مكر الله: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (الأعراف: ٩٩).
3- الرياء: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (الماعون: 4 - 7).
4- الغل: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحشر: ١٠).
5- الحسد: «ولا تحاسدوا»
6- الإعجاب بالنفس أو الرأي: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه».
7- محبة ما لا يحبه الله، والمحبة لغير الله – تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: ١٩)، إلى ما هنالك من آفات هذه المضغة حتى تستقيم.
وثانيتها: اللسان، والارتباط بينهما وثيق: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»، ومما ينبغي أن نمسك ألستنا عنه:
1- الكذب: إياكم والكذب.
2- الغيبة: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ﴾ (الحجرات: ١٢).
3- النميمة: «لا يدخل الجنة تمام».
4- شهادة الزور: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الحج: ٣٠).
5- السباب: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر».
6- الطعن واللعن: والفحش والبذاءة: «ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء».
7- اللغو: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (المؤمنون: ٣).
8- القذف، وهو الاتهام بالفاحشة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النور: ٢٣).
9- السخرية: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ (الحجرات: ١١).
10- التنابز بالألقاب، وهو أن ينادي المسلم على أخيه باسم يكرهه: ﴿لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ ( الحجرات: ١١).
إلى آخر هذه الآفات التي يجب أن يصوم عنها اللسان، «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم».
وثالثها: العين، ومما ينبغي أن تصوم عنه هذه الجارحة:
1- النظرة الخائنة: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (غافر: ١٩).
2- النظر إلى العورات: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (النور: ٣٠).
3- النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة: «النظرة سهم من سهام إبليس».
4- مطالعة ما ليس بإسلامي، ومشاهدة ما يدعو إلى الإباحية والتحلل: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ( الإسراء: ٣٦).
ورابعها: الأذن، ومما ينبغي أن تصوم عنه هذه الجارحة؛
1- الكذب، فقد ذم الله قومًا، فقال: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ (المائدة: ٤١).
2- الغيبة: «ولا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج على أصحابي، وأنا سليم الصدر».
3- التجسس: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات: ١٢).
٤- اللغو: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ (القصص: ٥٥).
5- الباطل والزور من القول، ولهو الحديث.
وخامسها: اليد، ومما ينبغي أن تصوم عنه هذه الجارحة:
1- البطش والإيذاء: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (الأحزاب: ٥٨).
2- الغلول: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ﴾ (آل عمران: ١٦١).
3- السرقة: «لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع بده، ويسرق الحبل فتقطع يده».
4- كتابة ما ليس بحق:
وما من كاتب إلا سيفنى *** ويبقي الدهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بكفك غير شيء *** يسرك في القيامة أن تراه.
5- منع حق قد وجب لله – تعالى - أو لخلق الله - عز وجل -: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (الماعون: ٤ : ٧).
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده».
وسادسها، وأخيرًا: الرجل، وينبغي أن تصوم هذه الجارحة عن:
1- السير إلى أماكن اللهو والخنا.
2- السعي في الأرض فسادًا إلى آخر هذه الآثام
ينبغي للمسلم أن يكبح جماح هذه الجوارح، ويحسن استغلالها في طاعة الله – تعالى -، والحذر من أن تكون شهودًا على صاحبها، قال تعالى:
﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النور: ٢٤).
﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (فصلت: ٢٠).
إن الصوم بهذا المعنى في شهر رمضان أكد ما يكون ثم يعيش المسلم بهذا الإمساك سائر أشهر العام، فيكون رمضان إلى رمضان التالي مكفرًا لما بينهما مع اجتناب الكبائر، كما جاء في الحديث الشريف.
كم يرجو المسلم ربه أن يعيش المسلمون بهذا الإمساك، كل أيام حياتهم فتكون كلها رمضان: «اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».
عندما تصبح أنت وأخوك جبلين من حديد!
روى الذهبي في السير في ترجمة الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله- رضي الله تعالى عنه -:
عن علقمة بن وقاص الليثي قال: رأيت طلحة بن عبيد الله، وأحب المجالس إليه أخلاها، وهو ضارب بلحيته على زوره، فقلت: يا أبا محمد، إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاها، إن كنت تكره هذا الأمر فدعه- يعني المشاركة في القتال في حادثة الفتنة بين الصحابة- فقال طلحة: «يا علقمة، لا تلمني، كنا أمس يدًا واحدة على من سوانا، فأصبحنا اليوم جبلين من حديد، يزحف أحدنا إلى صاحبه».
في هذا الخبر المؤثر، يوضح الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله، سبب عزلته، وسبب اختلائه بنفسه، وعدم رضاه الخوض في المشكلات بين إخوانه من الصحابة».
إنه يعلل سبب هذه العزلة، بأنهم كانوا من قبل يدًا واحدة: يتنازل كل منهم عن رأيه للآخر، والنفوس راضية، والأمور تمضي من خير إلى خير، يواسي بعضنا جراحات بعض، كلنا هم واحد، وهدف واحد، تضحي بكل شيء، حتى يسلم لنا هدفنا، وتتحق لنا غايتنا.
لكننا اليوم «أصبحنا جبلين من حديد»، كأصلب ما نكون في تعاملنا، لا يتنازل أحدنا عن رأيه، بل ويخطئ الآخر لسبب أو لغير سبب، بحق أو بغير حق.
لم يعد أحدنا كالأمس: يقبل عذر الآخر، ويغفر له زلته، حتى وإن أخطأ في حقه.
وهكذا حصل ما حصل بين الصحابة- رضي الله عنهم- بعد اجتهاد منهم، وسعي لطلب الحق، فهل نعي الدرس، فيتدارك العاملون للدعوة أمرهم، قبل عدم استطاعتهم ذلك؟!
علي بن حمزة العمري
تعال نؤمن ساعة
الثبات.. يحمل لواء النصر دائما
الثبات هو مجابهة الشدائد بقلب لا يفزع، وقدم لا يتزعزع، وقناة لا تلين، والثبات من الإقدام كالأساس من البناء، فمن لم يكن رابط الجأش لن يكون مقدامًا، ومن الناس من يدعون الشجاعة «وأفئدتهم هواء»!، وربما تورط أحدهم واندفع، ولكنه سريع الإحجام، سريع النكوص عند أول صدمة، حتى لتراه ضجرًا بالحياة، وبرما بالساعة التي أقدم فيها على ما عمل- كله فيما عمل- !!!، أولئك الذين ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ (المنافقون: ٤).
فالشجاعة درجات، ذروتها الثبات ساعة العسرة، والعين ترى تساقط المجاهدين: هنا تتجلى روعة الشجاعة، ويسطع المجد.
والتاريخ يحدثنا أن الثبات قد حمل لواء النصر في وقائعه الفاصلة، فيوم «حنين رد الثبات والعزيمة ما أضاع النكوص والهزيمة»..
﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ (التوبة: ٢٥).
ولكن النبي ﷺ ثبت للعدو حتى كسرت رباعيته الشريفة، فكان النصر حليفه.
﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: ٤٠).
ويوم (الردة) إذ ثبت أبو بكر- رضي الله عنه- في وجوه المرتدين عن الدين يوم انقلبت القبائل على أعقابها بعد وفاة الرسول، وقال قائلها:
أطعنا رسول الله من كان بيننا
فيالعباد الله ما لأبي بكر؟؟
أيورثنا «بكرًا» إذا مات بعده
وتلك لعمر الله قاصمة الظهر؟
فأقسم أبو بكر قسمه التاريخي «والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى النبي ﷺ لقاتلتهم على منعها»!، فكان النصر حليف الثبات على الجهاد، وتم لأبي بكر ما أراد.
ويقص علينا القرآن الكريم قصة طريفة عن بني إسرائيل، أولئك الذين كانت تمشي دماؤهم في شرايينهم بطينة متخاذلة لطول ما استعيدوا.
قال عز من قائل: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ (البقرة: ٢٤٦).
﴿قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة: ٢٥٠- ٢٥١).
فالثبات- إذن مخبار الشجاعة، وهو واحد في جوهره، وإن تعدد في مظهره: فالثبات على المبدأ القويم- أيًّا كان العنت وكان الإرهاق- كالثبات في ساعة المصيبة والخطب الجلل، والثبات في الدفاع عن الجماعة المظلومة- أيًّا كان العسف أو الخسف- هو بعينه الثبات في الدفاع عن الوطن المجتاح، والثبات على الرأي الحكيم- وإن كثر المعارضون والمثبطون- لا يقل نبالة عما تقدم من مظاهر الثبات وضروبه.
ولما كانت حياتنا الدنيا اختبارًا لنا ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ (محمد: ٣١)، فالواجب أن نروض أنفسنا على احتمال الشدائد، فلن يكون الاختبار يومًا هينًا، ولا سهلا لينا، والعاقبة للصابرين: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ ( البقرة: ٢١٤).
نجوى عوض أحمد
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل