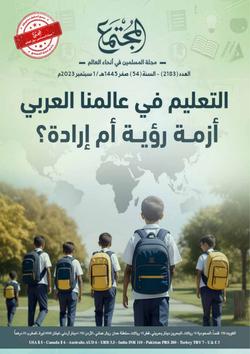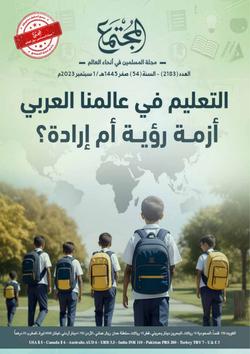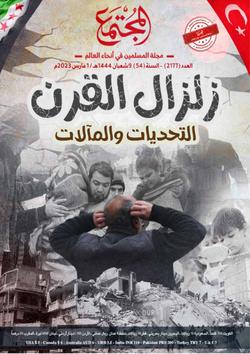العنوان حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون "أسئلة في الصميم" - الحلقة الخامسة
الكاتب عبدالحليم خفاجي
تاريخ النشر الثلاثاء 26-ديسمبر-1972
مشاهدات 17
نشر في العدد 131
نشر في الصفحة 18
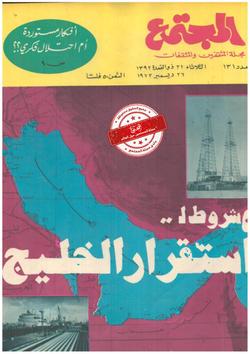
الثلاثاء 26-ديسمبر-1972
«يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار»؟
حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون
الحلقة الخامسة
أسئلة في الصميم
بقلم الأستاذ عبد الحليم خفاجي المحامي
دور العقل في قضية الإيمان
جدوى الجهد المشترك في الدراسة
· من العرض السابق للماركسية يبدو واضحا أنها تشتمل على ثلاث قضايا رئيسية «المادية الجدلية، «المادية التاريخية» فائض القيمة» مترابطة عضويا ومشدودة بعضها إلى بعض بخلايا بينية من مختلف الفروع والقضايا العلمية التي يحظى كل فرع منها بدراسة مستقلة على أيدي مختصين وبتشابك هذه الخلايا مع محاورها الأساسية على أيدي المنظرين أو فلاسفة الماركسية يتكون نسيج الماركسية. ذلك النسيج الذي وضع أسسه ماركس وطورته إضافات لينين وستالين وخروشوف ومن بعدهم ومن ثم فالدراسة الوافية تقتضي إلمامًا ومتابعة دائمة لما يسمى بالماركسية اللينينية الستالينية الخروشفية الماوية.. إلخ .
ومع هذا فإن تركيزنا على الإطار النظري الذي تركه ماركس سببه أن هذا الإطار السابق على كل هذه الإضافات ما زال هو الفعال في مجال الإقناع بالماركسية. وتعمل الممارسات العملية والأسماء التاريخية والواقع الدولي في المجال النفسي لا أكثر.
وكلما مر الزمن كلما ازداد الانفصام بين هذا الإطار النظري الذي تركه ماركس وبين الواقع العملي في البلاد الشيوعية حتى أن الماركسية اليوم وإن كانت بموازين العلم لا وجود لها وأصبحت شيئًا تاريخيًا بعد أن تحولت إلى مجرد شعارات عقائدية لا حقائق علمية إلا أن فاعليتها السياسية تجعل تلك البلاد تحرص عليها لأنها تتبدى بها كحاملات لرسالة إنسانية في سبيل تحرير الشعوب من الاستغلال والتخلف على أسس علمية محايدة، وبدون هذا القناع العقائدي ظهر الوجه الاستعماري سافرا.
ولم نكن نخفي دهشتنا في البداية من وجود أفراد قلائل يحملون درجات علمية عالية بين الشيوعيين، ولكن الاحتكاك عن قرب زال هذا الاندهاش حيث تحققنا أن المختص بفرع معين من فروع العلم تكون صلته في العادة ببقية الفروع الأخرى صلة ثقافية لا تخصصية مما قد يوقعه في رذيلة التسليم بكثير من القضايا الخارجية عن دائرة تخصصه وهي دائمًا كثيرة على مدار الماركسية. لأن المختص وإن أكتشف تخلف الماركسية في مادة تخصصه وعدم صحتها عمليا فإنه مع هذا يظل على اعتقاده بأنها صحيحة في القضايا الأخرى التي تشكل في مجموعها بناء متماسكا قادرًا على تقديم الحلول العلمية.
فلو اكتشف دارس الاقتصاد عدم صحة ما قاله ماركس في القيمة يظل أيضًا على اعتقاده بصحة النظرية في مجال الفلسفة والتاريخ والاجتماع ولا يستطيع أن ينفصل شعوريًا عن القضية العامة بسهولة ليعيش في فراغ مرة واحدة. ولو اكتشف دارس الفلسفة تخلف الماركسية في قضايا المادية الجدلية فإنه يظل على اعتقاده بصحتها في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وهذا يفسر سر ظهور بعض التشوهات العقائدية التي حاول بعض الزعماء فرضها على شعوبهم في محاولة جاهلة أو مشبوهة للجمع بين منهج الماركسية والعقيدة الإسلامية، وسوكارنو الذي كان يقول: إنني أؤمن محمد في السماء وبماركس على الأرض نموذج لهذا النوع.
وقد اكتشفنا على الطبيعة هذه الحقيقة.. حقيقة أن المتخصص في فرع قد يقع فريسة الفروع الأخرى وأنه إن كان أستاذا في جانب فهو تلميذ في الآخر ، وإن كان علميًا في جانب فهو يُسلم تسليم العوام في الآخر وإن كان منفتح الذهن في جانب فإنه متعصبة مغلقه في الآخر .
ولم يعد من ثم مدهشاً لنا أن نرى المتخصص يصول ويجول في مادة تخصصه ثم يعود إلى الحبو والتعثر في بقية مواضيع الماركسية يردد ما يقوله الجميع بنفس العبارات وبنفس الأمثلة المضروبة ونفس الاستنتاجات السياسية.. وما كنا لنلمس هذه الحقيقة أبدأ من خلال قراءة الكتب فقط، بل وما كنا نتوقعها...
وكأني بسؤال ذكي يتبادر إلى ذهن قارئ عندما يقول وماذا يكون الأمر لو اجتمع كل المتخصصين في كل الفروع معًا ليطابقوا بين مجموع علمهم وبين الماركسية أليس في هذا الحشد من علماء يكمن القول الفصل لها أو عليها؟
وأنا أقول للقارئ أن هذا قد حدث فعلاً حيث اجتمع ٣٩ عالما سوفيتيا في جميع التخصصات وأخرجوا في عام 1963 كتاب «أسس الماركسية اللينينية » وستأتي الإشارة إليه مفصلة فيما بعد وفيه أصاخوا لحقائق العلم في جانب وخضعوا لمتطلبات السياسة في جانب آخر والمدرك لحقيقة الترابط بين القضايا يجد أن أحدهما لابد وأن يلقى الآخر فأما أن يقوى العلم على دواعي السياسة وأما أن تخنق السياسة صوت العلم.. وفي جميع عصور الظلام كانت السياسة في المعلم وحقائقه.. هذا الجانب الذي أصاخ له هؤلاء العلماء هو إعلانهم بعدم وجود الجدل في الطبيعة، وأن بقي ذلك في المجتمعات أي عدم صحة قانون التناقض وصراع الأضداد في الطبيعة وصحة هذا القانون في المجتمعات البشرية وهو ما لا يستقيم في ظل الماركسية ويتناقض مع منهجها ولنا مع كل ذلك عود في موضعه من الدراسة وإنما كان الدافع هو التفكير بأن الماركسية تظل في المركز الأقوى بالنسبة لمتخصص الفرد وتظل في مزاولة إغرائها له وهنا تكمن إحدى صعوبات المواجهة التي تستلزم مواجهة مشتركة متخصصة وأتاحت لنا مواجهتنا المشتركة هذه القدرة. الأمر الذي لا يفطن إليه كل من ينشغل بالرد على جانب واحد منها في حدود تخصصه.
ولذلك كان المتخصصون فقط عاجزين عن مواجهتها منفردين أو مجتمعين بعيدًا عن العقيدة الشاملة. لأن الماركسية أشبه بالدين والدين لا ينتصر عليه إلا دين أشمل وأنفع. ولذلك كانت كل مواجهات الماركسية ضعيفة لأنها لم تقدم البديل حتى خرج عليها الإسلام بشموله لقضايا العقيدة والتشريع وبدعوته الدائمة إلى العلم.
· وفيما يلي بيان لخط تناولنا لمواضيع الماركسية: ابتداء من المادية الجدلية ومرورًا بالنظرية الاقتصادية ثم تفسير التاريخ. وأذكر القارئ بخط السير حتى يسهل أمر المتابعة وحتى إذا ما تشعب الكلام في إحدى النقاط لا يضل الطريق. سنبدأ بالكلام عن أسباب انتشار ظاهرة التفكير المادي بأوروبا دون غيرها من بقاع الأرض ثم حوار حول نشأة الحياة. يليه:
· هل الوجود مادة فقط؟
· وقفة مع قوانين الجدل.
· نظرية المعرفة «الأسلوب العلمي في الاستدلال على وجود الخالق».
· القضية المنطقية.
· منهجان علمیان: منهج للأشياء، منهج للإنسان
وعلى ضوء الحقائق العلمية الجديدة يكون لنا دراسة في داخل الإنسان قانونه، مفهوم الحرية، أداة الاختيار «الملكية»، أنواع الثروة، نظرية الربح ونكون قد أحطنا في الطريق بقضيتين من قضايا الماركسية "المادية الجدلية والاقتصاد" ثم نتناول تفسير التاريخ من جديد.
ثم نصل إلى الإسلام كمنهج كامل، نختص منه الكلام عن الملكية في إطار النصوص ثم من التطبيق العملي على مدار التاريخ الإسلامي حيث تقابلنا قصة الأرض العشرية والأرض الخراجية باعتبارها نموذجين لملكية خاصة إسلامية أو ملكية عامة إسلامية
وبهذا نكون قد حققنا غرضين في وقت واحد: تفنيد الماركسية وتوضيح الإسلام كمنهج حياة وبصفة خاصة في الجانب الاقتصادي، ونكون قد أزلنا كل ما هو غير علمي وأحللنا محله الحقائق العلمية كمرتكز لنظرية جديدة ثالثة في علاج القضايا الإنسانية جديدة في فهمنا لها لا أكثر مع التحفظ في استخدام اصطلاح النظرية أيضًا. وأفضل عليه «الدعوة».
· وفي مطلع تناولنا للمادية الجدلية نبدأ بالكلام عن أسباب انتشار ظاهرة التفكير المادي بأوروبا وهو موضوع نبت اهتمامنا به بعد انفضاض الندوة حيث كان اهتمامنا أثناء الندوة منصبا على الموضوعات بطريقة مباشرة ووردت الإشارة إلى ظروف أوروبا التاريخية بطريقة عابرة وقد أتيح لنا فيما بعد أفراد فصل مستقل يعتبر جديدًا في بابه لتفسير هذه الظاهرة
· انتشار ظاهرة التفكير المادي بأوروبا.. وأسبابها؟؟
أبادر بتقرير هذه الحقيقة وهي مسئولية المثالية من انتشار الفلسفة المادية ذلك أن الفلسفة المثالية أو التفكير المادي عموما نشأ كرد فعل الانحرافات الفلسفة المثالية وكتعبير عن أزمتها في نفس الوقت.
وسأزيد الأمر وضوحًا ببيان الظروف التاريخية والأجواء الفكرية التي شاعت فيها هذه الفلسفة المادية مما حدا بماركس إلى اختيارها أساسًا عقيديًا لنظريته الاقتصادية.
ولقد عاصر ماركس فترة المخاض الحضاري التي مرت بها أوروبا، حيث تنسلخ صيحة الحياة من صرخة الألم، وينسلخ ضوء النهار من ظلمة الليل البهيم. وهي فترة حرجة بطبيعتها تسمح بالرؤية الفكرية والرؤية النفسية في أكثر من اتجاه، بل وأكثر من ذلك حرجا أنها قد تدفع الرؤية النفسية في اتجاه مضاد للرؤية الفكرية، وينقلب الحرج إلى مأساة عندما تكون الغلبة للرؤية النفسية الكليلة فلا ترى الحق والخير من خلال موازينهما وإنما تراه من خلال هواها وعلى ضوء مصالحها وتحت ضغط مشاعرها ...وآلامها الدفينة التي خلفتها عصور الظلم والحرمان قبل أن ترى لها حقاً في الحياة الكريمة.
وإلى أن يمتلك الفكر المستنير زمامها ويحد اندفاعها ويحكم قيادها ويضيء الطريق بموازين الحق والخير المبرأين من شوائب الظروف الشخصية والملابسات التاريخية يظل انتشار الضباب حائلًا دون وضوح الرؤية النفسية والفكرية على السواء فتكثر من حولهما الضحايا.. الضحايا التي قد تتعدى الأفراد والجماعات فتصيب شعوبا بأسرها، فتعيش في قيود جديدة وآلام جديدة من حيث إنها تخلصت من قيودها وآلامها.
وهذا بالضبط هو ما عاشت فيه أوروبا وهو الذي ما زالت أيضاً تعانيه على مستوى القرن العشرين حيث كانت أسيرة لون معين من العقائد الموضوعة والفلسفات المخترعة ساهمت بوعي منها أو بغير وعي على بقائها أسيرة لون معين من الحياة والعلاقات لم يكن حصيلتها إلا مذلة الجسم ومذلة الفكر ومذلة الروح.
وقد كان هذا الأساس الفكري والعقيدي يمثل السلطة المعنوية التي استخدمتها القوى التي كانت ترى مصلحتها في استمرار، هذا اللون التقليدي من الحياة سواء في ذلك قوة الكنيسة أو قوة الإقطاع حفاظًا على دوام النفوذ والسيطرة وطالما تظاهرت قوة الكنيسة مع قوة الإقطاع للحيلولة دون صيحة الحياة ودون ومضات الضوء التي كانت ترسلها منارات الشرق الإسلامي على جميع مداخل أوروبا
المثالية والمادية
فمنذ عهود الإغريق والرومان حتى وقتنا الحاضر وأوروبا مسرح لنوعين من المذاهب الفلسفية. المثالية والمادية فقديمًا تقابلنا مثالية أفلاطون ومادية ديمقريطس وأبيتور وحديثًا تقابلنا في القرن ۱۹ مثالية هيجل ومادية فيورياخ.
ونذكر في هذا المقام الفلاسفة الماديين على مدار هذا المحور الزمني الفيلسوف انتستينس «٤٤٤ - ٣٦٨ ق.م» الذي كان يدعو إلى الرجوع إلى بساطة الطبيعة ورفض
الدين المتوارث ويرى في الوجود رأياً ماديا.
ومنهم أيضًا روسيلينس في القرن 11 «1050– 1120 م» الذي جدد المذهب المادي على عهد المدرسين ومنهم وليم فون في القرن 14 «١٢٧٠- ١٣٤٧م» الذي أرجع المعرفة كلها إلى التجربة الحسية. إلخ وهكذا إلى أن نصل إلى فيورباخ في القرن 19
ومن البديهي ألا نتوقع أن يكون ما نتناوله هذه المذاهب المثالية والمادية على السواء السواء في القرن ۱۹ أو القرن ۲۰ على نفس مستوى تناولها في القرون الأولى وإلا أسقطنا من اعتبارنا كل ما استفادته البشرية من تقدم علمي على مدار هذه الحقبة الطويلة أثر على طبيعة تناول المشكلة، ولكنه لم يغير جوهرها.. وقد تناوب الاتجاهان الظبة في ميدان الفكر والحياة أيضًا انتهى بهما المطاف في القرن العشرين إلى اقتسام أوروبا في ميدان الفكر والأرض معًا.
فقسم يدين بالمادية ويرفع رايتها علنا فوق رقعة الاتحاد السوفيتي وتوابعه وقسم آخر يدين بالمثالية ويرفع رايتها على استحياء فوق بقية دول الغرب وتفصح عن تصرفاته وسلوكه المشوب بكثير من اللوثات المادية.
أما تساؤلنا مَن سبب هذا الانقسام والخصام الشديد فتقع مسئوليته الكبرى على الاتجاه المثالي، ولتوضيح الأمر نذكر بأن الاتجاهات الفلسفية المثالية منذ القدم كانت تتناول منوعات شتى مثل البحث في الطبيعة بفروعها من فلك وحيوان ونبات، وفي المنطق وفي الأخلاق والسياسة والرياضيات وفي الإلهيات وجاءت محنة الفلسفة من خلال موضوع الإلهيات عندما تجاوزت في البحث منطقة الأمان فيها.
ذلك أن الفلاسفة المثاليين استطاعوا بإعمال فكرهم أن يصلوا إلى نتيجة صحيحة ونقطة بدء سليمة علميا وهي وجود خالق لهذا الكون البديع يتصف بالكمال المطلق، ولكنهم انحرفوا بعد ذلك في جميع متعلقات هذه القضية.. فكيف كان ذلك؟! وما نتائجه؟!
· إن قضية وجود الله تعالى هي في الواقع قضية علمية إنسانية أي يستطيع العلماء في كل عصر التدليل على صحتها بمختلف الاستدلالات العلمية ومن ثم يقول الفقهاء أن الإيمان بوجود الله مقدم على الإيمان بالرسل ولم تكن الرسل تبعث إلى أقوام يجهلون هذه الحقيقة، ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾( الزخرف: 9)
ولكنهم كذبوا الرسل. وفي عصرنا الحاضر نجد العديد والجديد من الأدلة العلمية في إثبات هذه الحقيقة حتى أصبح كل فرع من فروع العلم يشكل نافذة جديدة عليها ولقد صدر الكثير من الكتب في هذا المجال «الله لجون كلوفر، والله يتجلى في عصر العلم». إلخ
ولم تعد المشكلة في محاولة إثبات ذلك. بل تنبت المشكلة الحقيقية فيما تثيره هذه القضية من عديد الأسئلة في نفس الإنسان بعد اطمئنانه فكريا إليها هذه الأسئلة تعتبر ثمرة طبيعية للمعرفة لا يستطيع أحد من الناس أن يتجاهلها ولا يملك الفكاك منها، بل أنها تظل تفرض نفسها في إلحاح شديد لا يتوقف حيث يثور التساؤل عن ذات الله تعالى وصفاتها ومدى وكيفية التعامل معها، وعن معنى الحياة والموت وعن كله الوجود بأسره وعن النفس وخباياها وعن ظلال ذلك كله على سلوكنا وغايته.. إلى آخر هذه الإلحاحات التي تولد القلق الدائم والتوتر المستمر في النفس ما لم تهتد إلى أمرها.. ولا يملك أحد أن يعزل سلوكه اليومي من نتيجة الأجوبة عليها ويظل في خاطره أجوبته الخاصة الخاطئة بالطبع والتي لا يفصح عنها لأحد أن لم يجد الإجابة الشافية عليها من خارج وهذا ما يشكل في النهاية مفهوم العقيدة عنده.. فكيف يكون صمام الأمان في تكوينها؟
· وهنا يبرز سؤال هام، هل في مقدور الفلسفة أن تتكلم كثيرًا عن الطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات قبل أن تنفصل عنها وتصبح علوما محدودة غايته أنها ما زالت تجهل أما أن تجيب في على كل التساؤلات الخاصة بالألوهية ومتعلقاتها فهذا ما تردت فيها بالتخمينات والشطحات ذلك أن هذه القضايا لا تخضع بطبيعتها لموازين الإنسان، وليس معنى ذلك أنها معدومة لأنها مبنية على أصح صحيح علميًا هو وجود الله تعالى حسبما سنبين أدلة ذلك في فصل تال.
· ولا شك أن هذه التساؤلات ستظل حائرة في الصدور ويظل الإنسان حائرًا معها في السلوك ويظل المجتمع بأسره حائرًا في التشريعات والقيم إلى أن تجد الإجابة الشافية طريقها إلى النفوس فتذهب الحيرة ويستضئ، السلوك بنور المعرفة الصافية.. فكيف السبيل إذن إلى هذه المعرفة..
والفطر السليمة لا تكف عن البحث عن وسيلة للصلة بذات الله تعالى الذي تحققت من وجوده فكريا ولم ترنو بعد وجدانيا أنها تريد أن تسمع منه هو سبحانه الإجابة على كل ذلك..
وهذه الفطر السليمة تستهجن عدم قيام هذه الصلة بالله الذي خلقها ثم دلها عليه، بل أنها لتتعلق به أن يفعل هو ذلك، والمنطقي أن تتم هذه الصلة بين موجودين وجودًا علميًا كل منهما يعرف الآخر وإذا لم تتم هذه الصلة فإنها تكون إذن قطيعة غير مفهومة ولا مقبولة أننا نستهجن هذه القطيعة ممن تعرفه من البشر فكيف نصبر عليها ممن عرفنا ربوبيته لنا، فالصلة قضية منطقية مبنية على أصل علمي.
ويلبى الله تعالى أشواق هذه الفطرة ويشير إلى منطقية هذه الصلة في قوله تعالى،﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾( الأنعام: 91)، وفي قوله تعالى،﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾(الإسراء: 95). ويستهجن موقف المكذبين بذلك في قوله تعالى ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ﴾( يونس: 2).
· فعن طريق-الوحي-صلة الله تعالى بخلقه تتم معرفة جميع حلقات المعرفة المغيبة عن حواسنا وتتم القدرة على التعامل معها وبالتالي تتم الحركة الصحيحة للإنسان.
فالتدليل على وجود الله تعالى قضية إنسانية وبتكملتها بالوحي تصير قضية إسلامية.
ومن عجيب أمر هذا الوحي أنه يخبر عن كل ما ليس في طاقة البشر معرفته بوسائلهم العلمية التي اقتضت حكمة الله أن يجعلها موصلة إلى حقيقة الحقائق وهي الذات الإلهية ولا يجعلها موصلة إلى ما عداها من أمر الملائكة والبعث والحساب.
الرسل بدورهم إلى تأكيد صدقهم كما كانوا دائما قمة قومهم في العلم والخلق وفعل الخيرات وبعد البحث كانت المعجزات أسلوبا مطلوبا لنقل مركز الثقة إليهم ريثما يتم تحريك العقول تحريكًا ذاتيًا.
· نخلص من ذلك أن سبيل الأمان: في موضوع الإلهيات بالذات، هو أن للعقل دوره في الاستدلال على الله تعالى فقط وألا يتجاوز هذه المنطقة وإلا دخل في دائرة الظنون والتخمينات.. كما أن للوحى دوره في تكملة المعرفة بصفات الله تعالى وما يجب وما يستحيل في حقه تعالى وما يلزم معرفته من جميع حقائق العقيدة والتزاماتها التشريعية.
· ولكن هل وعت الفلسفة المثالية هذا الدرس بالطبع لا. إذ حاولت أن تكمل العلم بالله تعالى وصفات وصلته بخلقه عن طريق التخمين والتخيل فجاءت بركام من التصورات الشاذة القريبة مما أوقع الفكر الإنساني والسلوك البشري في متاهات كثيرة.
وقد ذهب الفلاسفة في ذلك مذاهب شتى فمنهم من تصور الله تعالى حالًا في جميع المخلوقات يتبدى فيها ومنهم تصوره ملك على عرش عظيم أبدع خياله في وصف الأسود الرابضة من حوله ومنهم من تصوره أنه عقل محض أو روح محض منعزل كلية عن خلقه بعد أن بث في كل شيء ناموسة ومنهم من تصور سبحانه- يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ومنهم من تصوره فكرة مطلقة ما زالت تحاول التعبير عن نفسها من خلال التدرج في الكائنات إلى أن وصل إلى الدولة ومؤسساتها إلى آخر هذا الخلط الذي لا يحده حصر.. ومثل ذلك عن الروح والبعث، والجزاء، والخير، والشر..
· فماذا كانت النتيجة؟
كانت النتيجة أن تعقدت حياة الناس وتقاذفتها شتى الاتجاهات واضطرت السلوك واضطرت معه العلاقات والقيم فمن إفراط في السلبية في ظل مثالية أفلاطون التي دعتهم إلى هجر عالم الحس إلى عالم الخيال والمثال إلى إفراط في الإيجابية تعطى الإنسان سلطان الله في الأرض في فلسفة نيتشه.
فكان من الطبيعي أن يكون لذلك كله رد فعل قوي في صورة التفكير المادي الذي لا يؤمن إلا بالطبيعة الملموسة المحسوسة وينكر ما عداها ويرى في إشباع الملذات قيمة عليا. ولم يفطن هذا الفكر المادي إلى الفصل بين أصل القضية الصحيح وهو وجود الله، وبين ما أحاط بها من انحراف المثالية فوقع في خطأ رفض القضية ككل بجميع تعاليمها.
وهكذا تناوب الاتجاهان التفكير الأوروبي والحياة الأوروبية عمومًا أحدهما الجاني والثاني هو ثمرة الجريمة والاتهام طبعاً موجه إلى مختلف أنواع التفكير المثالي.. لكن أين كانت الكنيسة من ذلك كله ؟!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل