العنوان خصائص الحضارة الإسلامية.. مع النماذج
الكاتب أ.د. عبد الرحمن علي الحجي
تاريخ النشر الثلاثاء 27-فبراير-1979
مشاهدات 55
نشر في العدد 434
نشر في الصفحة 23
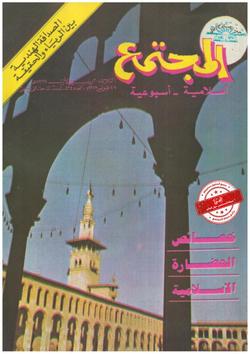
الثلاثاء 27-فبراير-1979
الحضارة الإسلامية روح ونور في الفرد والجماعة والدولة
وحين نحدث عن خصائص الحضارة الإسلامية، فإنما نتحدث عنها بيانًا، ونشهدها عيانًا، وهي تتحرك في الإنسان – فردًا وجماعة، مجتمعًا ودولة – سلوكا في كافة جوانب الحياة وتخصصاتها.
فهي – هنا – دراسة سلوكية ونفسية، وفي بنية مجتمع تلك الحضارة من خلال وصف ذلك البناء، وبيان طبيعته وفقه حقيقته، والتمثيل بوقائعه. وهذا شرح لبعض خصائصها، ولعله يتاح فيما بعد لكافتها، وربما نزيد، وننقص في عددها.
الخصيصة الأولى:
الألفة والمحبة:
وهي شاملة لكل ما يحيط بالإنسان من مخلوقات الله، وتقوم الإنسانية التي عليها تبني هذه العلاقة الإنسانية التي عليها تبن هذه العلاقة بين الإنسان وبين ما حوله. ومن غير شك فإن هذه الخصيصة – مثل غيرها من الخصائص – مستمدة من الإسلام وطبيعته، ونقرأ فيها صورته، لأن بناء النفس المسلمة يقوم على الإسلام وشريعته، وحين لا يتم هذا في داخل النفس الإنسانية لا يتم في خارجها، لأن النفس هي نقطة البدء في بنية الإنسان والمجتمع المسلم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾ (سورة الرعد: 11).
وتشير هذه الخصيصة إلى ألفة الفرد مع نفسه وواجباته ومحبته لذلك كله، ولا تعني الألفة التعود على الشيء، إنما هي التآلف والرضا والارتياح به وحسن العلاقة معه... وحين يتقدم هذا الأمر يزداد ويصبح محبة متماسكة، وحرصا عليه وسعيًا إليه ومن أجله، وهي تشمل ألفة الفرد ومحبته لمجتمعه وأهدافه، محبة في الله وطاعة له وابتغاء لمرضاته.
وأمام هذا تظهر حقيقة النظريات الأخرى التي عالجت قضايا الإنسان، فلم تصل إلى ما يحب ويطلب، كما لم تحل مشكلاته، بل زادته انحرافًا؛ إذ زينت له ولوج متاهات الضلال، والأمثلة على ذلك خلال التاريخ الإنساني كثيرة، منها نظرية فرويد وما أورثته من تهوين شأن الخطيئة، واعتبارها أمرًا طبيعيًا لا يصح الخجل منه، كما وضعت الإنسان في مكان أدنى من مستواه، بعيدًا عن مدارج الارتقاء؛ يعيش في هبوط منخفض، بدت آثاره في عدد من المجتمعات التي تبنت هذا الاتجاه واعتمدته، وكان ذلك متفاوتًا بأسباب من الأخذ بها.
وقل مثل ذلك في نظريات دارون وماركس وتلامذتهم وأتباعهم، وما تعرفه عن خطايا وآثام وارتكابات الحضارة الحديثة – شرقًا وغربًا – خارج بلدانها الذي ذاق منها الناس الويلات، وما زلنا نسمع الكثير عما يدور في أحيائها، على الرغم ممَّا نشهده من تقدمها العلمي، الذي لم يعصمها من الاستمرار في الانحدار السريع كذلك، إن لـم يكن مشاركًا فيه بسبب غياب هدى الله، فما كان لها من عاصم، إذ لا عاصم من أمر الله، وكم من أصوات من داخل أتباعها تعالت، تحذر وتذكر وتنادي من غرائب الجرائم والتصرفات والاتجاهات التي تحدث هناك، على الرغم من تيسير كل أسباب الراحة، وارتفاع مستوى الفرد المادي، وشمول الخدمات إلى حدٍّ يكون مدهشًا وغريبًا ومرعبًا كذلك، بحيث إنه يتكرر ذكر جعل شذوذ الأخلاق قانونًا مباحًا، وتجري من الأحداث ما تشير إلى هبوط أو انعدام المستوى الإنساني مهما اعتبرناه محدودًا، وليس ببعيد ما جرى قبل سنوات قليلة حين تعطلت الكهرباء في مدينة نيويورك ليلة واحدة، فكان الذي جرى أهون منه بكثير مما يجري في غابات من الوحوش الكاسرة، ومثل هذا وأكثر منه ننتظره من حضارة تنقطع عن الله وشريعته وهداه، فهي إذن جاهلية ما دامت كذلك على الرغم من تقدمها العلمي والمظاهر المختلفة، لكن في فحواها وحقائقها وطبيعتها لا تختلف عمَّا عرفناه من الجاهلية، إن لم تكن هذه جاهلية متفننة بقدر تفننها بالوسائل المادية، وتقدمها العلمي الدنيوي.
وهذا الإفلاس الكالح، والخواء الفاضح، أو الجحيم المحرق، والطوفان المغرق لا يغني عنه الأدب المجنون المحموم، متباعدًا عن الواقع، بوسائل أشد إفلاسًا، كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولعله يقود إن شاء الله – تعالى – إلى التعرف للأخذ بالإسلام، وبناء الحياة الكريمة، وقيام الحضارة الفضلى الوحيدة حضارة الإسلام الطاهرة، تلك التي جربتها الإنسانية؛ فاطمئن قلبها، واستقرت نفسها، وارتوى ظمؤها، واستراح ضميرها، حين ركنت إلى الله – تعالى – وأوت إلى ظله، وسعدت بشرعه، فتنبت الحياة من جديد وتورف حضارته صالح النيات وطيب الثمرات، فيعود إلى الله من شروده، وينتعش من خموده، متشرق أرض الله بنوره الأبلج الوهاج الدافئ الفياض.
ومن السهل رؤية صورة الألفية والمحبة في المجتمع المسلم، جاوزت حدود المجتمع الإسلامي إلى غيره من مجتمعات مخلوقات الله – سبحانه وتعالى.
إن صلة المسلم بكل ما من حوله تقوم على التآلف والحب، وكل هذا نابع من الحب في الله، حسب أمره وشرعه، مستمد منه وسائر في ضوئه وتوجيهه، وهو حب لا يتأثر إلا بمقاييس الإسلام الأصيلة، ولا يتغير بأي طارئ، وليس عرضة للتأثر بعوامل أخرى.
يتعامل المسلم مع الإنسان بالمحبة، وحسن الصلة وحب الخير، وهو الأساس، والمواقف من الناس تحدد من تصرفاتهم وموقفهم من الإسلام. ومن نفس المنطلق نبغض الشر وتحدد موقفنا من أهله، وذلك معنى قوله – صلى الله عليه وسلم –: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» (أخرجه أبو داود).
ومن هنا فالمسلم يحمل الخير والهداية الناس، ويحرص على إيصاله لهم، فهو واجب إسلامي كما بيَّن القرآن الكريم ووضحته سيرة الرسول – صلى الله عليه وسلم – والآيات في ذلك كثيرة ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (سورة النحل: 125)، ويقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم –: «لئن يهدي بك الله رجلًا واحدًا أحب إليك من حمر النعم».
وإن المسلم يحنو على الناس والحياة والمخلوقات، ويحب حتى الحيوان والظواهر الكونية الأخرى، فإن الرسول – صلى الله عليه وسلم – بيَّن ذلك بوضوح، وقوله – صلى الله عليه سلم – الآتي يبين بقوة وإنسانية عالية لا نجدها في غير الإسلام، ولا يمكن لها أن تكون: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» (رواه مسلم).
ومن الأحداث التي توضح ذلك أنه في مسيرة جيش الفتح إلى مكة – في رمضان من السنة الثامنة للهجرة الشريفة – رأى – صلى الله عليه سلم – في الطريق كلبة تنبح وتذب عن أولادها ومن حولها يرضعنها، فأمر – عليه الصلاة والسلام – أحد الصحابة الكرام أن يقف إلى جوارها؛ حماية لها، ولا يدع أحدًا يتعرض لها أو لأولادها، وممَّا يزيد في روعة هذا العمل ورفعته وبهائه ومقامه أنه – صلى الله عليه وسلم – وسع هذا الأمر، وهو يقود جيشًا فاتحًا في حملة يقصد فتح عاصمة الوثنية يوم ذاك، فلم يشغله ذلك عن الاهتمام بهذا الحيوان، وليعلمنا – صلى الله عليه وسلم – أن الإسلام كل لا يتجزأ ولا يهمل بعضه، وإن كان قليل الأهمية، حين يكون المهم مائلًا فلا تجزئة بين الأمور، لأنها سمات خلقية تقوم على العقيدة الربانية.
وهذه القضية ظاهرة واضحة عامة في كل التاريخ الإسلامي وحضارته، مبثوثة في كل مكان وحال وحين. من ذلك ما يتعلق بهذا الأمر مما له صلة بنوع يخصه.. والوقف بألوانه وكليته موضوع يستحق بحثًا معتنيًا مترويًا متقصيًا يتناوله على هذا الأساس، واحدًا من وجوه الحضارة الإسلامية نلمسه جليًا مشرقًا في الحياة الإسلامية للمجتمع المسلم، ثمرة من ثمار العقيدة والعبادة لله رب العالمين والأخذ بشريعته المثلى، وهو بعمومه ذو صلة وثقى بهذه الخصيصة «الألفة والمحبة».
ولقد تنوع الوقف في كافة العالم الإسلامي على امتداد عصوره وسعة رقعته، وكان المسلمون يهرعون لتوفيره متنافسين متطوعين بأعز ما يملكون، سواء في حياة الشخص وهو كثير وغير مألوف، أو حين تدركه المنية أو يتركه في وصيه. وما زلنا نتمتع بخيره حتى اليوم في كثير من بقاع العالم الإسلامي، على الرغم من توقيد كثير من روافده ومحاولات الإتيان عليه. حتى لقد شمل الوقف أنواعًا وأموالًا وجانب طريفة، ذلك أن أوقافًا من المزارع والأراضي والدور تخصص للحيوانات بأنواعها وحتى العجزة منها.
وقد علمنا الإسلام – نحن المسلمين – حب الكون كله وما فيه، لأنه من خلق الله تعالى، فالرسول – صلى الله عليه وسلم – يقول عن جبل أحد: «أحد جبل يحبنا ونحبه»، ومن هنا فليس في حس المسلم ولا تصوره تنافر وسوء علاقة مع أي شيء مما حوله، كما هو في النظر الغربي وغيره الذي احتوى الحضارة الحديثة واحتوته، والتي سرت إلينا بعض أفكارهم ومصطلحاتهم وعباراتهم، حتى ما بدأنا لا نجد فيها غرابة أو غربة، من أمثال: ترويض الطبيعة التغلب على الطبيعة، الصراع مع الطبيعة، الانتصار على الطبيعة فكل ذلك تصورات ذات ارتباط وثني اجترته الحضارة الحديثة من الحضارة اليونانية الوثنية، إحدى روافدها. فهناك عند القوم اصطراع دائم مع الفكر والحياة والإنسان أورثته قالبًا معينًا في التفكير والصور وبناء المجتمع وحضارته، حدد أسلوبه وعلاقاته ونوع تعامله وأموره الأخرى. وهكذا كانت فعلًا كل أحواله وحياته صراعًا وما وصل إليه كان بعد صراع، وجوانب حياته مطبوع بالصراع؛ حتى غدا عندهم طبيعة وأساسًا يعولون عليه ويتعاملون به وإليه يؤولون.
إن الكون ومن وما فيه خلق من مخلوقات الله – تعالى –، وبعض منه سخره الله – تعالى – للإنسان بقدرته وحكمته ورحمته، يحمد الله – تعالى – أن سخر له مما في هذا الكون، ويسجد له شاكرًا أن هيَّأ له أسباب الانتفاع، وذلل له الصعوبات ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (سورة الملك: 15)، فإذا ما حقق شيئًا سجد الله خاشعًا، من غير أن يرد في حسه أنه انتصر عليه بعد معركة ضد عدوه، بل هو فضل من الله ومنة ونعمة ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾ (سورة الزخرف: 13).
وحين دخل الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – مكة فاتحًا، كانت هيئته في منتهى التواضع والخشوع والشكر لله – تعالى – على ما أكرم به من الفتح قارئًا سورة الفتح، ثم وقف بذي طوى والناس من حوله، فأحنى رأسه حتى لتكاد لحيته من شدة تواضعه تمس رجل ناقته القصواء بكتيبته الخضراء، وقال: «العيش عيش الآخرة».
فالمسلم ينظر إلى الكون، وإلى كل ما ومن حوله بالألفة، ويرتبط معه بالمحبة، فالجميع من خلق الله الذي هيأ الأسباب وأنزل الهداية، وكلها تسير في عين الاتجاه مصدرها واحد، تخط طريقها إلى الله؛ طائعة عابدة حامدة ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (سورة آل عمران: 81-83).




