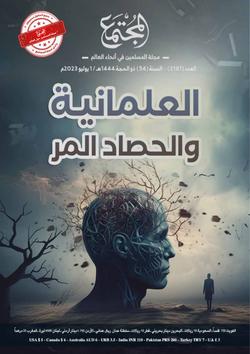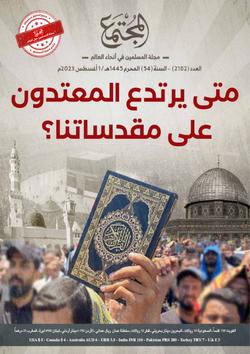العنوان دراسات: موقف المجتمع الأمريكي المعاصر من الإسلام
الكاتب د. إبراهيم أبو ربيع
تاريخ النشر الثلاثاء 19-نوفمبر-1996
مشاهدات 786
نشر في العدد 1226
نشر في الصفحة 44
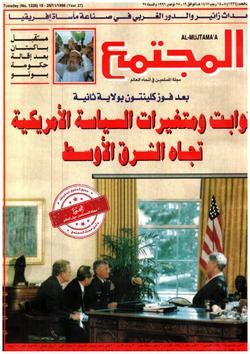
الثلاثاء 19-نوفمبر-1996
هدف المسلمين في أمريكا هو التعايش مع المجتمع الأمريكي على أساس المحافظة على السمات المركزية للإسلام في احتكاكه وتحاوره مع الثقافة القائمة.
الذي أراه من خبرتي الطويلة في الولايات المتحدة أننا اكتشفنا حيوية جديدة للإسلام في حياتنا وهو ما أفاد الدعوة الإسلامية.
المجتمع الأمريكي الأبيض يعاني من ضعف الهوية وانفصام تاريخي وخاصة لتاريخ الحضارة الحديثة.
مما لا شك فيه أن أمريكا المعاصرة هي مجتمع صناعي متقدم، ولذا فمن الصعب فهم هذا المجتمع دون فحص وتحليل نظامه الثقافي والمعالجات الثقافية التي تتعلق بالدين بشكل عام وبالإسلام بشكل خاص، وقبل الدخول في الحديث عن إشكالية الموقف الأمريكي الفكري والثقافي من الإسلام والمسلمين، لابد أن نبدي بعض الملاحظات الضرورية والعامة على الإنتاج الثقافي الأمريكي:
1-إذا عرفنا الثقافة كإنتاج نظري وتطبيقات عملية لأنماط فكرية معينة، فإن المجتمع الأمريكي المعاصر من أهم منتجي الثقافة في العالم الحديث وخاصة بسبب الإمكانيات العقلية والتكنولوجية والمالية الهائلة المتيسرة لهذا المجتمع.
2-إن المجتمع الأمريكي كأي مجتمع غربي هو وليد التحولات العلمية والفكرية ما بعد الثورة الصناعية، ولذلك فهذا المجتمع مبني على أسس علمانية، عقلانية، فردية ومادية ويتخذ مفهوم التقدم Progress كأهم مفهوم فكري في انطلاقاته الفكرية والمادية، وهذا المفهوم هو الطابع الرئيسي للمؤسسات الأمريكية المبنية على التوسع ثم الاستهلاك المتزايد(1).
3-بالرغم من مقولة الناقد اليساري هربرت ماركوز في كتابه الشهير الذي ينتقد فيه النظام الأمريكي «الإنسان ذو البعد الواحد»(۲)، فإن ما يميز المجتمعات الصناعية الحالية وخاصة الأمريكي منها هو انعدام الحريات الحقيقية للفرد والمجموعة، وأن النظام الصناعي الاستهلاكي قد نجح في فرض آراء ومعاملات أحادية الجانب، إلا أن الناظر على الساحة الثقافية والفكرية الأمريكية يرى منذ الثورة الطلابية في الستينيات تحولات ثقافية ودينية جذرية في المجتمع الأمريكي، وهذا ما يتكلم عنه ببراعة تامة الكاتب الأمريكي المعاصر كريستوفر لاش في كتابه «ثورة الصفوة»(3).
ففي هذا الكتاب يقول المؤلف: إن الدين المسيحي مثلًا يلعب دورًا مهمًا في الحياة السياسية والثقافية لأمريكا، لدرجة أن بعض المفكرين الدينيين من أمثال جيري فولويل، وبات روبرتسون، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الصفوة الأمريكية الحاكمة فكريًّا ودينيًّا، فإلى جانب ملايين التابعين وبلايين الدولارات التي يسيطرون عليها من خلال كنائسهم، فهؤلاء المفكرون الدينيون يسيطرون أيضًا على برامج تليفزيونية وإذاعية تصل إلى ملايين المستمعين ليس في أمريكا فقط وإنما في العالم ككل، وهذه الآراء الدينية وإن لم تكن جديدة إلا أنها تأخذ أبعادًا جديدة في إطار علاقة جديدة بين الدين والمجتمع في أمريكا المعاصرة.
إلى جانب الأفكار الدينية المختلفة التي تشغل الفكر الأمريكي المعاصر، انبثق في العقود الثلاثة السابقة مجموعة لا بأس بها من المفكرين الأمريكيين من الوزن الثقيل والذين يركزون على تعامل أكبر بين الثقافة الأمريكية والثقافات الأخرى.
موقف المجتمع الأمريكي من الإسلام:
تقودنا المقدمة هذه للسؤال التالي: كيف نستطيع أن نفهم موقف المجتمع الأمريكي من الإسلام وثانيًا: لماذا أصبح الإسلام إشكالية في الثقافة الأمريكية المعاصرة؟
للإجابة على هذين السؤالين، يجب أن نلاحظ أن هناك أكثر من موقف تجاه الإسلام والمسلمين في المجتمع الأمريكي: يمكن تلخيص هذه المواقف في:
1-الموقف الحكومي الرسمي: وهو أكثر المواقف المعروفة بسبب ربطه بالسياسة والاهتمام الأمريكي الإستراتيجي والاقتصادي في العالم الإسلامي، ويمكن تلخيص هذا الموقف في أن الحكومة الأمريكية تحترم الإسلام كدين ولا تجد أي إشكالية في ذلك، ولكن من الناحية العملية فإن الحكومة الأمريكية من الممكن أن تكون مستاءة من بعض التصرفات الإسلامية، مثل ربط الدين بالسياسة.
2-الموقف الأكاديمي: وهو موقف أكثر تعقيدًا من الموقف السابق، وسوف نشرحه في سياق هذا المقال.
3-الموقف الديني المسيحي: وهذا هو أقل المواقف المفهومة من قبل القارئ العربي، وأعزو هذا لكثير من الأسباب، من أهمها أن الكتابات العربية الجدية عن الدين المسيحي وتشعباته في الغرب قليلة نسبيًّا، إلى جانب أنه لا يوجد متخصصون عرب ومسلمون في موضوع الدين المسيحي على الرغم من أن الاستشراق في بداياته كان يأخذ طابعًا مسيحيًّا.
بالرغم من كل ذلك فأستطيع أن أقول إن الموقف المسيحي من الإسلام والمسلمين غير موحد نسبيًّا، فعلى الرغم من أن الكثير من الكنائس لا تعترف بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن هناك اتجاهات جديدة تؤيد التحاور الإسلامي- المسيحي، وفهم أكبر للإسلام في الحياة الأمريكية المعاصرة.
4-الموقف اليهودي والصهيوني تجاه الإسلام: وهنا أيضًا يجب أن نركز على الفرق بين الموقف اليهودي الديني من الإسلام والموقف الصهيوني السياسي من الإسلام، فاليهود في أمريكا هم أكبر أقلية مؤثرة على الناحية السياسية والأكاديمية والثقافية للمجتمع الأمريكي، فالموقف الصهيوني يتخذ موقفًا سلبيًّا من الإسلام ويتهم الدين الإسلامي بأنه المسؤول عن العنف ضد إسرائيل وأهداف يهودية أخرى، وعلى المستوى الديني والفكري اليهودي، فالموقف مختلف إلى حد ما في الساحة الثقافية والفكرية الأمريكية اليهودية حيث انبثق تيار فكري جديد يقف ضد الصهيونية السياسية ويناضل من أجل تيار يهودي متفتح على الأديان والحضارات الأخرى، ومن أهم ممثلي هذا التيار المفكر والفيلسوف اليهودي المعاصر رالف ليرنر(٤)، وخاصة من خلال كتاباته في المجلة التي يحررها Tikkun.
فليرنر يعتقد أن الإسلام هو دين روحاني وسماوي عظيم، وأن المجتمعات المادية الغربية بحاجة إلى مثل هذه الروحانية، ومن هنا فإن ليرنر يرى كما رأی أستاذه إبراهام هيشل(٥) في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن أن الفكر اليهودي المعاصر يجب أن يكون متفتحًا، خاصة على المسيحية والإسلام، وأن الصهيونية ليست الوحيدة التي تمثل الشعب اليهودي، فالذي يحاول أن يفعله ليرنر هو فتح أبواب الحوار مع الإسلام والمسلمين، خاصة أن أي باب للحوار كان قد أغلق في الماضي بسبب إشكالية الصراع العربي الإسرائيلي(٦).
5-الموقف الخامس والأخير هو الموقف الشعبي الأمريكي من الإسلام، وسوف يتجلى لنا هذا الموقف في سياق المقال.
بدايات الإسلام في أمريكا:
عرف المستوطنون البيض الإسلام كدين وحضارة قبل الإعلان عن استقلال أمريكا في عام ١٧٧٦م، إن اكتشاف كولومبس لبلاد شاسعة جديدة وهجرات البيض من غرب أوروبا بسبب الاضطهاد الديني إلى أمريكا، والاكتشافات الزراعية والاقتصادية الهائلة في هذا العالم الجديد أدى إلى دخول عنصر جديد وهو الحاجة إلى استعباد ملايين البشر من إفريقيا للعمل في المزارع الأمريكية الجديدة، إن معظم هؤلاء العبيد الذي أتى بهم قهرًا من إفريقيا وخاصة من غرب ووسط إفريقيا كانوا من المسلمين(۷)، ومن هنا كان تعرف الرجل الأبيض على الإسلام والمسلمين من خلال قهر واستعباد الملايين والطمس الكامل للهوية الدينية والثقافية والحضارية للإنسان المستعبد.
ويسبب التحولات الثقافية في المجتمع الجديد ودخول عامل الاستعباد فإن الكثير من المسلمين الأفارقة المستعبدين أجبروا على اتخاذ دين أسيادهم كدين جديد لهم.
مشكلة دينية:
ولكن الواقع الثقافي الأمريكي والضمير الأمريكي المسيحي على مستوى البيض والسود واجه الإسلام كمشكلة دينية وثقافية مع انبثاق حركة المسلمين السود المسماة «أمة الإسلام» تحت رئاسة إليجا محمد في الخمسينيات من هذا القرن(۸)، اتسعت حدة هذه المشكلة مع بروز مالكولم إكس(۹)، كقائد جديد إلى جانب إليجا محمد واغتياله بعد رجوعه من الحج في عام ١٩٦٥م، إن حركة المسلمين السود تحدَّت الدين المسيحي والحضارة الأمريكية على الأسس التالية:
1-تطور الدين المسيحي في أمريكا الشمالية كدين للرجل الأبيض فقط، ودين يؤمن بفلسفة العنصرية والاستغلال والاستعلاء الثقافي والحضاري على بقية الناس وخاصة السود، ووجهة النظر هذه ما يزال يعبر عنها وريث إليجا محمد الرئيس لويس فراخان الذي ما زال يجسد نفس الأفكار التي كانت رائجة في الستينيات.
2-بسبب إيمانهم بدين الرجل الأبيض فإن السود في أمريكا لا يستطيعون أن يتحرروا من قبضة الرجل الأبيض إلا إذا ثاروا كليًّا على هذا الدين.
3-إن الإسلام بمفهوم إليجا محمد «وهذا لم يكن بالمفهوم السني الصحيح حتى بعد وفاة إليجا في عام ۱۹۷۵م» هو أيديولوجية معارضة للدين المسيحي والأفكار العلمانية والمادية السائدة في المجتمع الأمريكي.
4-إن المجتمع الأمريكي الأبيض خاصة يعاني من ضعف الهوية وانفصام تاريخي وخاصة للتاريخ القصير نسبيًّا الذي عاشت به الحضارة الأمريكية.
مما تقدم نستطيع أن نستنتج أن الإسلام بمفهوم جماعة إليجا محمد كان هو القوة المركزية الوحيدة في المجتمع الأمريكي الناقدة للنظام الثقافي والفكر السائد على أسس دينية خارج المسيحية، صحيح أنه كان هناك في الخمسينيات والستينيات بعض الحركات الدينية غير المسيحية كاليهودية والهندوسية التي كانت منتقدة للنظام القائم، ولكن هذا الانتقاد لم يتجمع حول حركة شعبية كما كان الحال بالنسبة لـ «أمة الإسلام»، ومن هنا فإن المجتمع الأمريكي يواجه الإسلام كإشكالية دينية وحضارية، إذ إن هناك على الأقل ميل عظيم عند بعض مفكري المسلمين السود إلى تقديم بديل للنظام القائم، بالإضافة إلى أن هذا التحدي يواجه أيضًا الكنائس السوداء بشكل خاص، إذ إن الكثير من أعضائها تحول إلى الإسلام والحركة الإسلامية في أمريكا.
الهجرات العربية:
إن انبثاق الإسلام كحركة أيديولوجية لم يكن نهاية المطاف لتوسع الإسلام وخاصة من خلال مساعي المهاجرين المسلمين من مختلف العالم الإسلامي إلى شمال أمريكا، فهذه الهجرة ابتدأت وبالذات من المنطقة العربية في أواخر العصر العثماني بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي كانت تمر بها الدولة العثمانية في أواخر حياتها، وكانت الهجرات الإسلامية منبعها الطبقة المتوسطة التي تعتمد التجارة كأساس حياتها، ثم ازداد معدل الهجرات بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة من قبل العلماء والطلاب المسلمين، ومما لاشك فيه أن هجرة المثقفين التي تعد من هجرة الأدمغة تؤثر سلبيًّا على الدول الإسلامية إذ إن أحسن العقول الإسلامية لأسباب مادية وسياسية اختارت العيش خارج الوطن، ولكن التفاعل الحضاري يبدأ من هنا... إذ إن المسلمين في أمريكا اليوم والموجودين تقريبًا في كل منطقة في أمريكا يشاركون في الحياة الثقافية والدينية للمجتمع الأمريكي عن طريق نقل الأفكار الإسلامية وإبرازها عمليًّا على الصعيد الاجتماعي والثقافي، والملاحظ أيضًا أن أبناء الطبقة المتوسطة من العالم الإسلامي الذين هاجروا إلى أمريكا والذين كانوا متغربين في ثقافتهم وتعليمهم يكتشفون معنى جديدًا للإسلام في حياتهم في المجتمع الجديد، فالغربة تعلم الشخص الشيء الكثير، ومنها أن الشخص يكبر سنًّا ويتعلم الأشياء الجديدة، ويكتشف أن النجاح المادي في هذه الحياة ليس هو كل شيء فيرجع إلى ينابيع دينه وإلى أسس حضارته لكي يجد البديل عما يعيشه في أمريكا، فالذي أراه من خبرتي الطويلة في الولايات المتحدة أن الكثير من الأطباء والمدرسين والمهنيين المسلمين في أمريكا يكتشفون حيوية جديدة للإسلام في حياتهم وحياة عائلاتهم.
هذا الاكتشاف له آثار إيجابية على مجال الدعوة الإسلامية، إذ إن الكثيرين من المهنيين المسلمين يبدؤون بالدعوة إما عن طريق المساجد أو المراكز الإسلامية أو اجتماعات إسلامية أو اجتماعات إسلامية- مسيحية(۱۰)، هذا التفاعل الإيجابي مع المجتمع الأمريكي يختلف عمليًّا عن الإسلام كحركة أيديولوجية كما فهمها «أمة الإسلام» في الماضي.
فالهدف هنا ليس نقد شامل للمجتمع الأمريكي وثقافته وإنما التعايش معه على أساس المحافظة على السمات المركزية للإسلام في احتكاكه وتحاوره مع الثقافة القائمة، ولكن على الرغم من أن هذه الترجمة للإسلام في الواقع الأمريكي من قبل المهاجرين المسلمين خاصة ليس ثورة أيديولوجية ضد الفكر الأمريكي، إلا أنه يؤدي إلى إشكاليات أعمق على مستوى فهم الأمريكان للإسلام والمسلمين، فوسائل الإعلام الأمريكية التي تسيطر على الثقافة الشعبية للمجتمع تقدم صورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين وتربط بين الإسلام والعنف وبين التيارات الإسلامية التجديدية والعداء للغرب.
هذا الموقف العدائي من الحركات التجديدية في العالم الإسلامي وإن ظهر بشكل قوي بعد الثورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹م، إلا أنه موجود هناك من قبل، فالصراع العربي الإسرائيلي، وتأييد أمريكا المطلق لإسرائيل خاصة منذ حرب السويس في عام ١٩٥٦م ساعد وسائل الإعلام على خلق أعداء خارجيين من الإخوان المسلمين إلى الناصرية إلى الحركة الفلسطينية... إلخ، المهم هنا أن مساعي المسلمين في أمريكا في إعطاء صورة جيدة عن الإسلام للمجتمع الأمريكي ما زالت مستمرة ولها حاجة هائلة.
الإسلام على المستوى الأكاديمي والفكري الأمريكي:
برزت أمريكا كدولة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية وكان من أهم نتائج الحرب العالمية الثانية أن أمريكا ورثت الإرث الاستعماري والاقتصادي لبريطانيا وفرنسا في العالم الثالث بشكل عام وفي العالم الإسلامي بشكل خاص، ولكن يجب أن نلاحظ أن علاقة أمريكا ثقافيًّا ودينيًّا في العالم الإسلامي كانت قد سبقت الحرب العالمية الثانية بعشرات السنين، وخاصة عندما ركزت الحركة التبشيرية المسيحية البروتستانتية على العالم العربي في إرساء قواعد دينية وأكاديمية، ومن هنا فلم يكن غريبًا بالمرة أن جهود البروتستانت ركزت على إقامة الجامعة الأمريكية في بيروت وفي القاهرة، وروبرت كولج في إسطنبول في القرن التاسع عشر كوسيلة للتبشير بالأهداف البروتستانتية الأمريكية، ولتخريج نخبة من العلماء في العالم العربي والإسلامي الذين يفكرون تفكيرًا غربيًّا، ويهتمون بنشر المبادئ الرئيسية للحضارة الأمريكية الوافدة(۱۱)، فهذه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الممولة تمويلًا جيدًا من قبل الكنائس والمؤسسات المسيحية الأمريكية ابتدأت عصر الاستشراق في أمريكا بتأسيس أول كرسي للدراسات الإسلامية والعربية في هارتفورد سیمناري(۱۲) في عام ۱۸۹۲م، وكان معظم الطلاب المتخرجين يدرسون أسس الدين الإسلامي، وينشرون الأبحاث المهمة قبل تأسيس أقسام لدراسات الشرق الأدنى في جامعات برنستون وكولومبيا وأماكن أخرى.
ومع خروج أمريكا منتصرة بعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك حاجة أكاديمية في بعض الجامعات الأمريكية العليا في إنشاء مراكز للدراسات الشرق أوسطية والشرق الأدنى، وكانت القيادة الأكاديمية لهذه المؤسسات عادة مستوردة من الخارج مثل المستشرق هاملتون جب(۱۳)، وهو إنجليزي الأصل وقد درس في برنستون وهارفارد، وفون جروبناوم المستشرق المشهور الذي كان مهتمًا بالفكر الإسلامي الحديث(١٤)، وهو ألماني الأصل وكان في جامعة كاليفورنيا، والمستشرق المشهور أيضًا ويلفرد كانتويل سميث(١٥)، الذي أسس مركز دراسة الأديان المقارنة في مجيل يونفرستي في كندا، وكان من تلاميذه المسلمين المشهورين معطي علي(١٦)، وزير الأوقاف الإندونيسي السابق، وبعد ذلك أسس مركزًا مشابهًا في جامعة هارفارد في بوسطن في الولايات المتحدة.
على الرغم من العمق الفكري لهؤلاء المستشرقين وإبرازهم الأهمية الدينية والروحية للإسلام، إلا أن الدراسات الاستشراقية بمعناها الكلاسيكي أخلت الطريق أمام علماء نظريات التحديث مثل الأخوين روستو، ودانيل ليرنر، وليونارد بایندر، فنظريات التحديث كانت تعتمد على المقولة إن السبيل الوحيد لتحديث المجتمعات الإسلامية يأتي عن طريق قبول العلمانية الفكرية ومفهوم التقدم في الاستهلاك والإنتاج، وعن طريق الاستغناء عن الإسلام كوسيلة للتقدم، فمثلًا بايندر يقول: «إن الإسلام يشغل حيزًا صغيرًا في نظريات التحديث لأنه دين لا يساعد على النمو والفكر التقدمي(۱۷)»، وهذا معناه أن الإسلام هو جزء من «المجتمع المغلق» بمفهوم الفيلسوف البريطاني المشهور كارل پوير، ولكي تصل المجتمعات الإسلامية إلى مستوى «المجتمع المفتوح» يجب التخلي عن الإسلام كدين وموروث ثقافي(18).
بالطبع فإن نظريات التحديث هذه لم تتنبأ من خلال نظرياتها وطابعها الفكري بظهور قوي وجديد للإسلام في المجتمعات الإسلامية الحديثة، فقد فشلت بالتنبؤ مثلًا بظهور الحركات التجديدية الإسلامية، وبالعلاقة المركزية بين الدين والمجتمع في العالم العربي والإسلامي المعاصر.
عبر الفكر التحديثي الأمريكي عن فشله الذريع بالنسبة للإسلام عن طريق هجوم كاسح على الحضارة الإسلامية من قبل أحد أعمدة نظريات التحديث، وهو العالم السياسي الأمريكي المشهور صامويل هانتجتون في مقالة مطولة في مجلة «Foreign Affairs» في عام ۱۹۹۳م تحت عنوان «صراع الحضارات»(۱۹)، فيعترف الكاتب -على الأقل- أن للإسلام حضارة، وأن له دورًا هائلًا في الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية للمسلمين المعاصرين، ويرى أنه إذا كان المسلمون لا يقبلون بنظرية التحديث، فالبديل الأوحد هو الصراع مع الحضارة الغربية، فالإسلام له حدود دموية، ونظرية الجهاد في الإسلام لا يمكن أن تؤدي سوى إلى تنافس وتناحر أكبر مع الحضارة الغربية، ومن الرابح يا ترى؟ إنه الغرب بالتحديد.
الاستشراق الكلاسيكي:
مما تقدم، نستطيع أن نستنتج أن الإسلام في دراسة الاستشراق الكلاسيكي الأمريكي والغربي بشكل عام، كان إشكالية دينية ثيولوجية، وكانت إحدى طرق الاستشراق الكلاسيكية في البحث هي المحاولة على البرهنة أن الإسلام صورة مشوهة عن المسيحية أو اليهودية، في عصر نظريات التحديث كان الإسلام أيضًا إشكالية بمعنى أنه دین موجود ومفقود في آن واحد، أي لا أهمية له مع أن هناك مسلمين، ولكن نظرية الصراع كما يتبناها هانتجتون وعدد لا بأس به من الجناح المحافظ في الحكومة الأمريكية، والنخبة الحاكمة الأمريكية ترى الإسلام كإشكالية يجب أن يتم القضاء عليها من خلال صراع جديد للحضارات.
رغم هذه النظريات التحديثية التي تؤمن بالصراع مع الإسلام والمسلمين يجب علينا أن نلاحظ أن هناك عددًا لا بأس به من المفكرين والفلاسفة الأمريكان من الوزن الثقيل الذين لا ينظرون إلى الإسلام من منطلق الصراع، وإنما التعامل معه على أساس أنه دين عالمي وتوحيدي، وفي هذا المجال فهم يضعون الإسلام على مستوى التعامل مع المسيحية واليهودية(۲۰)، هذا التعامل البناء واضح في كتابات إدوارد شيلز(۲۱)، وريتشارد دورتي (۲۲)، فمثلًا فرورثي، وهو فيلسوف أمريكي براجماتيكي من الطراز الأول ويعمل في جامعة فرجينيا، ويشبه في أفكاره إلى حد ما أفكار الفيلسوف المصري الراحل زكي نجيب محمود، يقول: «إن الإسلام عمليًّا هو جزء لا يتجزأ من التجربة الأمريكية بشكل عام، وأن عدد المسلمين في أمريكا سوف يفوق عدد اليهود مع بداية القرن الواحد والعشرين».
إن هذا الموقف يدل على أن الجزء الواعي والمثقف ثقافة عميقة في المجتمع الأمريكي المعاصر يختلف في انطلاقاته الفكرية عن منظري التحديث وصانعي الثقافة الاستهلاكية، وينظر إلى الإسلام على أنه امتداد مهم للأخلاق اليهودية المسيحية الحاكمة في الثقافة الأمريكية.
مما تقدم نستطيع أن نلخص هذا المقال بالنقاط التالية:
أولًا: إن الموقف الأمريكي من الإسلام والمسلمين هو موقف متجانس عمليًّا، فعلى الرغم من عمليات التشويه التي تقوم بها الصحافة والإعلام في أمريكا، وعلى الرغم من أن المادية تطغى على هذا المجتمع بشكل أسطوري، إلا أن هناك أصواتًا أمريكية تنادي بالتفاهم مع الإسلام والتعامل معه كجزء لا يتجزأ من التجربة الدينية والثقافية المعاصرة.
ثانيًا: إن منتجي الثقافة وخاصة الثقافة الشعبية ينحون منحى سلبيًّا من الإسلام، وبهذا الاتجاه السلبي فهم يعبرون منطقيًّا عن مركزهم في الإنتاج الثقافي الأمريكي الذي يسمح لهم أن يكونوا متخصصين بالمعنى الضيق للكلمة، أي متخصصين مثلًا في الإرهاب، ووعيهم الاجتماعي يقول لهم إن المسلمين مسؤولون عن نصف الإرهاب في العالم، ومن خلال منطقهم الثقافي الضيق وبسبب عدم الوعي الكافي لدور الإسلام الحضاري والثقافي في التاريخ الحديث والمعاصر، فهؤلاء المنتجون للثقافة الشعبية يربطون بين الإسلام والإرهاب وبين الإسلام وخراب مجتمعاتهم.
معنى ذلك أنه على مستوى الثقافة الشعبية لا يوجد فهم كامل أو إيجابي عن الإسلام، اللهم إلا في المجتمع الأمريكي الأسود الذي يتخذ موقفًا مختلفًا.
ثالثًا: إن ازدياد عدد المسلمين وتبوؤهم تدريجيًّا لمراكز حساسة في جميع مجالات المجتمع الأمريكي كفيل بأن يعطي صورة أفضل عن الإسلام والمسلمين، ولكن هذا الجهد يستغرق الوقت الكثير، ويستغرق جهودًا جماعية منظمة، وهذا مما أدى إلى وعي جماعي إسلامي أكبر بضرورة إبراز النواحي الإيجابية لدينهم وثقافتهم.
رابعًا: مما لا شك فيه أن الإسلام يمثل إشكالية ثقافية في المجتمع الأمريكي المعاصر كما شرحنا سابقًا، ويجب في نفس الوقت ألا ننسى أن المجتمع الأمريكي بشكل خاص والغرب بشكل عام يمثلان إشكالية حادة بالنسبة للعرب والمسلمين المعاصرين، وللأسف لا يوجد هناك متخصصون عرب ومسلمون أكفأ في الدراسات الأمريكية، والدراسات المسيحية، والدراسات اليهودية، ودراسات الفكر الغربي بشكل عام، إلى جانب ذلك لا يوجد في العالم الإسلامي مراكز أبحاث عن العالم الغربي كما هو الحال في الغرب عن الإسلام، فكم يكون عدد المتخصصين العرب والمسلمين في المسيحية مثلًا؟ لا يوجد سوى قلة قليلة ومعظمها تعتمد على مصادر ثانوية ولا تعرف اللغات المطلوبة لدرس وبحث المسيحية أو اليهودية أو أي تيار فكري مهم.
فإشكالية الإسلام في الغرب وأمريكا يواجهها إشكالية الغرب وأمريكا في العالم الإسلامي، ومن هنا فإننا نحن المسلمين نواجه تحديات شديدة ليس فقط في التعريف بالإسلام ونشره في العالم الغربي، وإنما أيضًا في فهم العالم الغربي والعقل الغربي بشكل عام، وهذه التحديات هي أخطر مما نواجهها في العالم الإسلامي على مستوى العلم والطب، فإذا نظرنا إلى الساحة العلمية البحتة نرى آلاف الأطباء والعلماء المسلمين، وبعضهم قد نال شهرة عالمية في مجال تخصصهم، ولكن نرى القلة في مجال الفكر والدين والفلسفة المشهورين عالميًّا، فمعركتنا طويلة ومضنية، وإذا لم نجابه الواقع الفكري والغربي بفهم واع وشامل فسوف نسمح -كما يقول المفكر الإسلامي الراحل الشيخ محمد الغزالي- للغزو الثقافي في الامتداد في فراغنا .
الهوامش
1- Richard Hofstadter, Anti- intellectualism in American Life «New York: Alfred Knopf, 1963».
2- Herbert Marcuse, one Dimensional
Man «Boston: Beacon Press, 1964».
3-Christopher lasch, The Revolt of the
Elite «New York: Doubleday, 1994».
4- Ralph Lerner, Tikkun, A Bimontly
Magazine of Jewish Culture and
Thought.
5-Abraham Heschel, Judaism and Hu- manism «Philadelphia: Jewish Philo- sophical Society, 1958».
6- Ibrahim M. Abu- Rabi, "Jewish- Muslim Dialogue." In Oxford Ency- lopedia of the Modern Muslim World, ed. John Esposito «Oxford: Oxford University Press, 1995».
7- Aminah Mccloud, African American Islam «New York: Routledge, 1995».
8- Aminah Mcloud, African American Islam «New York: Routledge, 1995».
9- Malcolm X, The Autobiography of
Malcolm X «New York: Ballantine Books, 1965».
10-Yvonne Y. Haddad and Jane I. Smith, eds. The Muslim Communi- ties in North America «Albany: State University of New York Press, 1994».
11- Samir Khalaf, «New England Puri- tanism and Liberal Education in the Middle East: The American Univer- sity in Beirut as a Cultural Trans- plant», Insherif Mardin, ed., Cultural Transitions in the Middle East «Leid- en: Brill, 1994».
12-William D. Mackenzie, «Duncan Black Macdonald: Scholar, Teacher, and Author». In The Macdonald Presentation Volume «Princeton: Princeton University Press, 1933».
13- Hamilton Gibb, Modern Trends in Islam «Chicago: University of Chica- go Press, 1947».
14-G. E. Von Grunebaum, Modern Is- lam: The Search for Cultural Identity «Berkeley: University of California Press, 1962».
15-W. C. Smith, Islam in Modern His- tory «New York: New American Li- brary, 1957»
16- Ali Munhanif, «Islam and the Struggle for Rligious Pluralism in Indonesia: A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali». Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, vol. Three, Number one, 1996.
17- Leonard Binder, Islamic Liberal- ism: A Critique of Development Ide- ologies «Chicago: University of Chi- cago Press, 1988».
ولنقد الكتاب السابق Hنظر مقال الكاتب:
Ibrahim M. Abu-Rabi, «Is Liberalism in the Muslim Middle East Viable? A Critical Essay on Leonard Binder's Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies», Hamdard Islamicus, Volume XII (4), Winter 1989, PP. 15- 30.
18- Karl Popper, The Open Society and its Enemies, 2 Volumes «Princeton: Princeton University Press, 1964».
19- Samuel Huntington, «The Clash of Civilizations. «Foreign Affairs, Sum- mer 1993».
20- Neil Jumonville, Critical Crossings:
The New York Intellectuals and Postwar America «Berkeley: Univer- sity of California Press, 1991».
Martin E. Marty, Ed. Fundamentalisms Observed «Chicago: The University of Chicago Press, 1991», Fundamen- talisms and the State and Fundamen- talisms and Society.
21- Edward Shils, Tradition «Chicago: University of Chicago Press, 1982».
22- Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity «Cambridge: Cam- bridge University Press, 1989».