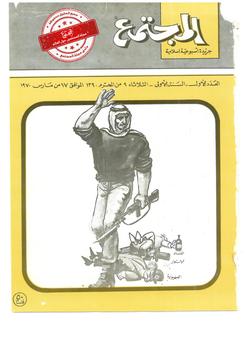العنوان دراسة فكرية.. الواقع الإسلامي المعاصر والبحث عن حل
الكاتب د عبد الحميد أحمد أبو سليمان
تاريخ النشر الثلاثاء 28-ديسمبر-1976
مشاهدات 22
نشر في العدد 330
نشر في الصفحة 18

الثلاثاء 28-ديسمبر-1976
▪ الجزء الثاني
▪ جوهر الحل المطلوب:
والحل المطلوب لمشاكل شعوب الأمة الإسلامية في العصر الحديث لا يمكن أن يكون في حلول ولا مؤسسات مستوردة من الماضي ولا من الخارج، بل إن هذه الحلول يجب أن تنبع عن فكر إسلامي أصيل يعي جذوره الحضارية والتحديات التي يجابهها والواقع الذي يعيشه ليعبر عن الشخصية المسلمة وعن غاياتها وأهدافها في الحضارة والتاريخ بكافة أعماقها وشمولها.
إن على المفكرين المسلمين والقيادات المسلمة أن يأخذوا أنفسهم بالطريق الوحيد المفتوح أمامهم وإن بدا اليوم شاقًا، إن الحل المطلوب لا بد من أن يبدأ من أرضهم وتاريخهم ودينهم ودوافعهم، يواجهون بأصالته التحديات المعاصرة، وإلا فإن التجارب الفاشلة المريرة، التي عانى منها العالم الإسلامي خلال القرون الماضية لن تساوي فتيلًا ويمكن لكل القيادات المسلمة وكل المثقفين المسلمين وكل الجماهير المسلمة والعواطف المسلمة، أن تحلم بالتقدم وبالعزة والقوة، ولن يكون نصيبها إلا حصادًا أمر مما ذاقت وباله حتى اليوم.
والحل المطلوب لا يمكن أن يصنعه فرد واحد فهو لا بد وأن يكون شاملًا للجوانب الاجتماعية كلها، في السياسة والاقتصاد وفي العلاقات الاجتماعية وفي الأخلاق، إن ذلك المستوى من الحل هو مهمة مؤسسات علمية جامعية، يقوم عليها طلاب ومفكرون ورجال في عمل دائب مستمر يتحرك بتحرك الحياة ويتجه معها، فهو عملية دائمة دائبة تواكب سير الحياة في مجتمع الإنسانية.
إن كل ما سأحاوله هنا هو أن أتعرض لجوهر المنهاج والتصور الإسلامي ودليل حركة المجتمع المسلم في كافة ميادين الحياة والقيمة الكبرى التي تحكم قيمه وعلاقاته.
إن هذا المنهج الذي يمثل قاعدة الحل الإسلامي يتلخص في أمرين أساسيين: التوحيد والخلافة «بمعنى أمانة استخلاف الإنسان في الأرض».
▪ الأمر الأول- التوحيد:
ومصدر فهمنا للتوحيد يجب أن يكون أصلًا أساسيًا وإيجابيًا كما أراد الله له أن يكون، لا مجرد قضية من قضايا المتكلمين، إن التوحيد في المفهوم القرآني هو معيار الحقيقة التي يُبنى عليها كيان الوجود والخلق، ولذلك يصبح التوحيد هو المعيار الذي يحدد معالم الحياة المسلمة وأساليبها ونظمها ومقوماتها ما كانت على الأرض حياة، وما دام للبشرية مجتمع، على كل الأحوال وكافة وجوه النشاط، أخلاقًا، واجتماعًا، واقتصادًا، وسياسة.
إن التوحيد هو قانون الوجود الذي يكشفه لنا الوحي من الخالق العليم وذلك أن الوجود حركة متكاملة متجانسة هادفة وفق إرادة الخالق المدبر ووفقًا لحكمته.
وهكذا فالتوحيد في المفهوم القرآني ليس مجرد قضية كلامية ولا مجرد رد على شبهات قديمة كالتثليث ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ ﴾ (المائدة: 73) «5- 73» أو الدهرية والعدمية في صورها القديمة والمستحدثة ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الحج: 3) «22:3»، ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ ﴾ (الجاثية: 24) «45:24»﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (الأنعام: 29) 6:29 ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ (الأنعام: 31) «٦: ٣١»، ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (الروم: 7) «۷:۳۰».
بل إن القرآن وإن رد على هذه الشبهات إقرارًا للحقيقة، وتنزيهًا للذات الإلهية، إلا أن ذلك لا يغير الحقيقة القرآنية الكبرى، وهي أن التوحيد حقيقة أزلية، أبعد وأشمل من مجرد قضية نفي الشبهات والأكاذيب والافتراءات عن الذات الإلهية.
إننا نعي حقيقة التوحيد وأبعادها الشاملة، ونلمسها من المفهوم القرآني، حتى مجال الرد على الشبهات والافتراءات على الذات الإلهية، فالله- عز وجل- يقول ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ( التوبة: 30-31-32-33-34) «٩: ٣٠ - ٣٤»، وبذلك فإننا نرى أن السياق القرآني قد رد شبهات اليهود والنصارى في أمر عزير وعيسى- عليهما السلام-، وفي نفس الوقت وضح أن هذه ليست القضية الأساسية بل هي تقليد ومحاكاة في الكفر واللغو لمن قبلهم، وأن جوهر القضية هو ما تقود إليه تلك الانحرافات والأقوال، من تقليد الأحبار والرهبان مقاليد الألوهية في الحياة والمجتمع، ليكون الظلم والطغيان والبعد عن سبيل الله في الحق والعدل وأداء الحقوق.
وهكذا كان أن استتبعت الآيات روايتهم لتلك الأقوال والشبهات في الذات الإلهية ما فوضوا إلى الأحبار والرهبان من أمر الألوهية وكما صفاتها في توجيه حياتهم ومجتمعاتهم مما يقود إلى ظلم الناس وأكل أموالهم وكنز الثروات والصد عن سبيل الله.
فالكفر بوحدانية الله والشرك به ليس بالافتراء على الذات الإلهية وكمال صفاتها وحسب، بل هو في انتهائها بادعاء صفات الألوهية أو نسب قدراتها وتسليم مقاليد الأمر في توجيه حياة البشر إلى فرد أو جماعة من البشر تعرض الناس والكون للظلم والفساد.
يقول الله -عز وجل-: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ*إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ( الجاثية: 18) « ٤٥: ١٨ - ۱۹» ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (الجاثية: 23-24) «٤٥: ٢٣ - ٢٤» ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ ( الجاثية: 26-27) «٤٥: ٢٦- ۲۷».
وهكذا فمن يقلد مقاليد الألوهية غير الله فليس شركه في أمر صفات الله، ولكن شركه في أخذ نفسه وعلاقاتها وغاياتها بغير ما أمر به خالق كل شيء ولذلك كان الرد والتوبيخ في السياق القرآني في الآية السابقة وفي إلزام الكفار الحجة على فساد أمرهم وبطلانه هو أن الألوهية لا تكون إلا للخالق القادر العليم صاحب الأمر.
وهذا المعنى يؤكده الأداء القرآني في آيات كثيرة وبأساليب متعددة من ذلك قول الله تعالى وجل شأنه: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (القصص: 62)
﴿وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۞ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ*وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ ﴾ (القصص: 75-76-77-78) ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ (القصص: 81) ﴿وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (القصص: 82) ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص: 83) «۲۸: ٧٤-٨٣».
وهكذا نرى القرآن حين تحدث عن قضية الشرك، أتبعها قصة فساد قارون وطغيانه واستبداده وفق هوى نفسه، وكيف أن قارون لم يكن يطيع في ذلك إلا نفسه، ذلك بعد أن نسب إليها زورًا القدرة من وراء العلم والمعرفة المحدودة التي من الله بها عليه، فأهلكه الله وأخزاه، وحرمه بكفره وضلاله، وامتداد معاني التوحيد إلى جوانب الحياة وتعريف قضاياها يوضحها أيضًا هذا السياق القرآني، فاستمع إلى قول الله- عز وجل- يؤكد الوحدة والشمول في حياة البشر ووجودهم: ﴿أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ﴾ (الماعون: 1-2-3-4-5-6-7) «۱۰۷: ۱- ۷».
إن التوحيد في المفهوم القرآني، هو التعبير عن الحقيقة الأزلية التي يقوم على أساسها الكون والوجود.
وجوهر التوحيد هو وحدة الخالق وكمال صفاته وتفرده بالألوهية، ونفي صفات الألوهية عن كل إنسان وكل شيء عداه ويستتبع تلك الحقيقة أن الكون كله بما فيه الإنسان والأرض وكل ما أودع فيها من الثروات من خلق الله الذي قدر أمره، وأحكم صنعه، وسخره وفق إرادته، وأن الناس في أصل خلقهم وحقوقهم على ما أودع الله الكون من ثروات سواسية، لا يتميز بعضهم على بعض ولا يظلم بعضهم بعضًا ولا يطغى بعضهم على إرادات أو حقوق بعض، ومن هنا كان وعي الإنسان لحقيقة الذات الإلهية، وصفات الخالق وقدراته التي تفرده بحقوق الألوهية، ذا معنى في حياة البشر فلا تنحرف علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ولا تقوم إلا على أساس انتصار الحق والعدل والمساواة والتعاون والشورى بين الإخوة الشركاء فكلهم بشر، خلق الله في أرض الله، ليس منهم من هو إله أو نصف إله، يُخلَقون ولا يَخلقون، تعالى الله عما يشركون.
ولهذا كانت الرسالات وذروتها رسالة الإسلام تقوم جميعها على توضيح هذه الحقيقة الأزلية التي يقوم عليها الكون، والتي تحدد بدورها معالم الخلافة الصالحة للبشر في الأرض، وتقودها إلى قانون التوحيد في الكون، والالتحام به وتحقيقه في التعامل مع الكائنات على أساس الانسجام والتكامل الذي يمتد إلى كافة جوانب حياة البشر ونشاطهم، بما يحقق بينهم الإخاء من شورى وعدل وتعاون ومساواة في حياتهم ويسعى بهم إلى الخير والحق في علاقاتهم بأنفسهم ومع إخوانهم، ولذلك كان الشرك كما يصوره القرآن كفرًا وظلمًا وفسادًا، ما بلغ من قوم إلا أفسد أمرهم، وانتهى بهم إلى الظلم والبغي والدمار.
إنه دون التوحيد لا يوجد ضابط ولا موجه ولا قانون يقيم ويبقى على التعامل العادل أداء لواجب الخلافة البشرية في الكون، إن الصلاح والحق في سلوك البشر- إذا انعدم القبول والتسليم الواعي بعقيدة التوحيد- يصبح ظنًا وعشوائية.
إن التوحيد في حياة الإنسان المسلم هو في الجوهر ضابط التوجيه في مسلكه نحو غايته السامية في التعامل مع الحياة والكون ولا ضبط ولا توجيه له قيمة موضوعية حقيقية في الحياة سواه.
والقرآن الكريم يتناول أبعاد التوحيد ويوضحها من كافة جوانبها فهو ينزه الله عن الشبيه ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ* ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ (الإخلاص: 1-2-3-4) «۱۱۲: ١-٤»، ويوضح صفاته وعلاقاته بالكون ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور: 35) «٢٤ : ٣٥» ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: 62) «۳۹: ٦٢» ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ (سبأ: 3) «٣٤: ٣» ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ ( الفرقان: 2) «٢:٢٥» ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88) «۲۷: ۸۸».
ويوضح القرآن الكريم حقيقة علاقة المخلوقات بالله جل شأنه ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (الإسراء: 44) «١٧: ٤٤».
ومنتهى الأمر في أي شيء يراد تحديد وجهته، ورسم خطة سيره- إذا لم يكن يراد بالأمر فساد ولا عبث- أن يرد إلى من له القدرة والعلم وبيده زمام الأمر وهذا في حياة البشر مقام الألوهية، ولهذا كانت آيات الذكر الحكيم تؤكد وتنسب دائمًا- في الرد على المشركين والكفار- حق الألوهية إلى الله وحده؛ لأن الله وحده دون سواه خالق الكون والحياة الذي يعلم حقيقة كل شيء، فأمره وتوجيهه هو الحق الأولى بالاتباع، ومن ذلك قول الله- سبحانه وتعالى-: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (الفرقان: 3) «٢٥ : ٣» ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: 101) «٦: ١٠١»، ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (طه: 49-50) «۲۰: ٤٩-٧٩» ﴿إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (طه: 98) ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام: 101-102-103) «٦: ۱۰۱- ۱۰۳» ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام: 106) «٦: ١٠٦».
وهكذا فإن القرآن في عرض وتوضيح مبدأ التوحيد ينفي كل صفات الألوهية من كمال العلم وقدرة الخلق عن كل أحد عدا الذات الإلهية، ويتشدد في رد الشبهات والدعاوي الباطلة، لأن ذلك هو المدخل إلى تمييز البشر على البشير، والاستبداد بحقوقهم وإرادتهم، فيكون الظلم والضلال والشرك، ليصبح البعض آلهة والبعض أنصاف آلهة، بأسماء وأساليب شتى، كلها كفر وظلم، من الكذب على ذات الله أو دعوى النسب أو النيابة أو الاصطفاء والقدرة، لهذا أكد القرآن حقيقة موضع الألوهية للخالق وحده مرة إثر مرة، على مدى المرحلتين المكية والمدنية، ونفى قدرة الخلق عن كل ما عداه، كما أكد ووضح معنى ذلك ودلالته في حياة الإنسان، وهي أن الإنسان خلق وأن الإنسان خلق وحدة واحدة تنبع من مصدر واحد لها أصل واحد وطبيعة واحدة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء: 1) «٤ : ١» ويؤكد القرآن أن وحدة الإنسان لیست کلمات مجردة، ولكنها تعني الإخاء والمساواة والتضامن في أصل الحقوق والموارد فأصل كل ثروات الكون المسخرة للإنسان من عند الله وحده ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ ﴾ (الزمر: 6) «٣٩: ٦».
﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَال الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (إبراهيم: 31-32-33-34) «١٤: ٣١ - ٣٤»، والآيات والأحاديث التي تفصل مساواة الإنسان كتساوي أسنان المشط- ومشاركتهم في مصادر الرزق التي أودعها الله الكون كثيرة، لمن شاء تتبعها، ووحدة الذات الإلهية وتفردها بصفات الألوهية، ووحدة الخلق وفقًا لقانون التوحيد في التكامل والانسجام الهادف ووحدة الإنسان المكلف بمسئولية أمانة الخلافة في الأرض، لا تعني إلا العدل والتعاون والتضامن والإحسان في حياة البشر وعلاقاتهم وروابطهم، والقرآن الكريم والسنة النبوية لم تهمل هذا البعد والامتداد لهذا المعنى من معاني التوحيد ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ (النحل: 90) «١٦: ۹۰» ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8) «٨:٥» ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2) «٢:٥».
والتوحيد كما يعني المساواة والإخاء والعدل في حياة الإنسان، فإنه يعني تحريم الظلم والبغي والإسراف على كافة ألوانه، والشرك بالله هو الظلم الأكبر لأنه يصرف الإنسان عن الحقيقة ومصدرها من الكون، ويكل حق الألوهية إلى غير صاحبها، فتجري خلافة الإنسان في الأرض والخلائق، لا وفق الحق بل وفق الهوى وما تسوله الحياة والكون والإنسان وتنحرف عن غايتها، النفوس بجهلها وجهالتها، فيفسد بمقياس الحق والحقيقة أمر الحياة والكون والإنسان وتنحرف عن غايتها، ويزول عنها شرف الأمانة وقصد الغاية، ولا بد من أن ينتهي بها الظلم الأكبر إلى ما دونه من ألوان الظلم والإسراف والفساد.
يقول الله في القرآن الكريم على لسان لقمان عليه السلام: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: 13) «۳۱: ۱۳» ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ﴾ (النساء: 116) «٤:٤٨»، ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الحج: 25) «٢٢: ٢٥»، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ (النساء: 168) «٤: ١٦٨»، ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾ (الكهف: 59) «٥٩:١٨» ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الروم: 29) «۳۰: ۳۹»، ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: 27) «٢٥ : ٢٧» و﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (طه: 43) ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ﴾ (طه: 49) «۲۰: ٤٣-٧٩» ﴿وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (الأنفال: 54) «٨ : ٤٥»، ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ (هود: 112) «۱۱: ۱۱۲»، و﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (الأعراف: 33) «۷: ۳۳» ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْض﴾ (القصص: 77) «۲۸: ۷۷» وهكذا كان من الواضح أن الغاية من طرح القرآن لقضية التوحيد ومعانيه وأبعاده هي الأخذ بيد البشر إلى الحق والحقيقة وصرفهم عن الظلم والبغي والفساد والإسراف في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية فأوضح بذلك معالم الصراط الرباني الحق في حياة الفرد والجماعة أن الإنسان يحمل مسئولية الخلافة في الأرض بتمثل معاني التوحيد في الحياة.
ففي ميدان الاجتماع والأخلاق أكد الإسلام أمر ومسئولية الجماعة وحقوقها، ورد إلى كل ذي حق حقه وكرامته الإنسانية وأمر بالبر والإحسان والتزكية والإيثار والرحمة، وحرم الزنا وما يستتبعه من ألوان ظلم النفس وظلم المرأة والطفل وما يستتبع ذلك من تحطيم سياج نعمة الأسرة في القلوب والنفوس كما حرم كل ما يؤدي إلى الزنا والفاحشة وجعله كالقتل وكالخمر «الذي يذهب العقل ويميت الضمير ويضيع المسئولية» من كبائر الإثم والظلم والبغي والفساد ويجلب غضب الخالق ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (الأنعام: 151-152-153) «١٥١:٦-١٥٢» ﴿لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ﴾ (الإسراء: 22-23) ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ (الإسراء: 26) ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 28-29-30-31-32-33-34-35-36) «۱۷: ۲۲- ۳۹».
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: 90) «٥ : ٩٠» و﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سورة الأحزاب: 35) «۳۳: 35» و﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 71) «۹: ۷۱» و﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ (النساء: 32) ٤: ٣٢.
ويقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما جاء في رواية مسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن ستر مسلمًا ستره الله القيامة ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».
وقصد الحق والحقيقة لذاتها، ولذلك فالتوحيد في الاجتماع مسئولية وعدل وتكافل، وفي الأخلاق النقاء والطهارة عن كل ما يفسد ويضر ويجر إلى ظلم، وهو تعبير وحماية لقيم الإسلام ونظامه في ميدان السياسة والاجتماع والاقتصاد.
والتوحيد في الاقتصاد «وهو أمر يحتاج اليوم إلى وعي خاص وفهم دقيق لما يحتل من اهتمام الناس في هذا العصر، ولما طرأ من تغير في مصادر الثروة ووسائل إنتاجها» يعني المشاركة التعاون والتكامل بما يحول دون ظلم وضع اليد الجائرة على مصادر الثروة وموارد الإنتاج، بما يقود إلى التباين الفاحش بين الناس والتحكم الظالم في معاشهم وقدراتهم، وذلك صونًا لقيم العدل والإخاء وكفالة لحق الضعفاء والمحرومين في الجماعة.
إن التوحيد في الاقتصاد يعني أن الناس سواسية في أصل الحق على مصادر الثروة الطبيعية، والظروف العامة في الأرض لمجتمع وأن كل فرد قادر يجب أن يحصل على نصيب كامل عادل من مصادر الثروة يضع فيه عمله ويكسب منه رزقه بحسب حال موارد الأمة وأن يحفظ في إنتاج القادرين حقوق الضعفاء والمحرومين في موارد الثروة وفي ما يكتسبه المالكون والعاملون بسبب تلك الثروات، ومن التطبيقات التي أملتها روح الإسلام في مجال العلاقة الاقتصادية الإسلامية مثال المؤاخاة التي أقامها الرسول- عليه الصلاة والسلام- بين المهاجرين والأنصار في المدينة، ومن ذلك أيضًا نظام الخراج الذي أرساه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- حين حجز أرض الشام والعراق ومصر عن أن توزع بين جنود جيش الفتح وأبقاها في أيدي العاملين فيها وألزمهم بالخراج إلى بيت المال لينال كل الناس نصيبهم من ثروة تلك الأرض.