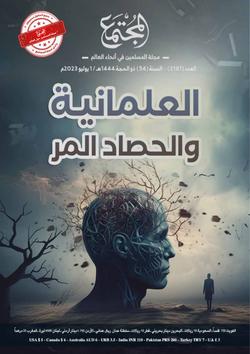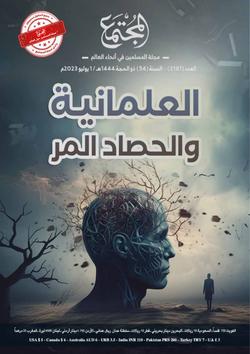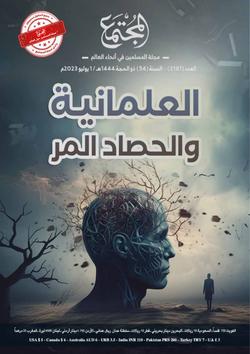العنوان دور الفكر في عملية التغيير (1 من 2)
الكاتب د. جاسم المهلهل آل ياسين
تاريخ النشر الثلاثاء 03-ديسمبر-1996
مشاهدات 22
نشر في العدد 1228
نشر في الصفحة 66
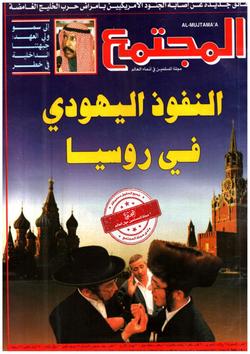
الثلاثاء 03-ديسمبر-1996
نقوش على جدار الدعوة
التغيير مطلب منشود لا يقتصر على المجتمعات والشعوب، بل يتعداها إلى كافة أشكال المؤسسات الاجتماعية والإدارية، وحتى الحياة الفردية الخاصة.
والتغيير سنة حياتية وضرورة إنسانية إذ لا يمكن أن يبقى الناس رهينة وضعية معينة لا تتحرك ولا تتطور سلبًا أو إيجابًا، والتغيير يصل بلا ريب إلى كافة جوانب الحياة «الإنسان نفسه وفكره وسلوكه، والبيئة المحيطة المتفاعلة مع هذا الإنسان»، والقرآن الكريم بين لنا أن عملية التغيير هذه مرتبطة بالإنسان وفكره وإرادته وسلوكه، قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ﴾(الأنفال: 53)، فالإنسان يملك أن يستبقي نعمة الله عليه، ويملك أن يزاد عليها إذا هو عرف فشكر، فكما يملك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر، وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه (1)، إذن فالتغيير في معتقدنا - نحن أمة الإسلام - متعلق تمامًا بمدى ارتباطنا وقربنا من الله تعالى ارتباط النفوس والأفكار ببارئها وفق منهجية فكرية إسلامية قوامها الإيمان العميق بالله، والالتزام بأوامره والامتناع عن نواهيه، والتصور المشترك للحياة والكون، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بأنفسهم﴾ (الرعد: 1،1).
فعندما يستبدل الناس أحوالهم القبيحة بأحوالهم الجميلة يزيل الله عنهم نعمته ويسلبهم إياها، وعندما يسلكون طريق الاستقامة ومنهج التغيير من الجاهلية إلى الإسلام بيسر الله تعالى لهم ذلك وفق أساليب ورؤى متعددة «تغيير فكري، تغيير اقتصادي، تغيير اجتماعي... إلخ»، وقد شهد التاريخ وشهدت الأمم التنوع في أشكال التغيير، فمنهم من كان مدخله لتغيير الجانب الاقتصادي، وآخرون دخلوا المدخل السياسي، وما إلى ذلك من مداخل اجتماعية وعسكرية وتربوية.. إلا أن الفكر بلا ريب كان المهيئ والفاعل الأول في كافة عمليات التغيير، فهو بوابة المعرفة ومختبر التصور والمحرك للعمل، والفكر عند الفلاسفة «هو إعمال العقل في الأشياء للوصول إلى معرفتها، وهو مرادف للنظر العقلي والتأمل ومقابل للحواس، والفكر حركة وانتقال، والأولى أن يشترك في معنى الفكر القصد، والفكر هو حركة النفس في المعقولات وفيه القصد، لأن حركة النفس في المعقولات بلا اختيار كما في المنام لا تسمى فكرًا». (2)
والفكر هو مطلوب من الناس إعماله لكي يسلكوا جادة الصواب قال تعالى:﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (البقرة: 219)، ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا﴾(آل عمران: 191)، إلا أن علاقة المسلمين بالأفكار ليست كسواهم من الأمم، ذلك لأنها مرتبطة بمنهج فكري ومنظومة فكرية لها ثوابتها ومبادئها ومنطلقاتها تغترف من الإسلام لتبدع من خلاله، من هنا نستطيع القول إن أي نتاج فكري لا أصل له يبقى رابطه ضعيفًا وغير ذي جدوى، ويشهد على ذلك واقعنا العربي والإسلامي، حيث إنه ومنذ التغيير الفكري الذي سيطر على الأمة لغير صالح الإسلام لم يزد الأمة إلا انحناءً وتخلفا، وقد عالج المفكر الإسلامي مالك بن نبي هذا المنحى في كتابه «مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي»، واضعًا اليد على أن مشكلة المفجر الملائم للبلاد الإسلامية «أي الطاقة التغييرية» يجب أن تجد حلًا بعيدًا عن النظريات المشتقة من «آدم سميث»، أحد أول من نظر للرأسمالية الليبرالية، وكارل ماركس، وفي ذلك دعوة للانبعاث الفكري من خلال منظومة فكرية ذات جذور إسلامية تتناغم مع ما تتوق إليه الأمة الإسلامية.
وقضية وجود منهج إسلامي واعتماده في عملية التغيير يشكل محور هذه العملية، ذلك أن الوحدة الفكرية بين أفراد الأمة تفضي إلى وحدة الرؤى والحلول في التنظيم الشامل للحياة، فإذا ما تفرقت بهم سبل النظر واختلفت مناهجهم فيه انتهى كل إلى رؤية مخالفة لرؤية الآخر في الآراء والأعمال معًا، وتلك هي الفرقة والشتات (3)، وهذا ما نلحظه بدقة في تاريخ المسلمين، ففي فترة البناء الأولى فترة الرسولﷺ ومن بعده خلفائه الراشدين تجلى المجتمع الوحدوي المتعاضد، ذلك أن مشاربهم كانت واحدة وكذلك مآربهم فكانوا متحدين تحت لواء واحد، يحكمهم منهج فكري لا بديل عنه ولا منازع يجد ما يستلب فيه، إلا أن الصراع والتفكك بدأ مع دخول الأفكار الغربية وتداولها بين الناس على حساب الاهتمام بالفكر الإسلامي، إن التغيير الأشد فتكًا الذي حدث في تاريخ المسلمين هو التغيير الفكري الذي بدأت معالمه مع قوة دولة الإسلام وتغلغل الفكر اليوناني والمترجمات من بلاد الفرس والهند التي عكست مناهج غيرت في تصور الناس للإسلام، واستمر التغيير الفكري يوجد الخلافات والنزاعات بين أبناء الأمة الإسلامية ويتجلى في أعنف صوره بعد انهيار الخلافة الإسلامية العثمانية، وما تلاها من سيادة المنهج الفكري الغربي المادي العلماني، الذي جعل من مؤسسات وأفراد الأمة ترسانات متقابلة متنافرة كل منها يدين بفكرة مناقضة للأخرى.
الهوامش
1 - سيد قطب في ظلال القرآن المجلد ٤ ص 37 ط7 1391هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 7.
2 - جميل صليبا، عضو مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982م.
٣-فتحي يكن، المتغيرات الدولية والدور الإسلامي المطلوب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1416هـ - 1995م، ص 84.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل