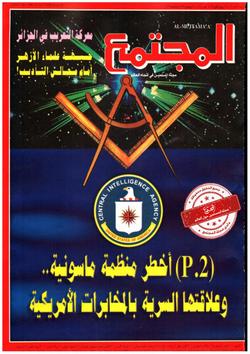العنوان المجتمع التربوي (1063)
الكاتب د.عبدالحميد البلالي
تاريخ النشر الثلاثاء 24-أغسطس-1993
مشاهدات 21
نشر في العدد 1063
نشر في الصفحة 46
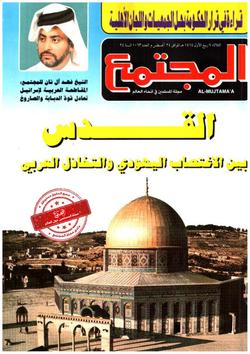
الثلاثاء 24-أغسطس-1993
وقفة تربوية
ذكاء داعية
هكذا دأب الدعاة الذين يعيشون هموم الدعوة في كل لحظة من لحظات حياتهم، ويحترقون على واقعهم، مما يجعلهم في هم دائم، وتفكير لا ينقطع بالوسائل الجديدة، لإنكار المنكر، وإيصال دعوة الله للناس. أعرف أحد الدعاة من هذا الصنف، كان يعمل موظفًا في إحدى المؤسسات الحكومية. وقد ابتلاه الله بزملاء في قسمه لا يعرفون سوى سقط الكلام وبذيء العبارة، والفحش من الحديث. وكان صاحبنا هذا خطيبًا ففكر في طريقة ينكر عليهم ما هم فيه، فهداه الله إلى فكرة ذكية، وهي استشارتهم بالمواضيع التي يمكن أن يتناولها في خطبته، وإذا به يتفاجأ بتفاعلهم مع هذه الفكرة، وكل منهم يشخص له الواقع الأليم.
وما يحدث من مناكر يرونها بأعينهم ويسمعونها من شركائهم. يقول ذلك الداعية: لقد كسبت في هذه الطريقة أمرين: الأول إنهم أعطوني من المعلومات ما لا أستطيع الحصول عليه بمجهوداتي الفردية. ويسبب صعوبة ولوج من هو مثلى في تلك الأماكن المشبوهة.
الثاني: إنهم لم يعودوا يتحدثون بهذه الأمور بعدما شخصوها لي بالتفصيل.
ولا شك أن هناك أمرًا ثالثًا حصل عليه صاحبنا، وهو إشعارهم بالثقة وبالمسؤولية تجاه هذه الأمور.
ورابعًا: كسره للحاجز النفسي بينه وبينهم وإمكانية مصارحته بقضاياهم الشخصية. وهكذا يجب أن يكون الدعاة، يبحثون في كل طريقة مشروعة للوصول إلى غاياتهم.
آلام قلم وكلمات أمل
المعاناة العاشرة
معاناة من رفق الطريق
بقلم: الشيخ جاسم مهلهل آل ياسين
أخي أرأيت ما في البوسنة التي اقتطع من أراضيها أكثر من ٨٠% وهجر من أبنائها مئات الألوف؟ أرأيت ما يحدث في كشمير؟ وتايلاند وبورما والفلبين؟ أرأيت ما يحدث في آسيا الوسطى «جنوب الاتحاد السوفيتي سابقًا» من قتل وسحق وتهجير للمسلمين وأظن أنه لا يخفى عليك من قبل ذلك نبأ المسجد الأقصى وفلسطين إنها مواجع وأحزان جاشت في الفؤاد حينًا فظهر بعضها على هذا القلم، لعل في البوح بها تخفيفًا عن صاحبها ودعوة إليك يا أخي لأن تعاون في حلها وتعمل على زوالها وما ذلك على الله بعزيز.
هدف واحد
الحركات العاملة للإسلام متعددة، وكلها تهدف لرفع راية التوحيد، وتحكيم شريعة الله وتحقيق المجتمع الذي تظله العدالة، وتشيع فيه الحرية، ويأمن الإنسان فيه على نفسه وماله وعرضه فلا يُعتدى عليه بغير حق، ولا يُرد رأيه بغير حجة، ولا يشكك في نيته ما دام مظهره ملتزمًا بالإسلام.
وهذا هدف نبيل يسعى إليه كل مسلم عرف الإسلام واتبع منهج رسول الأنام، لأنه يتبع الحق ولا يتبع الهوى، ويتمسك بالقرآن والصراط المستقيم ولا يبغى عوجًا عن الطريق، ولا انحرافًا في السلوك.
ولن يتم للعاملين في الحركات الإسلامية تحقيق هذه الغايات إلا إذا ارتفعوا بأنفسهم عن البحث عن سقطات الآخرين والتشهير بها إن وجدت أو البحث عنها ومحاولة إيجادها أو الإيهام بوجودها إن لم تكن موجودة فعلًا، لأن هذا يعوق المسير ويجعل الدعاة العاملين ينظرون لأنفسهم ولا ينظرون -أحيانًا إلى غاياتهم، فيتعطلون وقد يتوقفون، وفي هذا إضاعة للجهود، وبعثرة للقوى وتفريط في عضد يؤيد. وساعد يساند.
النصيحة دين نعبد الله فيه
ولسنا نود أن يظل الخطأ سائدًا، والعيب شائعًا، فذلك ما لا يرضاه إنسان سمع قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه «رحم الله امرءًا أهدى إلى عيوبي» ولكن النصيحة لها أصولها، ورد الناس إليها مرهون بتلك الأصول المرعية التي إن خرجت عنها صارت فضيحة لا نصيحة.
فما بالك بالباحثين عن الأخطاء والمنقبين عن قلوب الناس ونواياهم وأنهم كانوا يريدون في الموضع كذا، وفي ذاك الموضع كذا، وتبدأ الكتابات التي تشوه صورة هذا الداعية أو ذاك. وقد يحمل هذا التشويه في ثناياه كلمات هي إلى السب والطعن والتجريح أقرب منها إلى التصويب والتوضيح، مما يجعل التلاقي بين العاملين في الحركات الإسلامية صعبًا والتوحد بينهم بعيدًا، إذ إن أصحاب هذا الاتجاه يصابون بموت القلب لأنهم ينتقصون إخوانهم، وقد يسخرون منهم، فيثيرون بذلك حفيظتهم، فأنى يلتقون؟ وكيف يجتمعون؟ ولقد قال ابن ناصر في الرد الوافر كلمة حق ننقلها لما لها من أثر جدير بالاعتبار قال «لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالثلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، ومن مات قلبه، وخمدت شعلة الإيمان في فؤاده ماذا ينتظر منه؟
حب الخير للجميع منهج المخلصين
ونحن نضرع إلى الله ألا يميت قلوبنا أو قلوب أحد من إخواننا المسلمين، وندعو أنفسنا وإخواننا لأن نجد في طريق الدين، وأن نسعى نحو الهدف الكريم هدف إقامة شرع الله في الأرض، وألا نبذر بذور الفرقة، أو نبعثر أشواك الاتهامات هنا أو هناك فذلك يبعدنا عن الطريق.
ندعو أنفسنا وإخواننا لأن نكل الحكم على النيات لمن يعلم السر وأخفى، وأن نحسن الظن بالعاملين، وأن نقيل عثراتهم ونلتمس لهم أعذارًا لما قد يكون منهم من أخطاء لم يتعمدوها، ولربما كانت منهم اجتهادًا وأخطأوا فيه ولم يصيبوا.
ندعو أنفسنا وإخواننا لأن يكون حالنا متمثلًا هذا القول:
وكلمة حاسد من غير جرم
سمعت، فقلت: مرى فأنقذيني
وعابوها على ولم تعبني
ولم يعرق لها يومًا جبيني
وما من شیمتي شتم ابن عمي
ولا أنا مخلف من يرتجيني
بصرت بعيبه فكففت عنه
محافظة على حسبي وديني
على طريق سلف الأمة نسير
ولنا في السلف الصالح أسوة حسنة في ذلك، فقد كانوا يرعون حرمة العلماء والدعاة إلى الله أحياءً وأمواتًا، وهذا يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من مائتي سنة.
ومن هنا وجب علينا -نحن المسلمين عامة والعاملين في الحركات الإسلامية خاصة- أن نغفر لمن أساء إلينا، ولا نشفى منه غيظنا، بل إن إسداء النصح بالطريقة الشرعية المقبولة خير لنا جميعًا، إذ نبدد به ظلمة الفرقة، قال ابن عباس: ما رأيت رجلًا أوليته معروفًا إلا أضاء ما بيني وبينه، ولا رأيت رجلًا أوليته سوءًا إلا أظلم ما بيني وبينه.
ولقد عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي، فوجد عنده أباه عليًا، فقال: ما جاء بك إلينا؟ ما يولجك عليك؟ قلت: ما إياك أتيت، ولكن أتيت ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوده، قال علي: أما إنه لا يمنعني غضبي عليك أن أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من عاد مريضًا لم يزلْ يخوضُ في الرحمةِ حتى يجلسَ فإذا جلس اغتمس فيها.» (أحمد:14260) تلك آثار الصالحين تدلنا عليهم وتجذبنا إليهم، وتجعلهم لنا خير قدوة في هذا المجال، فلتكن لنا آثارنا في التسامح والعفو والصفح؛ حتى ننال رضوان الله، ونكون من السائرين على درب الصالحين.
يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لا يحل لأمرئ مسلم يسمع الكلمة من أخيه المسلم أو عن أخيه المسلم أن يظن بها سوءًا وهو يجد لها في الخير محملًا»
يا دعاة الخير انظروا بنفس صافية وعين راضية
ما دامت الكلمة تحمل طوايا الخير في ثناياها، فلماذا نسئ بصاحبها الظن، ونحملها على غير ما ينبغي؟
فلا يفعل ذلك إلا كل من لم تخلص نيته، ولم تصف سريرته، إنه هو المنقب عما تحمل الكلمات من إساءات يبذرها في طريق المسلمين، ليسئ بها إليهم لأنه -بذلك- يرضي نفسه التي لم تعرف غير السخط والضيق، ولو أنها عرفت الرضا، لعرفت معه حق الأخوة، ولعرفت معه أن المتأول لا ينبغي أن يعاب أو يذم، بل الأولى به -إن أخطأ- وأن ينصح وأن نبين له الطريق.
وتلك هي العلة إنها عين السخط التي لا ترى من الدنيا نصفها المضيء، ولا ترى من الكوب نصفها المليء، وفي ضوء رؤيتها القاصرة تنساق إلى الجدل، واللجاجة فتقع في المحظور الشرعي الذي تجذبه العلماء، وجعلوا بينهم وبينه سدًا حاجزًا، وبونًا بعيدًا، وهذا هو الحسن البصري وقد قيل له: نجادلك؟ فقال: لست في شك من ديني. وقال العباس بن غالب الوراق سألت إمامنا أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله: أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، أرد عليه؟ فقال: لا تنصب نفسك لهذا أخبره بالسنة ولا تخاصم، فأعدت عليه القول: فقال: ما أراك إلا مخاصمًا.
أخي الداعية أسباب القطيعة شر فاحذرها
إن أسباب الوقوع في المخاصمة كثيرة، لأن المسائل منها ما هو قطعي لا مجال للمخاصمة فيه، والكثير من المسائل ظنية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، فقد تكون المسألة عند رجل قطعية، لظهور الدليل القاطع كمن سمع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده، وعند آخر ظنية لعدم بلوغه النص، أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من دلالته.
وبناء على ما تقدم فما ينبغي لأحد أن يتهم آخر بغير دليل طالما توفر حسن النية وخيرية المقصد، وفي هذا ترك للمجادلة والمخاصمة، يدفع بالناس إلى التعاون فيما بينهم مما هو مشترك عام والأعذار فيما يرون فيه خلافًا مع غيرهم فالحق مطلب الجميع، وإننا لنأخذ الحق من كل من تكلم به وأظهره كما قال الإمام ابن تيمية: «ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به»
والعارفون بالحق يعرفون أصحابه، وأما الذين يعرفون الرجال فلربما غفلوا عن الحق ما لم يرد على ألسنة رجالهم وأقلام كتابهم، ومن ثم فقد يجادلون وقد يخاصمون وهم عن الحق بعيدون، وعن جادة الطريق حائرون.
ميزان العدل آية الدعاة فاستعملوه
إن الله سبحانه يحاسب الناس على أعمالهم خيرها وشرها، فمن ثقل خيره فله الثواب، ومن ثقل شره فعليه العقاب، ولكن بعض الناس لا يرى غير الخطأ ويعجز عن رؤية الصواب، ويظل خطأ الآخرين في نظره يتضخم ويقوى، ويشتد حتى يظهر في الصورة أمام الناظرين وحده، فيظهر صاحبه فردًا أو جماعة وكأنه مجموعة من الأخطاء ليس غير، وهذا ظلم بين، فلو عاملنا الناس بميزان العدل لنظرنا إلى حسناتهم وسيئاتهم، وحكمنا بالغالب عليهم فإن كثرت الحسنات قبلنا منهم الصحيح، وعذرناهم فيما وقعوا فيه من سيئات ونصحناهم بتركها، وإن كانت الأخرى نصحنا وبينا الحق بالدليل والبرهان من غير سب ولا إيذاء ولا اعتساف، أخذين بقول الشاعر:
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد
جاءت محاسنه بألف شفیع
وليس على الناس ملام إن عملوا وجدوا واجتهدوا ثم لم تثمر جهودهم شيئًا مذكورًا، فإن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد استجاب له.
وعلىّ أن أسعى وليس علىّ إدراك النجاح، فالنجاح أو النصر مقدر بقدر الله يؤتيه الله من يشاء من عباده، ولكن الذي على العباد أن يأخذوا بالأسباب كلها، وأن يخلصوا لله أعمالهم، وألا يتركوا شيئًا أمروا به إلا وفعلوه، ثم يكون بعد ذلك كله النصر أو غيره بحسب مشيئة الله التي لا يعلمها الناس، وإنما هم يعلمون أن عليهم البذل والتضحية والعمل المستمر مع الإخلاص، وتبقى نتيجة كل ذلك عند الله سبحانه قد يثيبهم عليه في الدنيا والآخرة، وقد يدخر لهم الثواب في الآخرة وحدها.
والإنصاف يتطلب منا أن نحسن الحكم على الناس إن أحسنوا، ولا نسئ الحكم عليهم إن هم أساءوا غير عامدين، فقد يكونون مجتهدين أخطأوا الطريق، وقد تكون لهم رؤية صحيحة جديدة، يراها الناس على غير ما ألفوا وعلى غير ما عرفوا فيظنون أنها مخطئة، وهي مصيبة ويرتبون على ذلك أمورًا وظنونًا تتهم صاحبها فلا يكون غير الجدال والخصام والقطيعة.
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة
بين الأنام وإن كانوا ذوي رحم
ونحن في هذا ندعو أنفسنا وإخواننا لحسن الظن، ونفي التهم والبعد عن الجدال واللجاجة والخصومة، والأخذ بعين الإنصاف، ففي ذلك تتلاقى الجهود وتتوحد الاتجاهات، وتقوى الأمة، وتأخذ في طريق إظهار الدين الإسلامي على الدين كله ولو كره المشركون.
من عوامل الارتقاء بالنفس (2 من 2)
بقلم: ناجي الخرس
التشوق إلى الجنة والعمل لها:
قال رجاء بن حيوة: أمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثوبًا بستة دراهم فأتيته به فجسه وقال: هو على ما أحب لولا فيه لينًا
قال: فبكيت
وقال: فما يبكيك؟
قال: أتيتك وأنت أمير بثوب بستمائة درهم، فجسسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه خشونة، وأتيتك وأنت أمير المؤمنين بثوب بستة دراهم فجسسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه لينًا،
فقال: يا رجاء، إن لي نفسًا تواقة، تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن أدركها، إن شاء الله عز وجل[1].
فمجد العلا ما ناله غير ماجد
يخاطر بالروح الخطير فيظفر
إذا ذكرت جنات عدن وأهلها
يذوب اشتياقًا فانحوها ويشمر
العامل الأول «تجديد النية»
الله غايتنا
وانطلاقًا من صحة المقصد كان لا بد للداعية من استحضار النية وتجديدها، والسعي إلى تخليصها من الشوائب المكدرة من طلب علو أو جاه أو الاستزادة من مكسب أو ثناء والتذكر دائمًا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
« إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرتُهُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ فَهجرتُهُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ ومن كانت هجرتُهُ إلى دنيا يصيبُها أو امرأةٍ ينْكحُها فَهجرتُهُ إلى ما هاجرَ إليْهِ »(البخاري:54) حديث متفق عليه
إذ إن النية التفريق بين عمل المؤمن المقبول وغير المقبول، والنية فيصل بين العادات والعبادات، كما أنها تميز الفرض عن المندوب، وصلاح الأعمال لا تكون إلا بخلاص النيات، وقد جاءت الأخبار المستفيضة أن قبول الأعمال بصوابها وإخلاصها وهما مقتضي شهادة التوحيد، فالإخلاص أن يكون العمل لله وحده، والصواب أن يكون وفق شرعه الذي شرعه للناس.
وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث، وليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث»
واتفق بعض العلماء على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال: ربعه، وقال بعضهم: يدخل في ثلاثين بابًا، وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابًا.
ولأن حديث النية يحدد ركن العمل الأساسي وهو الإخلاص؛ لذلك كان التذكير به لكل مؤمن لا بد منه وعلى الداعية أن يكون أشد تذكرًا واستحضارًا لهذا الحديث وأن تعلم أن: «النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالًا أو مالًا، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو العمل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل[2]».
ذكر الغزالي عن أحد الذين كانوا يعنون بفعل الخير أنه كان يطوف على العلماء يقول:« من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملًا لله تعالى، فإني لا أحب أن يأتي عليّ ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله، فقيل له: قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما استطعت ،فإذا فزت أو تركته فهم بعمله فإن الهام بعمله كعامله»[3]
يقول عبد الله أبو جمرة الأندلسي رحمه الله: «وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك».
قال الثوري رحمه الله «كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل».
قال بعض العلماء «اطلب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي الخير فأنت بخير»
تنقية النية من الشوائب
الداعي إلى الرياء عظيم وكبير؛ وذلك بسبب أن النفس مجبولة على حب الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله وقد أحسن الشاعر حيث قال
يهوى الثناء مبرز ومقصر
حب الثناء طبيعة الإنسان
يقول المحاسبي رحمه الله: «وهو يقرر أن النفس الإنسانية تطلب لذتها دائمًا، وأن شهوة النفس خفيفة كامنة كمون النار في العود، فإذا منع المسلم نفسه شهوتها بإلزامها بالعبادة والطاعة حاولت أن تجد لذتها بسبيل آخر وهو التزين بالطاعة لتنال حمد الناس».
· عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قالَ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: أنا أغْنَى الشُّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَن عَمِلَ عَمَلًا أشْرَكَ فيه مَعِي غيرِي، تَرَكْتُهُ وشِرْكَهُ» (رواه مسلم:2985)
· عن أبي سعيد الخدري قال خرج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ونحنُ نتذاكرُ المسيحَ الدجالَ فقال: « ألَا أُخبركم بما هو أخوفُ عليكم عندي من المسيحِ الدجالِ قال قلنا بلى فقال الشركُ الخفيُّ أن يقومَ الرجلُ يُصلي فيُزيِّنُ صلاتَه لما يرى من نظرِ رجلٍ »(ابن ماجه:3408) قال محقق المشكاة :حديث حسن.
· روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللهَ تعالى لَا ينظرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأمْوالِكُمْ ، ولكنْ إِنَّما ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم »
يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله
لو أراد أحدنا أن يحصي ما يستطيع تحقيقه من الإرادات التي تثور في قلبه، لوجد أن الذي يتحقق منها نسبة ضئيلة بجانب ما لا يستطيع تحقيقه.
ولا نريد بالنيات التي تدخل في الإحصاء تلك الخواطر العابرة وأحاديث النفس المارة، بل نريد تلك النيات التي بلغت مرتبة العزم والتصميم.
والسبب في قلة الإرادة التي نستطيع تحقيقها: أن الأعمال التي نروم تحقيقها لا تتوقف على مجرد إرادتنا لها، فهناك حوائل ذاتية وخارجية تمنعنا من تحقيق ما نعزم على فعله، فالأجساد قد تضعف عن تحقيق المراد بسبب عظم المراد كما قال الشاعر
وإذا كانت النفوس كبارًا
تعبت في مرادها الأجسام
وقد يمنع المرء من تحقيق مراده مرض مسهد أو هرم مقعد أو فقر مجهد أو عدو قاطع للطريق أو ظالم يحبسه في داره.
هذه الموانع والحوائل الذاتية والخارجية التي تمنعنا من كثير من الأفعال الخيرة التي تقربنا إلى ربنا، وترفع منزلتنا عنده لا تمنع النية من التحقق والوجود، إذ النية طليقة من القيود التي تكبل الأجساد.
النية عمل القلب والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه
إن يسلب القوم العدا ملـکي وتسلمني الجموع
فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع
فمهما ضعفت الأجساد ومهما اشتد ظلم الظالمين، فقلب الإنسان يبقى حرًا طليقًا يتوجه إلى الله في السراء والضراء راغبًا راهبًا يريده بالخير ويقصده بالطاعة [4](1)
العامل الثاني «المبادرة الذاتية»
المبادرة بفعل الخير قبل وجود الموانع: ومن ظواهر قوة الإرادة المبادرة بفعل الخير قبل وجود الموانع، وهذا ما أرشد إليه الإسلام
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
« بادِروا بالأعمالِ سبعًا : هل تنظرون إلَّا فقرًا مُنسِيًا ، أو غنًى مُطغِيًا ، أو مرضًا مُفسِدًا ، أو هِرَمًا مُفنِّدًا أو موتًا مُجهِزًا ، أو الدَّجَّالَ ، فشرٌّ غائبٌ يُنتَظرُ ، أو السَّاعةُ فالسَّاعةُ أدهَى وأمرُّ ».(الترمذي:2306) «رواه الترمذي بإسناد حسن»
لأن هذه السبع التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمبادرتها بالعمل فهي مجموعة أعراض في حياة الإنسان صارفه له عن العمل أو مقعدة له عنه أو قاطعة له عنه قطعًا كليًا.
ليس في كل ساعة وأوان
تتهيأ صنائع الإحسان
فإذا أمكنت فبادر إليها
حذرًا من تعذر الإحسان
ذاتية أبا عقيل الأنصاري
في معركة اليمامة وفي بدايتها أصيب أبا عقيل الأنصاري بسهم على كتفه الأيسر، فأصيب بالشلل، فأخذ إلى مكان بعيد عن ساحة المعركة حتى يُعالج، وكان ذلك في أول النهار، فلما انتصف النهار كانت الغلبة لصالح الأعداء، عندها صاح مناد الأنصار فقال للأنصار: حتى يجتمع الأنصار في مكان واحد وتحت راية واحدة؛ وذلك لزيادة الحماسة وتقوية الروح المعنوية عندهم، كان ممن سمع هذا النداء أبا عقیل رضي الله عنه، فأراد أن يقوم من مكانه، فرأه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: إنه لا ينادي الجرحى، فقال أبا عقيل: كأن المنادي نوه باسمي لأنني من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوًا.
نعم أخي الحبيب إن المؤمن تكفيه الإشارة وغيره لا تكفيه حتى العبارة.
العامل الثالث «الاستمرار في العطاء».
الاستمرار في الخير مطلب شرعي قرآني قال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: ٩٩).
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدْومُها و إن قَلّ »(البخاري:6465)
وليس من أمر يحفظ المسلم من الانزلاق كالعمل الصالح، فهو نمو للمسلم وحصن له من العادات الجاهلية؛ لذلك نرى أن الأعمش بقي قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى، والاستمرار طريق العز والانتاج، وهو عنوان الجد والمثابرة والبعد عن الإسفاف والمهاترة.
قال ابن المديني: قيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب» وهذا سمة المجدين، وقد وصف أبو جعفر أحمد بن عبد الله المهدي القيرواني بقولهم: كان في الدراسة والمطالعة آية، لا يكاد يسقط الكتاب من يده حتى عند طعامه»[5] (۲)، وسئل أحد العلماء إلى متى تطلب العلم؟، قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تكتب بعد.
صدقة الاختيار لا صدقة الاضطرار
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الفَقْرَ، وتَأْمُلُ الغِنَى، ولَا تُمْهِلُ حتَّى إذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، ولِفُلَانٍ كَذَا وقدْ كانَ لِفُلَانٍ.» (البخاري:1419)
وفي هذا الحديث من التربية الخلقية أمران:
الأول: يوجه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة خلق حب العطاء لا سيما العطاء الذي يكون محله، والذي يبتغي به وجه الله تعالى وهو عطاء الصدقة، ولا سيما أيضًا العطاء الذي يكون الإنسان معه شديد الحرص على ما يملك واسع الأمل بالحياة غير مرتقب الموت وغير يائس من طول البقاء، وطول الأمل يكون عادة في حالة الصحة والقوة، ومع طول الأمل يزداد الطمع بالدنيا والحرص على أموالها ومتاعها.
الثاني: يوجه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لخلق قوة الإرادة وخلق علو الهمة اللذين ينشأ عنهما الحزم والعزم والمبادرة إلى فعل الخير دون تهاون أو إهمال أو توانٍ أو تقصير، فكثير من الناس يريد الخير ولكن ينقصه الحزم والعزم، وتتقاصر همته عن التنفيذ، فيصاب بداء التهاون والإهمال والتواني والكسل والتسويف في الأمور حتى يضيع عمره كله، وعندئذ يجد نفسه أمام أجله المحتوم وليس في صحيفة أعماله ما يعطيه ثمرة نافعة، وليس في مزرعة حياته إلا فقر مغبر أو نبات غير مثمر، فإذا أراد أن يتدارك ما فات لم يسعفه الوقت بأن يغنم ما يطمع فيه، وعندئذ لا يجد أمامه إلا الوصية يوصى بها، فيوصي لفلان بكذا من تركته، ولفلان بكذا مع أن تركته صائرة حتمًا إلى غيره، فهو بعطائه هذا إنما يعطي من مال غيره لا من مال له فيه مطمع لنفسه، ولذلك لم يأذن الله له أن يتصرف إلا في حدود ثلث ما له، وهذه صدقة تصدق الله بها عليه، إذ أذن له أن يوصي بثلث ما له لغير الوارثين، أما الوارث فلا وصية له كما ثبت في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم [6](۳)
العامل الرابع: التوبة بعد الطاعة «استئناف التوبة»
«فاعلم الآن: أن التوبة نهاية كل عارف وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهي نهاية والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، بل هي في النهاية في محل الضرورة.
فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في آخر الأمر عند النهاية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أشد ما كان استغفارًا وأكثره، قال الله تعالى: ﴿ لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة / ۱۱۷) وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه. فجعل الله سبحانه «التوبة عليهم» شكرانًا لما تقدم من تلك الأعمال وذلك الجهاد، وقال تعالى في آخر ما أنزل على رسوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر: ١، ٢، ٣)
وفي الصحيح «أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة -بعد ما نزلت عليه هذه السورة- إلا قال فيها:
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»[7] (٤) وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا فهم منها علماء الصحابة - كعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم: أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله وآخر ما سمع من كلامه عند قدومه على ربه «اللهم اغفر لي، وألحقني بالرفيق الأعلى»[8] (٥) وكان يختم كل عمل صالح بالاستغفار كالصوم والصلاة والحج والجهاد، فإنه كان إذا فرغ منه وأشرف على المدينة قال «آيبون تائبون، لربنا حامدون»[9] (6) وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار وإن كان مجلس خير وطاعة، وشرع أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار فيقول عند النوم «استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه»[10] (۷)، وأن ينام على سيد الاستغفار»[11] (۸)
المراجع:
1) «وفيات الأعيان لابن خلكان 2/ 301»))
«فتح الباري: 1/ 13» (2)
إحياء علوم الدين 4/ 364» (3)
مقاصد المكلفين -د. عمر الأشقر ص ٤٤٠. (4)
5) ضوابط في العمل الإسلامي -ص ۷۹ –الشيخ جاسم مهلهل))
الجزء الثاني ٦٣٩ -عبد الرحمن حبنكة الأخلاق الإسلامية -ا (6)
- رواه البخاري ٤٩٦٧ (7)
رواه البخاري ٤٤٤٠ (8)
- رواه البخاري ۱۷۹۷ (9)
ضعیف رواه الترمذي ۳۳۹۹ (10)
تهذيب مدارج السالكين -الجزء الثاني ص ۱۰۲۲. (11)
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل