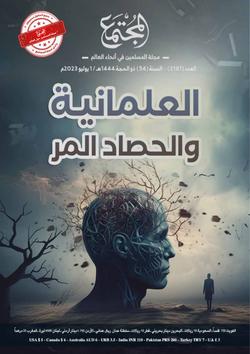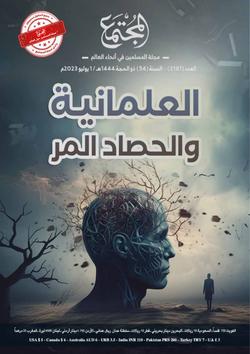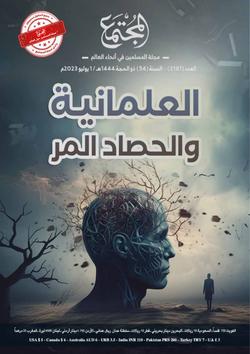العنوان شؤون دولية: 1282
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 30-ديسمبر-1997
مشاهدات 15
نشر في العدد 1282
نشر في الصفحة 40
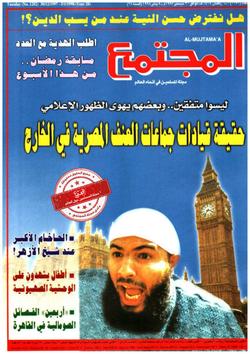
الثلاثاء 30-ديسمبر-1997
التنافس التركي- الإيراني في الشرق الأوسط
إيران وتركيا تسعيان على ٤ محاور لتعزيز قوتهما الإقليمية والدولية
كان من أهم التداعيات العميقة لحرب الخليج الثانية، انهيار النظام الإقليمي العربي وبدء الحديث عن طرح نظام بديل له، وكانت الفرصة حينها سانحة للتقدم بمشروع إطار جامع جديد يحقق هدفًا غربيًا بشكل عام، وأمريكيًا بشكل خاص، ألا وهو دمج إسرائيل في جسد المنطقة تحت مظلة جديدة، وكانت الشرق أوسطية هي البديل الجاهز المطروح، الذي يدخل المنطقة في إطار تعريف جغرافي اصطناعي، ينزع عنها سماتها الأساسية العربية والإسلامية، تلك السمات التي كانت تشكل فيما مضى الأطر التي ينضوي تحتها الإقليم والتي تلفظ بطبيعتها الكيان الصهيوني.
وحتى الآن لا يوجد تعريف محدد متفق عليه لهذا النظام المصطنع، فالبعض يقصر الشرق أوسطية على المنطقة العربية دون شمال إفريقيا أو منطقة الخليج، في حين يتسع المفهوم لدى البعض الآخر ليصل إلى الجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا، وفي كل الأحيان تبقى إسرائيل جزءًا رئيسيًا فيه.
وكان من ضمن نتائج حرب الخليج أيضًا تصاعد طموحات دول الجوار الجغرافي «تركيا- إيران» للعب أدوار إقليمية متزايدة على حساب العرب، وفي ظل اختلاف التوجهات والمنطلقات السياسية لكل منهما «ثورية إسلامية إيرانية وعلمانية تركية»، دخلا في تنافس إقليمي دار على عدة محاور هي:
- دور قيادي في العالم الإسلامي.
- النفوذ في شمال العراق.
- الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج.
- ملء الفراغ السياسي الناشئ في جمهوريات وسط آسيا الإسلامية.
دور قيادي في العالم الإسلامي:
يعتبر العالم العربي تركيا دولة مسلمة، عضوًا في منظمة المؤتمر الإسلامي وتربطها علاقات جمة مع كثير من الدول العربية، ولذا تعتقد تركيا أنها تمثل البديل الذي تفضله النخبة السياسية العربية. وذلك إذا اضطرت إلى موقف تختار فيه بين تركيا وإيران.
أما إيران فتعتقد بأنها تقدم النموذج الثوري لبعض الحركات السياسية الإسلامية في المنطقة العربية، ومع الاستمرار الإيراني في طرح شعار الإسلام بديلًا عن القومية وهو ذات الشعار المطروح من جانب الحركات الإسلامية في المنطقة العربية يستمر اتهامها بالتدخل في شؤون البلدان العربية إلا أن تطورين مهمين قد غيرا كثيرًا من هذه الحسابات هما:
1- التحالف العسكري الإسرائيلي- التركي والذي أدى إلى توتر علاقات العرب مع أنقرة بصورة غير مسبوقة، زاد منه الإطاحة برئيس الوزراء التركي ذي الاتجاهات الإسلامية الداعية إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية، نجم الدين أربكان؛ حيث وضح أن تركيا في اهتمامها بالشرق الأوسط وموقعها فيه بعد فترة طويلة من اهتمامها بسياساتها الأوروبية، لم تكن تقصد عودة تركيا الدولة الإسلامية الشرق أوسطية بكل ما يحمله ذلك من معنى ويحتاجه من تغييرات في السياسات والتوجهات، وإنما تركيا التي تسعى إلى استعادة دورها الذي تعرض للاهتزاز بعد انهيار الشيوعية في الاستراتيجية الأمريكية، بكافة الأساليب عبر مختلف الطرق.
٢ - نجاح خاتمي في الوصول للحكم في إيران، والذي أشاع جوًّا من الانفراج في علاقات بلاده مع دول الجوار العربية، وأعلن أن إيران لم تعد بحاجة إلى تصدير الثورة، وأدى تلازم ذلك مع التدهور في عملية التسوية، وعدم قدرة واشنطن على ممارسة الضغط الكافي على إسرائيل وتطورات التحالف العسكري بين تل أبيب وأنقرة كل ذلك أدى إلى التحسن في العلاقات العربية الإيرانية، وقد كان الحضور العربي الفاعل في قمة طهران الإسلامية هو أبلغ دليل على هذا الأمر.
الشمال العراقي:
لا شكّ أن هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية وتغير موازين القوى لصالح تركيا، هو الذي دفع إلى السياسة التركية الجديدة إزاء المشكلة الكردية، حيث وجد الرئيس التركي الراحل تورجوت أوزال في المتغيرات الجديدة فرصة لتصدير المشكلة الكردية خارج تركيا فطرح مشروعًا لحل مشكلة الأكراد أطلق عليه «خريطة أوزال لكونفيدرالية العراق بعد صدام»، وتضمنت الملامح الأساسية للمشروع ما يلي:
1- إقامة كونفيدرالية عراقية تتألف من ثلاث مناطق متساوية الحقوق عربية وتركية وكردية وتضم المنطقة الكردية محافظتي السليمانية، وأربيل بينما تتألف المنطقة التركية من محافظتي كركوك والموصل، وتتألف المنطقة العربية من باقي أجزاء العراق.
٢- أن تكون إيران وتركيا وسورية- وهي الدول المجاورة للعراق وبها أقلية كردية- ضامنة للكونفيدرالية المقترحة التي ستقوم على أساس نظام برلماني تمثل فيه المناطق الثلاث بصورة متساوية.
٣- اعتماد مشروع مالي لمساعدة العراق على إعادة بناء ما دمرته الحرب، وستعمل تركيا على حل مشكلة مياه الفرات مع سوريا والعراق، وتنفيذ مشروع السلام الذي دعت إليه منذ أعوام، والذي يتضمن مد أنابيب للمياه من نهري سيحان وجيحان إلى دول الخليج عبر العراق وسورية.
٤ - إلغاء ثلاث مواد في الدستور التركي تقيد حرية الرأي وهي المادتان ١٤١، ١٤٢ اللتان تحرمان الترويج للنزعات الانفصالية، والدعوة إلى الأفكار الشيوعية وتصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، والمادة ١٦٣ التي تحرم الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
غير أن مشروع أوزال لاقى معارضة قوية من سوريا وإيران اللتين رفضتا بشدة تقسيم العراق أو أية صيغة أخرى تصل إلى نفس النتيجة عمليًا. كما عارضه الأكراد في العراق وفي تركيا ذاتها.
وإزاء ذلك بدأت تركيا في تنفيذ عملياتها العسكرية في شمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يدعو إلى انفصال جنوب شرق تركيا.
وقد وضح أن تركيا تسعى لإقامة منطقة أمنية في شمال العراق كما فعلت إسرائيل في جنوب لبنان، تحقيقًا للأطماع التركية القديمة في ضم جزء من أراضي العراق وخاصة منطقة الموصل وكركوك البتروليتين، وإحياء أحقية تركيا في تعديل خريطة الحدود وفقًا لاتفاقية لوزان التي وقعت عام ١٩٢٤م؛ حيث أعلن أكثر من مسؤول تركي خلال السنوات الأخيرة عن التطلع لإعادة ولاية الموصل إلى تركيا للاستحواذ على نفطها وخيراتها، وتصفية النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة الكردية العراقية؛ حيث تدعم إيران حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
أما بالنسبة لإيران فقد رفضت المشروع التركي الخاص بإقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق، وذلك يرجع للتخوف الإيراني من تطور الإدارة الكردية إلى حكم ذاتي كامل يكون دافعًا لأكراد إيران للاستمرار في مطالبهم بحكم ذاتي مماثل ومن جهة ثانية تتخوف إيران من امتداد الهجوم التركي إلى أراضيها مما يهدد حدودها، وهو ما حدث فعلًا في هجوم عام ١٩٩٥م عندما هاجمت الطائرات التركية بعض القرى الإيرانية على الحدود مع العراق، وتمت تسوية الأمر بأن تدفع تركيا تعويضات مالية لإيران.
الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج العربي
يمثل الخليج العربي بالنسبة إلى إيران واحدًا من أهم ثوابت سياستها الأمنية والاستراتيجية ليس فقط بحكم الموقع الجغرافي للمنطقة، وإنما بالنظر أيضًا إلى أنها تمثل مستودعًا للبترول وتمثل المركز الرئيسي لثقل الدور الإيراني في المنطقة والعالم، وخاصة أن النزعة ذات الطابع الإمبراطوري والتوسعي جزء لا يتجزأ من طبيعة الدولة الإيرانية لاعتبارات يراها بعض المراقبين تمس التماسك الداخلي لمجتمع التعددية العرقية والقومية، وخاصة إذا ما توافرت الظروف والإمكانات للعب هذا الدور.
وقد برز هذا الدور عبر الوجه الديني للثورة الإيرانية، فضلًا عن استمرار احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، وانتهاكها المجال الجوي العراقي لقصف قواعد منظمة «مجاهدي خلق». ويمكن القول بأنه في حالة الإمارات فإن افتعال إيران لوضع الأزمة يقصد به تحقيق هدفين:
- إثبات أنه لا أمن في الخليج بدون مشاركة إيران وعلى خلفية ذلك تعارض إيران أي وجود لقوات أجنبية في المنطقة سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو حتى مصرية أو سورية.
- إبراز الحضور الإيراني في مواجهة نظيره التركي.
أما بالنسبة لتركيا، فمنطقة الخليج تمثل أهمية جيواستراتيجية وأمنية، ومن ثم يمثل أي اختلال في التوازن الاستراتيجي لصالح إيران مساسًا بالأمن القومي في التصور التركي، هذا بالإضافة إلى أن الدور الإقليمي الجديد لتركيا في غرب آسيا وفي الخليج، في ظل التحولات الدولية الجديدة، يفتح الباب مجددًا أمام تركيا خاصة في ظل المحاولات الغربية لتحويل معادلة منطقة الشرق الأوسط من «النفط- التكنولوجيا» إلى «النفط- المياه».
وأخيراً، وبالرغم من هذا الخلاف والصراع بين تركيا وإيران، إلا إنهما- على ما يبدو- في حال اتفاق تام حول الموقف من «النظام الإقليمي العربي»، فإيران من جهة ترى أن تفكيك وانهيار النظام العربي مصلحة قومية إيرانية ومدخلًا لدور إقليمي أكثر بروزًا خاصة في منطقة الخليج، أما تركيا من جهة أخرى، فترى أن حرب الخليج الثانية قد جاءت بمتغيرات أمنية وسياسية واستراتيجية، بل وثقافية، تدفع نحو إعادة تشكيل المنطقة على نحو كبير على أنقاض النظام العربي وأن دخولها كطرف فاعل ومؤثر في الجغرافية السياسية والأمنية للمنطقة، لن يقفز- فوق المواريث السلبية- إلا عبر النظام الإقليمي الشرق أوسطي.
جمهوريات آسيا الوسطى
يتنافس العديد من القوى الدولية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي على موطئ قدم في جمهوريات آسيا الوسطى الغنية بمصادر النفط والغاز الرخيصة، كما أنها تمثل سوقًا تجارية رائجة فضلًا عن سعي هذه القوى لأخذ دورها ومكانتها الإقليمية إما للحفاظ على إرث ثقافي معين أو تصديره، أو الخوف من هاجس أصولي أو عرقي «انفصالي» على مشارف حدودها أو بداخلها... إلخ، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع هذه المداخل تتلاقى في نقطة واحدة وهي الاستفادة من المنافع الاقتصادية والتجارية التي تكتظ بها المنطقة.
وفي هذا الإطار اعتمدت تركيا على التقارب العرقي واللغوي والثقافي في العديد من دول آسيا الوسطى بعض الأحيان للمشاركة بدور أساسي في ترتيبات المنطقة خاصة على المستوى الاقتصادي وتعزيز فعاليتها الاقتصادية أمام إيران من ناحية، والاستفادة من المنطقة في حالة بقائها خارج السوق الأوروبية من ناحية أخرى.
كما يهدف الدور التركي في المنطقة إلى تقديم النموذج التركي العلماني لدولها بهدف قطع الطريق على إيران بالاستعانة بالحليف الأمريكي.
ومن جانبها تعارض وتراقب الولايات المتحدة عن كثب الدور الإيراني في المنطقة خصوصًا بحر قزوين، ومشاركتها في صفقات الطاقة المستخرجة منه، وترى واشنطن ضرورة إحكام العزلة التي تفرضها على إيران بما يحول دون تطلعاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية في منطقة آسيا الوسطى، وتسعى بالضغط على حلفائها وشركائها في المنطقة لفك ارتباطهم بمصالح إيران في الجمهوريات الإسلامية من ناحية، وتقوية وجود منافستها «تركيا» في المنطقة من ناحية أخرى.
الدور الإيراني في آسيا الوسطى- على خلاف غيره- يعتبر تحركًا في واحدة من أهم دوائر الأمن الإقليمي الاستراتيجي، ولذا فقد كثفت إيران من جهودها في الفترة الأخيرة لتدعيم تواجدها في هذه الجمهوريات خصوصاً بعد التوغل التركي في شمال العراق، وهي كلها عمليات عسكرية تجرى على الحدود الغربية لإيران فضلًا عن التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل.
وليس من قبيل الصدفة أن تدعو إيران إلى إنشاء منظمة بين الدول المطلة على بحر قزوين تضم كلًا من إيران وأذربيجان، وتركمانستان، وكازاخستان، وروسيا، حيث إن هذا التكتل لا يضم تركيا بصفتها غير مطلة على بحر قزوين، وربما لهذا السبب بالذات سعت إيران وبقوة لإنجاح هذه الفكرة لاستبعاد تركيا من الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تذخر بها المنطقة خصوصًا النفط والغاز الطبيعي.
ویرى المراقبون أن اندفاع إيران نحو هذه المنظمة ليس لمواجهة النفوذ التركي فحسب، وإنما يرجع أيضًا لاعتبارات ثقافية ودينية، فضلًا عن العوامل الجيوبوليتيكية في السياسة الإيرانية باعتبارها حلقة الوصل بين الشرق الأوسط ووسط آسيا وغربها، فمنذ تفكك الاتحاد السوفييتي لم تجد إيران بُدًّا من إعادة توجهها نحو آسيا الوسطى والقوقاز، وخاصة أن هذه المناطق كانت جزءً من الإمبراطورية الفارسية القديمة، كما أن للمواطنين الإيرانيين امتدادات عرقية في معظم بلدانها، ومن ثم باتت الاستراتيجية الإيرانية موجهة بالأساس نحو ملء الفراغ في آسيا الوسطى والقوقاز منذ فبراير ۱۹۹۲م من خلال منظمة التعاون الاقتصادي «إيكو»، ومنظمة بحر قزوين والاتحاد الثقافي للدول الناطقة بالفارسية «وهي إيران وأفغانستان وطاجيكستان».
والسؤال الآن: ما الأهداف الإيرانية من هذه التوجهات القوية نحو آسيا الوسطى؟ يتضح من العرض السابق للتحركات الإيرانية في المنطقة أنها ترمي إلى تحقيق الأهداف التالية:
١- الاستفادة من السوق التجارية الواسعة التي تشكلها بلدان منطقة آسيا الوسطى، وخاصة أنها تستطيع استيعاب الكثير من المنتجات الإيرانية في مقابل استفادة طهران من مواردها الطبيعية الرخيصة، الأمر الذي جعل البعض يصف التوجهات الإيرانية نحو المنطقة بالبراجماتية، وقد وصلت واردات طهران من هذه الدول إلى ٢٠٠ مليون دولار عام ۱۹۹۳م، في حين وصلت صادراتها إليها بالإضافة إلى روسيا إلى ٥٠٠ مليون دولار في العام نفسه.
٢- الاستفادة من ترسانة الأسلحة المتطورة النووية وغير التقليدية لديها في تحديث المؤسسة العسكرية الإيرانية، ويذكر أن بعض التقارير أشارت إلى أن إيران ربما حصلت على بعض الرؤوس النووية من كازاخستان في مقابل حصول الأخيرة على البترول والعملة الصعبة، فضلًا عن استعانة إيران بأكثر من ٥٠ خبيرًا وعالمًا نوويًا سوفييتيًا للعمل في منشآتها النووية.
٣- تعزيز الدور الإيراني في هذه المنطقة لمواجهة النفوذ الأمريكي في منطقة الخليج.
٤- تعزيز تحرر الحدود الشمالية الإيرانية من الضغوط التي كان يشكلها وجود دولة عظمى، ومن ثم تحرر إيران من عقد الماضي المتمثلة في انتهاكات الاتحاد السوفييتي السابقة لسيادتها القومية منذ بداية القرن العشرين.
وتصب هذه الأهداف في إطار أكبر وأشمل وهو بناء المكانة الإقليمية والدولية لإيران.
إلا أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هي أن إيران، وعلى الرغم من جهودها المضنية لتثبيت أقدامها في آسيا الوسطى، فإنها لم تحقق النجاح المأمول في مواجهة تركيا التي حققت إنجازات كبيرة، واقتصر النجاح الإيراني على طاجيكستان التي تربطها بطهران علاقات لغوية وثقافية متينة، وفي ظل الكشف عن مخزونات هائلة للغاز والنفط في منطقة بحر قزوين تصل إلى ۲۰۰ مليار برميل، بدأت الأنظار تتجه إلى إيران كممر لخطوط النفط من المنطقة إلى العالم باعتبار أن هذا هو البديل الاقتصادي الأرخص والأوفر، إلا أن الولايات المتحدة قد وقفت ضد ذلك بشدة مفضلة خط أنابيب عبر تركيا، أو روسيا، أو حتى أفغانستان.
وعلى خلفية ذلك زارت وزيرة الخارجية الأمريكية باكستان وعرضت خطة لتسوية الأزمة الأفغانية تضمن أمن خطوط النفط عبر الأراضي الأفغانية، إلا أنه وحتى في هذه الحالة لا يمكن لواشنطن أن تستبعد إيران التي تحتفظ لنفسها بدور محوري في أفغانستان من خلال تأييدها للفصائل الشيعية به.
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية
جاءت بعد أطول اجتماع في «كامب كايرو»
المجتمع الصومالي يرحب باتفاقية القاهرة
مقديشو: مصطفى عبد الله:
شهدت القاهرة في ٢٢/١٢/١٩٩٧م مراسم توقيع اتفاقية إعلان القاهرة المبرمة بين الفصائل الصومالية التي اجتمعت في العاصمة المصرية في الفترة ۱۲ نوفمبر - ۲۲ ديسمبر ۱۹۹۷م، وبعد مناقشات شاقة دامت أكثر من أربعين يوماً توصلت الفصائل إلى اتفاق وصفته الخارجية المصرية بأنه تاريخي وينص على عقد مؤتمر مصالحة وطنية يتمخض منه تشكيل حكومة وحدة وطنية يترأسها مجلس رئاسي مع رئيس فخري للدولة ورئيس للوزراء وبرلمان.
وهكذا سرت نسمات التفاؤل في أوصال مجتمع أنهكته الحروب الأهلية والكوارث الطبيعية، فاستبشر بهذه الاتفاقية خيرًا واعتبرها خطوة إيجابية للخروج من المأزق السياسي وترك العيش في الظل فوضى عارمة وبلا حكومة مركزية، وانتهاء ويلات الحرب الأهلية التي أكلت الأخضر واليابس. شارك اجتماع القاهرة كل من تحالف علي مهدي وتحالف حسين عيديد بـ ١٤ مندوبًا من كل طرف، وقاطع هذا الاجتماع محمد حاج إبراهيم عجال زعيم شمال الصومال وقد اتفق الطرفان على عدد من المبادئ:
1 - وحدة أراضي الجمهورية الصومالية واستقلالها وسيادة حدودها.
٢- نظام حكم فيدرالي يضمن الحكم الذاتي للأقاليم، وتحدد الحكومة الانتقالية شكل النظام الفيدرالي وتنفذه.
٣- تكوين مجلس رئاسي من ۱۳ عضوًا يتم انتخابهم من قبل مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده في بيدوه بأغلبية بسيطة، ويختار المجلس الرئاسي رئيسًا للدولة بالأغلبية البسيطة في حين تتطلب إقالته أغلبية ثلثي الأصوات.
٤- يختار مؤتمر المصالحة الوطنية رئيسًا للوزراء، ويمكن عزله من قبل المجلس الرئاسي بأغلبية ثلثي الأصوات.
٥ - تكوين جمعية تأسيسية من ۱۸۹ عضواً.
٦ - إقامة نظام قضائي مستقل يخضع لقوانينه وأنظمته، ويحظر إنشاء محاكم خاصة.
٧- يتم تحديد مهام هذه المؤسسات في ميثاق الفترة الانتقالية.
٨- الفترة الانتقالية للحكومة ثلاث سنوات يجوز تمديدها- إذا دعت الضرورة- إلى خمس سنوات من قبل الجمعية التأسيسية.
٩- تشكيل لجنة لوضع مسودة ميثاق الفترة الانتقالية.
وحول مؤتمر المصالحة الوطنية اتفق المؤتمرون على عقد مؤتمر مصالحة وطنية بمدينة بيدوه جنوبي غربي الصومال، يشارك فيه ٤٦٥ مندوبًا يمثل ١٦٠ منهم التحالفين اللذين أبرما الاتفاق، ويأتي الباقي من القبائل المختلفة مع مراعاة ثقلهما النسبي، ويكون موعد المؤتمر ١٥ فبراير عام ۱۹۹۸م الذي تعد له لجنة تحضيرية.
والجدير بالإشارة أن عضوين من تحالف علي مهدي انسحبا من الاجتماع في لحظاته الأخيرة، وهما العقيد عبد الله يوسف والجنرال آدم عبد الله نور؛ حيث لم يقتنعا بكيفية توزيع مندوبي مؤتمر المصالحة الوطنية المقترح ووصفا هذا التوزيع بأنه غير عادل.
كما لم يوافق العقيد عبد الله يوسف على تحديد مدينة بيدوه مضيفة للمؤتمر وكان يفضل مدينة بوصاصو.
وبعد انسحابهما من المؤتمر سافرا إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا وأصدرا فيها بيانًا اتهما فيه الحكومة المصرية بالانحياز لطرف معين!
المجتمع الصومالي رحب بهذه الاتفاقية التي قد تكون بداية نحو حل الأزمة المستعصية التي بلغت ذروتها في سنواتها السبع العجاف، فهل يكون العام الجديد عاماً فيه يغاث الناس وبداية للجمهورية الثالثة؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل