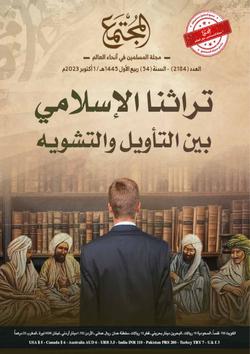العنوان فشل حوار القاهرة: نتيجة طبيعية للقفز في الهواء.
الكاتب أسامة أبو رشيد
تاريخ النشر السبت 20-ديسمبر-2003
مشاهدات 26
نشر في العدد 1581
نشر في الصفحة 20

السبت 20-ديسمبر-2003
■ تجاهل دعاة اجتماعات القاهرة الدروس المستفادة من الهدنة السابقة المنهارة وأصروا على أن توقع الفصائل على هدنة تسفك فيها دماؤها دون إمكان للردع.
■ مشروع القيادة الوطنية الموحدة لا ينجح إلا بالاعتراف بـ «الإزاحات» التي شهدتها موازين القوى الفلسطينية.
الفشل الذي وصلت إليه حوارات القاهرة بين ۱۲ فصيلًا فلسطينيًّا، مثل نتيجة طبيعية لمقدمات خاطئة.
فمن ناحية، ينبغي التأكيد أولًا على أن أجندة الحوار الفلسطينية -الفلسطينية في القاهرة لم تكن فلسطينية بمعنى الكلمة بالدرجة الأولى، بقدر ما كانت استجابة لاحتياجات داخلية وخارجية لأطراف أخرى منها الدولة الراعية مصر التي أرادت اصطياد عدة عصافير بحجر واحد أولًا: إعادة إنتاج دورها المحوري في معادلة الشرق الأوسط، وهو الدور الذي تم تحجيمه أمريكيًا وإسرائيليًا، خصوصًا بعد التدخل الأمريكي في العراق. وثانيًا أن مصر وكنتيجة مترتبة على ذلك. وإن كانت إرهاصاته بدأت تلوح منذ سنوات -بدأت تخسر مكانتها في المنطقة لصالح دول أصغر منها حجمًا وأقل أثرًا في معادلة المنطقة، معتمدة -أي تلك الدول الأقل حجمًا وأثرًا -على ارتباطها الوثيق وتحالفها المعلن مع الولايات المتحدة، التي وظفتهم كمعبدي طرق لسياساتها وساعي بريد تحذير ونذير للدول التي ما زالت لا تحظى بالرضا الأمريكي الكامل. واشنطن: أسامة أبوا رشيد
هذا لا ينسينا أيضًا تحول دور مصر ومكانتها من وتد المنطقة إلى التجاوب مع متطلبات ورغبات الولايات المتحدة إلى حد جعل من الدور المصري أقرب إلى كاسحة الألغام الأمريكية في طرقات المنطقة ودروبها، ورغم ذلك كله، ورغم ما قدمته مصر، على الأقل بسبب انسحابها من لعب دورها الريادي الطبيعي، فإن مصر لم تجد حلاً لاستعادة الهيبة. بالتعريف المصري الرسمي، إلا بمزيد من التعاطي مع الأجندة الأمريكية وما يؤكد هذا الأمر إعلان عرض مشروع الهدنة المأمول على واشنطن
أما على الصعيد المصري -الصهيوني فنجد أنه على الرغم من أنه قد مضى على توقيع اتفاقية كامب ديفيد أكثر من أربعة وعشرين عامًا، إلا أن العلاقة المصرية -الإسرائيلية لا زالت علاقة باردة، ولا زالت تل أبيب تتحدث عن خطر مصري، وذلك في سياق جذب الموقف المصري الرسمي أكثر فأكثر نحو القاع السياسي، وفي هذا الإطار يمكننا فهم تهديد مسؤول مصري للفصائل الفلسطينية بأن الولايات المتحدة دخلت عام انتخابات، وهذا أمر غير مهم للفصائل، فأمريكا الانتخابات هي نفسها ما بعد الانتخابات من حيث الانحياز لإسرائيل لكن الأهم في التهديد هو الجزء الثاني منه، وهو أن لا دولة عربية ستقف مع الفلسطينيين في حال تصعيد الموقف. فالبعض لا يرى طريقًا لتفريغ أي احتقان أمريكي -غربي نحو بلاده إلا بمزيد من التنازلات، ولكن غالبًا عبر البوابة الفلسطينية الأضعف، حتى ولو اقتضى ذلك الطلب إلى الفلسطينيين -كما حدث بالفعل -التغاضي عن الموت والدمار الذي يزرعه شارون في صفوفهم لمدة عام يتوقف إطلاق النار الفلسطيني فيه -طبعًا الفلسطيني فحسب -وتوكيل سلطة أوسلو وجنيف الوصول إلى حل خلال هذا العام وبالطبع، فإن الحل لن يكون أفضل حتى من اتفاقية جنيف التي قرأت الفاتحة على حق العودة. وجعلت من شرقي القدس، محمية دولية، ومن المسجد الأقصى متحفًا دوليًّا، لا مقدسًا إسلاميًا تقوم من أجله حروب عقيدية وحضارية.
أما على الصعيد الفلسطيني الداخلي، فإن الأمر يأخذ أبعادًا أخرى أكثر أهمية وعمقًا. فبداية نجد أن راعيي حوارات القاهرة عن الجانبين الفلسطيني والمصري يصران على استبعاد الدروس المستفادة من الهدنة السابقة المشروطة من جانب واحد، طبعًا هو الجانب الفلسطيني، والتي دامت زهاء ستين يومًا. حصد خلالها الفلسطينيون شهداء ومنازل مدمرة ومزيدًا من الأراضي المصادرة والتهويد ومئات المعتقلين والسبب كان واضحًا لكل عاقل، حيث إن الكيان الصهيوني أصر منذ البداية على أنه ليس طرفاً في الهدنة، وأن لا التزامات تقع على عاتقه في هذا الشأن وكانت النتيجة انفجار الهدنة ذاتها في وجه إسرائيل والفصائل والسلطة الفلسطينية، عبر العمليات الفلسطينية، وما تلاها من جرائم إسرائيلية.
إذن، وجدنا في حوارات القاهرة إصرارًا غريبًا من قبل الدولة الراعية والسلطة الفلسطينية، والتيار الرسمي في فتح -حيث يعارض جناحها العسكري كتائب الأقصى الهدنة كما يعارض اتفاقية جنيف. على عدم الاستفادة من هذا الدرس العميق، بل ووجدنا من يتحدث بصراحة أن لا ضمانات بالتزام الكيان الصهيوني بهذه الفرصة الجديدة من وقف إطلاق النار، ومع ذلك إصرارًا في اتجاه آخر على أن توقع هذه الفصائل على هدنة تسفك فيها دماؤها دون طرح إمكانات الردع وتسجل التصريحات الإسرائيلية الرسمية خلال حوارات القاهرة أن تل أبيب لن تلتزم بشروط هدنة الفصائل وبأن الأمر لا يعنيها، إلا من ناحية حجم التدخل العسكري وعملياته ولا ينبغي هنا التغاضي عن أن مصطلح إطلاق النار نفسه، مصطلح مضلل بالنسبة للجانب الفلسطيني، فإسرائيل تمارس القتل والجرائم بحق الفلسطينيين يوميًّا، في حين أن إمكانات الردع والرد عند الجانب الفلسطيني، متمثلًا في فصائل مقاومة لا تمكنها من الرد اليومي الرادع، أو على الأقل ضمان إشعار الطرف الآخر بالألم المتبادل بذات الكثافة.
وفي ذات السياق، نجد إصرار السلطة الفلسطينية وفتح الرسمية وبعض الفصائل المكتبية على ضرورة أن تودع الفصائل هدنتها لدى السلطة الفلسطينية لكي تتمكن هذه الأخيرة من مفاوضة الكيان الصهيوني عليها الغريب هنا أن هـذا الإصرار، يأتي في ذات الوقت الذي كانت فيه جولات المفاوضات الفلسطينية «الرسمية» والإسرائيلية تتكثف في لندن ومدريد وغير بعيد عن ذلك كانت شخصيات فلسطينية محسوبة على السلطة وفتح وبعض الفصائل المتحالفة معها توقع في جنيف على كنس» حق العودة الفلسطيني من المشروع الوطني الفلسطيني، وتجعل من قضية القدس وكأنها دمل.
ينبغي فقنه» والتخلص منه. ولا ينبغي أبدًا هنا السقوط في تضليل شعارات السلطة الفلسطينية بأنها ليست طرفًا في اتفاقية
جنيف، فمن ناحية فإن بعض الشخصيات التي شاركت في الاجتماع العلني الأول لها في منتجع على البحر الميت في الأردن هم من أعضاء المجلس التشريعي الممثل لفتح أي حزب السلطة ومن ناحية ثانية، دعم عرفات الديبلوماسي، في عباراته للوثيقة. أيضًا إرساله مستشاره للأمن القومي جبريل الرجوب لحضور حفل التوقيع في جنيف كممثل عنه.
وفوق هذا وذاك الكشف من قبل رموز جنيف من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عن أن الحوارات بدأت مباشرة بعد انهيار محادثات كامب ديفيد في يوليو ۲۰۰۰، أي في الوقت الذي كان فيه باسر عبد ربه، رمز الوثيقة فلسطينيًّا، عضوًا في السلطة رسميًّا ومن ثم فإن الحديث عن إبداع هذه
الهدنة لدى السلطة لكي تفاوض عليها، وتفويضها نهائيًا ملف المفاوضات، كان بمثابة دعوة لفصائل مثل حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، والجهاد تحديدًا، وبدرجة ثانية الجبهة الشعبية، لتجرع السم إراديًا، وهم المعارضون أصلًا لمسار التسوية بشكل عام وجذري في حال الفصيلين الإسلاميين.
من هنا نفهم اعتراض حماس تحديدًا على مثل هذا الإبداع والتفويض المطلق للسلطة، خصوصًا أن تجربة أكثر من ثلاثة عشر عامًا من «ثقافة التفاوض الفلسطينية الرسمية لا تبشر بخير، والدلائل أكثر من أن تعد وتحصى في مدريد، وأوسلو ۱و۲، وطابا وواي ريفير.. إلخ. بل حتى كامب ديفيد التي صمد فيها ياسر عرفات عاد ليعلن فيما بعد حصاره في المقاطعة موافقته على مشروع كلينتون الذي قدم له فيها.
ولعل اتفاقية جنيف تمثل نموذجًا آخر من منطق المفاوضات الفلسطينية، فإذا كان الفلسطينيون الرسميون مستعدون لتقديم هذا الحجم من التنازلات الطرف منبوذ في الشارع الإسرائيلي الآن، ولا يحظى بشعبية، وليس في الحكم، فكيف يمكن انتمائهم والثقة فيهم حال تفاوضوا مع الحكومة الرسمية بقيادة اليميني المتطرف شارون المدعم بحكومة فيها يمينيون يزايدون عليه. وما الذي يضمن لفصائل المقاومة أن لا مفاوضات سرية تجري الآن في الغرف المغلقة ووراء الكواليس كما كانت جنيف سرية من وراء الشعب الفلسطيني، ومن يضمن لهذه الفصائل أن لا يكون المطروح في المفاوضات السرية - كما العادة - سفك دمائها والسعي لاجتثاثها من الأرض. أي منطق سياسي يدعو صاحبه إلى أن يطعن نفسه بنفسه في القلب.
قضية أخيرة تتعلق بمشروع القيادة الوطنية الموحدة فلسطينيًا فهذا لا شك أمر مطلوب، ولكن إن أريد له النجاح فلابد أن يراعي موازين القوى والحقائق الجديدة على الأرض. فمن غير المنطقي سياسيًا أن تبدي السلطة استعدادها لإشراك فصائل كحماس والجهاد والشعبية في صنع القرار على أساس صوت واحد أي بمعنى آخر مساواة فصيل كحماس
-الفصيل الأكبر والأبرز حاليًا - مع فصيل من مخلفات الماضي وذكرياته كالجبهة الديمقراطية، التي اكتشفت فجأة أن الالتزام اليساري والاشتراكي لا يتناقض مع التزلفية والتسلقية السياسية أو مع فصائل ظل وه مكاتب كحزب الشعب الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي. إن ما تعرضه السلطة هو جعل فصائل بحجم حماس وشعبيتها مزكيًا، لقرارات الأغلبية، لا من حيث الحجم والنفوذ والتأييد الشعبي وحجم النضال، بل من حيث العدد والمحسوبية على السلطة وتيارها في فتح، بحجة أن القرارات تتخذ بصيغة
ديمقراطية في إطار القيادة الموحدة.
الحاجة لمشروع واقعي
باختصار الوضع في فلسطين يحتاج فعلًا إلى ضوء في نهاية النفق، خصوصًا في ظل تعدد الأجندة الفلسطينية وعدم اتفاقها، وغياب المقاربة الجماعية فيما يتصل على الأقل بتعريف البرنامج أو الحقوق في حدها الأدنى، وهو الأمر الذي يقلل من فرص تحقيق إنجازات من وراء هذه الانتفاضة وقطف ثمارها بشكل يتناسب مع تضحياتها، ولكن في الوقت نفسه لا مع يمكن أبدًا القبول بأن يكون الضوء المرجو في نهاية النفق مزيدًا من عقود الإذعان على شاكلة أوسلو التي تمثل المسبب الحقيقي للوضع الراهن الفلسطيني بكل شهدائه وجراحاته وآلامه وأراضيه المصادرة. أو بكلمة أخرى ضبابية مستقبله من غير المعقول أن يكون الثمن إعادة إنتاج رموز الأزمة ومشاريعهم من جديد وإن أريد لأي مشروع الصياغة قيادة وطنية موحدة النجاح، فمن الضروري جدًّا أن يكون هذا المشروع واقعيًا، لا قفزة في الهواء دون الأدوات اللازمة إن حركة حماس اليوم تمثل وزنًا سياسيًّا ومقاومًا وشعبيًّا في الساحة الفلسطينية لا يمكن التغاضي عنه، أو إنجاح أي مشروع بدونها وهذه الحركة معروف موقفها منذ نشأتها من ناحية تحفظها على الإقرار بشرعية وحدانية تمثيل منظمة التحرير للقضية والشعب الفلسطينيين، وذلك جراء الخلاف البنيوي بين مقاربة الطرفين لطرائق وآفاق ومآلات الصراع، حسب منظمة التحرير في نسخته الأخيرة، أو الصراع الإسلامي مع المشروع اليهودي «الصهيوني» المدعوم غربيًا على أرض فلسطين حسب رؤية حماس العامة وإن حماس التي بقيت عند موقفها المتحفظ من مسألة تمثيلية المنظمة في أسوأ مراحل اختلال توازن القوى بين الطرفين، وذلك لصالح امتداد المنظمة المتمثل في السلطة الفلسطينية في الفترة الممتدة من عام ١٩٩٦ وحتى ٢٨ سبتمبر ۲۰۰۰ تاريخ انطلاق انتفاضة الأقصى، لن تقبل اليوم بأن تقدم تنازلًا مجانيًا في هذا الشأن مع عودة ميزان القوى بينهما إلى التقارب النسبي، خصوصًا وأن الثمن المطلوب من حماس تقديمه هو القبول باتفاقات تعتبرها خيانة في صيرورة الصراع.
القيادة الموحدة
إذن كي ينجح مشروع القيادة الوطنية الموحدة، وكذلك السعي لتلمس الضوء في نهاية النفق، ينبغي على بقايا السلطة الفلسطينية، أن تتبنى مقاربة إنقاذ وطني شامل عبر استنهاض وتوظيف كافة مكونات القوة والفعل في الساحة الفلسطينية، لا مجرد محاولة بث الحياة من جديد في جثث هامدة، كانت يومًا تمثل قوى فعل في الساحة الفلسطينية أو فصائل أخرى تم استنساخها لتعزيز ديمقراطية الزيف العددية التي مورست طويلًا لتطويق عناصر القوة والفعل الحقيقية في الساحة الفلسطينية، وذلك في أفق تمرير مشاريع استسلام جديدة، سيكون ثمنها الأول تقديم عناصر القوة والفعل الحقيقية نفسها على مذبحها منظرو التفاوض دائمًا يتحدثون عن الواقعية، فكونوا واقعيين الآن: لا حل إلا بالالتفات إلى الحقائق الجديدة على الساحة الفلسطينية وبالاعتراف بالإزاحات الكبيرة التي شهدتها موازين القوى الفلسطينية والثقل الشعبي والسياسي فيها. وعندها فقط سيكون البحث في أي مشروع وطني إنقاذي واستثماري مستقبلي واقعيًا، لا قفزًا في الهواء كما حدث في القاهرة.