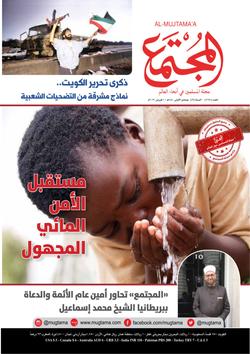العنوان في المقاصد والمنهج المقاصدي
الكاتب محمد شاويش
تاريخ النشر السبت 09-مارس-2002
مشاهدات 27
نشر في العدد 1491
نشر في الصفحة 42

السبت 09-مارس-2002
بدون معرفة المقاصد تتحول الأحكام إلى ما يشبه أعضاء ميتة متفرقة لا يجمعها جامع.
اشتهر عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - فهم مقاصد النصوص والسير معها، ومن أمثلة ذلك إيقاف صرف سهم المؤلفة قلوبهم، وإيقاف حد السرقة في عام الرمادة.
كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله -فيما نعلم أول من تكلم عن علم مستقل اسمه «علم مقاصد الشريعة»، وهو في مقدمة كتابه الشهير «مقاصد الشريعة الإسلامية»، يشرح نظرته إلى هذا العلم بأنه العلم الذي ينبني على قطعيات يستند إليها الفقهاء ولا يختلفون فيها، كما يستند أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة، وعلم أصول الفقه - في رأيه -لا يفي بهذا الغرض؛ لأن مسائل أصول الفقه مختلف فيها بين الفقهاء تبعًا لاختلافهم في مسائل الفروع التي استخلصت منها، وثمة سبب آخر لانعدام الإجماع في مسائل أصول الفقه يعود في رأيه إلى كون هذه المسائل لا تبحث في حكمة الشريعة ومقصدها بل تبحث في قواعد التفسير اللغوي للنصوص، وفي قواعد استخراج الأوصاف المناسبة المنضبطة التي بنيت عليها الأحكام؛ لكي يمكن القياس بعد معرفة هذه الأوصاف التي سموها العلل، أما البحث في المقاصد فلا يشغل إلا جزءًا ضئيلًا من كتب الأصول، قل من ينتبه إليه.
ولهذا شمر الشيخ ابن عاشور - رحمه الله - عن ساعد الجد، وقرر العمل على تنفيذ مشروعه الذي يشرح فكرته كما يلي: «إذا أردنا أن ندون أصولًا قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارف عليها، وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين، ونعيرها بمنظار النظر والنقد، فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي علقت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفكر والنظر ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة، ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية، ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه غير منزو تحت سرادق مقصدنا هذا من تدوين مقاصد الشريعة، فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل علم مقاصد الشريعة»(۱).
والشيخ ابن عاشور يقسم مقاصد الشريعة إلى قسمين: مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ويعرف المقاصد العامة للشريعة بقوله: «مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضًا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها» (۲).
أما المقاصد الخاصة، وهي مقاصد الشرع في أبواب المعاملات فيعرفها بأنها «الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة؛ كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة، إبطالًا عن غفلة أو عن استزلال هوى وباطل شهوة. ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس مثل قصد التوثق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النكاح، ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق» (۳).
والمفكر الإسلامي الثاني الذي تصدى لموضوع المقاصد في العصر الحديث هو الأستاذ علال الفاسي - رحمه الله - وقد خصص له كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها«، وفي هذا الكتاب يقول: «المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها» (٤)
ويبدو أن الذين كتبوا في هذا الموضوع في العصر الحديث لم يخرجوا عن تعريفي ابن عاشور وعلال الفاسي، وانظر مثلًا ما كتبه الأستاذ أحمد الريسوني في كتابه «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» عن تعريفي د. وهبة الزحيلي ود. عمر الجيدي للمقاصد، فهو يقول: إنهما تبنيا التعريفين دون أي تنبيه على ذلك (٥).
والريسوني واحد من الباحثين المعاصرين الذين اهتموا بموضوع المقاصد وبالتحديد بنظرية المقاصد عند الإمام الشاط،بي وهو يتوصل إلى التعريف التالي: «مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد» (٦)، غير أننا نجده بعد قليل، وخلال حديثه عن النظر المقاصدي عند الإمام العز بن عبد السلام يسوق تعريفًا أبسط للمقاصد: «الكلام في المصالح والمفاسد هو كلام في مقاصد الشريعة التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد»، هذا التعريف البسيط نتبناه نحن أيضًا على شرط توسيع معنى «المصلحة» و«المفسدة»، بحيث يحتوي تلك المصالح والمفاسد مما أنت به النصوص الشرعية الثابتة التي قد لا يدركها العقل في وقت أو زمان ما. وهذا التحفظ نراه ضروريًّا، وعلى أساسه يمكن لنا إزالة التعارض الظاهر بين المنهج المقاصدي والمنهج الذي يقف عند النصوص.
ويرى الأستاذ الريسوني بناء على دراسته لكتابي ابن عاشور والفاسي تقسيم المقاصد إلى ثلاثة أقسام:
المقاصد العامة: وهي التي تراعيها الشريعة، وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية أو في كثير منها.
المقاصد الخاصة: وهي المقاصد التي تهدف الشريعة لتحقيقها في باب معين أو في أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع «مثلًا مقاصد الشريعة في أحكام العائلة».
المقاصد الجزئية: وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب (۷).
حين نتكلم عن «المقاصد» في الشريعة الإسلامية فإننا نتكلم في الحقيقة عن «معنى» هذه الشريعة؛ إذ إنه من المزايا الباهرة للإسلام أنه مبني بناء منطقيًّا سواء في العقيدة أو الفقه، وهذا بحد ذاته ناتج عن طابع الرسالة الإلهية الإسلامية الأكبر، إنها رحمة للعالمين، والطابع العقلي للشريعة الإسلامية عائد إلى كونها خاتمة الشرائع السماوية، فهي شريعة الإنسانية التي بلغت سن الرشد، ومن خواص الراشد أنه يطلب الاقتناع خلافًا لغير الراشد، وهذا الطابع العقلي نفسه هو أحد تجليات الكرم الإلهي الذي رفع الإصر عن الأمة، ومن أعظم صور الإصر بلا شك فرض شريعة لا يستطيع العقل فهم تعاليمها وعللها على الناس، ولنا أن نقارن هذه الشريعة السمحة مع شرائع سابقة حفلت بالأوامر والنواهي غير معلومة العلة أو الحكمة، فبينما نجد الشريعة الإسلامية الناسخة لجميع الشرائع التي سبقتها قد أحلت الطيبات وحرمت الخبائث، طيبات يميل العقل والفطرة السليمة إليها ،وخبائث هي على العكس ينفر منها كل ذي عقل وفطرة سليمة حتى عند عرب الجاهلية المنصفين، وهذا ما جرى مع مفروق بن عمرو وهو من شيبان بن ثعلبة، وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - عرض على هذه القبيلة دعوته في الموسم على عادته في أول عهد الدعوة، فسأله مفروق إلام تدعونا أخا قريش؟، فتلا النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة النحل: 90)، فقال: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك، وظاهروا عليك، نجد أن الشريعة اليهودية مثلًا حرمت بعض الطيبات ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (سورة النساء: 160:161)، أيضًا نقرأ في قصة البقرة التي أمرهم الله بذبحها كيف قادهم تعنتهم إلى أن فرض الله عليهم سلسلة من المواصفات العسيرة غير ظاهرة المعنى للبقرة التي كلفوا بذبحها.
«المقاصد» هي روح الشريعة التي تتخلل كل نصوصها وبمعرفة المقاصد تصبح النصوص أعضاء في جسم حي حافل بالحياة؛ لأنه حافل بالمعنى، يشير فيه كل حكم إلى الآخر، ويدل عليه، وما أحسن وأعمق ما قال العلامة المجاهد العز بن عبد السلام: «ومن تتبع مقاصد الشارع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك ومثل ذلك من عاشر إنسانًا من الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر، ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة» (۸).
وبدون معرفة المقاصد تتحول الأحكام إلى ما يشبه أعضاء ميتة متفرقة لا يجمعها جامع ولا تجدي المجتهد الذي يريد استنتاج حكم في واقعة مستجدة ما نفعًا.
المصالح والمفاسد
نحن إذًا تعتقد أن الشريعة مقصدها الدائم جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن الله - عز وجل - تكرمًا ومنة منه على الخلق، لا يأمر إلا بالأصلح، وهذا ما يستطيع الإنسان بفطرته معرفته غالبًا، وإن عجز بعض الناس في بعض الأوقات عن فهم المصلحة في بعض جزئيات الشريعة.
والمصلحة التي نتكلم عنها هي المصلحة الشرعية التي جاءت بها كليات الشريعة أو جزئياتها، وهي المصلحة الحقيقية التي يجوز أن تعلل بها الأحكام لا المصلحة الزائفة المستندة إلى الهوى العابر أو المصلحة الفئوية أو الطبقية أو ما شابهها مما يسير عليه الضالون أفرادًا وجماعات، وقد جاء علماء الأصول بتقسيم ثلاثي للمصالح التي أخذت بها الشريعة الإسلامية، فقالوا: إن الشريعة إنما وضعت للمحافظة على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، أما «الضروريات»: فهي ما تقوم عليه حياة الناس، ولا بد منها لاستقامة مصالحهم، وبدونها يختل نظام حياتهم، وتعم فيهم الفوضى والفساد، و«الضروريات» عند جمهور العلماء خمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
وأما «الحاجيات»: فهي ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة، وإن فقدت لا يختل نظام حياتهم، ولا تعم فيهم الفوضى ولكن ينالهم الحرج والضيق.
وأما «التحسينيات» فهي كل ما تقتضيه المروءة والآداب، وإن فقدت لا يختل نظام الناس كما لو فقدت الضروريات، ولا ينالهم حرج كما لو فقدت الحاجيات، ولكن تكون حياتهم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة، فـ«التحسينيات» بهذا المعنى ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات (۹).
في الضروريات الخمسة شرع الجهاد لحماية الدين من العدوان والمحاربة من يقف عقبة في سبيل الدعوة إليه، وفرضت العقوية على المرتدين والمبتدعين وحجر على المفتي الماجن. ولحفظ النفس شرع لإيجادها أولًا الزواج ولحفظها ثانيًا حق كل إنسان في أن ينال ما تقوم به حياته من مأكل وملبس ومسكن، وحرم الانتحار والقتل العمد، وأبيح الدفاع عن النفس، ولحفظ العقل حرم الإسلام الخمر والمخدرات، وقد يضيف المرء إلى هذا تحريم كل ما من شأنه الإضرار بالصحة العقلية من أنواع مفسدات العقل، ولحفظ النسل جاءت أحكام الزواج والطلاق والعدة وحد الزنى وحد القذف أيضًا (۱۰). ولحفظ المال شجع الشرع على كل النشاطات المنتجة من صناعة وزراعة وتجارة ووضع التشريعات الكثيرة التي تنظم إنتاج السلع وتوزيعها وتنظم المبادلات مثل أحكام البيع والإجارة وغيرها، ولحفظ المال أيضًا شرع الحد في السرقة وحرمت المبادلات التي فيها عين الأحد الطرفين والغرر عمومًا، وأكل أموال الناس بالباطل، وحرم الربا تحريمًا مغلظًا إلى آخره، ويضيف بعض العلماء العرض «وهو في اللغة موضع المذمة والحمد في الإنسان، فهو لا يقتصر على مفهومنا الآن لهذه الكلمة» إلى الضروريات وتصبح بهذا ستة.
وفي «الحاجيات» شرع الإسلام كل ما يرفع الحرج، وييسر المعاملات، شرع الرخصة عند المشقة، وشرع بعض العقود التي تيسر على الناس - وإن خالفت القواعد العامة للعقود - وكما أبيحت المحظورات للضرورة أبيحت أيضًا للحاجة.
وللحفاظ على «التحسينيات» شرعت الطهارة للبدن، وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد، وشرعت قواعد معاملة الناس بالحسنى والعفو عند المقدرة، وإنظار المعسر، وإفشاء السلام، وتحريم المقاطعة بين المسلمين، وشرعت مكارم الأخلاق، وأقر ما كان منها في الجاهلية.
ولاعتبار المصلحة في الشرع ضوابط تكلم عنها الفقهاء ومن «أشهرهم أبو حامد الغزالي»، ومن هذه الضوابط أن يكون للمصلحة ما يشهد لها من كليات الشريعة، وألا تقترن بمفسدة أعظم منها، وأن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية، كلية لا تخص فردًا أو فئة بالتعارض مع مصلحة الجماعة. ومن شروط اعتبارها ألا تناقض نصًّا قطعيًّا ثابتًا خلافًا لرأي شاذ قال به نجم الدين الطوفي قديمًا، ووجد حديثًا من يرحب به من المبهورين بالثقافة الغربية، وهذا الرأي يقول بتقديم المصلحة على النص عند التعارض.
ومن الذين تصدوا للرد على هذا الرأي في عصرنا د. محمد سعيد رمضان البوطي، وخلاصة رده:
أولًا: إن الطوفي يناقض نفسه حين يقو:ل إن الشريعة لم تأت إلا لرعاية مصالح العباد، ثم يقدم هذه المصالح على نصوص الشريعة.
ثانيًا: إن المصلحة ما هي إلا فرع مستخلص من نصوص الشريعة، وبالتالي فهي ليست دليلًا مستقلًا قسيمًا للنص عند تقسيم الأدلة.
ثالثًا: إن الطوفي يناقض نفسه فيقول: إن المصلحة مجمع عليها، فهي أقوى حتى من دليل الإجماع؛ إذ اختلف في هذا الدليل.
رابعًا: إن الطوفي يخلط بين اختلاف المجتهدين في تأويل النصوص واختلاف النصوص نفسها؛ إذ إن النصوص لا تتعارض، وإنما قد تتعارض تأويلاتها (۱۱).
والشريعة تقوم على ميزان دقيق بين جلب المصالح ودرء المفاسد، وثمة قواعد فقهية كثيرة توجه المجتهد في هذا المجال مثل: «الضرر يدفع قدر الإمكان» «الضرر لا يزال بمثله» «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» وغيرها.
وفي الواقع إن القواعد الفقهية التي تخص الميزان المصلحي الدقيق الذي تتكلم عنه تستغرق أغلب هذه القواعد حتى تلك التي لا تبدو علاقتها مباشرة مع موضوع المصلحة فإذا أخذنا مثلًا القاعدة الكبرى التالية «اليقين لا يزول بالشك» نستطيع بقليل من التأمل أن نرى القدر الهائل من المصالح المنوط بالأخذ بهذه القاعدة ومقدار المشاق والمفاسد التي سنتحملها إن لم نأخذ بها.
-------------------------------------
الهوامش
(1) «مقاصد الشريعة الإسلامية»، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص 8
(2) م ن -ص ٥١
(3) من -ص ١٤٦
(4) «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها»: علال الفاسي، ص3.
(5) أحمد الريسوني: «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»، ص7.
(6) م ن -ص 7.
(7) م ن -ص ۸.
(8) محمد الطاهر بن عاشور، م س -ص ۷۱
(9) عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه -بلا دار نشر ولا مكان طباعة -الطبعة العشرون ١٤٠٦هـ ١٩٨٦ م. ص ٢٠٤-١٩٦ .
(۱۰) حد القذف يمكن من جهة أن نعده حفظًا للنسل؛ لأن فيه تشكيكًا بالنسب وهو من جهة أخرى يمكن عده حفظًا للعرض وثمة فرق بين مفهومي حفظ النسل، و«حفظ العرض»، فالأخير يخص كل ما يتعلق بالسمعة الاجتماعية للإنسان، وإنما جرى الخلط حتى عند عالم متبحر مثل الأستاذ عبد الوهاب خلاف؛ بسبب تغير دلالة كلمة «العرض»، بين عصرنا وعصر علماء السلف.
(۱۱) د. محمد سعيد رمضان البوطي -ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية -ص ۱۷۸-۱۹۰
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل