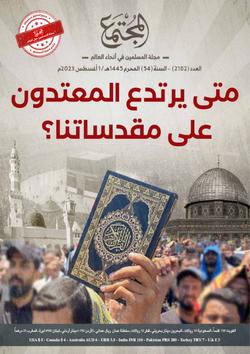العنوان مقال الأسبوع: أسس الحياة الاجتماعية
الكاتب أبو الأعلي المودودي
تاريخ النشر الثلاثاء 28-ديسمبر-1993
مشاهدات 18
نشر في العدد 1081
نشر في الصفحة 34
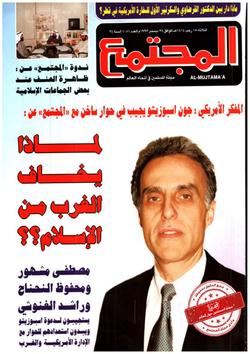
الثلاثاء 28-ديسمبر-1993
مؤسس الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية
- الاختلاف في طبائع البشر من الأمور الفطرية إذ إن الإنسان- مادام بشرًا- فمن اللازم أن يبقى منفردًا بمزاجه، منفردًا بذوقه، منفردًا بذهنه، ولا يمكن أن يتحول الناس إلى لون واحد أو نمط بعينه.
- وكذلك من مقتضيات الفطرة أن يعيش الإنسان مع غيره من الناس مرتبطًا بهم في حياة اجتماعية ومدنية- وهو أمر لا مفر منه- ولن تقوم الحياة الاجتماعية إلا بقيام التساند بين أفراد البشر، والتوافق بين أفكارهم، والمشاركة في الأهداف والغايات والتسامح عند الخلاف.
- أهمية التوافق بين «الفردية والجماعية»:
هذان المقتضيان لفطرة البشر متناقضان بل متشاكسان إلى حد كبير. ويتوقف بناء نظام الحياة بصورة ناجحة على الحيلولة دون التناحر بين المقتضيين المشار إليهما، وعلى البحث عن طريق يجعل الاثنين يتحققان في آن واحد ولم يقترن مجتمع من المجتمعات البشرية في العالم بالتقدم والبناء إلا حينما تمكن ذلك المجتمع من وضع مبادئ وأسس يتفق عليها جل أفراده إن لم نقل كلهم، وتضمن ذلك الاتفاق فرصًا أو مجالات تحقق مقتضيات اختلاف الطباع البشرية وكل مجتمع لم يوفق في هذا النوع من الاتفاق وتحمل الخلاف الفردي في مجال معين وقف البناء وبرزت إلى الوجود قوى الشر والتدمير تعمل عملها.
- أثر التصادم بين الفردية والجماعية:
- إن الذي نراه في واقع الأمة إنما هو فصل مزدهر للخلافات خلاف في التفكير خلاف في الغايات والأهواء خلاف بين الفئات والجماعات خلاف في كل شأن حتى إذا قام أحد يبنى شيئًا يأتي آخر فيعاكسه، وإذا أراد ذلك لآخر أن يعمل عملًا ينهض الثالث ويدمره، والنتيجة أنه لا يتمكن أحد منهم أن يبنى شيئًا ما هذا الوضع أصبح عقبة كأداء في سبيل البناء أي نوع من البناء، بينما انتعشت عوامل الهدم تلقائيًّا وخلا لها الجو أردناها أم لم نردها.
- فإذا كنا قد أصبحنا أعداء أنفسنا فإنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في أن نفيق من جنون الخلافات والمعاكسات، وأن نوطن أذهاننا على البحث عن الأسس التي يمكن أن يتفق عليها سائر المسلمين أو أغلبهم حتى نحول طاقاتنا وكفاءاتنا عن الهدم نحو «البناء».
- وليس من المتعذر أن نعثر على أسس كهذه. إنما المطلوب هو أن نتوجه بأذهاننا وعقولنا نحو البحث عن أسس التوافق بدلًا من النقر على أوجه الخلاف فشيء يسير من التغيير في وجهة النظر يسهل علينا هذه القضية؛ لأن أسس التوافق قريبة منا وليست بعيدة عنا نستطيع أن نعثر عليها في ديننا نجدها في حضارتنا وتقاليدنا نستشفها في تجارب العالم، ننالها في ضوء توجيه العقل العام بكل وضوح.
- أسس تحقق الاتفاق:
- ودعوني أضع إصبعي على طائفة من الأسس التي يمكن الاتفاق عليها بيننا وأسجلها ليتفكر فيها أولو الأحلام فأتناول قبل كل شيء المبادئ التي لابد منها لإيجاد «جو البناء» في مقابل «جو الهدم».
1- الالتزام بالصدق والعدل:
- الأمر الأول الذي يجب أن تلتزم به سائر الفئات هو: «الصدق والعدل» فالخلاف إذا اتسم بالأمانة، والدليل في إطاره الواقعي كان نافعًا معظم الأحوال، فبهذا تتماثل للناس نظرات متضاربة في أشكالها الصحيحة، ويسهل على الناس تقرير ما يقبلونه أو ما يرفضونه، وإذا لم يكن نافعًا فلا أقل من أن لا يكون مضرًا، ولكنه ليس من أمر أكثر ضررًا على المجتمع من أن يكون الشخص فيه على خلاف مع غيره فيلجأ بدون تأخير إلى «مبدأ شيطاني» قائل: "بأن الحرب تبيح كل حيلة"، ثم يأتي يوجه إليه كافة الأنواع من الاتهامات الكاذبة وينسب إليه بتعمد أقوالًا هو منها بريء، ويقدم وجهة نظره في أسلوب مختلق، وإذا كان خلافه معه في القضية السياسية يصفه بالخائن وعدو الوطن، وإذا كان في القضية الدينية يثير الشبهات في دينه وإيمانه إلى أن يشمر عن ساقه ويجعل غايته في الحياة تنكيسه وتخذيله.
- فهذا الأسلوب من الخلاف لا يعتبر عيبًا من «الوجهة الخلقية» فقط، وإنما من «الوجهة الشرعية» أيضًا، بل يتولد منه عدد لا يحصى من المساوئ، هذا الأسلوب ينمى العداء المتبادل في عناصر المجتمع ويوقع عامة الناس في التضليل والخدعة، ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يقرر رأيًا سليمًا في القضايا الخلافية.
- كما يتولد بذلك في المجتمع جو متكدر يساعد على التقاتل والتناحر، لا على التعاون والتفاهم قد يحقق شخص أو جماعة بهذا الأسلوب بعض المصالح العاجلة، إلا أنه مجموعا يجلب على الأمة ضررًا لا ينجو منه حتى أولئك الذين اختاروا هذا- الأسلوب الشنيع- من الخلاف بظنهم أنهم يحسنون صنعاء فالخير كل الخير في أن لا نتخلى عن جانب من الصدق بأية حال في خلافنا مع أحد مهما يكن وضع الخلاف، وأن تنصفه بما نريده لأنفسنا.
2- ضرورة التسامح في الخلاف:
- الأمر الثاني هو: التسامح في الخلاف أي نحاول أن نفهم وجهة نظر الآخرين ونعترف بحقهم في الرأي:
- أمر من صميم الطبيعة أن يعتقد شخص فيما يراه من رأى أنه حق وعزيز عليه، إلا أن الاحتفاظ بكافة الحقوق بخصوص الرأي في منتهى الغلو في حب الفردية ولا يتماشى ذلك مع سير الحياة الاجتماعية أبدًا، ويزيد الطين بلة افتراض أحد أن رأيًا مخالفًا لرأيه يستحيل أن يقوم على الأمانة فكل من يخالف رأيه فلا إيمان له ونيته ليست حسنة.
- هذا الموقف يثير في المجتمع جوًّا عامًّا من سوء الظن، ويحول الخلاف إلى العداء ولا يجعل العناصر المختلفة في المجتمع- وهي مضطرة إلى التعايش في مجتمع واحد - صالحة للوصول إلى التفاهم. ولا ينتج من هذ الوضع إلا أن تبقى عناصر المجتمع الأماد طويلة في تصارع وتحارب. ولا يمكن عمل البناء ما دام لا يقضى على غيره من العناصر، أو يهلك الجميع بالتناحر والتناطح إلا أن يأتى الله بقوم آخرين ويسلمهم مهمة البناء.
- ومن سوء الحظ أن مجتمعاتنا تفاقم فيها مرض عدم التسامح، وسوء الظن والإعجاب بالرأى ولم ينج منه إلا القليلون أصيبت به الحكومات وأرباب السلطة، أصيبت به الأحزاب السياسية، أصيبت به الجماعات الدينية، أصيب به رجال الصحافة حتى استشرى سم هذا المرض في القرى والحارات وإلى التجمعات الصغيرة في الريف وليس له من علاج إلا أن يتقدم كل شخص ذي نفوذ في دائرته ومحيطه فيبدل عقليته أولًا، ثم يلقن الناس من خلال سلوكه درسًا في الصبر والاحتمال وسعة الصدر.
3- استنفاد الطاقة في عرض الرأي بدلًا من الرد على الغير:
- والأمر الثالث الذي يجب أن يراعيه كل من يشتغل في مجال من مجالات الحياة الاجتماعية أن يستنفد كل طاقته في عرض موقفه ورأيه بصورة إيجابية بدلًا من أن يستهلك طاقته في الرد على غيره.
- مما لاشك فيه أنه يكون- أحيانًا- من اللازم نفى أمر لإثبات أمر آخر، إلا أنه يجب أن لا يتعدى هذا النفي حدود الضرورة، وأن يكون الأصل الإثبات لا النفي، ولكنه مع الأسف الشديد أن الأمر عندنا بالعكس مما قلت تبذل عندنا معظم الجهود في استنكار ما يفعله الغير وتشويه سمعته لدى الآخرين، بل فريق من الناس لا يتجاوز عمله عمل النفي إبداء بينما فريق آخر يظن أن نجاحه فيما عنده من مشروع إيجابي يتوقف على النفى الكامل لكل مشروع موجود في الساحة هذا طريق خاطئ تتولد منه القبائح والشنائع، وتنشأ منه العصبيات ، وينتشر في المجتمع بصفة عامة عدم الثقة بين الناس، وأكبر من هذا وذاك أن عامة الناس يتعودون بعد ذلك على التفكير السلبي بدلًا من التفكير الإيجابي.
4- عدم فرض الرأى بالقوة:
وهناك أمر آخر يجب الاعتراف به كقاعدة كلية هو: لا يجوز لأحد أن يفرض رأيه على غيره بالقسر.
- وكل من يريد من الآخرين أن يقبلوا رأيه فعليه اللجوء إلى الأدلة لا إلى القوة.. وكذلك كل من يريد أن ينفذ مقترحه على نطاق جماعي فعليه أن يقنع الناس على ذلك بالترغيب والترشيد ، ولا ينفذه قسرًا وقهرًا.
- واعتقاد أحد أن ما يحمله من رأى هو حق ونافع للأمة والبلد لا يكفى له أن ينهض ويبدأ في محاولة تسليطه على الناس قسرًا ولا يؤدى هذا التفكير إلا إلى الصراع والمقاومة، وبالتالي إلى تكدير الجو، ويمكن تسليط رأي من الآراء على الناس بهذا النوع من الأسلوب إلا أنه لن يحالفه النجاح أبداء لأن النجاح لا يتحقق إلا إذا قبله الناس عن رضا قلوبهم.
- ومن الأسف الشديد أن الذين يملكون نوعًا من أنواع السلطة، سواء أكانت تلك السلطة مصدرها الحكومة أو الثروة أو النفوذ يقعون في سوء فهم هو أنهم ما داموا يملكون السلطة فلا حاجة لهم أن يسلكوا لتطويع الناس لرأيهم وتجسيد إرادتهم طريقًا طويلًا متمثلًا في كسب رضا الناس بالإقناع، بل يفضلون استخدام القوة لذلك.
- إلا أن التاريخ الإنساني يؤكد أن هذا النوع من الممارسات القسرية أفسد طبيعة الشعوب ودمر أنظمة الدول، وانصرف بالناس عن طرق متسمة بالأمن والهدوء والعقلانية إلى الثورات والانقلابات العشوائية.
5- أهمية التخلى عن العصبيات:
- وآخر هذه الأمور في هذا الصدد هو: يجب أن نعد أنفسنا على التفكير والعناية بما فيه خير البلاد وصلاحها وتقدمها كمجموع، وأن نتخلى عن العصبيات المحدودة النطاق القليلة الفوائد.
- حيث إن تآلف رجال طائفة معينة من الطوائف الدينية بعضهم مع بعض، أو تجانس الناطقين بلغة واحدة بينهم، أو عناية سكان إقليم من الأقاليم بأبنائه أمر فطر عليه البشر، لا يجوز استنكاره وتقبيحه، ولا يطلب محوه، ولكن إذا جات طوائف صغيرة تلجأ إلى العصبية بناءً على مصالح محدودة، وتفتح المعارك الشرسة؛ لتحقيق مصالحها الطائفية وأهدافها المحدودة، فمن المحتم أن ينتهى هذا الوضع إلى تكبيد البلد والشعب بالأضرار والخسائر.
- فعلى كل منا أن يفهم جيدًا ويعمق في ذهنه تمامًا: أن لا يتجاوز حدوده الفطرية في صدد انتماءاته الطائفية أو الجنسية أو اللسانية أو الإقليمية.
- إذ إن العناية بكل شيء كلما تحولت إلى عصبية تعود دمارًا وخرابًا، لأن كل عصبية تثير عصبية مضادة، والعصبية ضد العصبية لابد أن تثير التناحر والنزاع، فكيف يفلح قوم تكون عناصرهم التكوينية قائمة على الصراع؟ هذه هي المبادئ الخمسة إذا لم يلتزم بها جميع رجال السياسة والدعوة في الأمة فلن يتأتى جو يوفر لها الأسس المتفق عليها، وإذا التقوا على وجه الافتراض، على اتفاق صناعي فلن يدوم ولن يعطى نتائج مرجوة.
- أسس النهضة:
- ودعنا ننظر الآن ما هي الأسس التي يمكن بناء نظام الحياة عليها في جو صالح من التفاهم والمصالحة، إلى أقصى حد.
الإسلام:
- أول أساس ينفعنا فيما نحن فيه هو «الإسلام»، أي نجعل كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- مصدرين للهداية والتشريع.
- وقد قررنا أول ما قررنا أن يكون «الإسلام بمصدريه أساسًا للاتفاق» لأن غالبية الأمة من المسلمين وهذا ما تقتضيه عقيدتهم التي يؤمنون بها، وما تتطلبه حضارتهم وتقاليدهم الموروثة. - وما يلح عليه تاريخهم في ماضيهم القريب يتعذر عليهم، بل يستحيل عليهم أن يعرضوا عن الأحكام والتعليمات التي جاءتهم من الله ورسوله، وأن يختاروا مناهج وشرائع أخرى تعاكس ما أمر به الله ورسوله عن رضا قلبهم؛ فإنهم لن يرضوا بقلوب صادقة مطمئنة بتنفيذ مناهج وأنظمة ما أنزل الله بها من سلطان ولن يقبلوا عن طوع أنفسهم شرائع وقوانين يرونها باطلة تنافى عقيدتهم وإيمانهم، فالشيء الذي أشعل في قلوبهم جذوة الحرية والاستقلال ودفعهم إلى التضحية بالأنفس والأموال والأعراض، كان يتركز على أنهم لم يكونوا يريدون أن يعيشوا في ظل حياة غير إسلامية وتحت قوانين كافرة، فقرروا أن يستبدلوا بها نظام الحياة الإسلامي، فمن العبث أن نتوقع منهم اليوم أن يرفعوا أيديهم طائعين عن الغاية التي قدموا في سبيلها ما قدموا من التضحيات الجسيمة حتى نالوا الاستقلال.
- ومن الممكن- بدون شك - أن يتحملوا مضطرين مكرهين ما يطبق عليهم من «حكم تسلطي» -عضوض- ما ينافي نظام الإسلام، أو يحول دون تحقيق غايتهم، كما سبق أن تحملوا على مضض حكما استعماريَّا- كافرًا- فيجوز حدوث ذلك.
- أما إذا جاء شخص يطبق عليهم باستخدام العنف نظامًا غير إسلامي في شعب لا يرضى به ثم يظن أنه موفق ناجح في خطته فهو رجل خالٍ من العقل.
الفئات التي ترفض الاحتكام إلى الشرع:
والذين يرفضون هذا الأساس؛ أي كون كتاب لله وسنة رسوله مصدرين للتشريع يشتملون على أربع فئات:
الفئة الأولى: هم «المسلمون» الذين اصطبغوا، في أخلاقهم وحضارتهم وحياتهم الاجتماعية بالصبغة الغربية لحد أنهم يرتعدون بمجرد أن يتصوروا منهج الحياة الإسلامية.
الفئة الثانية: هم الذين لا ينكرون كونهم مسلمين ولكنهم قد تأثروا بالأفكار والنظريات الغربية حيث إنهم لا يكادون يؤمنون بالإسلام .
فهاتان الفئتان بسبب اتجاهاتهم المعينة يصرون على الأخذ بالنظام العلماني و«الأصح اللاديني» إذ إنه هو الذي يناسب طبيعتهم وذوقهم.
الفئة الثالثة: تشمل المسلمين الذين لا يرفضون نظام الحياة الإسلامي، إلا أنهم يريدون الأخذ بالقرآن لا بالسنة «كي يستطيعوا تفسير القرآن بأهوائهم».
الفئة الرابعة: تشتمل على الأقليات غير المسلمة والتي تفضل دائمًا النظام العلماني على نظام المسلمين الإسلامي .
أما الفئات الثلاث الأولى فإن نسبتهم إلى مجموع السكان تمثل الأقلية؛ فهل من العدل أن يبنى نظام الدولة على أساس لا تريده الملايين وإنما تفرضه الأقليات؟ ولو بنى- على سبيل الافتراض- فأية قوة تستطيع أن تكسب قلوب الملايين من الناس لإنجاح هذا النظام العلماني. ولا نقول لهؤلاء القوم أن يغيروا أفكارهم بغتة ولكن الذي نحب أن نقول لهم: إن أردتم خير الأمة وفلاحها في نظام يؤمن به ويتفق عليه الأغلبية الساحقة في الأمة. وطبعًا إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون على النظام العلماني أو على نظام ما يسمى بالديني ولكن بدون أن تكون السنة أحد المصدرين فلكم أيها الناس أن تحتضنوا ما تريدونه من الأفكار لكن عليكم أن تدعوا مقاومتكم للنظام الإسلامي.
وفيما يتعلق بغير المسلمين في بلادنا، فكم من مرة حاولنا إقناعهم، كما تحاول إقناعهم الآن أيضًا، بأن شريعة المسلمين لا تسلط عليكم، ولا يتدخل أحد في ديانتكم وتقاليدكم الحضارية.
تمارسون أحوالكم الشخصية كما تشاؤون، ويعطى لكم من الحقوق في كل شعبة من الحياة ما لا يعطى في أي بقعة في الأرض للأقليات .
ومن ثم كيف تصح مطالبتكم بأن نظام الدولة لا يقام على مرضاة الأغلبية، بل يقام علي مرضاة الأقلية، وإذا كانت لا تطبق هناك أحكامكم الدينية فما هو الفرق بعد ذلك بين أن تطبق شرائع الإسلام أو تطبق قوانين الديانة الكاثوليكية، إذ بالنسبة لكم كلا النظامين أجنبي فعلى أي أساس أنتم ترفضون نظامًا وتريدون نظامًا آخر؟؟
ومن الأدلة التي تساق على رفض الكتاب والسنة مصدرين للتشريع أن هناك تفسيرات مختلفة متنوعة للقرآن ، وليس هناك تفسير بعينه اتفق عليه، وكذلك السنة فلا نجد فيها خلافات تفسيرية فقط بل هناك خلاف في نسبة السنة نفسها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف تكون أساسًا تجمع عليه أغلبية البلاد؟!!
ونقول ردًّا على هذا التساؤل: إننا نتخذ نفس القرآن مصدرًا للتشريع، لا تفسيرًا من تفسيراته، وكذلك نتخذ نفس السنة مصدرًا للتشريع لا مذهبًا بعينه من مذاهب السنة. وكون «السنة» أساسًا للحياة فهو أمر يتفق عليه جميع المسلمين ما عدا أقلية لا تذكر. أما الخلافات التي تحدث في تفسير القرآن أو شرح السنة فيمكن حلها بكل سهولة بما يلى من الطريقين:
الأول: إذا وجدت في المسلمين جماعة لا يستهان بها من الناحية العددية «كالأحناف أو السلفية» فقضاياهم تحل بما يأخذون به من تفسير للقرآن أو شرح للسنة.
الثاني: أما القضايا التي تعم البلاد وكافة السكان فيؤخذ في صددها تفسير يتفق عليه أغلبية البلاد. ويحق للأقلية أن تسعى جهدها لكسب الأغلبية إلى رأيها في حدود مشروعة.
نظام الشورى الإسلامي:
الأساس الثاني الذي يمكن الاتفاق عليه هو الديمقراطية، ونقصد من الديمقراطية نظام الشورى الإسلامي، ونستخدم مصطلح الديمقراطية الضرورة تعبيرية. ونظام الشورى مما يدعو إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الديمقراطية على عيوبها أفضل لتنمية الانتماء:
مما لا يكابر فيه أحد أن الديمقراطية كذلك تتضمن عيوبًا كثيرة وتزداد الديمقراطية فسادًا وفتنة إذا كان أهل البلد ينقصهم الوعي السياسي السليم، فيصابون بالتشتت الفكرى، والانحلال الخلقي، وتقوى فيه العناصر التي تفضل مصالحها الشخصية والعنصرية والطائفية والإقليمية، ومع اعترافنا بكل تلك الحقائق لا ننكر حقيقة كبرى هي أن نظام الشورى «أو النظام الديمقراطي في المصطلح الحديث» هو الطريق الوحيد لمعالجة عيوب الشعوب وإعدادها أممًا راشدة واعية.
ولكن ليس من طريق غير التجارب لإيجاد الكفاءة المطلوبة للممارسات السليمة الخالية من النقائص، زد على هذا أن النظام الديمقراطي هو النظام الوحيد الذي يثير في كل شخص الإحساس بأن البلد بلده وخير بلده خيره وشر بلده شره، ونشوء الخير أو الشر مرجعه صحة قراره الشخصي أو عدم صحته، وهذا الإحساس هو الذي يخلق في أفراد الشعب وعيًّا جماعيًّا نحو القضايا، وينشأ بذلك اهتمام الأفراد بصفتهم الفردية بالقضايا العامة. وبذلك يمكن آخر الأمر أن ينهض شعب بكامله ويستخدم ما يملك من القوة لإسعاد بلده بما فيه فلاحه، وتجنيبه ما فيه ضرره داخليًّا وعالميًّا.
الديكتاتورية أشد بلاء تصاب به الأمة:
أما الأشكال التي تقدم لنا مقابل النظام الديمقراطي فعلينا في هذا الصدد أن نفهم جيدًا أنه بقدر ما يكون سهلًا وميسًرا السير في طريق الدكتاتورية بعد تدمير النظام الديمقراطي بقدر ما لا يكون استعادة النظام الديمقراطي سهلًا وميسرًا. إن الدكتاتورية ولو قامت بطريق هادئ آمن لا يمكن القضاء عليه بطريق هادئ وآمن. كما لا يملك أحد الضمان بأن الذين قادوا الدكتاتورية في البداية هم الذين يتولون قيادتها في المستقبل، من الممكن أن ينقلب الأمر ويصبح الدكتاتور مسحوقًا والأمر مأمورًا، بل يصبح ضحية الدكتاتورية بشكل فظيع، ولذلك فإن على جميع الناس- الذين يمثلون الجماهير والذين يتجهون نحو النظام الدكتاتوري- أن يدركوا جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة؛ هل هم يستعدون لقبول نتائج الدكتاتورية هذه مادامت هي نتائج حتمية؟
والدكتاتورية مهما كانت صالحة التفكير، ومهما قامت بنوايا حسنة تولد طبيعتها طائفة من الخصائص التي لا تنفك عنها بتاتًا بل تثير المضاعفات الأخرى حتمًا.
وخلاصتها كما يلي: الدكتاتورية لا تتحمل النقد، وتحب المجاملة والتعلق، وهي تروج محاسنها وتستر عيوبها، ولا يمكن فيها كشف المساوئ، في وقتها وعلاجها في وقتها، وهي لا تتأثر بالرأي العام ولا تبالي بالأفكار والنظريات السائدة، ولا يدخل عليها أي تعديل أو تغيير داخلي بطرق مفتوحة بل بالمؤامرات وراء الكواليس الأمر الذي لا تراه الجماهير إلا كمتفرجين فقط وجماعة بعينها تملك نواصي البلد وتتصرف في قضاياها كما تشاء، بينما الآخرون يبقون مكتوفي الأيدي مسيرين، ولا يمكن في ظلها أن تتحرك قوة شعبية لغاية من الغايات برضا القلب وبإرادتها الخالصة. ومهما تبدو في بدايتها نافعة تتحول في النهاية إلى قوة قاهرة مستكبرة، فيأتي عامة الناس يتفكرون في الخلاص منها. إلا أن جميع طرق الخلاص منها بصورة سلمية تقفل واحدًا بعد آخر. وفي النهاية يدخل البلد عهد الثورات التي قليلًا ما تقربه بشاطئ النجاة.
هذه هي النتائج الصادرة من النظام الدكتاتوري فكل شخص يسبر فيها غوره بذهن صاف لا يفضل أبدًا أي نوع من أنواع الدكتاتورية .
- المقال ينشر بالعربية لأول مرة وقد ترجمه وأعده للمجتمع، الشيخ خليل الحامدي مدير دار العروبة في لاهور- باكستان
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل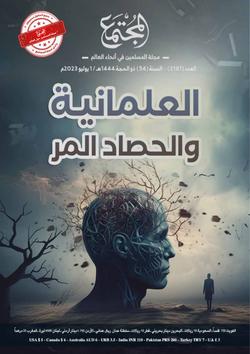
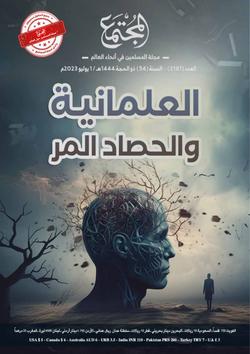
قراءة في مستقبل الأديان في العالم (3 - 3) الإسلام.. أرحام ولَّادة وأجيال يافعة
نشر في العدد 2182
35
الثلاثاء 01-أغسطس-2023