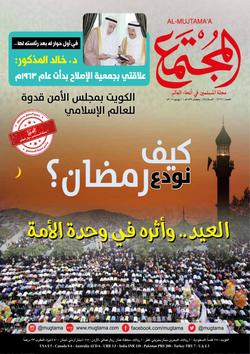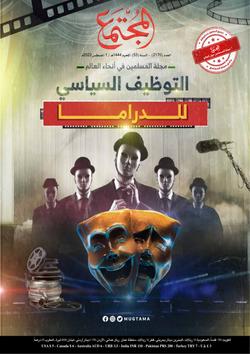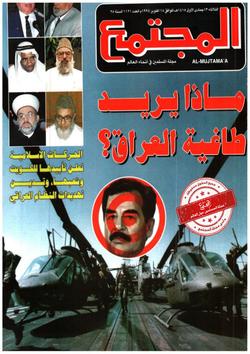العنوان مقال: 2170
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الاثنين 01-أغسطس-2022
مشاهدات 16
نشر في العدد 2170
نشر في الصفحة 52
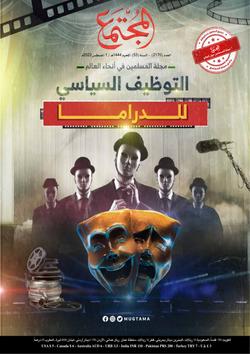
الاثنين 01-أغسطس-2022
كيف تحقق خشوع القلب في الصلاة؟
د. أحمد عيسي
ماجستير في الدراسات
الإسلامية
أشعر أن قلبي وقع في شبكات
الدنيا الفانية، ومتاهات الحياة المادية، وتسارعات العالم المتصادم الصاخب؛ فعليه
أن يتوقف! ليس بنبضه، ولكن بما يشغله ويملؤه، ليفر من هذا الاضطراب المحموم، إلى
لحظات سكينة وطمأنينة، لعله يجدها في خشوع الصلاة، ولكن كيف أحقق ذلك؟
إن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات، وفي الحديث عن معاذ: قال رسول اللّه صلى اللّٰه عليه وسلم: «ألا أخبرُكَ بِرَأسِ الأمرِ كلَهِ وعمودِهِ، وذِروةٍ سَنامِهِ؟»، قلتُ: بلى يا رسول الله، قال: «رأسُ الأمر الإسلامُ وعمودُهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سَنامِهِ الجهاد« (رواه الترمذي، صحيح)، والأمر هو الدين، ورأسه الشهادتان، وعموده الصلاة، أي كعماد البيت الذي لا يقوم إلا به.
عن عثمان رضي اللّٰه عنه، قال: سمعت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم
يقول: » ما من امرئ مسلم تحضره
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما
لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله» (رواه مسلم).
وفي «المصباح المنير»: خشع
خشوعًا إذا خضع، وخشع في صلاته ودعائه:
أقبل بقلبه على ذلك، وهو
مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت، وفي «المدارج»: الخشوع هو قيام القلب بين
يدي الرب بالخضوع والذل، وقال ابن رجب: أصل الخشوع لين القلب، ورقته وسكونه،
وخضوعه، وانكساره، وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه
خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له.
يقول اللّٰه تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُون (1)الْذِينَ
هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون﴾
(المؤمنون)؛ الذين هم في صَلاتهم إذا قاموا فيها خاشعون، وخشوعهم فيها تذللهم لله
فيها بطاعته، وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. (تفسير الطبري).
يقول السعدي: والخشوع في
الصلاة هو حضور القلب بين يدي اللّه تعالى، ستحضرًا لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن
حركاته، ويقل التفاته، متأدبًا بين يدي ربه، مستحضر جميع ما يقوله ويفعله، من أول
صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية، وهذا روح الصلاة، والمقصود منها، وهو
الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابًا
عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها.
وقال ابن كثير: والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه
لها، واشتغل بها عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما
قال النبي صلى اللّٰه عليه وسلم، في الحديث في النسائي بسند صحيح: «حُبب إليَّ الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في
الصلاة»، وقال صلى اللّه عليه وسلم: » يا بلالَ أقم الصلاةَ،
أرِحْنا بها» (رواه أبو داود، صحيح )
وكأن دخوله فيها هو الراحة من تعب الدنيا ومشاغلها؛ لما
فيها من مناجاة للّه تعالى وراحة للروحِ والقلب، وطلب الراحة في الصّلاة يصدر ممن
كان خاشعا فيها
المعاني القلبية التي تتم بها حياة الصلاة:
جاء في «إحياء علوم الدين»
(باختصار وتصرف): اعلم أن هذه المعاني تكثر العبارات عنها، ولكن يجمعها 6 كلمات،
وهي: حضور القلب، والتفهم، والتعظيم، والهيبة، والرجاء،
والحياء.
- 1حضور
القلب:
وهو أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما، ولا يكون الفكر جائلًا في غيرهما، ومهما انصرف عن الفكر في غير ما هو فيه، وكان في قلبه ذكر لما هو فيه، ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء، فقد حصل حضور القلب، يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق :37)
الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات
أصل الخشوع لين القلب وسكونه وخضوعه وانكساره
لا
علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة
؛ أي: قلب عظيم حي، ذكي، زكي،
فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات اللّٰه تعالى، تذكر بها، وانتفع، فارتفع، وكذلك من
ألقى سمعه إلى آيات اللّه سبحانه، واستمعها استماعا يسترشد به، وقلبه شهيد أي: حاضر، فهذا له أيضًا
ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. (تفسير السعدي).
وسبب حضور القلب الهمة: فإن
قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك ومهما أهمك أمر، حضر القلب فيه شاء أم أبى
فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه، والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلًا، بل
جائلًا فيما الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا، فلا علاج لإحضار القلب إلا بصرف
الهمة إلى الصلاة، والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها،
وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى، وأن الصلاة وسيلة إليها، فإذا
أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا، حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة،
وبمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر ممن لا يقدر على مضرتك
ومنفعتك، فإذا كان لا يحضر القلب عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك
والملكوت والنفع والضر، فلا تظنن أن له سببًا سوى فتور الإيمان، فلنجتهد في تقوية
الإيمان.
2-التفهم:
التفهم لمعنى الكلام أمر وراء
حضور القلب، فربما يكون القلب حاضرًا مع اللفظ ولا يكون حاضرًا مع معنى اللفظ
فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أريد بالتفهم، وهذا مقام يتفاوت
الناس فيه، إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات، وكم من معان
لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله، ومن هذا
الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر فإنها تفهم أمورا عن ذلك وسبب التفهم
بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى، وعلاجه إحضار القلب مع
الإقبال على الفكر والتشمر لدفع الخواطر، وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها
بالنزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها، وما لم تنقطع تلك المواد لا
تنصرف عنها الخواطر، فمن أحب شيئًا أكثر ذكره، فذكر المحبوب يملأ القلب، لذلك ترى
أن من أحب غير اللّه لا تصفو له صلاة عن الخواطر.
3 - التعظيم:
هو أمر وراء حضور القلب والفهم؛ إذ الرجل يخاطب الآخر بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه، ولا يكون معظمًا له، فالتعظيم زائد عليهما.
وهو حالة للقلب تتولد من
معرفتين؛ إحداهما معرفة جلال اللّٰه عز وجل وعظمته، وهو من أصول الإيمان، فإن من
لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه، والثانية معرفة حقارة النفسر وكونها عبدًا
مسخرًا مربوبًا ؛ فيتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع للّه سبحانه
فيعبر عنه بالتعظيم، وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال اللّٰه تعالى لا
تنتظم حالة التعظيم والخشوع، فإن المستغني عن غيره، الآمن على نفسه، يجوز أن يعرف
من غيره صفات العظمة، ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله، لأن القرينة الأخرى وهي
معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه.
4-الهيبة:
وهي زائدة على التعظيم، بل هي
عبارة عن خوف منشؤه التعظيم؛ لأن من لا يخاف لا يسمى هائبًا، فالخوف من لسلطان
المعظم يسمى مهابة، والهيبة خوف مصدرها الإجلال.
وهي حالة للنفس تتولد من
المعرفة بقدرة اللّٰه وسطوته ونفوذ مشيئته فيه، وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم
ينقص من ملكه ذرة، وكلما زاد العلم باللّه زادت الخشيه والهيبه.
5- الرجاء:
لا شك أنه زائد عما سبق، فكم
من معظم ملكًا من الملوك يهابه أو يخاف سطوته، ولكن لا يرجو مثوبته، والمسلم ينبغي
أن يكون راجيًا بصلاته ثواب اللّٰه عز وجل، كما أنه خائف بتقصيره عقابه.
وسبب الرجاء معرفة لطف اللّٰه
عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة، فإذا
حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعهما الرجاء لا محالة.
6 - الحياء:
مستنده استشعار تقصير وتوهم
ذنب، وسببه استشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق اللّه عز
وجل، ويقوي ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها، وميلها إلى الحظ العاجل في جميع
أفعالها، مع العلم بعظيم ما بقتضيه جلال اللّٰه عز وجل، والعلم بأنه مطلع على السر
وخطرات القلب، وإن دقت وخفيت، وهذه المعارف إذا حصلت يقيناً انبعث منها بالضرورة
حالة تسمى الحياء.
ما أحوجنا لتحقيق هذه المعاني
القلبية ليتحقق لنا الخشوع، وسط ضجيج لحياة المادية وتسارعها، ومشاغل الدنيا وهمومها
.•
أساتذة العقاد
وتجربة
العمى الطارئ
قل يُعقل ان
كاتبًا مثل العقاد لديه كل هذه المهارات وليس له أساتذة أو معلمون أو ملهمون؟
طلال مساعد
العامر
إمام وخطيب في
وزارة الأوقاف الكويتية
نستكمل في هذه
الحلقة الحديث الذي بدأناه في الحلقة السابقة حول نرجسية العقاد أو ما أسميناه
«سيرة الأنا في أنا العقاد«.
تطل نرجسية
العقاد من برج آخر، حين يظهر بأنه نسيج وحده وفريد دهره، حيث إنك بالكاد تحفل باسم
واحد لأساتذة العقاد، حتى إنك لتتساءل: هل بعقل أن كاتبًا مثل العقاد لديه كل هذه
المهارات التي لا يفتأ في سيرته يحدثنا عنها، وأيضًا لديه هذا الثراء الفكري
والتنوع الثقافي ليس له أساتذة أو معلمون أو ملهمون أو حتى زملاء، نفخوا فيه روح
الطلب أو صقلوا فيه هذه المواهب، أو علموه ما لم يكن يعلم؟
لكنها، في
تصوري، الأنا التي ربما -دون شعور الكاتب- لا تسمح بظهور أحد سواها في مسرح السيرة الذاتية.
بل إن ترجمته
الذاتية هذه لا تحفل بالعلاقات الاجتماعية؛ حيث يظهر فيها مترفعًا عن الناس، يأنس
بالبعد عنهم والخلوة بنفسه، حديًا في علاقاته؛ فإما أن يحب وإما أن يكره، لا توسط
لديه، يقول عن نفسه: ويغلب على المنطوين أنهم لا يألفون الناس بسهولة، وأعترف
بأنني واحد من المنطوين في هذه الخصلة.
فهو يعترف أنه مطبوع على الانطواء، لكن تأمل في اعترافه هذا : « إنني مطبوع على الانطواء، وإنني مع هذا خال -بحمد اللّه- من العقد النفسية الشائعة بين الأكثرين من أندادي في السن ونظرائي في العمل وشركائي في العصر الذي نعيش فيه«.
فانطواؤه
-بزعمه- لم يكن دلالة على علة نفسية؛ بل إنه يتمتع بالسلامة النفسية، إذ باستطاعته
أن يفضي بأي حديث وقتما يشاء ولم يكن انطواؤه هذا حائلا له عن ذلك، لكنه في الوقت
الذي يتبرأ فيه من الانطواء المرضي يرجم نظراءه وأنداده وشركاءه بالعقد النفسية
والمعاناة من الأسرار المكبوتة والخوف المرضي من البوح، وإيثار السكوت خشية
الكلام: فهو أيضًا يعترف أنه لا يعرف التوسط في العلاقات الاجتماعية بين الحب
والكراهية، ولا يريد أن يعرفه وشعاره قول الصولي: «واربًا بنفسك أن ترى إلا عدوا
أو صديقًا« .
حب مفرط للذات
لا يدع مجالًا لمخالف أو لمخطئ؛ فهو وإن كان يتعلل لمنحاه هذا بالعلل؛ فإن القرائن
السابقة على هذا الافتراض تذهب بالعلل كل مذهب، ثم إنه مخالف لآراء كثير من
العقلاء والحكماء، الذي يتمثل في شعرة معاوية، وفي قول علي بن أبي طالب رضي اللّه
عنه: «أحب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يومًا ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن
يكون حبيبك يومًا ما»، أما الرعونة في العلاقات وإقامة السدود فيها حينًا فهو ليس
من مذهب الأسوياء بله الحكماء، والغريب أنه برر مسلكه المتطرف هذا بسلامة علاقاته
من المنافع الشخصية، ويزعم أن الدافع إلى المرونة في العلاقات مع الناس والتوسط
بين الحب والكراهية هو ما يترقبه الناس من هذه المنافع؛ فهو يستدل على سلامة مسلكه
بفساد مسلك المخالف، وهل تبور الحجج إلا بمثل هذه المغالطات؟!
وقد التمس سببًا
قد يكون وجيها لهذه العزلة، يعود إلى زمن صباه، فحفر حفرة عميقة الغور للوصول إلى
المبرر المقنع والسبب الوجيه لإيثاره اعتزال الناس: حيث أرجعها إلى وباء انتشر في
مدينة أسوان وهو دون السابعة، وقد خلت المدينة حينها من أهلها، واعتزل الناس بعضهم
وحجروا أنفسهم في بيوتهم خوفًا من العدوى.
ولا أدري ما
مدى وجاهة هذا السبب في حبه للعزلة، ولا أدري أيضًا ما حال باقي الناس؟ هل جرى
عليهم ما جرى عليه من حب العزلة أم لا؟ لكن لا يخلو ما ذكره من طرافة؛ حيث إنه إن
صدق فيما قال فلنا أن نتساءل: ما حالنا بعد عامي الحظر والحجر في ظل وباء
«كورونا»؟ وما الآثار النفسية المرتقبة جراء التباعد الاجتماعي الذي قد يحصد ملايين
الملايين من الأرواح والعلاقات الإنسانية قبل أن يحصد المرض الحقيقي ملايين الأجساد ؟!
تجربة العمى
الطارئ
وربما يرتد إلى الأنا أيضًا ما عبر به عن شعور العمى الطارئ الذي أصيب به لما أجريت له عملية جراحية في عينه؛ فهو بالإضافة إلى أنه لم يهتز لها وبدا رابط الجأش غير مكترث للظلام الدامس الذي لفه، بدليل أنه يتباحث -كما ذكر - مع بعض جلسائه ضاحكًا عابثا حول الاختلاف في التعبير اللغوي عن إطفاء الأنوار بين أهل الشام وأهل مصر؛ إمعانًا في إظهار القوة النفسية التي يتحلى بها العقاد أمام هذه الأزمة التي عادة ينهار أمامها نظراؤه من العقلاء والمفكرين، ويمضي في هذا الاستعراض حتى يلوي عنق البلاء لصالحه؛ حيث إن عماه الطارئ تزامن مع إطفاء الأنوار في بلده لأجل الغارات الحربية يقول: «لأنني أطفأت الأنوار قبل أن تتصايح الأصوات حول الدار: أطفئوا الأنوار .. أطفئوا الأنوار« .
وقد قارنت بين
موقفه من العمى الطارئ وموقف الكاتب أحمد أمين، حينما أجرى عملية لعينيه اضطر لأن
يضع لضماد عليها لأشهر، ظل فيها في ظلام لطبق هيمنت عليه حينها عاطفة صادقة، ساقته
لأن يحاكي شعور من تألموا لفقد أبصارهم؛ فبكوا أنفسهم وأبكوا الناس، كبشار بن برد، وأبي العلاء المعري؛ بل كان عماه الطارئ هذا بمثابة
الفرصة المثلى لمراجعة النفس ومحاسبة الضمير والعودة إلى الذات لقاء ما فرط، وقد
استحضر أثناء هذه الأزمة النفسية التي مر بها اعترافات «تولستوي» ومراجعات الغزالي
في «المنقذ من الضلال»؛ فقد كانت فرصة فريدة للتعرف على الذات على حقيقتها متجردة
من الأوسمة والألقاب والهالات يقول: «إن الذي يوقعك في هذا التفكير المحزن هو
انطواؤك على نفسك وتقويمك لها قيمة أكبر مما تستحق، وهل أنت إلا ذرة صغيرة على هذه
الأرض ماضيها وحضرها ومستقبلها لكن للحق أقول: إن كلمات التشجيع والتنبؤ بالمستقبل
الواعد التي تلقاها العقاد هي التي قادت دفته للنجاح الآنا عند العقاد جعلته
يتجاوز في أثناء حديثه عن تكوينه الثقافي كُتَّاب عصره ويتجاهل نظراءه منهم ترجمته
الذاتية لا تحفل بالعلاقات الاجتماعية حيث يظهر فيها مترفعًا عن الناس يآنس بالبعد
عنهم والخلوة بنفسه
الثقافي
والكتابة المتميزة، فهو لا يفتأ يذكر كلمة للإمام محمد عبده في حقه لما تصفح
كراسته في صغره أثناء زيارة الإمام لمدرسته: «ما أجدر هذا أن يكون كاتبا بعد« .
يقول العقاد على إثر هذه الكلمة: «لا أبالغ إذا قلت: إن كلمة الأستاذ الإمام هي دون غيرها التي حفزتني إلى الكتابة« .
ولا شك عندي
أن أعدادًا غفيرة من مثل العقاد سواء كانوا في زمنه أم في أزمنتنا هذه يجلسون على
قارعة الحياة، تحمل بين جوانحها دفعات هائلة من الإبداع تستحيل بسبب الكبت
والتهميش والتنمر والحسد إلى طاقات معطلة ذابلة تؤثر السكون والعزلة، كانت تكفيها
كلمة تشجيع كهذه التي ألهمت العقاد فساقته سدة الريادة الثقافية.
إنصاف «أنا » العقاد صحيح أن الأنا عند العقاد جعلته يتجاوز في أثناء حديثه عن تكوينه الثقافي كتّاب عصره، ويتجاهل نظراءه منهم؛ بل ويضرب صفحًا عن ذكر شركائه في المشاريع الثقافية، إلا أنه من المفيد جدًا أنه ذكر لنا العديد من الكتب التي كوَّنت قاعدته المعرفية، والأهم من ذلك هو ما ذكره في سيرته الذاتية حول فلسفته في القراءة التي ترتكز على ثلاثة محاور :
- 1فهو لا يهوى القراءة ليكتب أو ليزداد عدد سني عمره، إنما يقرأ لأن
حياة واحدة لا تكفيه -على حد تعبيره- لكن القراءة دون غيرها تعطيه أكثر من حياة
واحدة ليس بعدد سنواتها طبعًا، وإنما بما تحويه الكتب من أفكار وتجارب أمضى فيها
مؤلفوها أزهى سني أعمارهم.
- 2شعوره العميق بما يقرأ ؛ فهو يعيش في صفحات الكتب التي يقرؤها كأنه
يحيا بين أحياء؛ حتى لكأنه يرى تلك الشخصيات الأدبية أو السياسية أو العلمية؛
فتتمثل له ملامحهم وعاداتهم، تجد ذلك مثلًا في قراءته للشاعر ابن الرومي.
- 3في صباه حينما كانت الكتب شحيحة في بيئته كان يضطر إلى إعادة ما يقرأ
؛ فتعلم من هذه الضرورة دستورا من دساتير القراءة خلاصته: إن كتابا تقرؤه ثلاث
مرات أنفع من ثلاثة كتب تقرأ كلًا منها مرة واحدة.•
الهامشان
(1) الخطر، أنا العقاد، ص 211.
(2) حياتي، أحمد أمين، ص 232.
مكانة الصدق
وأهميته في حياة المسلم
د. جمال نصار
أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ويقال: «صدق فلان في الحديث صدقاً: أخبر بالواقع».
والصدق يدعو
إليه العقل والشرع، خلاف الكذب، ومن هنا جاز أن ستفيض الأخبار الصادقة، حتى تصل
إلى درجة التواتر، ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة.
والصدق من
الأخلاق الأساسية التي يتفرع عنها غيرها، يقول بعض العلماء: «واعلم -رحمك اللّه-
أن الصدق والإخلاص: أصل كل حال، فمن الصدق يتشعب الصبر، والقناعة، والزهد، والرضا،
والأنس، وعن الإخلاص يتشعب ليقين، والخوف، والمحبة، والإجلال، والحياء، والتعظيم..
فالصدق في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به: صدق القلب بالإيمان تحقيقاً، وصدق النية في
الأعمال، وصدق اللفظ في الكلام».
وإنما كان
الصدق فضيلة، لأنه أهم الأسس التي تبنى عليها المجتمعات، ولولاه ما بقي المجتمع؛
ذلك لأنه لا بد للمجتمع من أن يتفاهم أفراده بعضهم مع بعض، ومن غير التفاهم لا
يمكن أن يتعاونوا، وقد وضعت اللغات لهذا التفاهم الذي لا يمكن أن يعيشوا بدونه،
ومعنى الإفهام أن يوصل الإنسان ما في نفسه من الحقائق إلى الآخرين، وهذا هو
الصدق».
وقد حث الإسلام على الصدق وبيَّن فضائله،
وأكد أنه من صفات النبوة، يقول تعالى: ﴿»وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً
نَبِيَّا﴾ (مريم: 41)، ويقول: ﴿وَاذْكُرْ فِي
الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً
نَبِيَّاً﴾ (مريم: 54)، وأمر عباده المؤمنين بالصدق، قال تعالى: ﴿يَا أيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة: 119).
من أهم مراتب
الصدق:
أولًا: صدق اللسان:
وذلك لا يكون إلا في الأخبار أو فيما يتضمن الأخبار ماضيًا أو مستقبلًا، ويندرج
تحته الوفاء بالوعد والخلف فيه، وحُق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه، فلا يتكلم إلا
بالصدق، وهذا هو أشهر أنواع الصدق.
ثانيًا: الصدق
في النية والإرادة:
ويرجع ذلك إلى
الإخلاص، وهو ألا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا اللّه تعالى، فإن مازجه
حظوظ النفس، بطل صدق النية، ويجوز أن يسمى صاحبه كذابًا .
ثالثًا: صدق
العزم: فإن الإنسان قد يُقدّم العزم على العمل، فيقول في نفسه: إن أعطاني اللّٰه
تعالى ولاية عدلت فيها، فهذه عزيمة تحتاج إلى صدق؛ لأنه بمنزلة التمام والقوة لها
كيلا يضعف أو يتغير وقت التنفيذ.
ولذلك قال النيي صلى اللّٰه عليه
وسلم: » رمَن
سَأَلَ اللّٰه الشّهادَةَ بصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللّٰه مَنازِلَ الشُّهَداءِ، وإنْ
ماتَ علَّى فِراشِهِ».
رابعًا:
الوفاء بالعزم: ذلك أن النفس قد تسخو بالعزم في الحال، إذ لا مشقة في الوعد
والعزم، لكن إذا حقت الحقائق وحصل التمكن، وهاجت الشهوات، انحلت العزيمة، ولم يتفق
الوفاء، ولهذا مدح اللّه تعالى هؤلاء المؤمنين الذين وفوا بعزائمهم، فقال سبحانه: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ (الأحزاب: 23).
خامسًا: الصدق
في الأعمال: وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو
به، وعلى المسلم هنا أن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر.
سادسًا: الصدق
في مقامات الدين: وهو أعلى الدرجات وأعزها، ومن أمثلته:
الصدق في الخوف، والرجاء، والتعظيم، والزهد، والرضا، والتوكل، وحب اللّه تعالى ورسوله صلى اللّٰه عليه وسلم.
من أهم فضائل
الصدق:
أولًا: أن
الصدق في القول يؤدي إلى الصدق في العمل والصلاح في الأحوال، يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً
سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (الأحزاب)، فالصدق في القول يؤدي إلى الصدق في الفعل، وهذا هو العمل
الصالح.
ثانيًا: الصدق
يهدي الإنسان إلى البر والخير، وقد بينه اللّه تعالى في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
وَالْمَلابِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِى الْقُرْتَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَاقَامَ الصَلاةَ وَاتى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ
هِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَآسَاءِ والضَّرَّاء وَحِينَ
الْبَأْسِ أولَبِكَ الْذِينَ صَدَقُوا وَأولَبِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾
(البقرة: 177).
ويقول النبي
صلى اللّه عليه وسلم:
»
إنّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلى البِرِّ،
وإِنّ البِرَّ هُدِي إلى الجَنّةِ، وإنّ الرَّجُل لَيَصْدُقَ حتّى يُكَتَبَ
صِدِّيقاً، وإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى
النّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حتّى يُكْتَبَ كَذّاباً «.
ثالثاً: الصدق
فيه النجاة، يقول تعالى: ﴿ قَالَ
الله هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن
تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللُّه عَنْهُمْ وَرَضُواْ
عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (المائدة: 119)؛ أي أن صدقهم في الدنيا ينفعهم في الآخرة، وفي
الحديث: «تحَرُّوا الصِّدقَ، وإن رأيتم أنَّ الهلَكةَ فيه فإنَّ فيه
النَّجاةَ»(8)، وعن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّٰه عنهما أنّ رجلا جاءَ إلى
النّبيِّ صلي اللّٰه عليهِ سلم، فقالَ: يا رسولَ الله، ما عَملُ لجنَّة؟ قالَ:
«الصِّدقُ، وإذا صدَقَ العبدُ بَرَّ، وإذا بَرَّ آمَنَ، وإذا آمَنَ دخلَ
الجنَّةَ»، قالَ: يا رسولَ اللهِ، ما عمَلَ النّارِ؟ قالَ: «الكذبُ إذا كذَبَ
العبدُ فجَرَ، وإذا فجرَ
كفَرَ، وإذا
كفَرَ دخل النّارَ».
رابعًا: الصدق
فيه الربح والفوز، يقول ابن عباس رضي اللّٰه عنهما : «أربع من كن فيه ربح: الصدق
والحياء وحسن الخلق والشكر»، وعن عبداللّه بن عمر رضي اللّٰه عنهما، أن النبي صلى
اللّٰه عليه وسلم، قال: »
أربعٌ إذا
كَنّ فيك فلا عليك ما فاتك مِنَ الدُّنيا: حفّظُ أمانة وصدْقُ حديث وحُسنُ خليقةٍ
وعِفَّةُ طُعْمةٍ».
إن الإسلام لا
يُعلَم المسلمين فضيلة لكلمة الصادقة وحسب، ولكنه يعلمهم أيضًا، كيف يجب أن يكون
تلقيهم لها، وكيف يجب أن تكون كفالتهم لها ولأهلها، وكيف يجب أن يكون مسلكهم إزاء
الكذب ولا يدين الإسلام الكذب و الاضليل حسب، ولكنه يميز بين ضروب من الرذائل،
ودرجات من الإثم، كلها تتصل بانتهاك المعرفة الصحيحة الصدق أصل كل حال فمنه يتشعب الصبر والقناعة
والزهد والرضا الإسلام لا يُعلّم المسلمين فضيلة الكلمة الصادقة وحسب بل كيف يكون تلقيهم
لها.
الهوامش
(1) المعجم الوسيط، 53
/1.
(2) أدب الدنيا والدين،
الماوردي، ص260 -261.
3) رسالة المسترشدين،
الحارث المحاسب حقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار السا للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة، الطبعة الخامسة، 1403ه - 1983، ص171.
(4) الأخلاق، أحمد أمين،
ص200 - 199.
(5) صحيح مسلم، حديث رقم
(1909).
(6) إحياء علوم الدين،
الغزالي، 387 /4 - 393 بتصرف.
(7) صحيح مسلم، حديث رقم
(2607).
(8) الترغيب والترهيب، 51
/4.
(9) مسند أحمد، حديث رقم
(6641).
(10) أدب الدنيا والدين،
ص261.
(11) مسند أحمد٠، حديث رقم (6652).
12) الفضائل الخلقية في الإسلام، أحمد عبدالرحمن، ص138 - 137.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل