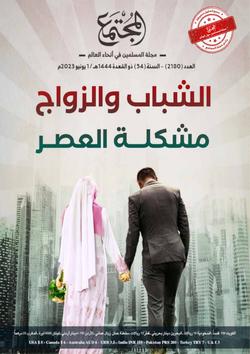العنوان ملامح من... المجتمع المسلم
الكاتب أحمد عثمان مكي
تاريخ النشر الثلاثاء 25-أبريل-1972
مشاهدات 17
نشر في العدد 97
نشر في الصفحة 19

الثلاثاء 25-أبريل-1972
مما يقر به الدارسون لعلمي الاجتماع والأجناس أن الإنسان منذ نشأته ظل يسعى جاهدًا مسخرا كل طاقاته وكل ما أكسبته له الأيام من خبرات وتجارب كي يؤسس مجتمعًا سعيدًا ينعم فيه بحياة مستقرة ويجد فيه راحة الشعور والضمير، ولعل هذا السبب كان هو الدافع القوي للعديد من الثورات والانتفاضات التي أحدثها الإنسان عبر تاريخه الطويل وحتى في تلك البقاع التي ظن البعض أنها قد تدرجت وتطورت حتى بلغت قمة عالية في التقدم والمدنية وتوفر أسباب الراحة والرخاء، حتى في هذه كانت الصيحات تتعالى مطالبة بالتغيير! ويدفعها لذلك الشعور بعدم الاستقرار النفسي الذي جعلها تعيش في حيرة وقلق وارتباك لغموض أهدافها في الحياة وطبيعة دورها في الوجود، فانساحت في تيه فكري مميت وتعددت أمامها السبل، وهذه الظواهر البارزة من حياة الإنسان اختلف في تفسيرها الباحثون ومنشأ هذا الخلاف هو اختلاف القاعدة التي ينطلق منها تفكير كل منهم، فضلًا عن فقدان بعضهم حلقات أساسية من هذه الظواهر إن هي غابت عن الذهن فلن يسلم تحليل النتائج من الخطأ ولحدث التناقض بين هذه النتائج وبين كثير من الأحداث التاريخية التي لا يشك أحد في ثبوتها وصحتها.
«نظرة الإسلام»
ينظر الإسلام إلى تلك الأطوار التي مرت بها البشرية في طفولتها فيعلل ذلك التيه والاضطراب تعليلًا دقيقا يبين فيه الداء وأصل الشقاء، وهو أن هذه العذابات النفسية والتعاسة التي مرت بالإنسان وطريق الهلاك الذي كان يمضي فيه، إنما حدث كل ذلك لأن القلوب خالية من الإيمان بالله ولأن الأرواح تقاسي من الخواء الروحي القاتل وقد بعدت عن الهداية والحق فاستمسكت بعقائد لا يقرها عقل واعٍ.
كما يذكر القرآن عن إبراهيم عليه السلام ﴿قَالَ أَفَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يَضُرُّكُمۡ * أُفّٖ لَّكُمۡ وَلِمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ﴾ (الأنبياء: 66-67) وبذلك أذل الإنسان نفسه ورآها تافهة لا قيمة لها..
ثم هانت عليه فرضي لها الهوان... ومن جراء ذلك عانت المجتمعات البشرية الكثير من ضعف وتفكك وحياة فراغ وضياع، حتى بعث الله برحمته وأنزل رسالاته من السماء لينهي طفولة البشرية ويأخذ بيدها من الضعة والاضطراب إلى الرفعة والاستقرار، ولكن كانت البشرية تنتكس كل مرة فتأتيها رحمة الله ثانية ثم تنتكس، فيبعث الرحمن لها من يبشرها ويذكرها ثم ينذرها حتى كانت خاتمة الرسالات التي جعلها الله آخر هداية للإنسان فكانت الدائمة الخالدة على مر الأزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
جاءت رسالة الإسلام فالتقطت الإنسان من سفحه وعماه ورفعته إلى منزلة السمو الروحي فربطته بقوة السماء ووثقت الصلة بينه وبين ربه.
وبأسلوب القرآن الذي تفرد به جعل الإنسان ذلك المهين يرفع ببصيرته إلى السماء ويتطلع إلى كرامته وإلى حقوقه العامة التي سلبها منه الطغاة والدجالون في حين غيبة عقله.
وبحركية الإسلام التي ميزته عن العقائد الأرضية اندفع الإنسان اندفاعًا وهو ينطلق مسرعًا إلى المجتمع السعيد الذي طالما أعياه البحث عنه وهو في ذلك التيه والضلال حين كان يزحف نحو الهاوية الخطرة، فنشأ ولأول مرة في تاريخ الإنسان المجتمع الكامل، أو اللقى الضائع! فانخرط في سلكه كل من أعمل عقله وفتح قلبه للحق من غير تعصب ولا مكابرة.
«مجتمع المدينة المسلم»
كان المجتمع المسلم في المدينة آية في كل أمر، وقد فاق حد التصور في سلامة تركيبه العضوي وقوة قاعدته التي يرتكز عليها، ذلك أنه كان المجتمع الأول الذي انبثق من عقيدة الإسلام واستمد منها وجوده، وهي تعده ثم توجهه ثم تطلقه في مسار رباني يحقق له سعادة الدنيا، والآخرة من بعد وترد أفراده إلى وحدة الأصل والمنشأ والمصير وهي ترسم لهم خطى الحياة الطيبة العفيفة ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء: 1).
فذابت نعرات الجاهلية ولم يعد رباط الدم هو الذي يكيف وضع المجتمع وعلاقات أفراده كما كان في الجاهلية القريبة، فامتدت الأخوة الشاملة حتى ساوت بين السادة والعبيد، وصار التفاضل بين أفراد المجتمع يخضع لقواعد جديدة الإيمان واستقامة العقيدة واتباع الرسول –صلى الله عليه وسلم– وبما يقدمه المسلم من عمل لربه ولمجتمعه حتى وإن لم ينتسب لأشراف العرب، بل ولا لملة العرب أجمعين، يذكر الرواة أنه كان بعض الصحابة يأتون بلالًا في دمشق ويذكرون فضله وما قسم الله له من الخير فيرد عليهم بقوله «إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدًا».
وتتجلى هذه المقاييس الربانية في أروع صورة حين جاء بلال إلى أبي بكر الصديق بعد وفاة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– فقال له: يا خليفة رسول الله: إني سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وهو يقول: «أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله»، فقال أبو بكر: فما تشاء يا بلال؟ قال: أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت، فقال أبو بكر: أنشدك الله يا بلال، وحرمتي وحقي، فقد كبرت وضعفت واقترب أجلي -يقصد إثناءه عن ذلك ليبقى بجانبه يعينه على أمور الدولة- وأقام بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو بكر، هذه صورة ما كانت تعرفها مجتمعات العرب الجاهلية أن يقوم رجل كأبي بكر، ينتسب لأشرف قبائل العرب يسعى لأن يسترضي ويقنع حبشيًّا لا يزال أثر قيد الرق على يديه، ولم؟ ليكون موضع رأيه ومشورته، ومودع سره!
لقد وثب المجتمع الإسلامي بالإنسان العربي وثبة ما عرفها التاريخ من قبل، فحرص على المساواة بين أفراده حرصًا يجعل الحق هو الفيصل بين الكبير والصغير وبين الرجل والمرأة أمام الحاكم، لا يؤثر على ذلك بيت ولا مركز، روي أن عمر بن الخطاب لما أخذ ابنه عاصمًا من زوجته المطلقة كانت هي تريد أيضًا أن تبقيه معها فاختصما إلى الخليفة الصديق ليقضي بينهما في شأن احتضان الولد، فقضى أبو بكر للأم دون عمر، وأمر أن يكون الولد تحت رعاية أمه وحضانتها، وقال مخاطبًا عمر: «ريحها وشمها ولطفها خير له منك».
هكذا يقضي أمام المجتمع المسلم دون أن تؤثر عليه مكانة عمر،
أقرب أصدقائه وأحبهم إلى نفسه، ودونما اعتبار لمواقف عمر أثناء بيعة أبي بكر يوم سقيفة بني ساعدة، وأنه هو-أي عمر- أول من بايعه وسانده ودعا الناس لمبايعته حتى إنه يبعث رسولًا لعلي بن أبي طالب وقد تخلف عن البيعة قائلًا له «إنك أقرب إلى رسول الله–صلى الله عليه وسلم– قرابة ولكنه أقرب منك قربة، والقرابة لحم ودم والقربة نفس وروح» ومع هذا لا يشفع له موقفه ذاك؛ لأن الأمور كانت توزن بميزان الإيمان ولأن حمية العقيدة هي وحدها التي تدفع للذود عن الحق وتجري العدل والإنصاف بين الأفراد. ولا حرج بين القاضي والمقضي عليه فالقلوب قد برئت من أمراضها.
وأفراد المجتمع على يقين تام بأنهم إنما يخضعون لدين رب البشر لا لحكم البشر لأن الحاكم لا يحكم بهواه، ولا يؤثر على قضائه حتى الانتصار لنفسه وأخذ القصاص لهما دون وجه حق. يدل على ذلك وصية علي بن أبي طالب بعد أن ضربه عبد الرحمن بن ملجم ضربة قاتلة بسيف حاد على رأسه يريد قتله-لاتفاق بينه وبين اثنين من الخوارج على أن يقتل هو عليا ويقتل الآخران معاوية وعمرو بن العاص- يقول علي في ذلك الموقف وهو يوصي ذويه وعشيرته: «النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. يا بني عبد المطلب، لا تجمعوا من كل صوب تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي» ثم يلتفت برأسه المشجوج إلى ابنه الحسن ويقول له: انظر يا حسن، إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربة واحدة، ولا تمثلن بالرجل لأني سمعت رسول الله –صلوات الله وسلامه عليه– يقول: «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور». هذه العدالة الرفيعة التي يطمئن المجرم تحت ظلها من أنه لا تضيع حقوق له، وإن جزاءه هو الجزاء العادل المبرأ مع الميل مع الهوى أو عصفة الغضب. هذه العدالة وجدت في المجتمع المسلم حيث وجد الإنسان راحة الضمير، ظالمًا كان أو مظلومًا، وحيث وجد الإنسان الأمن والطمأنينة مجرمًا كان أو بريئًا، الضعيف فيه قوي حتى يؤخذ له حقه، والقوي ضعيف حتى يؤخذ منه الحق.
ومن ملامح هذا المجتمع تلك الصفحات البيضاء الناصعة التي نستشرفها ونحن ننظر بين أرجاء المجتمع الرباني، فنرى حكامه قد زهدوا في حياة الدنيا ومتاعها وهم حفظة المال والمتاع، ولهم الأمر والنهي عن علي بن أبي الأرقم عن أبيه قال: رأيت عليا وهو يبيع سيفًا له في السوق ويقول: من يشتري مني هذا السيف فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله –صلى الله عليه وسلم–، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته».
ونرى صورًا من العلاقات التي كانت تسود بين الراعي والرعية، واهتمام أولي الأمر بأفراد رعيتهم فنعجب لها نحن من بعد أربعة عشر قرنًا، بل ويظن أناس أنها من الأساطير أو من نسج الخيال. يروي أنس بن مالك: بينما عمر يعس بالمدينة إذ مر برحبة من رحباتها فإذا هو ببيت من شعر لم يكن بالأمس-وفي هذا دلالة على أنه يطوف بها كل يوم- فدنا منه، فسمع أنين امرأة ورأى رجلًا قاعدًا، فدنا منه، فسلم عليه، ثم قال: من الرجل؟ فقال: رجل من أهل البادية، جئت أمير المؤمنين أصيب من فضله، فقال عمر: ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت؟
فرد عليه قائلًا: انطلق يرحمك الله لحاجتك! قال عمر: على ذلك ما هو؟ قال: امرأة تمخض، قال: هل عندها أحد؟ قال: لا. فانطلق أمير المؤمنين حتى أتى منزله، فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة عربية تمخض ليس عندها أحد قالت: نعم إن شئت قال: فخذي معك ما يصلح للمرأة في ولادتها من الخرق والدهن، وجيئيني ببرمة وشحم وحبوب فجاءت به وقال لها: انطلقي وحمل أمير المؤمنين البرمة ومشت أم كلثوم خلفه حتى انتهى إلى البيت، فقال لها: ادخلي إلى المرأة. وجاء حتى جلس إلى جانب الرجل فقال له: أوقد لي نارًا. فجعل، فأوقد تحت البرمة حتى أنضجها، ووضعت المرأة، فقالت أم كلثوم، يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام! فلما سمع الرجل قولها «يا أمير المؤمنين» هاب عمر فجعل يتنحى عنه -وهذا يدل أيضًا على أن الراعي لم يكن يتميز عن رعيته حتى يكاد الغريب لا يعرفه- فقال عمر للرجل: مكانك كما أنت! وحمل عمر البرمة ووضعها على الباب ثم قال لأم كلثوم، أشبعيها -أي للمرأة الوالدة- ففعلت وأخرجت له البرمة، ثم قام عمر – رضي الله عنه – فأحضرها ووضعها بين يدي الرجل وقال له: كُل ويحك! فإنك قد سهرت من الليل، ففعل ثم قال لامرأته: اخرجي، وقال للرجل: إذا كان غدا فائتنا نأمر لك بما يصلحك، ففعل الرجل وأجازه عمر وأعطاه ما يصلحه ويقوم بحاجته».
إن المرء ليتوارى خجلًا أن يقدم صورًا كهذه للذين يتولون مقاليد الأمور في البلاد التي تسمى بالعالم الإسلامي وما الخجل إلا لبُعد ما بين الإسلام وبين من ينتسبون إليه، بُعد في التصور، وبعد في السلوك، وبعد في الصلة بالعلي الجليل حتى حدثت الجفوة بين الإسلام والمسلمين، وتغيرت معالم المسلمين حتى خرج بعضهم عن دائرة الإسلام وصرح بكفره قولًا أو عملًا.
وتردى في التخبط والضياع من جديد، وأصابه البؤس والشقاء من جديد، ونسى ما كان عليه أمر أسلافه من الهلكى، وزاغ عن الدرب فأزاغ الله قلبه. كل هذا بينما لا تزال معالم الإسلام ثابتة راسخة تمد يدها للحيارى التعساء إن هم أرادوا السعادة وإزالة هذا الشقاء. ولكن حقًّا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾ (الرعد: 11).
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلالقيم العلمية والأخلاقية في الحضارة الإسلامية.. الدين والحياة وجهان لعملة واحدة
نشر في العدد 1811
42
السبت 19-يوليو-2008
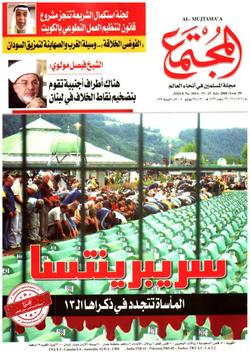
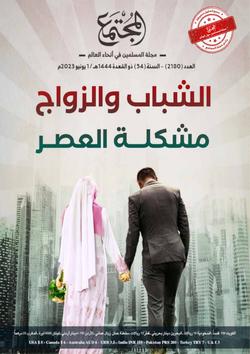
العادات الاجتماعية بالدول العربية وتأثيرها على زواج الشباب
نشر في العدد 2180
150
الخميس 01-يونيو-2023