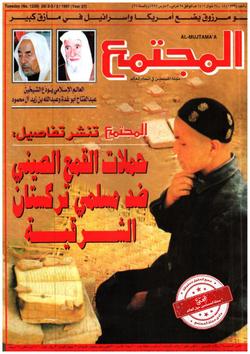العنوان المجتمع التربوي (1291)
الكاتب د.عبدالحميد البلالي
تاريخ النشر الثلاثاء 03-مارس-1998
مشاهدات 38
نشر في العدد 1291
نشر في الصفحة 56
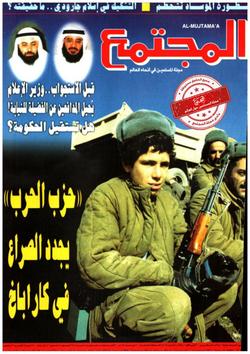
الثلاثاء 03-مارس-1998
• من فقه الظواهر الدعوية في ضوء السنن الإلهية (٢من 3)
• كبت الفكر وفكر الكبت في المجال الدعوي.
• الحوار يؤدي إلى تطور الفرد والمربي معًا، ومناخ الحرية والشورى هو الذي يبني الرجال ويصنع الأحرار في الدولة المسلمة.
بقلم: د. حمدي شعيب
بالنظرة الكلية لظاهرة كبت الفكر وفكر الكبت تلك السنة الإلهية الاجتماعية على أساس أنها سنة إلهية تتميز بالثبات والاطراد، فيمكننا البحث عن مرتكزات عامة لتلافيها، أو لعلاجها، أما من حيث الأسباب فهي لا تختلف كثيرًا عما ذكرناه من عوامل أثرت على ذلك الفني المعتل ويمكننا أن نضعها على قسمين رئيسيين أولًا: عوامل داخلية، وهي العوامل الفسيولوجية أي التي تعود إلى طبيعة وشخصية الفرد نفسه، ثانيًا: عوامل خارجية تجمعها حالة مناخية من الكبت الفكري، وهي:
١- عوامل تعود إلى توجهات المربين، من حيث واقعية التعامل مع الفرد، إما إفراطًا أو تفريطًا.
٢-عوامل تعود إلى التوتر المناخي الاجتماعي السائد وأثره على الفرد.
٣-عوامل تعود إلى الصراع والضغط النفسي والرقابي على الفرد من داخل مؤسسته أو من خارجها من المجتمع المحيط.
وبعيدًا عن العامل الشخصي أو الفسيولوجي فإن المحصلة العامة للأسباب إجمالًا، هي التي تعود إلى طبيعة المناخ الاجتماعي داخل أي مجال وارتباطه بالسلوك الاجتماعي للأفراد المنتسبين له.
وخلاصة ذلك أن السلوك يكون أثرًا ونتيجة للمناخ والتوجه السائد، وقد تتضح القضية أكثر من خلال الحديث عن العلاج.
ب- أما عن المظاهر: فهي صور متعددة ومنوعة للسلوك الاجتماعي للأفراد داخل المؤسسة والذي يترجم الواقع العملي للفكر المعوج، أي فكر الكبت وفكر الكبت هذا ما هو إلا محصلة نهائية أو إفراز طبيعي لحالة أو مرحلة الكبت الفكري، التي قد تسود المناخ الاجتماعي للمؤسسة.
ونجد أن هذه الظاهرة تبرز في نسب مختلفة من السلوك، فتتدرج من مجرد التهتهة إلى أن تبلغ الشدة في حالات متقدمة من البكم الفكري، والتعبيري، والدعوي، والحركي، والتنظيمي، والتربوي.
1 - أما عن التهتهة والبكم الفكري، وهي حالة من عدم القدرة أو العجز، حيث يبدو فيها الفرد في حالة من عدم الإدراك للفكرة أو الوسائل والأهداف التي تقوم عليها مؤسسته، وتكون الشدة عندما يصل إلى درجة البكم الفكري.
٢- التهتهة والبكم التعبيري، وهي حالة يبدو فيها الفرد عاجزًا نسبيًا أو كليًا عن التعبير عن أفكاره والتي يدركها.
وتدبر ما ذكرناه من المثال القرآني حول الأبكم الكل، العاجز، وكيف لا يستوي مع الرجل الذي على صراط مستقيم، وهو الذي يستطيع التعبير والحركة بفكرته فيأمر بالعدل.
٣- التهتهة والبكم الدعوي، وهي نوعية يبدو فيها الفرد مدركًا للفكرة والوسائل والأهداف وقادرًا على التعبير، ولكنه إما في حالة التهتهة الدعوية، حيث يبدو موسميًا في نشاطه، ودعوته إلى ما يحمله من أفكار وإما في حالة من البكم الدعوي، فيكون صائمًا تمامًا عن الدعوة.
٤- التهتهة والبكم الحركي، وهي نوعية المدرك للفكرة القادر على التعبير عنها والداعي لها بنشاط ولكنه إما في حالة من التهتهة الحركية أي لا يحمل الذاتية والمبادرة والقدرة على التجديد في وسائله، وإما يكون في حالة من البكم الحركي، فلا يتحرك إلا إذا حرك ولا ينشط إلا إذا نشط، وهي حالة من الإفراط في فهم معاني الجندية، وتطبيقها.
٥-التهتهة والبكم التنظيمي، وهي حالة ذلك الفاهم المعبر الداعي النشط ولكنه إما على حالة من التهتهة التنظيمية، فيميل إلى الفردية وعدم التنسيق مع غيره من الأفراد، وإما على حالة من إلبكم التنظيمي، فيكون كثير الانتقاد لغيره مع العجب بأعماله وهي درجة نسبية من التمرد المقنع، التي يفتقد الفرد فيها فقه معاني الحركة الجماعية، والعمل المؤسسي، وأولويات المرحلة وفقه الموازنات.
٦- التهتهة والبكم التربوي، وهي نوعية ذلك الفاهم والمدرك لفكرته القادر على التعبير النشط في حركته المنضبط مع حركة المجموع، ولكنه على درجة من الدعة والسكون الفكري والدعوي، فيظل دومًا أسيرًا لمرحلة فكرية معينة، ولا يؤمن بالمرحلية الفكرية والتجديد التعبيري، فإذا تركته وعدت إليه بعد سنوات تجده يراوح عند نفس المستوى السابق، ويفتقر إلى القابلية للتطور والنماء.
وهناك صورة أخرى لهذه التهتهة التربوية تجد فيها الفرد يفتقر إلى التوازن والاعتدال أو الوسطية في جوانب التربية المختلفة.
ج- أما عن العلاج: فخلاصته أن نضع نصب أعيننا الأسباب المؤدية إلى تلك الحالة المرضية، ونحاول تلافيها، خاصة الاهتمام بأثر المناخ الاجتماعي، وتوجهات القائمين على العمل ولو قسمنا العلاج إلى قسمين رئيسيين على اعتبار الأسباب، فنجده:
أولًا: علاج الأسباب الداخلية الفسيولوجية وهذا يرتبط بمراعاة شخصية الفرد، وطبيعة تكوينه
1. في البداية يكون بحسن الاختيار والاصطفاء للأفراد.
٢-ثم بحسن التوظيف الجيد للفرد، ذلك بمراعاة قدرات وخصائص وشخصية كل فرد، فإن لكل مرحلة أفرادها، فإذا كانت بعض المراحل تتطلب الرواحل، فإن غيرها لا تتطلب إلا أنصاف الرواحل وأن لكل مهمة رجالها، بحيث يشعر كل فرد أنه على ثغرة لا يحرسها غيره، وواجبه أن يهتم بما أوكل إليه، فذلك من شأنه ألا يشعر الفرد ذو القدرات المتواضعة بالتقصير، ولا الفرد البارز بالعجب، قال رجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أتيتك في حاجة صغيرة، قال: فاطلب لها رجلًا صغيرًا.
ثانيًا: علاج العوامل المناخية الاجتماعية السائدة، وهو القسم المهم للوقاية من بروز تلك الظاهرة الاعتلالية، وذلك من أجل إيجاد ذلك المناخ الاجتماعي الصحي المنشود، الذي ألمحنا إليه في الدراسة التي أثبتت أن المناخ الحر الإقناعي، هو من أفضل الأجواء للبذل الجماعي، وكيف أنه ينتج سلوكًا انفعاليًا سويًا، ويفرز سلوكًا اجتماعيًا إيجابيًا منشورًا.
كما أنه هو المناخ المبارك الذي يفجر طاقات الفرد، ماديًا ومعنويًا، وذلك كما نفهمه من مغزى ذكر المثالين القرآنيين عن الأبكم والأمر بالعدل، ثم عن العبد المملوك والرجل الحر.
وهو المناخ المبارك الذي يعود بالخير على الفكرة، وعلى الأمة سواء الحاكم والمحكومين كما نفهمه من مغزى ذكر حالة قبول الفكرة ونجاة الأمة الممثلة بمملكة سبأ، مع المقارنة بما حدث مع فرعون وملئه وسنكتفي بذكر أبرز السمات المهمة والمنشودة والتي من شأنها أن تفرز مناخًا
اجتماعيًا صحيًا، فمنها:
١-الفقه الجيد للفكرة ولطبيعة الطريق وهي سمة قد يبنى عليها كل السمات الأخرى، وكذلك قد ينتج عن عدم الأخذ بها كل أنواع الخلل. وهذه تحتاج إلى المربي الذي يدرك أهمية وضوح الفكرة، وتدبر تعليق الرسول صلى الله عليه وسلم على أسئلة واستفسارات وفد بني شيبان المكون من مفروق بن عامر وهانئ بن قبيصة ومثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، وذلك في نهاية جلسة المفاوضات «ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق فإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه». (٢)
وكذلك الدعوة لن ينصرها إلا من فقهها وأحاطها من جميع جوانبها، ويدرك الحوار والمناقشة في تطور الفكرة في ذهن الفرد، وتأمل كيف كان عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنه يحرك تلاميذه ويستثيرهم: «ما لكم لا تسألوني؟ أأفلستم؟».
والحوار هو الأسلوب الذي يؤدي إلى تطور الفرد والمربي معًا، لأن القائد ينمو إذا كان يتحرك في مجموعة وينتهي إذا تخلى عنه من معه، قال الإمام الشافعي رحمه الله «كان الليث أفقه من مالك، إلا أنه ضيعه أصحابه» (٣)
2-الحرية: وهي سمة رئيسة يمكن أن نستشعرها من خلال تدبر تلك التجربة التغييرية التي قادها ذلك الصحب المؤمن من أصحاب الكهف، وكيف قال الحق سبحانه عنهم و ﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا﴾. (الكهف:١٩-٢٠).
لقد شاء سبحانه أن يستيقظ هذا الصحب الطيب من الرقدة الطويلة، وكان أول ما حدث هو التساؤلات المتبادلة حول المدة التي انقضت وهم نائمون، وكان الاتفاق الجماعي على ترك سر ذلك لعلم الله سبحانه والانشغال بما يفيد وبما ينبني عليه عمل، فهم جائعون ويحتاجون للطعام.
وأهم ما يتبادر إلى خلد القارئ المتدبر لحال هؤلاء الفتية المؤمنين عند استيقاظهم هو جو التساؤل وكانه هو المقصود من عملية بعثهم ﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ ﴾.ففي جو من الحرية وأخذ الرأي ومن التشاور، قد تم هذا الاتفاق الجماعي على ما يجب عمله كما اتفقوا مسبقًا على الاعتزال والإيواء إلى الكهف عند مواجهة المجتمع، فقد اتفقوا على الانشغال بما يفيد، وبما ينبني عليه من فعل إيجابي، وترك علم الغيب لله عز وجل، وهي القضية المباشرة والمقصودة من سرد القصة وهو ترك علم الغيب لله، لأنهم بذلك الجو الصحي، إذا اتفقوا على أمر معين فيما بينهم كان هذا ادعى أن يؤمن به غيرهم، وإلا فكيف سيواجهون الواقع بما لم يقتنعوا به أصلًا، ولم يتفقوا عليه؟
وهو ملمح طيب يذكر الدعاة والمربين ويؤكد على أهمية جو الحرية الذي كان من أثره الطيب هذا الاتفاق الجماعي والاقتناع بالفكرة قبل عرضها على الآخرين، وألا تطالب الغير بما لم تقتنع أنت به أصلًا، وعلى هذه الأسس يبنى الرجال ويصنع الأحرار.
٣-الشوري: وهي سمة ترتبط بوجود السمة الأولى فلا شوري بلا حرية ولا حرية بلا شورى، وهي مبدأ يكفي فقط أن نذكر أن سورة قرآنية عظيمة تحمل اسمها وفيها يقول الحق سبحانه مؤكدًا على ضرورة وجودها ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ۳۸)، وهي صفة وميزة بل وركيزة من ركائز وجود أي مجموعة بشرية، ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة، فإننا نجد أنها من صفة هذه الجماعة المسلمة، مما يوحي بأن وضع الشوري أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظامًا سياسيًا للدولة، فهو طابع الساسي للجماعة كلها، يقوم عليه أمرها كجماعة، ثم من الجماعة إلى الدولة، بوصفها إفرازًا طبيعيًا للجماعة (1) .
ونواصل في العدد القادم إن شاء الله تناول بقية السمات.
-------------------------------------
الهوامش
1 -بهجة المجالس وأنس المجالس١/٣١٢
٢-مختصر السيرة ابن عبد الوهاب ١٣٤ نقلًا عن النهج الحركي السيرة النبوية منير الغضبان ١/١٤٣
٣-حسن المحاضرة السيوطي ١/٢٠١ نقلًا عن القيامة جاسم المهلهل ٥٨
٤- في ظلال القرآن سید قطب ٢٥/٣١٦٠.
• كلمة إلى الدعاة.. غربة الهدهد
المتأمل في قصة هدهد سليمان يجد العجب العجاب في أمر هذا الهدهد، فعندما ذهب إلى مملكة سبأ، وشاهد ما فيها من عقائد باطلة اصطدم هذا الواقع الملموس بما تربى عليه الهدهد في مجتمع سليمان عليه السلام، وأحس بخطأ ما كانوا عليه، لذلك بادر بالتغيير، ولأنه تربى في مجتمع منظم له قيادة واعية رجع على الفور إلى قائده المسؤول عنه ولم يتصرف تصرفًا عشوائيًا.
وهذا الشعور، وهو شعور الغربة، هو الذي لابد أن يصاحب أفراد الصحوة وهو من المقاييس المهمة التي يقيس بها الفرد مدى صحة إيمانه؛ لأنه عندما يخالط المجتمع يجد قيمًا وأخلاقًا تصدم بما تربى عليه من مبادئ وقيم.
والشعور بالغربة له مردود على الفرد وكيفية تعامله مع المجتمع، فإما أن ينعزل تمامًا عن المجتمع تجنبًا لهذا الخطأ، وإما أن يتعامل مع المجتمع بعنف محاولًا تغيير هذا الوضع بالقوة، وهذان بالطبع مرفوضان.
لذلك كان دائمًا العمل الواعي المنظم داخل مجتمع وبيئة منظمة تتسم بأن لها قيادة واعية محكومة بضوابط الكتاب والسنة قائمة على الشورى مع السمع والطاعة ووفق أفراد يعي تمامًا كل منهم الدور الذي يقوم به وأنه لا مجال للفردية فيه، ولذلك فإن هذا المجتمع جدير بأن يصل إلى أهدافه المرسومة وغاياته المنشودة ليصل في النهاية إلى جنة الغرباء مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبي للغرباء»
وائل عبد الغفار علي
• نحو تطوير الذات «الحلقة الأخيرة »
عدنان القاضي
الأساس السابع: الاستفادة من التجارب أو الحياة التجريبية التي ينبغي أن يعيشها الإنسان.
يقول الأستاذ فتحي يكن: «ينبغي أن تسعى الأمة الإسلامية للاستفادة من كل التجارب العلمية التي أنتجتها الحضارة الإنسانية، ومن كل ما تفتقت عنه عقول البشر في شتى الحقول والميادين، ولذلك كان الإنسان يحرص على المجالسة للآخرين ليستفيد من تجاربهم وينتفع بما لديهم».
لا يكتسب الإنسان التجارب إلا بالحركة واقتحام الصعاب ومراجعة الناس في أعمالهم وتجمعاتهم ثم يبني تجاربه السابقة باللاحقة وبذلك يكون الإنسان مرجعًا ورمزًا وقدوة للآخرين القليلي الخبرة، ورد في هذا المعنى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله: «والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد بألف دينار من بيت الله فقالوا: يا أمير المؤمنين تقول هذا مع تحرّيك وحفظك للمال وتشددك في هذا الجانب، فقال عمر: أين يذهب بكم؟ والله إني لأعود برأيه وبنصيحته وبهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف»، وإذا سألنا عن سبب حرص عمر بن العزيز رحمه الله كان الجواب أن عبيدًا صاحب تجربة، وكلنا بحاجة إلى كل تجربة ومن أي إنسان ومن أي مجال من المجالات حتى تتطور النفس، ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله ، وهو في الحبس بأنه استفاد من كلام بعض المجرمين وبعض القتلة عندما كان يأتي إليه يقول: يا إمام لقد ضربت ألف سوط في شرب الخمر، وأنت على الحق، وكانت تلك الكلمات تقوية لقلبه وتثبيتًا له على النهج الحق.
علينا انتهاز كل فرصة سانحة من أجل زيادة الخبرات حتى تتراكم وتصبح وسيلة لتطوير الذات.
إن أفضل تجارب ينبغي على الدعاة دراستها ما ورد في القرآن الكريم من سير الأنبياء والمرسلين والصالحين، ثم سيرة صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، ثم سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الأبرار، والتابعين الأخيار وتابعيهم الكرام، ثم الصالحين من رجالات الإسلام المعاصرين، وأولي النهى والعقول الراجحة وبعدها يكون الداعية على خطى خطوته السابعة لتطوير الذات.
الأساس الثامن أن يمتلك الإنسان قدرة على الإبداع:
الإنسان السامي، والإنسان المبدع لا يرضى لنفسه أن تكون طبق الأصل لغيرها، ولا يرضى أن يكون مقلدًا في كل شيء دون إعمال فكر وتمحيص رأي، وإلا أصبح يراوح مكانه لا يجد سبيلًا يرقى فيه، على أننا نحذر من الابتداع بل نبدع ونخترع في الفصول لا بالأصول نتحرر من الجمود وننهض من الرقاد نعمل جاهدين واعدين يقول الأستاذ فتحي: «من الصفات التي يجب أن تتوافر فيمن يرشح لمهمة للتغيير صفة الإبداع، أي صفة العطاء والإنتاج الصفة التي تجعل المسلم في مجتمعه طبيعيًا وليس ذيليًا، نشيطًا متفاعلًا وليس كسولًا خاملًا» ويضيف أبو الأعلى المودودي رحمه الله: «ولا نكاد نغثر في هذه القرون على أثر فكرة مبتدعة واختراع مبتدع واكتشاف جديد، وبذلك طرأ علينا جمود فكري وغشي أجواءنا العقلية سحابة سوداء من العلم والتبلد».
ويؤكد على أهمية الإبداع صاحب كتاب «صناعة الحياة» الشرط اللازم لصناعة الحياة هو أن يبدع ويكون مجتهدًا ويأتي بالنادر الطريف، والحقيقة أن الإبداع ليس بدواء يوصف إنما يوفق له اللبيب ويميزه الخبير بعضه تجديد يأتي على غير مثال وسابقة، وبعضه تمرد على المألوفات والمسلمات المتوهمة إذا أدرك تخلفها واضطراب منطقها، وبعضه اشتقاق وقياس.
الداعية مطالب بالإبداع في بضاعته للناس مطالب بحسن العرض وبلطف التعامل، وبجودة السلعة، وبالإخراج الفريد.
والداعية الفذ لا تقف أمامه العقبات أو تميله المزالق بل تجده يعمل فكره من أجل التفادي ثم الانتصار ثم التمكين، فهذا المجهول في معركة القادسية عمد إلى صنع فيل من طين وأنس به فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذي كان يقدمها، فقيل له: إنه قاتلك قال لا ضير أن أقتل ويُفتح للمسلمين.
الأساس التاسع: أن يمتلك الإنسان القدرة على التخطيط.
لا يمكن للمرء أن يتطور ويسمو بدون تخطيط مسبق وعمل منظم متدرج المراحل مرسومة خطواته متوقعة عقباته مكتوبة تفصيلاته، والتخطيط ليس محصورًا على جانب من الجوانب بل إنه يشمل الإيمانيات والعلوم والثقافة والإدارة و ولنفصل القول في الأساسيات الأولية لأي خطة تطويرية:
١-إعداد البرنامج المراد تحقيق الأهداف من خلاله.
٢-الجدية والحسم في تنفيذ البرنامج الموضوع مع مراقبة الله تعالى والإحسان في الأداء والتنفيذ.
٣-أن يكون البرنامج مصحوبًا ومشفعًا بزمن لكل مرحلة من مراحله: متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟
٤- تجنب التضارب المحتمل حدوثه بين البرنامج والالتزامات الضرورية أو بعض الارتباطات الشخصية.
٥-التقويم المستمر والجاد للنفس: ماذا حققت؟ ولماذا تأخرت؟ ولماذا تعقبت؟ وكيف التخطي؟
٦- بعد النجاح في البرنامج قم بإعداد برنامج آخر يخدم جانبًا آخر من جوانب الشخصية غير السابق حتى تتم الاستفادة ويتم التطوير بشكل متوازن لجميع أعضاء الجسم، العضلية والعقلية والفكرية والنفسية وبهذا الأساس تكون قد أتممنا الأسس الهامة لتطوير الذات وقمنا بوضع القدم على أول الطريق بدون يأس أو تكامل نستمطر العون والتأييد من الله عز وجل ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾) التوبة:١٠٤)
تلك الأسس التي اجتهدنا في موضعها إن لم تلاق إرادة وعزمًا راسخًا، وجدية للعمل بها أصبحت ثقافة تغذي العقل ولا تحرك الجوارح وأصبحت أدبيات فارغة من أي روح تمشي بها في الناس تعمل وتخدم من مقصد واحد، وهدف سام.
• حكم بالسجن لمدة ثماني ساعات
ما أشد غفلتنا عن قيام الليل، ومن لذة المناجاة مع الرب الجليل سبحانه وتعالى، لقد جرى الزمان على بعضنا أن ينسى قيام الليل ولا يتذكره إلا مع مرور عبارة، أو سماع آية، أو توجيه داعية، وكأنها حقيقة اختفت وحلم انتهى. لقد قرأنا كثيرًا عن قيام الصالحين الليل وأغاني الشعراء، وهتاف الدعاة، فمر كل ذلك كالسحابة تمطر مطرًا فتحيي ساعة، ثم لا يلبث الجفاف أن يكر من جديد، وهكذا ترجع النفس .بعد سماع الموعظة إلى الغفلة ونسيان قيام الليل لقد حكمنا على أنفسنا بالسجن عندما ننام ثماني ساعات أو أكثر فأعرضنا عن قيام الليل والصلة بنجوم الأسحار، مع ربنا الغفار، بين صلاة واستغفار، فهل شبعنا من قراءة القرآن ودعاء ربنا الرحمن؟ نستغفر الله.
وما شغلنا إلا بعدنا عن الله، وهممنا الوضيعة وتجارتنا الكاسدة، إذ لو استشعرنا وأيقنا الثواب وتذكرنا وفكرنا، وألزمنا أنفسنا وحاسبناها لهان الأمر، وتم الأجر لو مر على الواحد منا ساعة أو لحظة وفقه الله فيها لقيام الليل لاستشعر الجمال وتحسس لنفسه خطوات الكمال.
فهلّا نطلق سراح أنفسنا من أنفسنا ونحن السجانون وبأيدينا المفاتيح فنسعى للقيام متلمسين الأسباب عندئذ ترقى النفس ويحصل الخير .
علي بن حمزة العمري
• لكِ الله يا أخوة
حزين وكأن الأرض ضاقت عليه بما رحبت! مهموم شارد البال يبتسم ثغره ولا يبتسم قلبه، جاء أحد إخوانه ليرى ما في نفسه من هم فيسليه أو داء فيداويه أو ألم فيتوجع له ففاتحه قائلاً: أخي ما لي أراك حزينًا مهمومًا لعلي أساعدك فما برح حتى تفجر كالبركان وقال: دعني وحالي أصارع همي، فقد أصابني ما يجعل القلب يبكي دمًا دمًا، فوضع أخوه يده الدافئة على كتفه وقال بصوت هادئ قل فأنا أحب أن استمع إليك.... قال بعد صمت طويل: أشكو إلى الله إخواني الذين طالما أحببتهم ولعلهم أحبوني وطالما رفعت يدي بالدعاء لهم ولعلهم دعوا لي الذين بكيت لفراقهم . وفرحت بلقياهم ما أسوأ تلك الأخوة التي يعلوها غبار التكلف ويغطيها غشاء التزييف ويعكر صفوها كثرة التأفف.
ينزل رأسه حزينًا ويتنهد بحرقة، تعلم أن إخواني أغلى ما أملك! ولكن ما بالهم لا يلقون لي اهتمامًا ألست أخًا لهم؟ ألم نتعاهد على هذه الأخوة؟ ألم نتعاهد على أن يعين بعضنا بعضًا، ولكن هبت الرياح وانكشفت الأوراق وظهر ما كان مختفيًا ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسياً يمرض أحدنا ولا يسأل عن حاله أحد ويضعف إيمانه وتتخلخل جوانبه فلا يجد من يؤمن معه ساعة!! أين الأخوة التي ننشدها لقد أصبحت مثالية أقرب من أن تكون واقعية؟ أين الحقوق؟ أين الواجبات؟ صارحتك بما تعجب فلا تعجب!
هذا نبي الله موسى يصارح شعيبًا عليه السلام بما يجول ويصول في قلبه قال تعالى و ﴿ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص).
«ثم يطرق لحظة فيستمر في الحديث»، نعم لعل لهم عذرًا أنا لا أعرفه فغفر الله لهم ودحر الله كيد الشيطان الذي يوقع بين الإخوان ألا تعجب معي لأولئك الدعاة الذين يولون اهتمامهم بعد بمدعويهم في بادئ الأمر فإن أيقن الداعية بثبات المدعو والله المثبت نسيه وجفاه ورماه في زاوية مظلمة وكأنه كتاب حينما فرغ منه ألقاه في غيابات المكتبة يعلوه الغبار وتأكله دودة الأرض.
فقال له أخوه: اسمع رعاك الله.. ما قلته واقع.. في الواقع نعم ما أجمل أن تكون القلوب أرواحًا مجندة وما أجمل أن تكون القلوب شفافة، وما أجمل أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ،فتسربت الدنيا إلى القلوب وتسللت الشهوات إلى الأنفس فأهملت الأخوة بحجة الانشغالات والارتباطات صارت الأخوة تبنى بغير طين، تكاد تنهار على صاحبه ولكن ليهنك سعة الصدر والتفاؤل ثم الصبر فمازالت الأخوة بخير، وما زال فيها من هم أهل لها يعطونها حقها ويؤدون واجباتها، فأحسن الظن فيهم ولا تشمت الأعداء بهم وكن كنملة سليمان عليه السلام حينما قالت معتذرة ﴿ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾. (النمل:۱۸)
وادع الله أن يجعلنا ممن قال عنهم ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾. (الحجر:٤٧).
صلاح مثنى اليافعي
• الرسول قدوتنا
أخي الحبيب مثلك يعلم أن إرسال الرسول من أعظم منن الله عز وجل علي عباده، فهو أفضلهم وأحبهم إلي الله وشريعته أكمل الشرائع يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾
(آل عمران:١٦٤)، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن مستنقع الكفر إلى واحات الإيمان.
إن القلوب التي تعرفه حق المعرفة تصبح أسيرة حبه تفديه بكل ما تملك وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، ملك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شغاف قلوبهم فأصبح أحدهم يشتاق إليه وهو عنده، وكان أحدهم يقف درعً وافيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سهام المشركين يتلقى السهام بصدره أو ظهره، وكذلك كان التابعون، فهذا ثابت البناني التابعي الجليل يقول لأنس بن مالك رضي الله عنه: «أعطني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما».
ولا يكمل إيمانك أخي الحبيب إلا بحبه لله فقد قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين».
وإذا علمت ذلك أخي في الله فإن المحب لمن يحب مطيع قال تعالى: (وقل أطيعوا الله والرسول ) بل وقال:صلى الله عليه وسلم «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا: ومن يأبى يا رسول الله قال: من عصاني فقد أبى» ثم استمع إلى التوجيه الرباني ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾. (الأحزاب:٢١).
فكان حقًا رسول الله بشخصه وشمائله وسلوكه وتعامله مع الناس قدوة عملية مترجمة لحقائق القرآن وتعاليمه وآدابه فأجعله أخي قدوتك في حياتك كلها، وإن قال أحدهم: فلان قدوتي فقل وأنت رافع رأسك بشموخ: الرسول قدوتنا.
خالد السبع
• النفوس العالية
لو تأمل الإنسان في النفوس وهمومها لوجد فيها من الاختلاف والتباين شيئًا عجيبًا، فدنية راضية بالهون لا يتعدى طموح صاحبها موضع قدميه، وأخرى لا ترضى بغير الأمجاد والمطالب العالية واجتياز الصعاب والعقبات من أجلها، فمتى رأت المجد في شيء حتى ولو كان باطلًا هان له كل شيء كما يروى عن أبي مسلم الخرساني أنه كان في حال شبيبته لا يكاد ينام، «فقيل: له في ذلك فقال: ذهن صاف وهم بعيد، ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع ، قيل. فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك قيل فاطلبه، قال: لا يطلب إلا بالأهوال، قيل فاركب الأهوال قال: العقل مانع، قيل فما تصنع، قال: سأجعل من عقلي جهلّا وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به فإن الخمول أخو العدم».
فهذا المثال من النفوس مجبول على طلب الأعلى إن كانت على خير ففي الخير وإن كانت على شر ففي الشر وما أروعها إن كانت على الخير.
ولو بحثنا عن الصفات التي تميزت بها هذه النفوس عن غيرها لوجدنا أن أهمها صفتان هما: رغبة قوية في مطلوبها، وثقة بقدرتها على بلوغه.
فهاتان الصفتان بعد توفيق الله لا تنال المطالب العالية إلا بتوافرهما في الشخص الذي رشح نفسه لنيلهما، وتوافر إحداهما لا يكفي، فأحيانًا تجد شخصًا ذا نية طيبة وصاحب رغبة قوية في بلوغ أمر ما، ولكنه سرعان ما يتخلى عنه، فإذا فتشت في نفسه وجدت أن تزعزع الثقة بكفاءته أدى إلى نوع من القعود والتخلي عن الأهداف التي ظن أنها كبيرة عليه ، أملًا في أن يحققها شخص مناسب وما درى أن ذلك الشخص كان هو ولكن عدم الثقة بالنفس أغشى بصره عن ذلك حتى تكون هذه حاله كلما شرع في عمل ما فيصبح عندها والعدم شيئًا واحدًا وأي نتيجة يطمح إليها الشيطان أعظم من هذه.
فالواجب علينا أن نعلم أن أصحاب النفوس العالية هم كثير بيننا ولكن شيئًا من غبار عدم الثقة قد يخفيها عن أصحابها فمتى حاولوا إزالته ظهر لهم لمعانها، وعندها يبدأ التغيير .
عبد العزيز المحيني