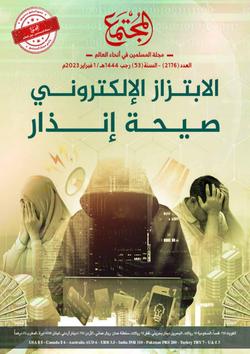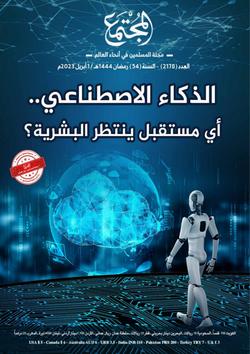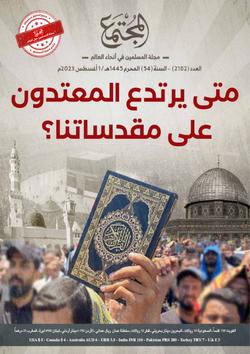العنوان هل يشتعل الفتيل؟
الكاتب علاء عبدالله
تاريخ النشر السبت 19-مارس-2005
مشاهدات 17
نشر في العدد 1643
نشر في الصفحة 32
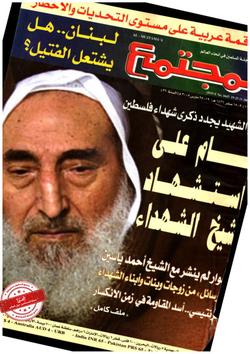
السبت 19-مارس-2005
«هل نجح الغرب في مخططه»... بهذه العبارة يمكن أن نلخص ما جرى في بيروت يوم الاثنين الماضي حيث غاب صوت العقل وفتح الطريق لتأجيج المشاعر الكامنة في نفس كل لبناني عاش الحرب الأهلية.. لقد تجمعت الجماهير يوم الإثنين الماضي في مشهد لم يسبقه إليه مشهد ولا حتى جنازة الحريري التي جمعت كل اللبنانيين من المناطق كافة، وما حرك هؤلاء ليس طلب الحقيقة كما يحاول البعض أن يتستر وراءه، بل الهدف الأول من هذا التجمع هو الوقوف في وجه المد الطائفي، وأكبر دليل على ذلك أن كل النداءات السابقة لتجميع الحشود ثم تنفع... فيما نفعت يوم الاثنين الماضي. الجديد في هذه المظاهرة ليس موقف النصارى فهم منذ اليوم الأول حملوا دم الحريري أكثر مما حمله أهل السنة، وإن كانت مظاهرة يوم الثلاثاء زادت من استفزازهم وحرضتهم أكثر على المشاركة، ولكن الجديد هو موقف أهل السنة أنفسهم وهم الذين كانت مشاركتهم في السابق ضئيلة، والمراقب للاعتصامات السابقة يجد أن تواجدهم في ساحة الشهداء كان ضعيفًا، وهو لا يتعدى تيار المستقبل، كما أن شعاراتهم المرفوعة كانت تختلف من شعارات المعارضة، فقد تميزوا بالشالات والشارات الزرقاء كما تميزوا بشعارات «الحقيقة والحرية والوحدة الوطنية» بينما شالات المعارضة الحمراء بلون الدم وشعاراتها كانت تركز على الحرية والسيادة والاستقلال.. إلا أن المشهد يختلف، مع أن شعار الحقيقة المرفوع واحد، فهل يمكن النظر إلى هذا الموضوع بمعزل عن الشحن المذهبي والذي يسعى إليه الكيان الصهيوني من أجل تجريد حزب الله من سلاحه؟ وهل يمكن النظر لهذا المشهد بمعزل عن المخططات الأجنبية والدولية التقسيمية التي أوضحها كل من العقلاء على شاشات التلفاز وفي الصحف؟ طبعًا لا ولكن... هل من مجيب؟
لا يختلف تحديد الهوية على المستوى الفردي عنه على المستوى الجماعي، ففيما تعبر الهوية الفردية عن خصوصية الإنسان باعتباره وجودًا منفردًا متميزًا عن غيره، تعبر الهوية الجماعية عن هوية المجتمع والأمة التي يتميزان بها عن غيرهما، فإذا انتزعت هذه الهوية منهما صار أمرًا آخر.
بين ثقافة العولمة والثقافات الأخرى
أحداث لبنان الأخيرة تجدد الحديث عن أولويات الانتماء
ومن هنا تجد اختلافا كبيرًا في الهويات الثقافية ليست فقط في العالم ولكن أيضًا في البلد الواحد، فعلى رغم محاولات فرض ثقافة العولة الأحادية على العالم، ومحاولة فرض قيم هذه العولمة واعتماد هذه القيمة مقياسًا للتخلف أو للتحضر، شددت الهويات الثقافية الأخرى على حقها في الوجود، ونشأ الصراع بين ثقافة العولمة والثقافات الأخرى، وكان أشد هذه الهويات الثقافية خطرًا على العولمة هي تلك التي تعتمد على الدين كأساس لهذه الهوية، ذلك لأن نمو ثقافة العولمة وتطورها قائم أصلًا على «فك الارتباط بين الدين والثقافة، فهي لا تستبعد القيم الدينية فقط، إنما تسلمها وتحملها تبعة ما تعانيه الشعوب المتمسكة بالدين وبثقافته من تأخر اجتماعي وترد اقتصادي». لهذا يربط البعض بين ظهور العولة وظهور الصحوة الدينية؛ على اعتبار أن الصعود في وجه من وجوهها هي أحد مظاهر العولمة أو مقاومة العولة.
الأهداف المستترة:
والحديث عن الهوية الثقافية الدينية إنما هو مدخل لتحليل بعض جوانب الصراع اللبناني والذي تجلي في الأحداث، والتي حاول إضفاء الطابع السياسي عليها، وإلغاء الطابع الطائفي الذي يتميز به لبنان عن غيره من البلدان.
كما أن تحليل بعض الأهداف المستترة للتحركات والتظاهرات التي قام بها فريق من الشباب اللبناني عقب اغتيال الحريري يستدعي أولًا التعريف بمفهوم الهوية اللبنانية والتي ذكرها نبيل خليفة في كتابه «الكتائب وعروبة لبنان» فقال: «إن اللبنانيين ليسوا متفقين على تصور واحد لهويتهم في لبنان» وهنالك ثلاثة تصورات أساسية لهذه الهوية:
أ- من منظور طائفي يجعل هوية المجتمع اللبناني حصيلة الهوية الطائفية القائمة فيه.
ب- من منظور قومي ولهذا التصور ثلاثة مناظير، منظور القومية اللبنانية والقومية السورية، والقومية العربية.
ج- من منظور طبقي ماركسي. ويعقب خليفة على هذا التصنيف والتفريغ في قوله: «في ضوء المنظور الذي يحدد به اللبنانيون هويتهم يتم النظر إلى تاريخ لبنان بحاضره، وإلى علاقته وإلى علاقة بمحيطة والعالم».
من هذا المنطلق يمكن أن تفهم هذا التحرك الذي قام به الشباب خلال تظاهراتهم المعارضة للحكومة، فالشباب الذين يشكلون مصدر التغيير الثقافي والاجتماعي تصرفوا من منطلق دفاعهم عن هويتهم اللبنانية وفقًا لمنطلقاتهم الثقافية التي ورثوها. بيوتهم واعتنقوها في جامعاتهم ومدارسهم، وهي كلها جاءت لتصب في خانة النوع الأول من الهوية اللبنانية التي حددها سيل خليفة في تعريفه.
اتجاهات الشباب:
ومن هنا فإن ادعاء هؤلاء بأن تحركهم جاء من أجل الدعوة إلى الوحدة اللبنانية وأن العلاقة له بالطائفية، أمر يمكن دحضه عبر قراءة الواقع الذي بين أن الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب جاءوا من جهة معينة وعبروا عن وجهة نظر واحدة، وإن حاولوا إنكار ذلك عبر رفع الأعلام اللبنانية ونبذ الأعلام الطائفية. كما يمكن دحض هذا الادعاء عبر قراءة الدراسات الكثيرة التي قام بها كثير من الباحثين حول هوية انتماء شباب الجامعات في لبنان، ومن هذه البحوث بحث أصدره كل من عدنان الأمين ومحمد فاعور كتابهما «الطلاب في لبنان واتجاهاتهم» والصادر عام ۱۹۹۸م، ويتضمن دراسة ميدانية طاولت ٢٤٣٦ طالبًا وطالبة في جامعات لبنان، ومن الملاحظات التي يمكن استنتاجها فيما يتعلق بالهوية الثقافية وارتباطها بنظرة الشباب إلى الدين والسياسة الأمور التالية:
1- في النظرة إلى هوية لبنان التاريخية وافق 55% على أن جذور لبنان التاريخية تعود إلى الفينيقيين، لكن هذا التوافق لا يكشف التباين المهم بين الطلاب تبعًا لميولهم السياسية ومذاهبهم الدينية، فالقول بعروبة هوية لبنان توافق عليه أقلية من المتعاطفين مع الأحزاب المسيحية «29% مناصري الكتائب والأحرار اللبنانية» «و2٦٪ من العونيين، مقابل أكثرية ساحقة من مؤيدي سائر التيارات «بين 84% و94%».
2- في النظرة انتمائهم إلى انتمائهم الوطني رأى الثلث أن انتماءهم إلى طوائفهم أقوى من انتماءهم إلى لبنان الحالي، غي حين صرح 43% منهم أنهم لبنانيون أولًا وأخيرًا، واللافت للانتباه هو أن الأقوى في الانتماء إلى طائفتهم من بين الطلاب، كان طلاب الموارنة (40%) ربما يعكس هذا الموقف شعورًا متناميًا لدى الموازنة، بأن الطائفة هي الملاذ لهم استتباعًا لشعورهم بتراجع الوزن الماروني في المعادلة السياسية الحالية، وبالتالي لتراجع انتمائهم إلى الدولة فيما كان السياسيون الموازنة قبل الحرب يتغنون بأولوية انتمائهم للبنان.
إن ما يعزز انتماء الشباب اللبناني لطوائفهم أكثر من انتمائهم لوطنهم هو هذا الفرز الطائفي الذي ازداد عمقًا، فانتمي شباب كل طائفة إلى جامعة معينة، وصبغ كثير من شباب الجامعات بصبغة الطائفة الغالبة غلى هذه الجامعة.
اتفاق الطائف:
وعندما ننظر إلى هوية لبنان السياسية هناك اختلاف في نظرة الشباب إلى اتفاقية الطائف وإلغاء الطائفية السياسية، ويظهر الموقف السلبي من اتفاقية الطائف لدى الطلاب المسيحين بمخلف مذاهبهم، وكذلك عند المتعاطفين مع الأحزاب المسيحية والعونيين والكليات الموحدة واليسوعية والكسليك والحكمة وغيرها واللبنانية الأمريكية فرع جبيل.
أما بالنسبة لإلغاء الطائفية السياسية فتدل الدراسة على أن ثلثي الطلاب وافقوا دون تحفظ على وجوب إلغائها، ورفض ذلك 13% لكن موافقة أغلبية الطلاب لا تنطبق على كافة الجامعات والطوائف الدينية والتيارات السياسية، ففي الجامعات الفرنكوفونية وفروع الجامعة اللبنانية التي تضم أكثرية من الطلاب المسيحيين، لا يتجاوز الموافقون على إلغاء الطائفية السياسية النصف، في حين أن الغالبية الساحقة من الطلاب في سائر الجامعات يؤيدون الإلغاء. هذا التباين بين الجامعات مرتبط بأثر الانتماء الديني والشعور / الولاء السياسي، يظهر أن معظم المتعاطفين مع أحزاب الكتائب والأحرار والقوات اللبنانية ونسبة مهمة من الأحزاب غير المصنفة ونصف المتعاونين مع التيار الوطني الحر لا يؤيدون إلغاء الطائفية السياسية، في حين تؤيدها الغالبية الساحقة (94.70%) من سائر التيارات من مناصري الحركات القومية والعلمانية والإسلامية.
ويمكن ربط الموقف من الطائفة السياسية بالانتماء الديني حيث يتميز الطلاب الموارنة وحدهم بأقل نسبة من الموافقين على إلغاء الطائفية السياسية (48%)، ويفسر هذا الموقف باستمرار خوف الموارنة بمختلف شرائحهم الاجتماعية من تعرضهم لمزيد من تراجع النفوذ السياسي في حال ألغيت الطائفية السياسية، وذلك بسبب استمرار التنافس في عدد الموارنة نسبة لأعداد السنة والشيعة.
كذب الادعاءات:
ما ورد كان الهدف من ورائه مجرد بيان كذب البعض بادعائهم الدفاع عن الهوية والانتماء اللبناني، وفصل هذا الدفاع عن موقفهم الطائفي، ليس ذلك فحسب بل السعي أيضًا إلى التقليل من شأن الطرف الآخر والشك بوطنیته، وبيان عجزه عن فك ارتباطه الثقافي بالدين.
إن ما يحصل في لبنان إنما يؤكد وجود علاقة وثيقة بين الدين والسياسة وخاصة عند الأشخاص الذين يشكل الدين عندهم معنى خاصًا، ويركز المستشرق الإنجليزي مونتجومري وات في كتابه الفكر السياسي الإسلامي على أن الأفكار التي تتضمنها ديانة الفرد «ترسم له الإطار الثقافي الذي يحيط بنشاطاته وبأعماله كلها، ومن خلال هذه العلاقة تكتب نشاطاته أهميتها، كما أن هذه العلاقة قد تؤثر بطرق معينة على البرنامج العام لحياته».