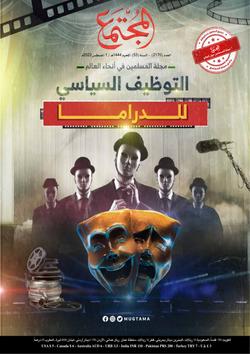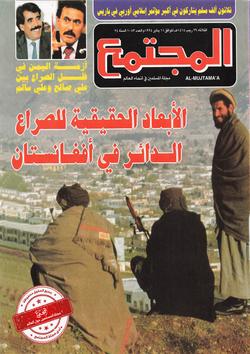العنوان المجتمع التربوي (العدد 1331)
الكاتب د.عبدالحميد البلالي
تاريخ النشر الثلاثاء 22-ديسمبر-1998
مشاهدات 10
نشر في العدد 1331
نشر في الصفحة 52
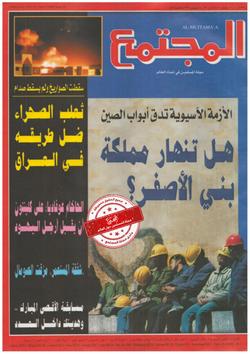
الثلاثاء 22-ديسمبر-1998
وقفة تربوية ... الناس في رمضان
الناس في شهر رمضان أنواع كثيرة، لا تعد ولا تحصى، منهم المتعبد، ومنهم المبتعد، منهم الأكول، ومنهم الغضوب، منهم السهران، ومنهم النوام، منهم من يتغير بعد رمضان، ومنهم من يظل على حاله، منهم من یزید وزنه، ومنهم من ينقص وزنه، فلنتعرف بعض هذه الأنواع:
العابدون: صنف من الناس أدركوا أن رمضان فرصة قد لا تعود إليهم، ولن يعيشوا ليدركوها ثانية، فاغتنموا كل ساعاته وأيامه بالتقرب إلى الله والتوبة إليه، وعمل الخير من قيام وقراءة القرآن والعطف على الفقراء، وصلة الأرحام، ومساعدة الضعفاء، وزيارة البيت الحرام، وغيرها من أنواع البر والخير.
الساهرون: فئة ينتظرون رمضان ليحيوا لياليه، لا بالعبادة، بل بالسهرات في الديوانيات على المحطات الفضائية المتنوعة، وعلى الثرثرة التي لا تنفع، وإذا ما جاء النهار ناموا فيه، وربما لم يستيقظوا إلا قريبًا من المغرب؛ حيث جعلوا ليلهم معاشًا والنهار لباسًا.
الغاضبون: هؤلاء في رمضان لا يستطيع أن يحدثهم أحد بشيء فمزاجهم «مغموس» يثورون لأتفه الأمور، وكأنهم وحدهم هم الصائمون، تقل إنتاجيتهم في رمضان، وتزداد آثامهم؛ بسبب بذاءة لسانهم، وسوء أفعالهم.
الصائمون من غير صلاة: هذا الصنف من أغرب الأصناف في رمضان؛ إذ يحرصون على الصيام، لكن من غير صلاة، وكان الإله الذي أمرهم بالصوم هو غير الإله الذي أمرهم بالصلاة، وبالرغم من أن الصوم عبادة شاقة، والصلاة أسهل منها بكثير، إلا أنهم يصرون على عدم الصلاة ونسوا أن الصلاة عمود الدين.
المجاهرون: أكثر الأصناف شذوذًا؛ إذ يصعب عليهم الإمساك عن الطعام أمام الناس واحترام مشاعرهم، فيتعمدون المجاهرة بالفطر؛ بسبب تبلد مشاعرهم، وقساوة قلوبهم، وخوائهم من قطرة واحدة من الحياء، وقديما قيل: «إذا لم تستح فافعل ما شئت».
نسال الله – تعالى - أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وعمل الخير في شهر الخير، وأن يعتقنا جميعا من النار.
أبو خلاد
رمضان
لوحة تربوية في سورة البقرة
بقلم: ناصر إبراهيم عبد اللطيف
- التربية في هذا الشهر تكليف ليس مقصود منه إرهاق النفس وإزهاتها.
- كلمة ﴿عَلَيْكُمُ﴾ في الآية تعني عبء التحمل.. وتذييلها بالتقوى يفيد الحكمة.
رمضان خصوصية العبادة، اصطفاء الزمن، ونزول القرآن: ثلاث اصطفاءات في هذا الشهر جعلت منه تكليفًا يخلص النفس من أعلاقها و أكدراها، وتعيش في رضوان من الله، يسعد به الزمان، والمكان، والإنسان، وذلك ما جعل من الصوم تكليفًا في كل الرسالات يراد منه تهذيب النفس الإنسانية التي هي موضوع كل الديانات، ما موقف هذا التكليف في القرآن الكريم؟
إن جغرافية هذا التكليف مع القرآن في سورة البقرة أكبر سور القرآن، ذلك إنها تحدث عن «التربية» تربية الإنسان الخليفة في الأرض، باعتبار أنه لإصلاح في الكون إذا ترك هذا الإنسان يكابد مرارة التجربة دون توجيه مسبق وهدى ينهجه في مسيرته الطويلة الشاقة على الأرض.
لقد نودي هذا الإنسان في بداية سورة «البقرة» بنداء القمة:﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢١- ٢٢).
ثم تمضي روس التربية في صورة البقرة تسلك صورًا متنوعة تكون مرآة حقيقية لواقع الإنسان وهو يهبط بمعصيته في مدارك شهواته، ثم هو يعلو في مراتب الفلاح بالتوبة، ابتداء من آدم- عليه السلام- حين يقتحم النهي في «ولا تقربا هذه الشجرة» إلى صورة الإنسان في أمة عريضة وهي أمة بني آسرائيل، ويعرض له النص القرآني في فذاذة تربوية لا نظير لها، تربية بالواقع وليس حشدًا من النصائح الثقيلة، إنما لوحات ووقائع تستوعب جوانب النفس كلها.
إن موقع رمضان ليس ينبو عن هذه الدروس التربوية، بل هو متضامن معها، تكليف ممتد في الزمن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٨٣).
فالتربة في هذا الشهر، «تكليف» ليس مقصودًا منه إعنات النفس وإرهاقها، ولكن «لحملها على قضايا عليا هي من معقبات هذا التكليف لصالح الإنسان، وهذا هو المقرر من تكاليف الإسلام.
فإذ خاطب الله المؤمنين بـ ﴿عَلَيْكُمُ﴾ في قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ﴾ (البقرة: ١٧٨) قد يلمح الإنسان المكلف من هذا الخطاب عبء التحمل، وهذه هي النظرة الأولى، ولكن خاتمة التكليف ستكون ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٩)، وكذا الأمر في السياق «عليكم» ليكون «وأن تصوموا خير لكم».
لماذا كتب كما كتب على الذين من قبلكم؟
إذا كان الصيام تربية النفوس وتهذيبًا لجامح الشهوات فيها، وإذا كانت صفة الصوم مختلفة من دين إلى آخر، لكن الحكمة تظل منة واحدة، وهو أنه سبيل تربوي لصلاح النفس البشرية لا عدول عنه، وذلك لكونه تشريعًا من لدن حكيم خبير، يعلم ما يذيب صخرة النفس التي تحطمت عليها كل أساليب التربية البشرية الحديثة ومفاهيمها الخاطئة في كثير الأحيان.
إن قول الله – تعالى -: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٨٣)، برهان علمي ودليل قاطع على أن النفس الإنسانية لا يصلحها إلا هذا الدواء، فخذوه من ربكم بقوة.
إن أمرًا تربويًّا يكلف الله به في القرآن- دائما- ينبه إلى أنه سنة ماضية في الخلق وتشريع سبق التكليف به حتى يأخذه المربي بلا غضاضة أو تشكك، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: ٥٩).
وهذه القضية واقع في حياتنا، فنحن لا نقدم في تطوير المناهج ووضعها في أطر حديثة إلا إذا ثبت جدواها في تجارب الآخرين، وأثبتت صدقًا وثباتًا يدفعان لتطبيقها في الحياة- ولله المثل الأعلى- ومما يدفع إلى التراجع عن منهج أو قانون معمول به هو فشله في الحياة العلمية، ذلك أنه وضع بعلم بفتقر إلى الحكمة التي تنشئ لهذا القانون استمرارًا.
إن قول الله – تعالى -: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٣) فيه تصريح بالعدل الإلهي، فذلك مستطرق في دين الله ممن سبقنا، فالدين على لسان الأنبياء واحد، فجميعه صدر من مشكاة واحدة.
فالذين يريدونها عوجًا، ويدعون أن صلاح الأمة في الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة عليهم أن يفرقوا بين أمرين:
الأول: هل نأخذ بأسباب الحضارة المادية من تكنولوجيا حديثة محروسة بقيم السماء، فلا يهم إن كانت شرقية أو غربية؟
الثاني: هل يريدون أن نأخذ بأسبابها الأخلاقية وتفسخها وانحلالها، مبهورين بما بلغته من تطور مادي وتقني- وهذا ما لا حاجة لنا به؟.
وعليهم ألا يقدموا بين يدي الله ورسوله، وألا يخدعوا أنفسهم والمسلمين معهم بزيف ثبت بهتانه، واكتوى العالم الغربي بناره.
فالقيم لا تطلب إلا من كتاب الله وصلاح آلة الإنسان من صانع هذه الآلة.
الصيام ولوحة التقوى
لكي نتحدث عن التقوى وعلاقة الصيام بها، علينا أن نتأمل في التركيبة القرانية التي يقع ضمنها الصيام، فسوف يتبين لنا: ما المراد بالتقوى التي لازمت مجموعة الآيات التي ذيلت بهذا المصطلح القرآني «التقوى».
ففي نصف الحزب الثالث من سورة البقرة تبدأ لوحة التقوى مبتدئة بالحديث عن البر «جماع الخير» مذيلة بقوله تعالى: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٧)، ثم يأتي بعده الحديث عن ﴿الْقِصَاصُ﴾ (البقرة: ١٧٨) ويُذيل الحديث عنه في الآية التاسعة والسبعين بعد المائة ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٩)، ثم يأتي الحديث عن «الوصية»، ومذيل الحديث عنها بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ١٨٠)، ثم يأتي الكلام عن الصيام وهو كذلك له التذييل نفسه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 183).
إن الحديث عن الصيام مختلف عن الحديث في الأحكام قبله، فلقد ذيلت آيته التكليفية بقوله:
﴿لعَلَّكُمْ تتَّقُونَ﴾، ثم حين يختم الحديث عنه وعن أحكامه بقوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتَّقُون﴾(البقرة: 187).
من هذه النصوص القرآنية سترى: أن التقوى ليست العبادات فقط، وليست المعاملات فقط، وليست العقيدة فقط، وليست شكليات الطاعة وحسب، بل إن التقوى تجمع كل أولئك في معناها.
فالتقوى ليست تولية الوجه قبل المشرق والمغرب في حركات ظاهرية، ما الحديث عن التقوى في آية الصوم إلا لحكمة عليا أرادها الله، وهي: ألا يكون رمضان مرادًا منه الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن وحسب، إنما مراد منه «التقوى» التي يعتدل بها ميزان الحياة وتستقيم معها كل مرادات الله من معاملات و عبادات وعقيدة وغيرها.
التقوى في الصيام- أيضًا- مطلوبة في الاعتدال النفسي؛ لأنه حين نتوجه لله بهذا العمل مخلصين له، فقد رددنا إلى التوحد النفسي من أي إشراك به، وهذا ما يجعل الإنسان المؤمن منسجم الملكات، ومنسجم التوجه هذا الانسجام الذي يحرم منه المنافق المتذبذب النفس المفتت الملكات، ساعة يواجه المؤمنين فيدعي الإيمان معهم، وساعة ينصرف عنهم إلى المنافقين أمثاله، فيعلن الانتماء الحقيقي لمبادئهم المنحرفة.
رمضان نداء السماء لوحدة المسلمين
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة: ١٨٣)، هذا النداء العلوي فيه من التكريم والاصطفاء لهذه الأمة التي أخرجت للناس، فصنعت على عين ربها، فجعل لها من العبادات ما ينقي معدنها، ويصفي روحها.
هذا التكليف الذي يذيب حاجز المكان، كفيل أن يقف عنده المسلمون وقفة تأمل واعتبار؛ ليعلموا أن خوفهم من المبادئ العالمية الجديدة التي تجتاح العالم تحت مبدأ «العولم» ليس أمرا ذا بال، إن هم حملوا مبادئهم بصدق في نفوسهم، وأيقنوا أن إسلامهم العالمي الرباني الإنساني فيه من القوة ومن الشفافية ما ليس في أي المبادئ الأرضية المعاصرة.
فهل رأيتم مبدأ يتوحد العالم حوله كما يتوحد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟، ذلكم هو الصيام موحد مشاعر المسلمين.
هل رأيتم مبدأ يتدارسه العالم في شهر كامل؛ ليتفقهوا في حكمه وأحكامه، وما اهتزت النفوس حول فضله وفضائله؟.
هل رأيتم مبدأ في هذا العالم يضمن انحناء النفس أمامه قبل الجسد؟، إنه الصيام ذو الحكمة العلية.
المسلمون في هذا الشهر عليهم أن يتعلموا منه كيف تُرَد النفس إلى ربها تتلقى منه الحق بقوة فتعود وقد تخلصت من شياطينها، وتعود وقد تزودت بفيض الإيمان ذخيرة النصر على النفس وزاد اللقاء في يوم اللقاء: ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء: ٨٨- ٨٩).
تأملات في موسم الشتاء
يأتينا موسم الشتاء والحمد لله في كل عام، وله نكهة وطعم خاص، ويغبطنا عليه كثير لما فيه من حلاوة، وجو معتدل، أو شتاء قارس تحس بحلاوته عندما تكون بقرب المدفأة أو «الدوة» أنت ومن معك من الأصدقاء والأخلاء أو الأهل، ويسعدك لعب ومرح الأطفال بالليل بالقرب منك، لما لليل من خصوصية أو من ناحية علمية من نظریات بازدياد نسبة الأوكسجين عند الشروق.
قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: ١٩٠).
وكثير من الأصدقاء الذين أعرفهم إذا ذهبوا لنزهة أو للتمتع بالبر الجميل، فإن كثيرًا منهم تكون له خلوة مع نفسه سواء وهو جالس بالقرب من المدفأة أو خلال ممارسة رياضة المشي؛ إذ تكون له خلوات يمارس فيها بالتفكر والنظر في مخلوقات الله وملكوته من القمر والنجوم بالليل والهواء النقي أو في الصباح، بالنظر إلى الجبال الراسيات كيف نصبت وشيدت، وإلى الأرض كيف هي مسطحة، وهذا كله يأتي تصديقًا للتفكر والنظر للملكوت الله، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ (شورة الغاشية: ١٧: 20).
وهذه المعاني والأحوال كلها ليس شرطًا أن تأتي من خلال الدروس والخواطر نلقيها؛ ليعتبر بها الناس، ولكن لا بد من أن تكون لكل عبد لحظات يخلو فيها مع ربه لينظر في مخلوقاته وعجائب مقدرته؛ ليزداد إيمانًا وتمسكًا بربه، وليتعرف مخلوقاته معرفة حقيقية بنعمة التفكير، والنظر الحصيف، مما يؤدي به في النهاية إلى الإمعان والإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع.
اللهم إنا نسألك إيمانًا صادقًا، وعلمًا نافعًا، ونسألك خلوات بالنظر في ملكوتك؛ لنزداد إيمانًا.
عبد العزيز الجلاهمة
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل