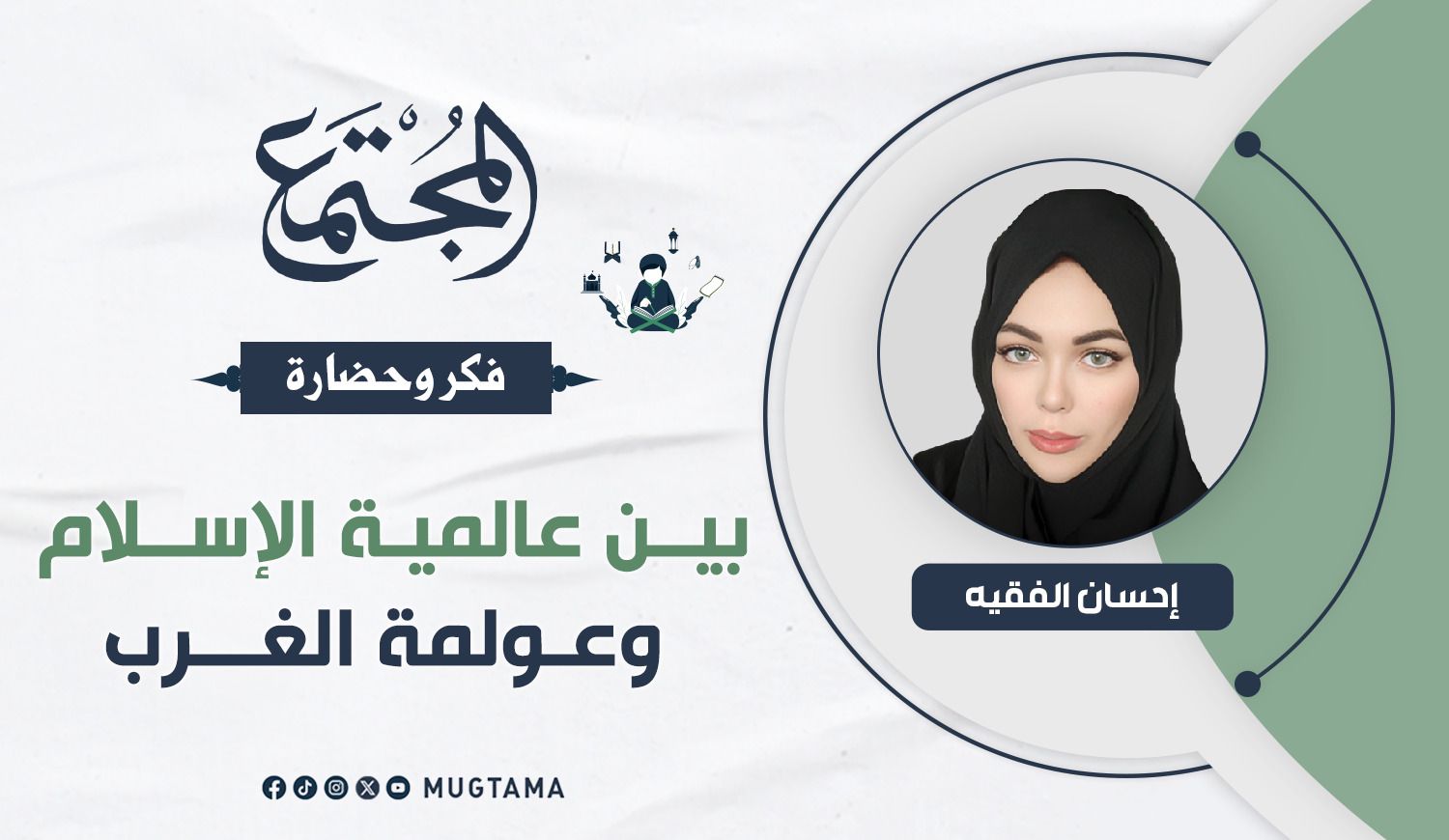إستراتيجيات الصمود في عصر العولمة

نعيش اليوم في عالم يُراد له أن يُدجَّن بالكامل على النمط الغربي تحت
دعاوى العولمة، التي باتت أداة لترويج قيم الغرب وثقافته باعتبارها المعيار الوحيد
للتحضر، فالأمر في حقيقته ليس تواصلاً بين الحضارات لتقريب الرؤى والتفاعل
الإيجابي البناء، لكنه على العكس أصبح صداماً ونفياً لكل ما هو غير متفق مع قيم
الغرب، ومحو لكافة الحضارات عبر جعل الغرب هو النموذج الذي يجب اقتداؤه إن بالرضا
أو بالقوة.
في ظل سيطرة تلك الحضارة الغربية على كافة أدوات القوة الناعمة والخشنة،
فقد أصبح العالم بأسره مجرد تابع وخاضع لتلك الحضارة، مع غياب شبه كامل لكافة
إمكانات ووسائل المقاومة العسكرية والسلمية ناهيك عن غياب الإرادة لذلك.
يزداد ذلك المشهد قتامة مع تصاعد الجدل حول جدوى المقاطعة لبعض إنتاجات
الغرب مثل وسائل التواصل أو أدوات التكنولوجيا غير المتوفر لها بدائل؛ ما يثير
تساؤلات عن إمكان المقاومة وجدواها وقدرتها على التأثير في ظل تجردنا من امتلاك
أدوات التقدم الفكرية والثقافية والاقتصادية اللازمة للوقوف في وجه الهيمنة
الساحقة للغرب.
الإستراتيجية
الأولى والرئيسة التي لا غنى عنها للصمود في وجه كافة الفتن هي الإسلام
ولكن، هل هذه هي النهاية؟ هل إلى خروج من سبيل؟ هل هناك وصفة للتقدم يمكن
استعارتها من خارج إطار الحضارة الغربية؟ وهل هناك نموذج حقيقي لحضارة قامت ونهضت
وحققت النجاح على الآخرين من الصفر؟
حضارة «الأميين»
كان العرب قبل الإسلام مجموعة من القبائل المشتتة المتنازعة، وهو ما أخبر
به القرآن في وصفه لحال العرب حين نزلت عليهم الرسالة قائلاً: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (الجمعة: 2)، فقد ساد التعصب والتفسخ والأخلاق الفاسدة والأمية
أيضاً بين العرب قبل الإسلام، كانوا بدواً منعزلين في الصحراء بين أمم راسخة في
الحضارة كالفرس والرومان واليونان، وقد لخصت تسمية «الجاهلية» ذلك العصر للتعبير
عن حال العرب.
هذه الحال تخبرنا عن النقلة النوعية التي ارتقت بالعرب من بدو رحل بعقلية
جاهلية متفسخة إلى فاتحين يملؤون الأرض عدلاً وخُلُقاً، ويشيدون في كل صقع عِلم
ومعمار شهد التاريخ بعظمته وتفرده، وهذه النقلة ما كانت لتكون من دون الإسلام.

وبينما يذهب الخبراء والعلماء أولاً حين يثور التساؤل حول الخطوة الأولى
لتحقيق النهضة نحو تمجيد التعليم، فقد صنع الإيمان في الحضارة الإسلامية معجزة من
رحم الأميين العرب، بل وأرسل إليهم رسولاً أمياً ليؤكد بأن الإيمان والقلب والعقل
هم مناط الأمر، بينما نرى رأي العين اليوم حضارة تخلت عن الدين والقيمة من أجل
العلم والاكتشافات والتطور قد دمرت الإنسانية والطبيعة وأفسدت الأرض وسفكت الدماء
وانتهكت الحرمات.
من هنا، فإن الإستراتيجية الأولى والرئيسة التي لا غنى عنها للصمود في وجه
كافة الفتن هي الإسلام الذي هو جماع أمر الأمة وأساسها المتين الذي به تصمد وعليه
تتكئ ومنه تستلهم القوة والعزيمة، وللوصول إلى تلك الغاية ينبغي لنا البحث عن
إستراتيجيات تمكن الأمة من الصمود وامتلاك القدرة على المقاومة الناجعة المؤثرة،
ومن أهمها:
- استلهام النموذج:
وضع النبي صلى الله عليه وسلم خلال فترة رسالته ورئاسته للمسلمين اللبنات
الأولى للنظام السياسي الإسلامي، يقول د. محمد ضياء الدين الريس، في كتابه
«النظريات السياسية الإسلامية» عن هذه الفترة بأنها: «الروح العامة التي تلهم
التفكير، وتُوجِد النموذج الكامل الذي تنظر إليه الآراء مهما اختلفت، وتؤلف النقطة
التي تلتقي عندها كل المذاهب مهما تضاربت وتصادمت».
إن عصر النبوة، كما اتفق أغلب دارسي التاريخ السياسي الإسلامي، كان بمثابة
نموذج ومثال يعبر عن الإسلام في كماله وتمامه، وهو القياس الذي ينبغي كلما أضعنا
وجهتنها وضللنا طريقنا أن نعود إليه مرة أخرى.
- الأخذ بالأسباب:
ويتطلب البحث عن النموذج واستلهامه أخذاً بأسباب التقدم بشكل عملي،
فالمسلمون وقتما بدؤوا في توسيع حدود دولتهم وشرعوا في تأسيس حضارتهم لم يركنوا
إلى الأماني والدعوات، بل أدركوا أن هناك أمماً سبقتهم بأشواط طويلة في ميادين
العلم وفروع المعرفة، فأخذوا ينهلون من تلك العلوم والمعارف بأكبر قدر ممكن من
الوعي والانتقائية عبر حركة ترجمة ضخمة وثرية، أسهمت بشكل مباشر في تشكل العقلية
الإسلامية الجديدة التي لم تنبطح أمام الوافد كلياً ولم ترفضه كاملاً، بل ارتأت في
نفسها القدرة على تذوق المعرفة وتقييم العلوم وأخذ ما يناسبها ورفض ما يعارضها،
فوضعت بذلك معياراً موضوعياً ومهماً يستند إلى تطويع العلوم والفنون لخدمة المجتمع
وليس العكس.
- الانتقائية:
وفي يومنا هذا قد يقول قائل بصعوبة انتهاج منهج الأولين من الصحابة
والتابعين الذين قامت على أكتافهم حضارة الإسلام، إذ كانت جاهليتهم منعزلة عن
الآخرين، فلم يختبروا تلك السيطرة التي باتت تلفنا من كافة الجوانب فلا تمنحنا
فكاكاً منها، لكن ذلك لا يعني الاستسلام حتماً وإنما فهم جوهر المبدأ الذي قامت
عليه الحضارات الناجحة وفي مقدمتها الحضارة الإسلامية ألا وهو مبدأ «الانتقائية»،
التي تطلب وعياً لفهم التمايز بين الوسيلة والغاية، كما يتطلب فهماً متعمقاً لأي
الأشياء يمكن أن تكون أداة أو وسيلة وأيها يمكن أن يرتقي إلى كونه غاية أو هدفاً
في حد ذاته.
نملك تاريخاً
يخبرنا أن النهوض من العدم ممكن إذا صدق العزم وامتد البصر إلى ما وراء الهيمنة
فقد صنع الغرب أدوات للتكنولوجيا والإنتاج والاقتصاد والحرب والتواصل، وهي
أدوات قد تكون لا غنى عنها في الاستخدام والاستهلاك والحياة، لكن استخدام الأدوات
لا يتطلب بأي حال التزاماً أخلاقياً بالغايات التي وضعها مبتكر تلك الأدوات،
فالتكنولوجيا أداة لكن استخدامها لتطوير إستراتيجيات عسكرية في القتل هو غاية
يمكننا رفضها، والسلاح أداة للردع لكن توجيهه لصدور النساء والأطفال وإذكاء الحروب
لتحقيق مكاسب من تجارة الأسلحة غاية غير مقبولة.
من ناحية ثانية، فقد وضع الغرب قيماً ومبادئ بمثابة غايات كبرى لحضارته
يمكن ألا نتفق في جعلها غاية وأن نسعى إلى تصنيفها كأداة، فلطالما كان الربح أكبر
غايات النظام الرأسمالي، وهو ما يجعل المال هدفاً، بينما يمكننا إعادة تقييم تلك
الغاية لوضعها في مكانها الصحيح طبقاً لرؤيتنا وقيمنا الإسلامية التي يكون المال
فيها مجرد أداة أو وسيلة لتحقيق النفع الإنساني والتكافل الاجتماعي والإنفاق في
سبيل الله.
ومن ناحية ثالثة، فالانتقائية تفرض علينا التمييز بين الأساسيات والفرعيات
في تعاطينا مع المنتجات الغربية، فما يمكن الاستغناء عنه وإيجاد بدائل له يجب أن
نتوقف فوراً عن استهلاكه، إعمالاً للقاعدة الفقهية الإسلامية «ما لا يُدرك كله لا
يُترك كله»، فإذا ما اضُطرِرنا إلى استهلاك بعض أدوات الغرب ومنتجاته فلزاماً
علينا إعمال الحذر والوعي للوقوف على الجوانب المظلمة التي صنعت من أجلها كي لا
نحقق الغايات المرجوة -غربياً- من استخدامنا له.
وأخيراً، فإنه وإن كانت أدوات المقاومة أمامنا محدودة وخياراتنا ضيقة فإن
شعور الانهزامية الذي بات مستشرياً في أوصال أمتنا ليس خياراً بديلاً بأي حال من
الأحوال، ولئن كنا لا نملك اليوم كل أدوات القوة، فإننا نملك وعينا، ونملك تاريخاً
يخبرنا أن النهوض من العدم ممكن، إذا ما صدق العزم وامتد البصر إلى ما وراء
الهيمنة.