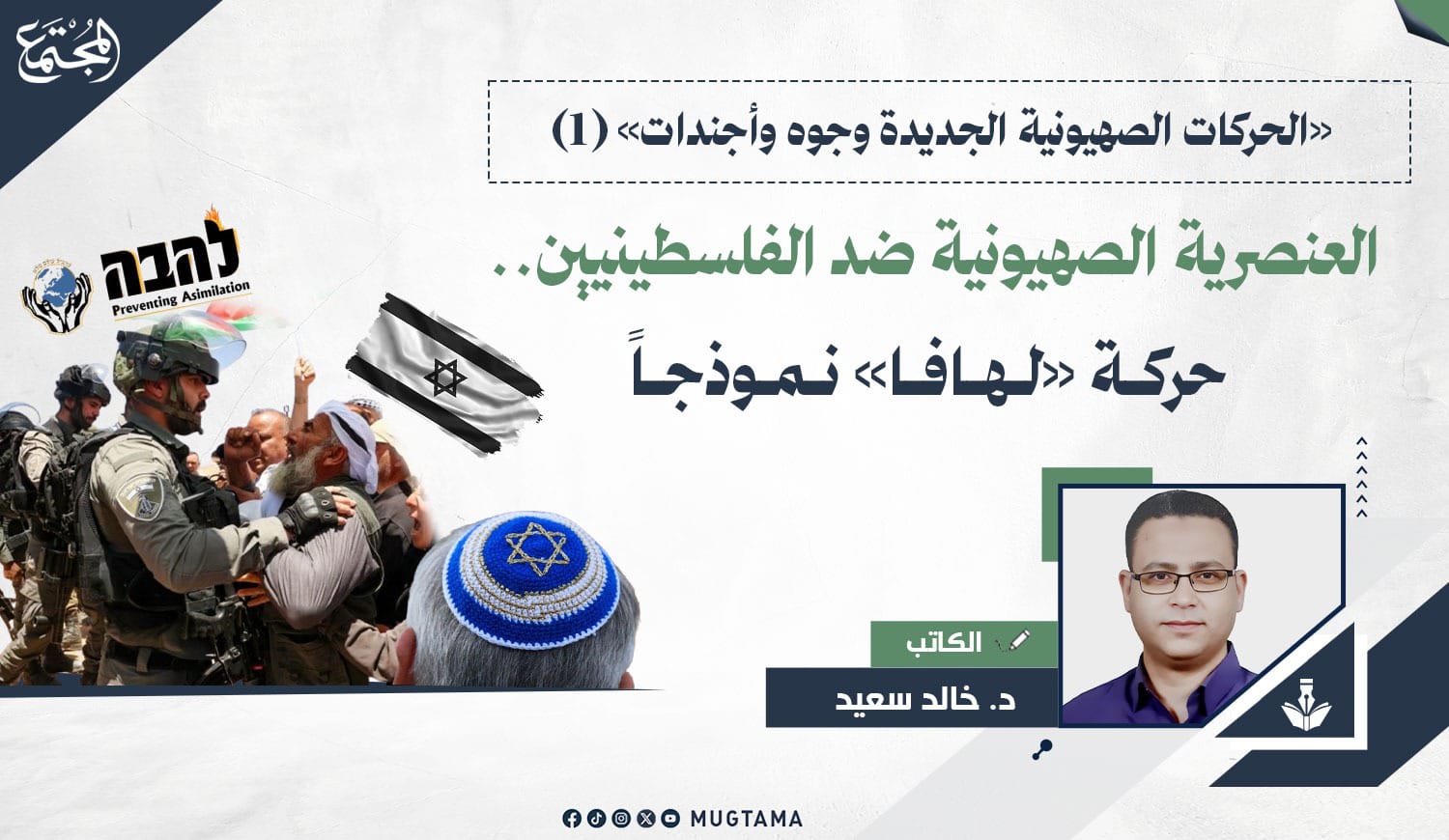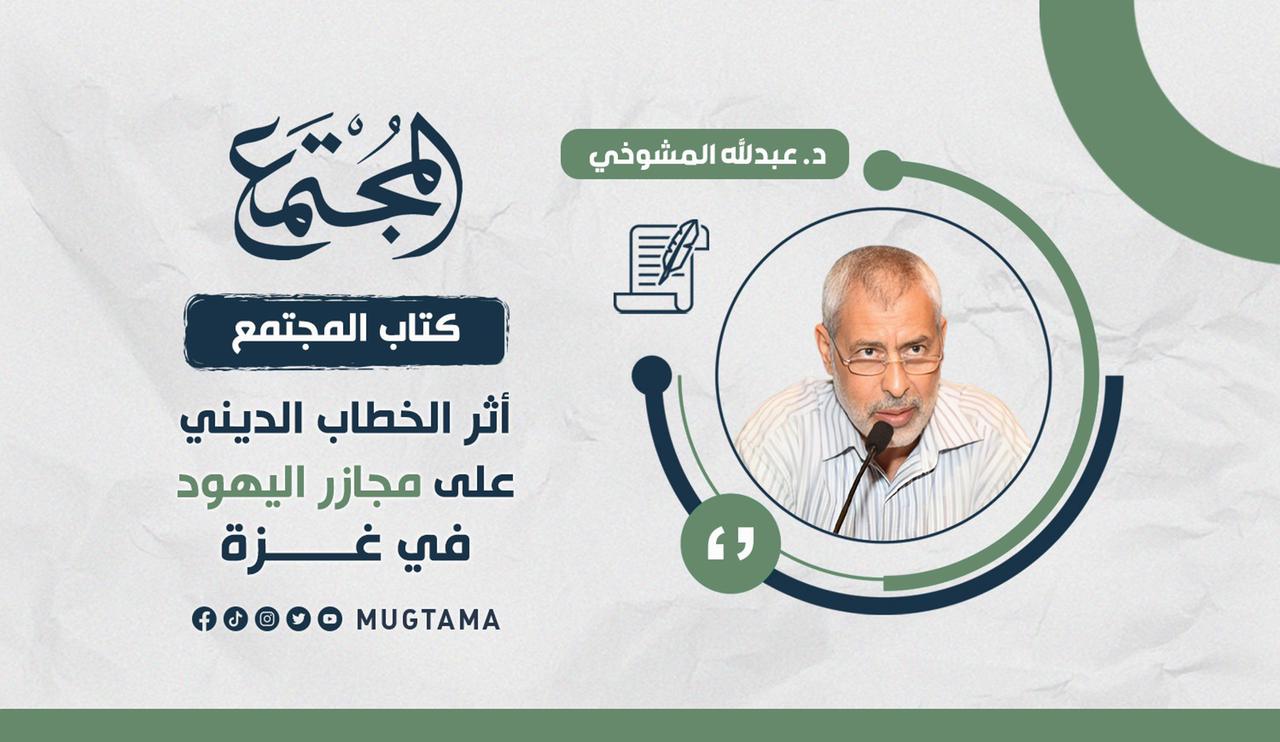الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب (4 - 4)
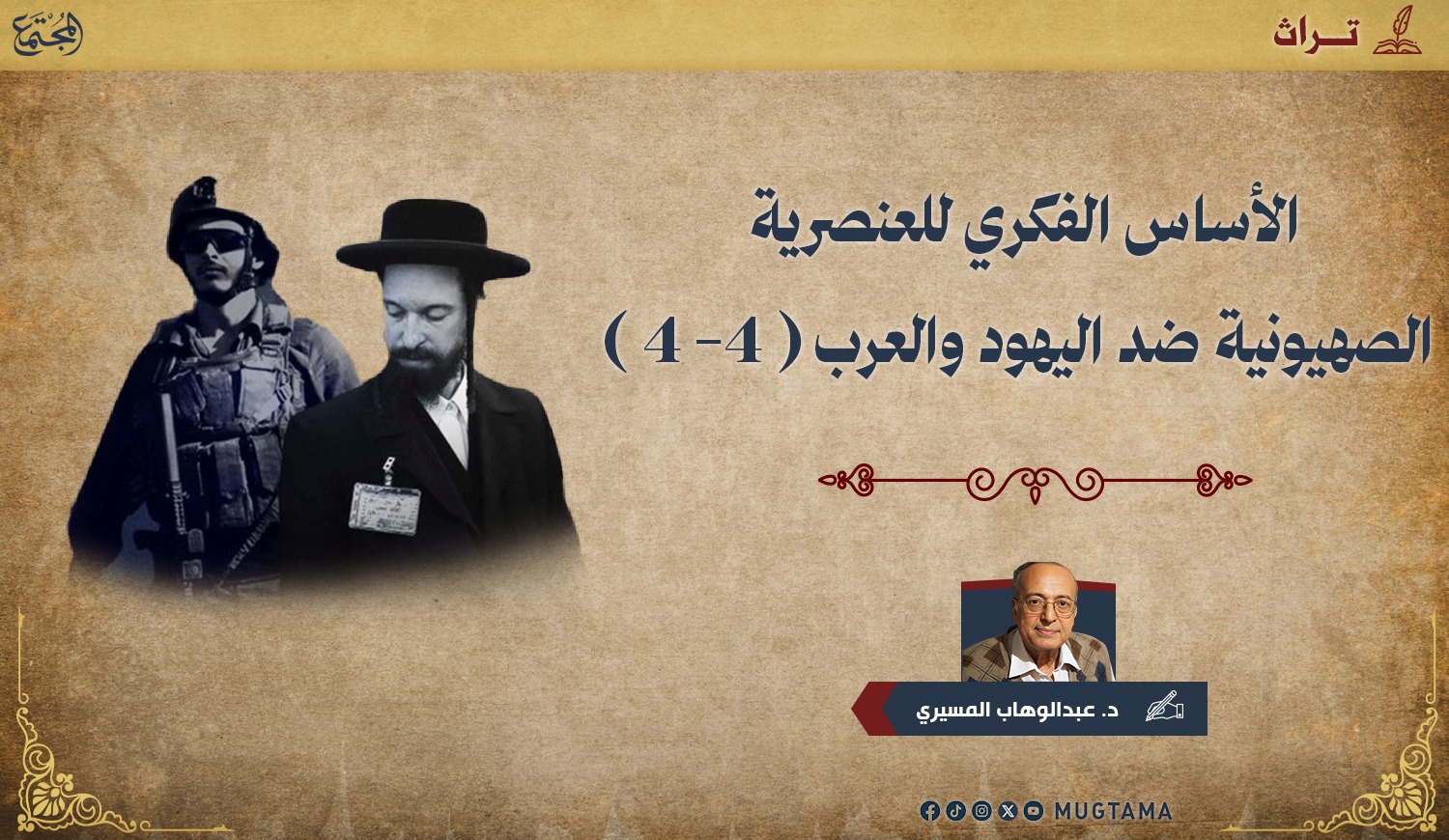
وإفراغ فلسطين
من كل سكانها أو معظمهم (أي تغييبهم) هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني، وهو عنصر
مُتضمَّن بشكل صامت في الصيغة الصهيونية الأساسية. وهذا أمر منطقي ومفهوم، إذ لو
تم الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها عليها لأصبح تأسيس الدولة الوظيفية مستحيلاً،
ولتم تأسيس دولة عادية تمثِّل مصالح سكانها بدرجات متفاوتة من العدل والظلم.
فيهودية الدولة (مع افتراض تغييب السكان الأصليين) هو ضمان وظيفيتها وعمالتها.
ومن هنا، كان اختفاء العرب حتمياً، ومن هنا كانت الصفة الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعماراً إحلالياً، فصهيونيته تكمن في إحلاليته، كما أن إحلاليته هي التعبير الحتمي عن صهيونيته (ويهوديته المزعومة).
ورغم أن رَصْد مقولة «العربي الغائب» وتوثيقها أمر بالغ الصعوبة لأن ما هو غائب لا يمكن رصده وتوثيقه بالطريقة التقليدية التي تعتمد على الاقتباسات والنصوص وتحليلها. ومع هذا، فإن هناك عدداً كبيراً من التصريحات والمفاهيم الصهيونية لا يمكن فهمها إلا في إطار مقولة «العربي الغائب». ويمكن أن يندرج تحت هذا كل ذلك الحديث المستفيض عن الأرض المقدَّسة وإرتس يسرائيل وصهيون وأرض الميعاد، فهو حديث يستند في نهاية الأمر إلى افتراض غياب فلسطين العربية.
والحديث عن
استيطان المهاجرين من روسيا القيصرية باعتبارها «عاليا»، أي «صعود»، والحديث عنهم
باعتبارهم «معبيليم»، أي يهود يدخلون فلسطين كما دخلها العبرانيون القدامى رغم كل
الصعاب والعوائق، هو أيضاً حديث يفترض غياب العرب وغياب تاريخهم. بل إنه يمكن
القول بأن المصطلح الصهيوني ككل (نفي، عودة، تجميع المنفيين.. إلخ) يفترض هذا
اليهودي الخالص الذي يفترض بدوره العربي الغائب. وقراءة أي نص صهيوني وفهم أي
برنامج صهيوني أمر صعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً، من دون افتراض مقولة العربي
الغائب كمثل أعلى ونقطة تحقُّق.
ويعبِّر الإدراك الصهيوني للعرب عن نفسه من خلال الهيكل الاقتصادي والقانوني للمستوطن الصهيوني ابتداءً من قانون العودة (عودة يهود المنفى إلى أرض الميعاد)، مروراً بقوانين الصندوق القومي اليهودي (القوانين التي تمكِّن الشعب المقدَّس من الاستيلاء على الأرض المقدَّسة)، وانتهاءً بالقوانين التي تمنع العرب من العودة إلى فلسطين (العربي الغائب أو الذي يجب أن يغيب).
العربي كيهودي واليهودي كعربي
ثمة موضوعان
أساسيان يتواتران في الكتابات الصهيونية: اليهودي كعربي والعربي كيهودي. ورغم
أنهما نقيضان، إلا أنهما ينبعان من إحدى الأفكار الأساسية المتواترة في الفكر
الصهيوني، وهي فكرة تصفية الدياسبورا (أي أعضاء الجماعات اليهودية في العالم). والصهيونية
تنطلق من الإيمان بأن الدياسبورا غير جديرة بالبقاء، فيهود المنفى شخصيات عليلة
مريضة طفيلية. ومما يجدر ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوي على نقد متكامل
متماسك لما يُسمَّى «الشخصية اليهودية». وقد أصبح هذا الانتقاد جزءاً من الترسانة
الإدراكية للصهيونية التي طرحت نفسها بوصفها الحركة التي ستُطبِّع اليهود، أي
تجعلهم قوماً طبيعيين، وتُخلِّصهم من الصفات السلبية المفترضة اللصيقة بشخصيتهم.
وقد تواتر
الموضوع الأساسي الأول، أي اليهودي كعربي، في الكتابات الصهيونية التي صدرت قبل أن
تتحدد معالم المشروع الاستيطاني الصهيوني تماماً، وقبل أن تتبلور خريطته
الإدراكية، وقبل أن يتحول العربي إلى الآخر (ولعل هذا قد حدث بعد وعد بلفور). وفي
هذه المرحلة، كان من الممكن النظر إلى العربي على أنه الشرقي وممثل الأغيار
الأصحاء الذين يمكن التشبه بهم والتوحد معهم للشفاء من أمراض المنفى، وحسب هذا
الإدراك يتحوَّل العربي إلى بطل رومانسي تحيطه هالات أسطورية كثيفة.
ويبدو أن بعض
المستوطنين الصهاينة الأوائل من أعضاء جماعة البيلو، انطلاقاً من الرؤى الرومانسية
التي كانت سائدة في أوربا آنذاك، كانوا ينظرون إلى استيطانهم في فلسطين باعتباره
نوعاً من "العودة إلى الشرق" الطاهر (مقابل الغرب المدنَّس المليء
بالشرور). وأن «العربي» هو الحكيم الذي سيعلمهم كل الأسرار ويأخذ بيدهم ويهديهم
سواء السبيل. وقد تبنَّى هذه الرؤية أحد زعماء موجة الهجرة الثانية، مائير
ويلكانسكي، وتبعه في ذلك جوزيف لويدور (صديق الزعيم الصهيوني حاييم برنر وقد لقيا
مصرعهما في إحدى المعارك مع العرب). ويُلاحَظ أن أول جماعة عسكرية صهيونية، والتي
كانت تُدعَى الحارس (هاشومير)، كانت ترتدي زياً عربياً، وأن بعض أعضائها كانوا
يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم.
وكان الأدب
الصهيوني في هذه المرحلة الأولى مفعماً بهذه الرؤية الرومانسية، فكتب موشيه
سميلانسكي الكاتب الصهيوني سلسلة من الكتب، تحت اسم مستعار هو الخواجة موسى،
يصوِّر فيها بإعجاب شديد حياة الفلسطينيين الذين تحولوا في هذه الكتب إلى بدو
ورعاة جائلين يُذكِّرون القارئ بشخصيات العهد القديم. وفي قصة قصيرة كتبها زئيف
يافيتس عام 1892، يرد وصف لطفل يهودي في مستوطنة بتاح تكفا يتعلم من العرب كيف
يدرب جسده على "الحرارة والصقيع وعلى الفيضانات والقحط".
ومن أكثر
الأمثلة تطرفاً وطرافة، مسرحية كتبها آرييه أورلوف أريلي نشرت عام 1912م في مجلة
هاشيلواح (التي كان يحررها ويصدرها آحاد هعام في أوديسا). تصور المسرحية جماعة من
المستعمرين الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا يعيشون في مزرعة جماعية. وبطلة
المسرحية هي المستوطنة الصهيونية ناعومي التي ترفض حب اثنين من زملائها وتؤثر
عليهما بائعاً جوالاً عربياً يُدعَى علي! وحينما يقتل أحد الرواد شاباً عربياً، ينتقم
علي لصديقه المذبوح بأن يقتل الصهيوني! ولكن حتى هذا الفعل لا يغيِّر من حب ناعومي
له. وتنتهي المسرحية بمونولوج عاصف تقول فيه ناعومي مخاطبة إخوانها الصهاينة:
"إن روحي تحتقركم أيتها الديدان المتحضرة. لقد تعلمت من العربي الضاري شيئاً،
لقد تعلمت منه هذه الكلمات: الله كريم" (وهذا هو عنوان المسرحية).
ويبدو أن هذا
التيار كان شائعاً لدرجة كبيرة حتى أن مجلة هاشيلواح نشرت مقالاً للناقد الصحفي
الصهيوني جوزيف كلاوزنر وجه فيه اللوم للكُتَّاب الصهاينة المستوطنين في فلسطين
الذين يصورون كل اليهود في فلسطين كمتحدثين بالعربية يشبهون العرب في كل شيء. وقد
استمر هذا التيار وأخذ شكلاً مغايراً وهو الدعوة إلى الوحدة السامية والإيمان
بالأصول السامية المشتركة لكلٍّ من العرب واليهود والتي عبَّر عنها فكر الحركة
الكنعانية التي انتشرت بعض الوقت بين المثقفين الصهاينة. ويجب ملاحظة أن هذا
الموقف من العربي، كبدوي وبطل رومانسي، يتسم بقدر كبير من التجريدية، فالعربي هنا
ليس إنساناً حقيقياً تاريخياً وإنما هو مقولة رومانسية مجردة ليست ذات حقوق
متعيِّنة. كما أن العربي هنا بدوي أي إنسان متنقل غير مرتبط بالأرض، الأمر الذي
يخدم المصالح الصهيونية ولا شك.
اقرأ أيضاً: الأسس الدينية لإجرام الجيش الصهيوني في غزة
وتمجيد العربي
هو في واقع الأمر فصله عن أرضه وعزله عن إنسانيته المتعيِّنة ليصبح شيئاً يشبه
الآثار الساكنة (التي نسميها «الأنتيكة» في مصر). والصهيونية في هذا، مرة أخرى، لا
تختلف كثيراً عن العنصرية الغربية، التي كانت لا تمانع بتاتاً في الإعجاب بـ
"الماضي التليد" و"الأمجاد الغابرة" ما دامت مقطوعة الصلة
بالواقع وما دامت لا تُستخدَم كمؤشر على ما يمكن أن ينجزه صاحب هذا التراث في
المستقبل. وقد اختفت هذه المقولة الإدراكية تماماً في الخطاب الصهيوني، ولم يبق
لها سوى أصداء خافتة باهتة.
أما مقولة
«العربي كيهودي» فهي أكثر وضوحاً ومركزية وتواتراً، فنحن إذا نظرنا لكثير من
المقولات الإدراكية الصهيونية (والإسرائيلية) ـ العربي كمتخلف، وتهميش العربي،
والعربي كحيوان اقتصادي، والعربي كشخص له انتماء قومي محدد، والعربي كطفيلي،
والعربي كشخص يحركه التعصب الديني، والقومية العربية كقومية عميلة للإنجليز،
للاحظنا أن هذه هي نفسها صفات اليهودي في أدبيات معاداة اليهود في الغرب، والتي
كانت تهدف إلى إسقاط حقوق اليهودي وطرده باعتباره شخصية طفيلية هامشية غير منتمية،
وإلى إبادته في نهاية الأمر.
وكما قلنا، كانت
هذه المقولات جزءاً من الترسانة الإدراكية للصهيونية تشبعت بها وتبنتها وطبقتها
على الآخَر (أي على يهود المنفى)، ثم أسقطتها على الآخَر (أي العربي)، كمحاولة
لتغييبه وتهميشه وتجريده وطرده وإبادته واجتثاث علاقته بالأرض، تماماً كما فعل
المعادون لليهود باليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي (والطريف أن اليهودي هنا
يصبح ممثل الأغيار الذي يذبح العربي كيهودي بعد أن ينسب إليه كل الشرور وينعته بكل
الرذائل، تماماً كما كان الأغيار يُسقطون حقوق اليهود ثم يقومون بذبحهم).
_________________
المصدر: كتاب
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية – الجزء الثالث: العنصرية والإرهاب الصهيونيان.