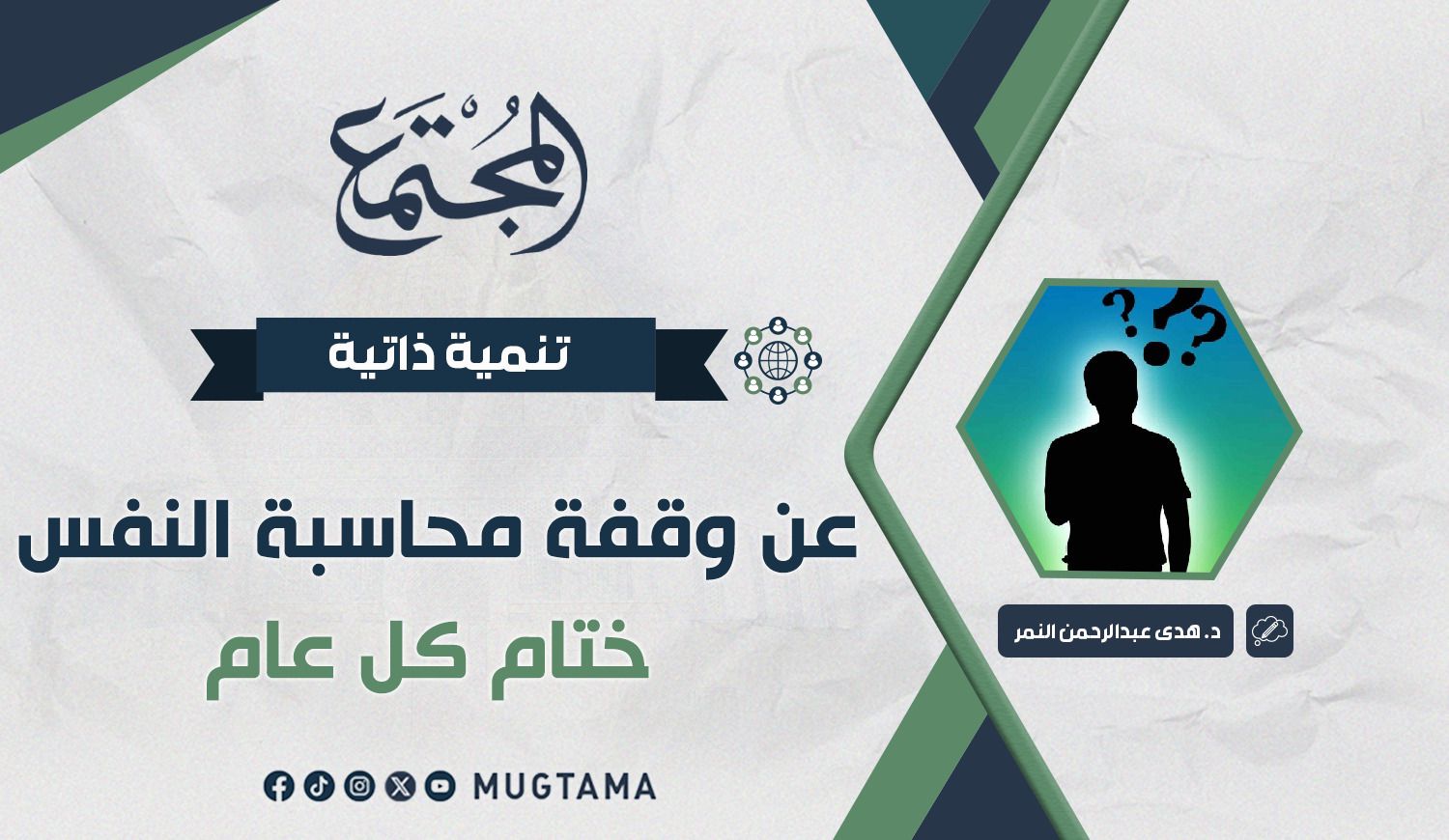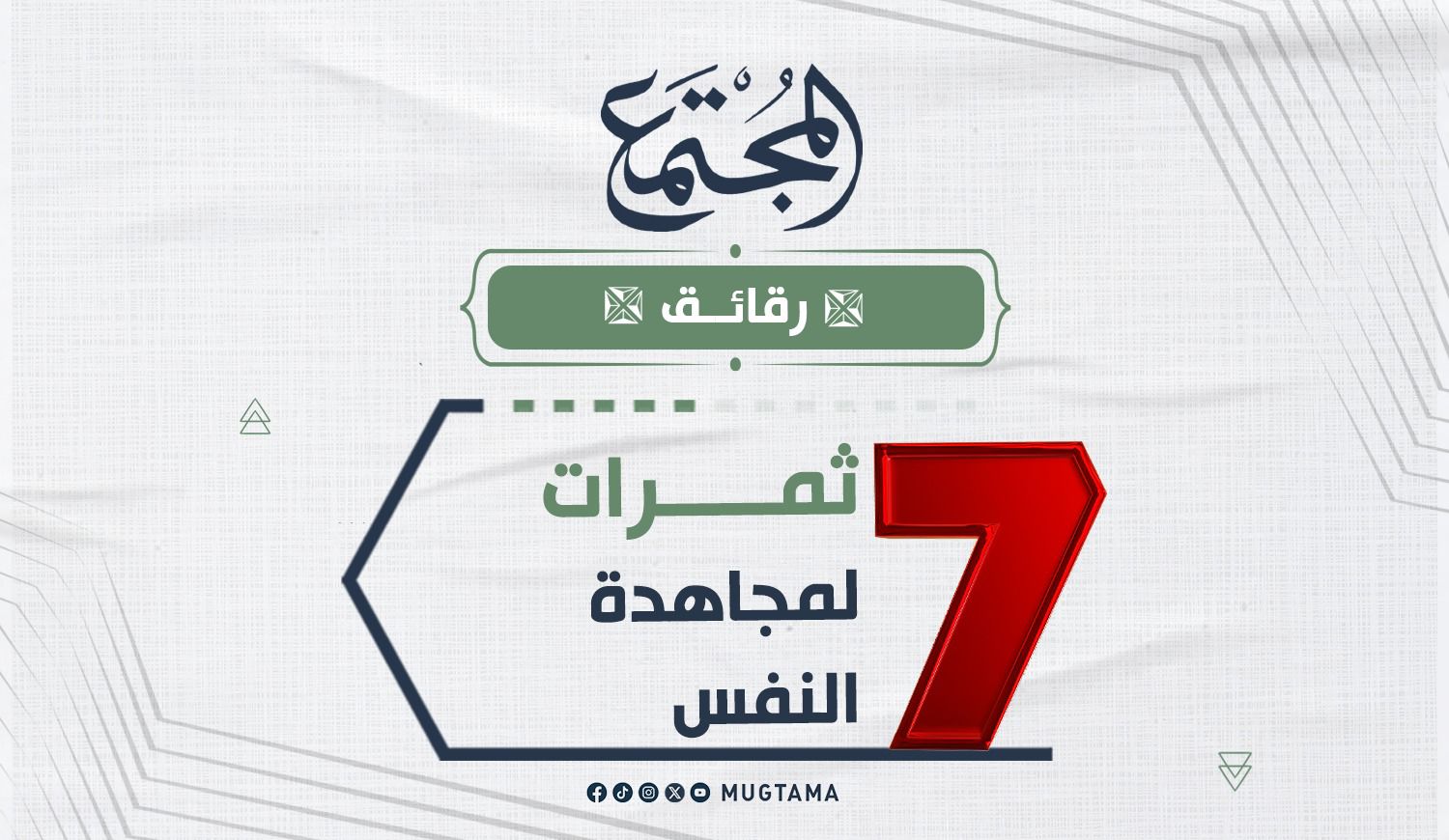الفتور الموسمي بعد رمضان.. 3 مفاتح للمصابرة والمثابرة
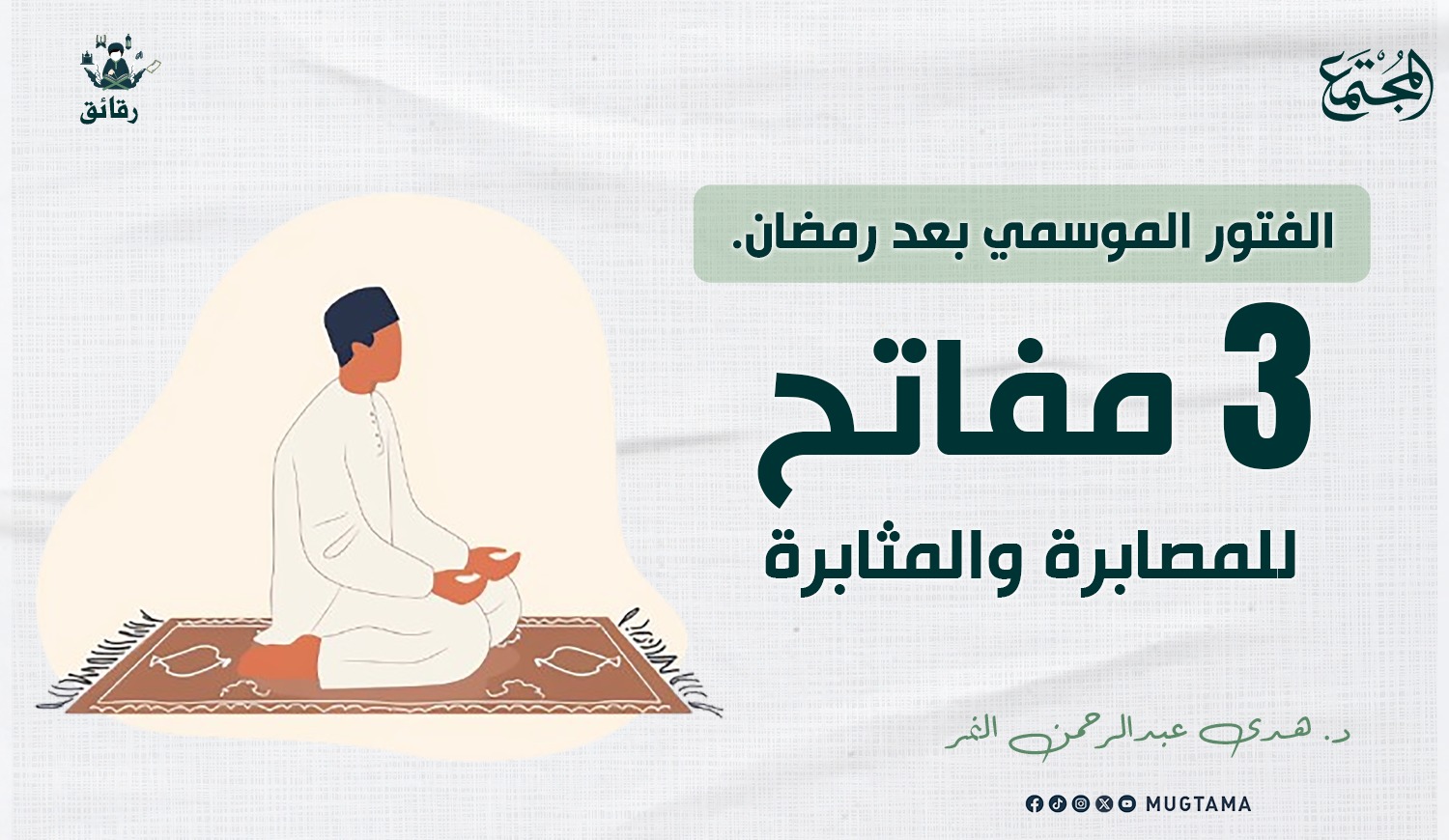
عندما يكون الكلام على التهيؤ لمواسم الخيرات والطاعات، يحشد البعض طاقاتهم
ويحبس آخرون أنفاسهم والكل مترقب للتعبئة الروحية من المحطة، وهذا استعداد حسن
ومطلوب، لكن يكون أحسن وأنفع عندما يذكر المؤمن نفسه أنه أبدًا في حاجة للتعبئة
وأبدًا في حالة جهاد مع النفس، وإلا فلماذا يكثر الخوف من الموت بسبب عدم
الاستعداد للقاء الله تعالى؟ لأننا ننظر لذلك الاستعداد بوصفه محطة ذات حين ستأتي
يومًا ما، وهكذا بالتسويف والتمني يضيع العمر يا ولدي، وكم ممن عوّل على موسم طاعة
أن يتدارك فيه ما فات فلم يدركه!
وإذن، كيف تكون حالة رياضة النفس طبعًا دائمًا؟ وكيف تستقيم النفس على
حقيقة دوام المجاهدة على كل حال، حتى في أوقات الفتور والتفريط؟!
1- إدراك معنى ومقصد رياضة النفس:
إذا راجعنا معجم «لسان العرب»، وجدنا في معاني الرياضة: «رَاضَ الدَّابَّةَ
يَرُوضُهَا رَوْضًا وَرِيَاضَةً: وَطَّأَهَا وَذَلَّلَهَا أَوْ عَلَّمَهَا
السَّيْرَ؛ الرَّيِّضُ مِنَ الدَّوَابِّ: الَّذِي لَمْ يَقْبَلِ الرِّيَاضَةَ
وَلَمْ يَمْهَرِ الْمِشْيَةَ وَلَمْ يَذِلَّ لِرَاكِبِهِ» (لسان العرب).
من التعريف يتبيّن أنّ عملية الرياضة تتطلب تمرينًا جادّا وتربية مُثابِرة،
وجهادًا مع طبائع وعادات المَرُوض حتى يَذِلّ ويُنقاد ويطيع، وينطبق هذا المبدأ
على أي نوع رياضة، بدنية أو معنوية.
وعليه، لا يمكن أن تكون غاية رياضة النفس وتربيتها تخليصَ النفس من مكامن
الشهوة وميول الهوى بالكليّة، بل ذلك ممتنع ابتداء! لماذا؟ لأنهما مركّبان في أصل
الخِلقَة، وعنصران لازمان في تكوينها تحقيقًا لقصد الاختبار في هذه الدار، إنما
غاية تلك الرياضة وذلك الجهـاد تزكيةُ كيـان الإنسان وتهذيبه، وفاقًا لأمر الله
تعالى وتبعًا له، وتوجيهُ ميول النفس حيث يَحِلّ توجيهها أو يُندَب، وحَجزُها حيث
يَحرُم أو يُكرَه.
تأمل في قوله تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ
تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ
بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المائدة:
94)، جاء في تفسيرها لابن كثير: «يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في
رحالهم، يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرًّا وجهرًا ليظهر طاعة من يطيع منهم في
سره وجهره، كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم
بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) (الملك: 12)».
وأما أن مادة خلق الإنسان ضعف، وأنه بحاجة لتسنيد وتشجيع وتحفيز دائم، فالإقرار
بحقيقة الضعف الكامن في خلقتنا لا يعني اتخاذه حجة للتخاذل أو مبرراً للانغماس في
القهر النفسي والعجز الوجداني، إذ إن في تركيبنا كذلك تطلعاً للمعالي وتشوقاً للجد
في معاملة الحياة، وإننا لم نُكلَّف بتكليف إلا وفي الوسع الإتيان به، فإننا لم
نكلف على الرغم من ضعفنا بل وفاقاً له، فالخلقة من الخالق والتكليف من الرب الذي
خلق، لذلك لا الضعف مانع صاحبه من أخذ حياته بقوة، ولا أخذ الحياة بقوة مانع صاحبه
من الانزلاق لما لا بد لابن آدم أن يذوقه من ضعف بدني ووجداني وحزن وألم وانجراف
وراء الهوى.. فإنما هي أحوال وأطوار النفوس في الحياة، وكل حول وكل طور له عبودية
وقته.
2- وطّن نفسك على مبدأ الرحلة:
إن إيمان المؤمن لا يَسلَخه من غرائزه ولا ينفي بشريّته، بل يتمّم مكارمهـا
وينفي خَبَثهـا، بناء عليه، فتهذيب النفس للاستقامة على أمر الله تعالى هي رحلة
العمر، وليس محطة واحدة فحسب تفرغ منها لتتفرغ بعد ذلك لحياتك! فالمسلم عامة
يتقلّب بين أطوار النفس؛ الأمارة واللّوامة والمطمئنة، وربّما يَغلِب على حاله
أحدها، لكنها ليست مراحل يتخلّص من أحدها لينتقل للأخرى، بل هو مُطالَب أبدًا
باليقظة لحاله ومتابعة أطواره.
ولهذا ننبّه تَكرارًا على معنى الرحلة في مقابل المحطة، لأنّ استحضار هذا
المفهوم في حد ذاته ومقتضياته، يحلّ كثيرًا من الآفات التي تعرض في الطريق وتؤدّي
لانصراف السالكين عنه بالكلّيّة، بدل الصبر عليها حتى تجاوزها، ومنها: طول الأمل
والتسويف، قصر النَّفَس وسرعة التململ، التذبذب والتردد بسبب الاشتغال بمتى الوصول
بدل منهج الوصول، نفسيّة أرِحنَا منها وعشق النهايات والتعجل للخلاص، التطرّف بين
تشدد قمة المثالية أو تهاون قاع الانحطاط، وَهْم انتظار التفرّغ.. إلخ.
وقِوام هذه الرحلة من جهة العبد: التريّض بصدق، والوقوف على باب الكريم
بأدب، ويفتح الله على عباده بما شاء متى شاء كيف شاء.
ويخطئ من يؤجّل الاشتغال بالتزكية والاستقامة حتى يفرغ من اتباع الهوى والمزاج عند مرحلة ما؛ لأنّ كأس الهوى لا قعر لها، فالشارب منها لن يرتوي أبدًا بل يزداد عطشًا دومًا؛ ولو لم يكن في اتباع الهوى إلا اعتياد الإدمان وإدمان العادة لكفى، كذلك، فالتزكية ليست محطة تحطّ عليها ذات مرّة أو تبلغها عند لحظة قرار، بل هي رحلة دؤوبة من المثابرة والمجاهدة والمدافعة والمصابرة، فالمسألة في التصور الشرعي ليست كبتًا للوجدان أو معاداة للنفس بذاتها، وإنما رياضة وتهذيب لمختلف أطوار النفس وجوانبها لتطويعها على أمر خالقها، الذي خلقها قابلة لهذا التطويع، وإن بعد حين من المكابدة والمصابرة، وفاقًا لجوهر الامتحان وغاية رحلة العمر في هذه الدار.
3- نبذ العـجـز.. والاستعصام بالله تعالى:
لا جدال في أثر مُلهيات الدنيا ومُنسياتها في إبعاد المؤمن عن التنبه إلى
حقيقة ذاته وبوصلة وجوده، ولذلك جعل الله تعالى أمام عينيه ركنًا شديدًا يأوي
إليه، وحبلًا ممدودًا يستعصم به، (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة: 5)، يستفتح بهما صلاته 5 مرات في كل يوم وليلة، ليُذَكَّر
مهما أنسي أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم القاهر، وأنه عبد لا
يملك من الأمر شيئًا، ولم يُرَد له أن يملك من الأمر شيئًا، إلا أن يّدين لله
بالعبودية ويستعينه على كل شيء وفي كل شيء.
وكم من عابد غافل في عبادته فيُبتلى ابتلاء تتناثر فيه نفسه ليستفيق ويعي
ألا نجاة إلا بالله تعالى، ولو خَلّاهم في استقامتهم الظاهرة، غافلين عن إبصار
منَّة الله تعالى وفضله عليهم، لهلكوا من العُجْبِ ورؤية النفس!
وجاء في تفسير القرطبي لقوله تعالى: (وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) (الإسراء: 74): لمّا نزلت هذه الآية قال عليه
الصلاة والسلام: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْن».
وكلُّ تقلبات الدنيا إنما هي لتُدرِكَ أيها العبد ضَعفَك، فلا تَـركَنْ إلى حَولِك، ولا تَأمَنْ نفسك على نفسك، ولِتَعْلَمَ أيها العبد فَضْلَه، فلا تعتمد إلا عليه، ولا تستشعر لحظةً الاستغناءَ عنه، فاستعن بربك، وإياك أن تعجـز على إيمانك به!