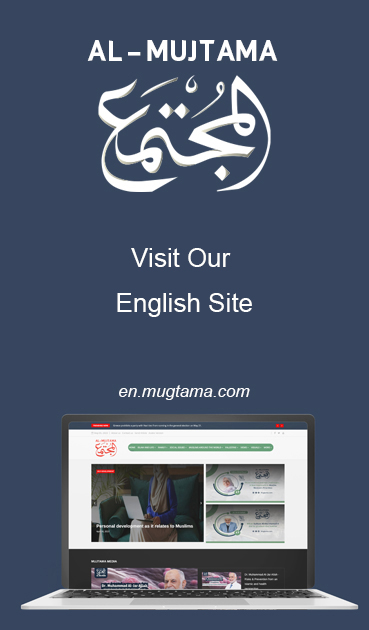المسلمون وصناعة المعرفة.. «بيت الحكمة» وأصداؤه
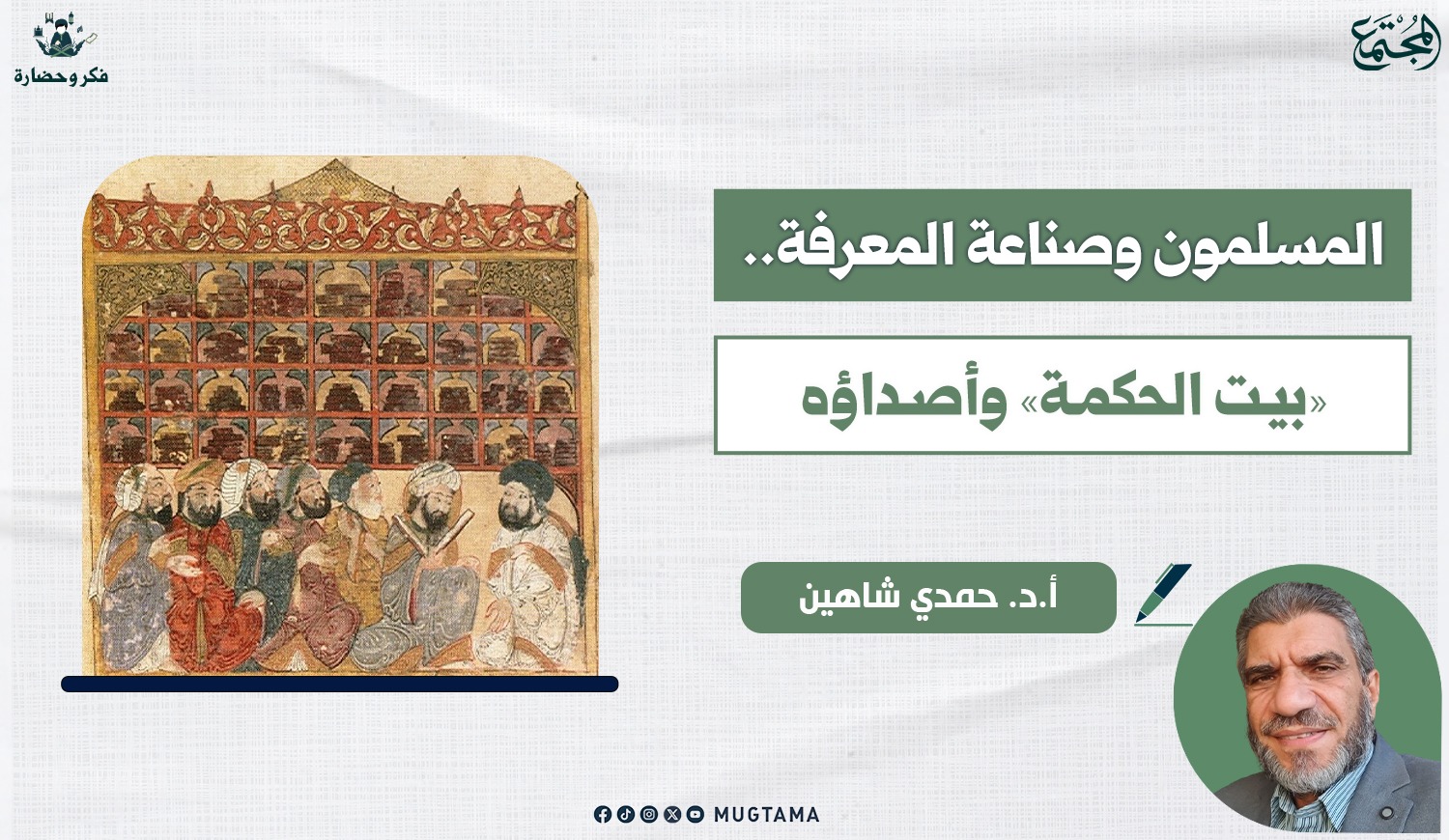
كان الإسلام المتغير
الثوري الأكبر في تاريخ العرب، حيث فتح طاقات الضوء المبهر في عتامة حياتهم،
فثوَّر العقول الراكدة، وأطلق طاقاتها المختزنة الآسنة، ودفعهم في تيار الحياه
الزاخر بعد عقود من التبلد والسكون.
امتلكت الأمة
الإسلامية منظومتها الحضارية الخاصة منذ البدايات الأولى؛ فالعلم فيها يقود إلى التوحيد،
والتوحيد يأخذ بناصيته إلى الرشد، حيث يصبح «العلماء ورثة الأنبياء»، والله تعالى
يقول: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
الْأَلْبَابِ) (الزمر: 9)، ويقول (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) (فاطر: 28).
والتفكير في
الإسلام عبادة، حيث لا تعارض بين النظر في كتاب الله المسطور وكتابه المنظور، قال
تعالى: (سَنُرِيهِمْ
آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
الْحَقُّ) (فصلت: 53)، وكل سعي للعلم عبادة تزيد المعرفة بالله، قال النبي
صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة».
والإنسان مخلوق
لعمارة الكون، والاستخلاف لا يكون إلا لمن تفتحت آفاق عقله بالعلم، ولما بدأ الله
خلق الإنسان (عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) (الرحمن: 4)، ففي نظرية المعرفة في الإسلام لا تناقض بين العلم
والدين، بل كل منهما يؤدي إلى الآخر.
وفي منظومة
المعرفة الإسلامية يتاح العلم للجميع، حيث تتولى الأمة أمور التعليم -لا الحكومة- من
خلال نظام الوقف الإسلامي، وفي المنظومة المعرفية الإسلامية يهتف العلم بالعمل،
قال سفيان الثوري: «العلم يهتف بالعمل؛ فإن أجابه وإلا ارتحل»، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ
تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ {2} كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا
مَا لَا تَفْعَلُونَ) (الصف).
وتأسست في
منظومة المعرفة الإسلامية ضرورة الاجتهاد والتجديد؛ ما فتح الباب لاختلاف الرؤى
والمواقف العلمية، واتسعت آفاق قبول الاختلاف وآداب الحوار والجدل، ومنذ عصر الخلفاء الراشدين ظهرت مدارس في الفقه والتاريخ في المدينة ومكة والبصرة والكوفة
الفسطاط ودمشق.. وغيرها، وفي كل منها ظهر أساتذة أعلام.
و«الحكمة ضالة
المؤمن، أنّى وجدها فهو أحق الناس بها»؛ لذا فقد انفتح المسلمون على علوم الآخرين،
أخذًا وعطاءً، ومنذ وقت باكر في عمر دولة الإسلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنصح
سلمان الفارسي بحفر الخندق، واتخذ مجانيق لحصار الطائف، ودوّن عمر الدواوين، وسكَّ
عبدالملك بن مروان العملة الإسلامية، مع صنوف أخرى من لوازم التطوير الإداري
للدولة.
ولما فتح
المسلمون فتوحاتهم الواسعة حيزت عندهم حضارات الأمم السابقة والحاضرة، فتجلت سمات
حضارة الإسلام التي قبلت الآخر، وتعايشت معه، وهي في ذلك تدرك أنها أمة دعوة لا
انغلاق، وبادلها الآخر صدق ولاء، في غالب الأمر، فلم يكد يمضي جيلان أو ثلاثة حتى
أصبح من الشعوب المفتوحة أعلام في علوم العربية، والتفسير والحديث والفقه
والتاريخ، وظهر سيبويه، وأبو حنيفة، والبخاري، ومسلم.. وأضرابهم.
حركة الترجمة وصناعة المعرفة
والسعي لمعرفة
لغات الآخرين قديم منذ عهد النبوة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت
بتعلم السريانية والعبرية فأتقنهما في مدة وجيزة، وفي عصر الأمويين تمت أكبر حركة
ترجمة عرفها التاريخ، فترجمت إلى اللغة العربية دواوين الدولة، وتم ذلك في بضع
سنين، ورصدت لأجله ميزانية ضخمة من بيت المال، لتتم السيطرة على الجهاز الإداري
للدولة، والقضاء على الفساد المالي لموظفين محليين؛ احتكروا معرفة لغة الدواوين
وقتها.
وورث العالم
الإسلامي مراكز حضارية بارزة كانت ذات شأن قبل عقود من الفتح الإسلامي، من أشهرها
الإسكندرية، وجنديسابور، والرها.. وغيرها، فحافظوا على موروثها العلمي، ومن بقي
بها من العلماء، وفي العصر الأموي ترجمت كتب في الطب والكيمياء للأمير خالد بن
يزيد بن معاوية، ثم جاء العصر العباسي ليشهد أكبر حركة ترجمة إلى العربية من لغات
الشعوب المفتوحة، وخصص الخليفة أبو جعفر المنصور جناحًا في قصره ليضم مئات من
الكتب العربية والمترجمة، وتميز عهد هارون الرشيد بإرسال بعثات علمية إلى الروم
لجلب المخطوطات اليونانية مهما غلا ثمنها، ولما ضاقت مكتبة جده المنصور عن استيعاب
ما زاده عليها أنشأ «بيت الحكمة».
مراحل تطور بيت الحكمة
بدأ «بيت الحكمة»
مكتبة، ثم انداحت دائرتها لتصبح مركزًا للترجمة، ومعهدًا للبحث والتأليف، ومقرًا
لحركة علمية كبرى تلقى فيه الدروس، وتعقد فيه الندوات، وتمنح منه الإجازات العلمية
للنابهين والفائقين، ثم ألحق بها مرصد فلكي، وفي بيت الحكمة تجاور العلماء العرب
والفرس والسريان واليهود والنساطرة المسيحيون! وتعددت أقسامه من أماكن للتأليف،
وأخرى للترجمة، وثالثة للنسخ، ورابعة للتجليد، وخامسة للتدريس.. فلما جاء الخليفة
المأمون -المسكون بحب الفلسفة، والحالم بأرسطو في منامه- جعل للمترجمين الجوائز
الكبرى، حتى أمر بأن يعطى كبار المترجمين زنة ما يترجمونه ذهبًا!
فلما تراجع أمر «بيت
الحكمة» نشأت على نهجها بيوت أخرى للحكمة، أقل شأنًا، في عواصم حضارية أخرى، في
خراسان والري وأصبهان.. وغيرها، وأنشأ الفاطميون بمصر بيتًا للحكمة لا يقل خطرًا
عن سمِيّه البغدادي، وأقام الخليفة الحكم المستنصر في قرطبة مكتبة عامرة بها نحو 400
ألف مجلد، بذل جهدًا في جمعها من مختلف الأقطار.
تركت ترجمة
المنطق والفلسفة أثرها على منظومة المعرفة في بلاد الإسلام، ليس فقط العلوم
التجريبية، بل على العلوم الإنسانية نفسها، ولا شك أن تأثير المنطق اليوناني على
علم الكلام كان واضحًا، وترك آثاره الإيجابية من حيث التسلح بالأدلة والبراهين
العقلية والمنطقية، لكن تبدت آثاره السلبية أيضًا في غلو بعض الفرق الإسلامية في
الانبهار بتقديم العقل على النص، واستباحة مجالات في عالم الغيب بوضعها تحت
المنظور العقلي.
لقد تركت
الفلسفة والمنطق أثرها على أخص علوم العربية؛ اللغة والنحو، وهو تأثر يراه بعضهم
عظيمًا، ويضعفه آخرون، بينما من المقطوع به تأثير المنطق وعلم الكلام على علم أصول
الفقه، وكثير من علمائه الكبار كانوا من علماء الكلام والمعنيين بالمنطق كالغزالي،
والآمدي، والجويني.. وغيرهم.
وقف كثير من
الفقهاء التقليديين موقف العداء أو النقد لتأثيرات الفلسفة اليونانية، وكتب
الغزالي «تهافت الفلاسفة»، وكتب ابن تيمية «نقض المنطق»، ووقف فقهاء الأندلس موقف
المعارضة لابن رشد وفلسفته، بينما لم تكن للفقهاء معارضة تذكر على الترجمات في
مجالات العلوم التجريبية من طب وفلك وهندسة.
والشاهد من ذلك
الدلالة على مدى حيوية العقل الإسلامي الناقد الحصيف تجاه الانفتاح على الثقافات
الأخرى، وحذرهم من تأثيراتها السلبية على عقائد المسلمين وخصوصيتهم.
وهو حذر
افتقدناه في طور الضعف الذي يعانيه المسلمون منذ عقود، حيث أصبح الانبهار بما لدى
الغرب المتقدم هو السمت الغالب عند الخاصة والعامة، وقليل من يقف موقفًا نقديًا
تجاه الحضارة الغربية.
ومن المهم هنا
أن نثبت أن أغلب النقدة للمشروع الحضاري الغربي هم من المفكرين الإسلاميين، مثل
محمد إقبال، ومالك بن نبي، ورجاء جارودي، وعبدالوهاب المسيري، وطه عبدالرحمن..
ولهذا دلالته في أن العقلية الإسلامية النابهة ما تزال في عافية.