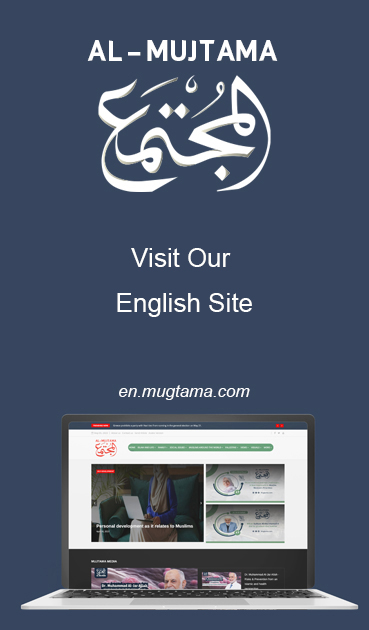الإيمان بالقضاء والقدر وعلاقته بالأخذ بالأسباب
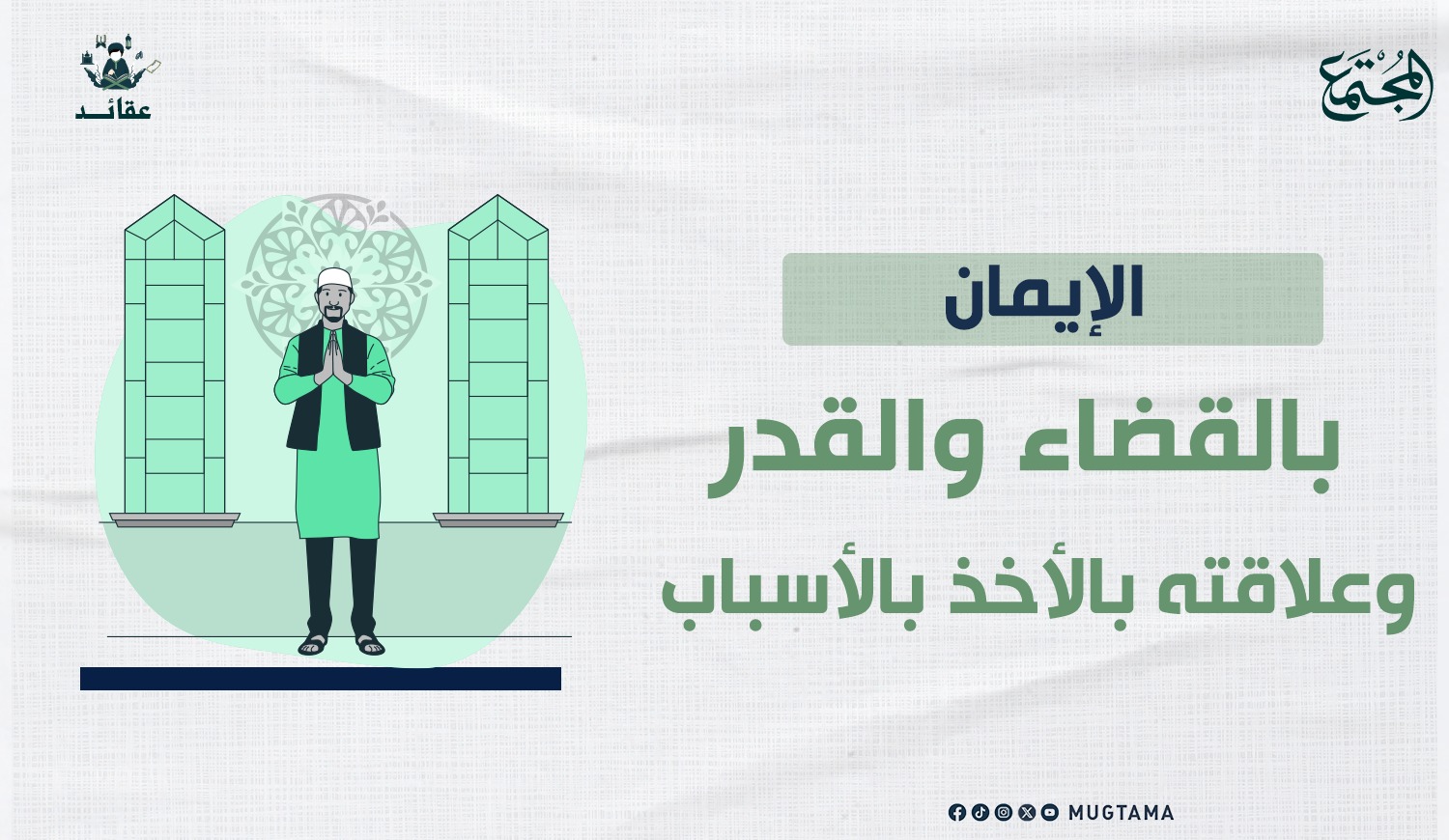
الإيمان بقضاء الله وقدره جزء من التكوين العقيدي للمسلم بعد الإيمان بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم بالقدر خيره وشره، فلا يقال: إنه المرء
مكتمل الإيمان حتى يكتمل إيمانه بكل تلك الأركان مجتمعة، وأن يفهمها فهماً صحيحاً.
الإيمان بالقدر في القرآن والسُّنة
قال الله تعالى: (إِنَّا
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (القمر: 49)، فكل أحداث الكون عند الله
مقدّرة لحكمة يعلمها سبحانه، وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا) (الطلاق: 3)، وقوله تعالى: (نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) (الواقعة: 60)،
فالحياة والموت هبة من الله ومحتومة بقدر محدد لا تقديم ولا تأخير، وقوله تعالى: (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ {22} لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا
تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) (الحديد)، وفي المصائب والمحن يقول تعالى:
(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (التغابن 11)، وقال عز وجل: (وعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا
يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ
مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام: 59).
وبينت السُّنة النبوية تفصيلات الإيمان بالقضاء والقدر، ونفت تماماً تعارض
الإيمان بالقدر مع فريضة بذل الأسباب اللازمة لاستمرار الحياة كما سنها الله عز
وجل، فالمجاهد عليه الجهاد، والعامل عليه الاجتهاد في العمل، والمريض عليه
التداوي، والطالب عليه الاستذكار..
روى عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه
على الماء» (رواه مسلم)، فالله عز وجل بسابق علمه في خلقه قد كتب أقدارهم، والأسباب
من القدر، والدعاء من القدر، والسعي من القدر.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من
الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث
على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة،
ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة»، ثم قرأ: (فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى {5}
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى {6} فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى {7} وَأَمَّا مَن بَخِلَ
وَاسْتَغْنَى {8} وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى {9} فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (الليل) (رواه مسلم)(1).
الإيمان بالقدر دافع للعمل والأخذ بالأسباب
وقد أجمع العلماء على أن الإيمان بقضاء الله وقدره لا يتنافى أبداً مع حرية
العبد في الاعتقاد والاختيار، ولذلك يجب
إرجاع أمر تلك المفاهيم للفقهاء في شرحها، وعدم ترك العنان للنفس لتحكم هواها
فتفسر النصوص على غير ما تحمله، فيقع الإنسان في الكفر والإلحاد من حيث لا يدري.
روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا
تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل،
فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» (رواه مسلم).
يقول ابن القيم في شرح الحديث: «هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبداً،
بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام
والعبودية ظاهراً وباطناً في حالتي حصول المطلوب وعدمه».
والقدر كله خير، فحين تنكشف الحكمة الإلهية من وقوع مصيبة مثلاً، يرى
الإنسان أن الأمر خير، فعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبت
للمؤمن لا يقضي اللهُ له شيئاً، إلا كان خيراً له» (صحيح ابن حبان)، فالإنسان يعمل
ليصل لصلاح أمره، وحين تتدخل إرادة الله لتتبدل النتائج، يظنها البعض شراً، بينما
هي عين الصلاح له، قد تتبين الحكمة وقد لا تتضح، لكنه موقن على أي حال أن في أقدار
الله كل الخير، وما عليه سوى العمل وترك النتائج عليه سبحانه وهو مطمئن النفس
مستريح البال.
الإيمان بالقدر في حياة النبي
الإيمان بالقضاء والقدر يترجم لحسن التوكل على الله تعالى، وحياة النبي صلى
الله عليه وسلم ترجمة لتلك المعاني العملية التي يجب أن تكون عليها الأمة التي
انحرفت عن سواء السبيل وعن فهم نصوص دينها، فكانت النتيجة هذا الهوان والضعف
والاتكال والانبطاح.
ففي علم النبي صلى اله عليه وسلم وبما أخبره به ربه أن هذا الدين منتصر،
وأنه دين البشرية الخاتم، وأن الناس سوف يدخلون في دين الله أفواجاً، فلم تقعده
تلك المعرفة عن العمل والمشقة والهجرة وترك بيوت الأجداد والجهاد وفقد الصحابة، بل
كانت دافعاً للعمل الجاد للوصول للنتائج التي بشر بها الله عز وجل في كتابه العزيز.
فقد أذن للمسلمين بالهجرة الأولى والثانية، وترك تاريخهم وأموالهم وأرضهم ،
وأمر الرماة بألا يغادروا جبل الرماة في «أُحد»، وانهزم المسلمون رغم وجود النبي
صلى الله عليه وسلم بينهم؛ لأنهم خالفوا أمره، وقصروا في العمل البشري المنوط بهم
مع قدرة الله عز وجل على نصرهم، وأمر بحفر الخندق حماية للمدينة في غزوة «الأحزاب»،
كلها أعمال بشرية خالصة، لكن كان فيها قمة التوكل على الله عز وجل، وترك نجاحها من
الأساس لتوفيقه سبحانه.
حال الأمة والخروج من محنتها(2)
حتى تخرج الأمة من محنتها فعليها العمل وترك الخلاف والتوحد على كلمة سواء
وترك الكسل والانتباه من تلك الغفوة التي طالت وامتد أثرها طويلاً، وتلك سُنة الله
في كونه، وسنن الله لا تحابي أحداً وقد قال تعالى: (فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) (فاطر: 43)، ويقول تعالى: (يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ) (المائدة: 16)؛ فمن اتبع؛ اهتدى.
______________________
(1) يقول ابن الأثير: المخصرة ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو
عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكئ عليه.
(2) مجدي عاشور، السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم، أصول
وضوابط، ص 158.