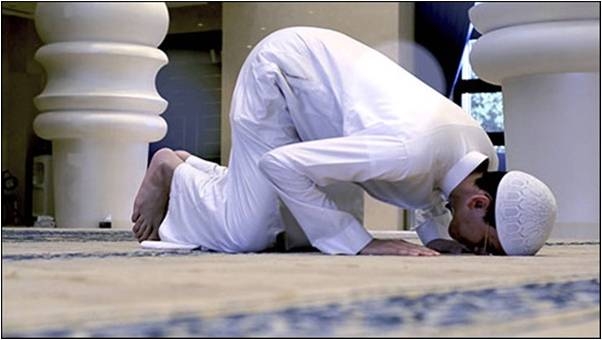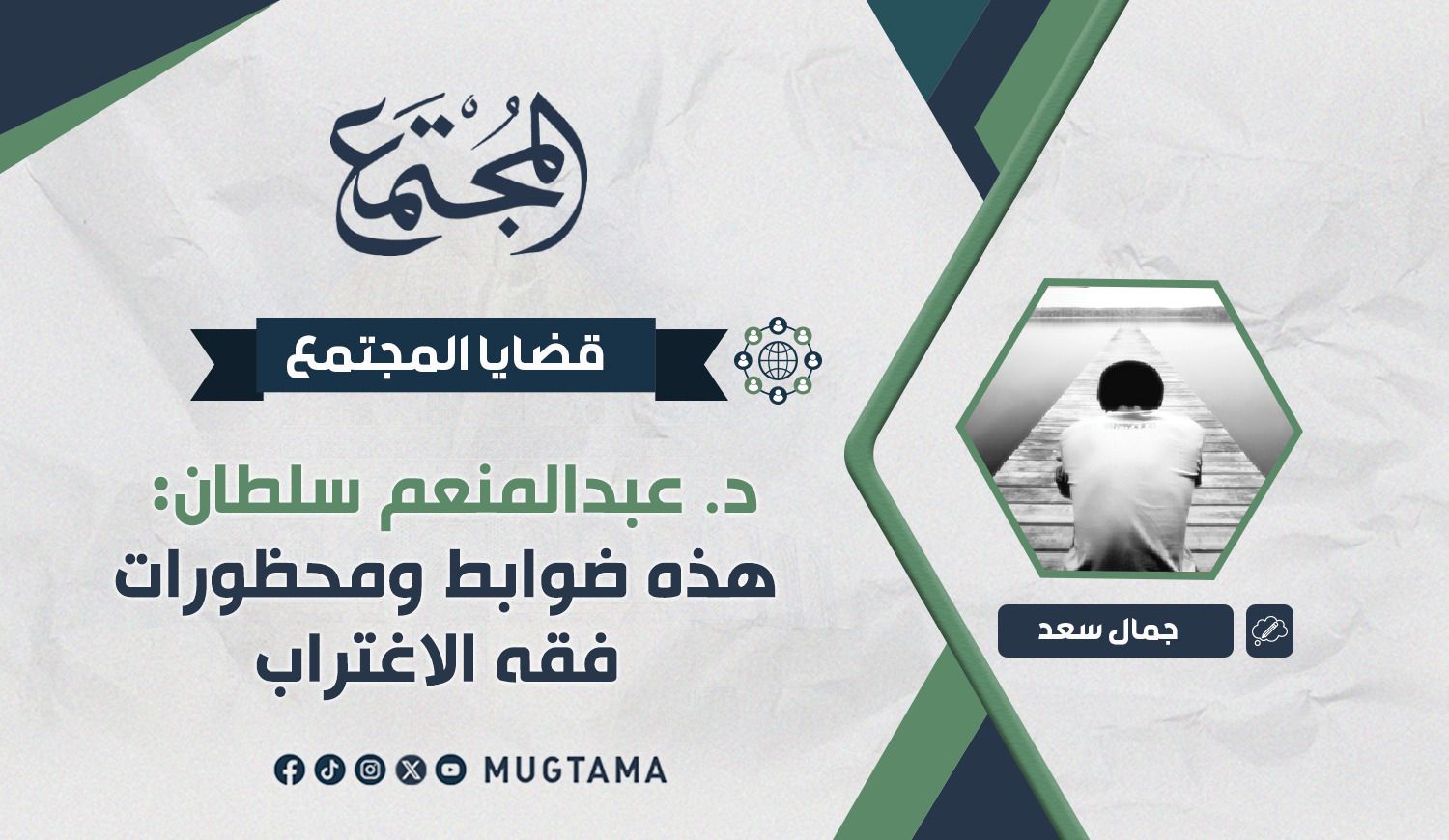جدلية الاغتراب والعزلة في الفكر الإسلامي
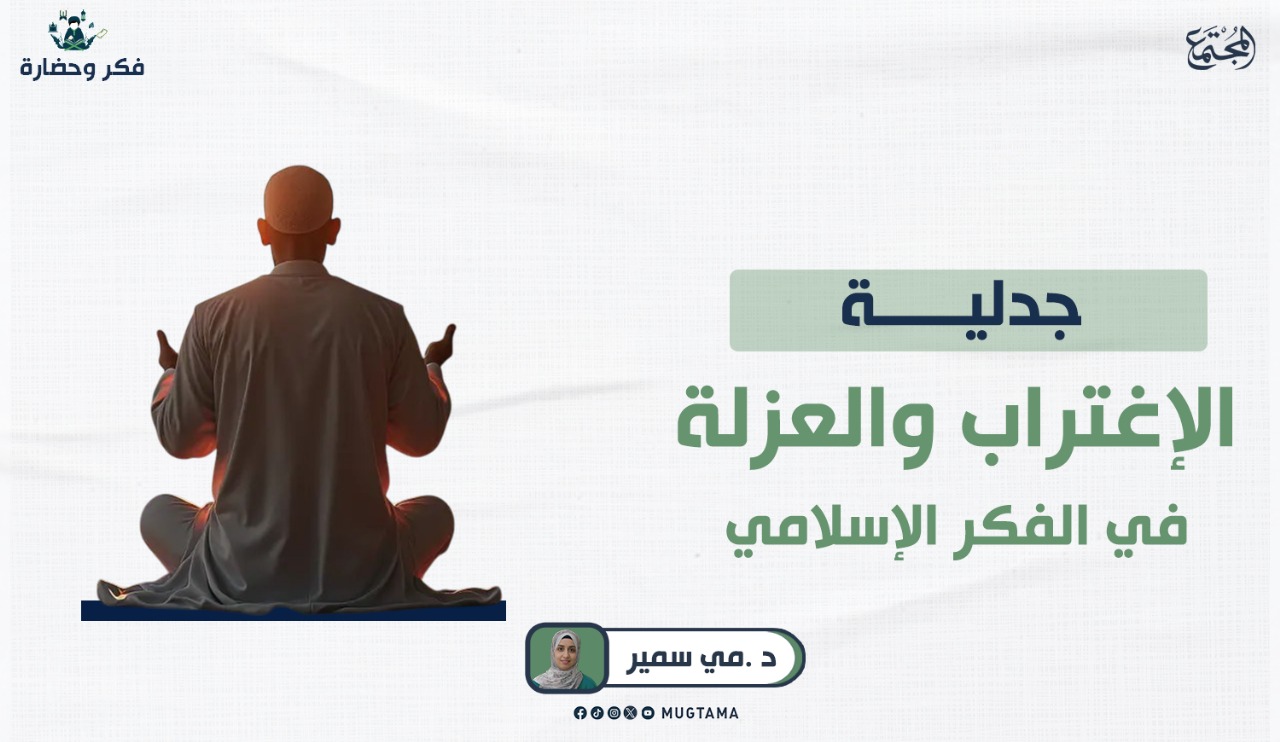
منذ غادر آدم
عليه السلام الجنة وهبط إلى الأرض بدأت رحلة البشرية مع الاغتراب، فالاغتراب هو
ذلك الشعور بأننا لا ننتمي إلى العالم المحيط بنا، وأن شيئاً ما ينقصنا؛ إنه رفضاً
نفسياً للتماهي مع العالم الخارجي وفقدان للانتماء للدوائر المُحيطة، وسعي إلى
النجاة بمعزل عن الآخرين، وهو فيه جوهره يعبر عن نزوع نحو العزلة –المادية أو
النفسية- وتفضيل الانفراد بالنفس على الانخراط مع الآخرين نتيجة رفض لهم وتمرد
عليهم.
وهذه الحالة وإن
كانت تصيب بعض الأفراد نتيجة تعرضهم لظروف وملابسات خاصة نابعة من دوائرهم الضيقة،
فإنها أيضاً قد تصيب فئة أو طبقة أو حتى مجتمعاً بأسره نتيجة فقدان الثقة واليأس
في إمكان تحقيق تواصل فعال وناجح مع الآخرين.
ورغم أن
الاغتراب قد لا يؤدي حتماً إلى العزلة عن الآخرين، فإن كثيراً من فئات العالم
العربي اليوم خاصة الشباب منهم قد دفعهم شعور الاغتراب إلى طرق أبواب الهجرة
والسفر خارج بلادهم، بينما لجأ آخرون إلى طرائق أخرى أسهمت في تفاقم العزلة بين
فئات المجتمع وتحولها إلى فقاعات من المجتمعات المفككة والمنغلقة على ذواتها.
وهنا يثور
التساؤل حول الطريقة التي عالج بها فلاسفة وفقهاء السياسة الإسلامية قضية العزلة
عن المجتمع، فإذا ما كان المجتمع فاسداً؛ هل على الفرد أن ينجو بنفسه ويبتغي سلامه
الشخصي ونجاته الفردية، أم أن الرؤية السياسية الإسلامية قد فضلت الانخراط في
المجتمع والاندماج فيه؟
المدنية
والعزلة في الإسلام
بالنظر إلى
الأدلة الشرعية الثابتة في القرآن والسُّنة، نجد بأن الإسلام دين جماعي بطبيعته،
حض على العمل الجماعي عبر تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وجعل الصلاة التي هي
أهم أركان الإسلام مناسبة للقاء الجماعي خمس مرات في اليوم، بالإضافة إلى صلاة الجمعة
مرة أسبوعياً، وصلاة العيد مرتين في العام.
من ناحية ثانية،
فإن فريضة الحج جماعية وعالمية، يأتي إليها المسلمون مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ في
اجتماع إسلامي سنوي ضخم يعبر عما أراده التشريع الإسلامي من لمّ شمل المسلمين
والحرص على توثيق روابط المحبة والألفة فيما بينهم.
ثم جاءت الزكاة
لتقدم دليلاً إسلامياً دامغاً على التآزر الاجتماعي المفروض شرعاً بين الأغنياء
والفقراء، وهناك عشرات الآيات والأحاديث النبوية التي أظهرت مدى تقدير الدين
الإسلامي للتآزر الاجتماعي والمحبة بين المسلمين وفرضت تكليفات جماعية عززت من
مسؤولية الفرد تجاه محيطه الاجتماعي، وحضت على المثابرة في الدعوة إلى الله والصبر
على أذى الآخرين والمجادلة بالتي هي أحسن.
الجماعة
في السياسة الإسلامية
برزت محورية الاجتماع
في الإسلام عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بادر الصحابة لاختيار خليفة
قبل حتى دفن النبي صلى الله عليه وسلم، رافضين ترك الأمة دون حاكم يسوس شؤونهم
ويحمي شوكتهم ويجمع شملهم ويحميهم من التشرذم والتفكك، وهو ما جعل ابن خلدون يؤكد
وجوب الإمامة بالشرع في الإسلام قياساً على إجماع الصحابة في تلك اللحظة.
وذهب كثير من
الفقهاء إلى التركيز على دور الخليفة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به كما لدى
الماوردي في «الأحكام السلطانية»، أو كما قال ابن تيمية في السياسة الشرعية بأن
الولاية واجبة لغرض: إصلاح دين الخلق الذين متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً، ولم
ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم.
تلك الرؤية
السياسية للخلافة أوجبت على المسلمين الاجتماع والاندماج في الحياة العامة من أجل
اختيار الخليفة وسياسة شؤون دينهم ودنياهم، وهو ما انعكس على ثراء سياسي اجتماعي
إسلامي في صدر الإسلام تمخض عنه حضارة ملأت الأرض نوراً بإشعاعها الثقافي والعلمي.
فلسفة
المدنية
وفي فلسفة
السياسة الإسلامية برزت المدينة باعتبارها الفضاء الوحيد الذي يمكن للفرد أن يصل
فيه ومن خلاله إلى الكمال، حيث تأثر فلاسفة الإسلام باجتهادات اليونان وآراء
أفلاطون وأرسطو التي أقرت بأن الإنسان كائن مدني بطبعه، حيث رأى ابن رشد في
المجتمع ضرورة ليس لكمال الإنسان فقط، وإنما لضرورة الحياة التي تحتم على البشر
التكامل سوياً لتبادل المنافع، فالإنسان على حد قول الفارابي مفطور على أنه محتاج
إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها؛ ومن ثم فإن المدينة هي الفضاء الأمثل
لتحقق الكمال الإنساني في الفلسفة الإسلامية.
وطبقاً لفيلسوف
الأخلاق ابن مسكويه، ففي المدينة يمكن للفرد أن يختبر فضيلته لا أن يصل إليها
فحسب، إذ إن ترك مخالطة الناس والتمسك بالزهد والتنسك والانعزال في مغارات الجبال
وصوامع الصحراء والسياحة في البلدان يجعل الإنسان بمنزلة الموتى والجمادات،
فالفضيلة الحقة لا يمكن أن تختبر لدى ابن مسكويه إلا بمساكنة الناس في المعاملات
وضروب الاجتماعات.
الصوفية
والنجاة الفردية
لكن اتجاهاً
معتبراً من فلاسفة الصوفية الإسلامية قد مالوا نحو تقدير أكبر للعزلة الفردانية عن
المجتمع، خاصة إذا ما ساد فيه الفساد، فرأى ابن باجة، في مؤلفه «تدبير المتوحد»،
أن الفرد المتوحد يجب أن يعتزل عن الناس جملة ما أمكنه، فلا يلابسهم إلا في الأمور
الضرورية، أو بقدر الضرورة، أو يهاجر إلى البلدان التي فيها العلوم، إن كانت
موجودة، وقد رأى ابن باجة أن ذلك لا يناقض فكرة المدنية التي اتفق عليها فلاسفة
السياسة الإسلامية لأنها مقصور على حالات بعينها يعجز فيها الفرد المتوحد أن يجد
صحبة صالحة من العلماء والأخيار.
وبينما جاءت
العُزلة على سبيل الاستثناء لدى ابن باجة، فقد ذهب أغلبية فلاسفة الصوفية نحو
تقدير العُزلة واعتبارها أمراً محورياً في حياة المريد أو السالك، فحذر ابن عربي،
في كتابه «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية»، من فكرة الصحبة ومخالطة
الآخرين، مؤكداً بأنها أشر شيء على المريد ومفضلاً قطع المألوفات وترك المستحسنات
وداعياً المريد لأن يكون مع جنسه وغيره كالوحش يفر منهم ويطلب بذلك الأنس بالله،
وهو ما يعني أن الصوفية قد فضلت العُزلة بشكل عام وفي ذاتها بقطع النظر إن كان
المجتمع فاسداً أم لا.
بينما قيد ابن
باجة العُزلة بفساد المجتمع وغياب الصحبة الصالحة، وهو ما ذهب إليه ابن طفيل في
قصة حي بن يقظان حين جعل بطل قصته يعتزل في نهاية القصة الناس بعدما قضى ردحاً من
الزمن في دعوتهم فلم يستجيبوا، وهو ما عني أهمية الدور الاجتماعي للإنسان الفاضل
ومحوريته لدى الغالبية العظمى من المفكرين والفلاسفة الإسلاميين على اختلاف
مشاربهم.
وقد اعتبر
الكواكبي، في كتابه «أم القرى داء العُزلة»، وترك الجماعية الإسلامية كأهم أسباب
فتور همة المسلمين وتخلفهم عن سائر الأمم، فأصبح كل فرد مسلم لا يهتم إلا بخويصة
نفسه وحفظ حياته في يومه، كأنه خلق أمة واحدة، في إشارة لما آلت إليه أحوال
المسلمين من عزلة واغتراب عن بعضهم بعضاً، لدرجة أنه لو خربت الكعبة لن تقف الحياة
أكثر من لحظة، ولما زاد تلاطم الناس على 7 أيام!
وأخيراً، فإن
الشعور بالاغتراب والرغبة في العزلة أمر طبيعي في فترات الفساد وعصور الخمول ومناخ
اليأس والتضييق، لكن الرؤية الإسلامية قد نهت عن اليأس وحضت على الانخراط في
المجتمع وبذل الجهد، ونبذت العُزلة وعدتها في تلك الحالة هروباً مذموماً من
مسؤولية الفرد المسلم إزاء أقرانه وإخوانه وأمته بأسرها، وهي رؤية تقدمية تفوق
كافة الآراء والنظريات الحديثة، ونحن إذ بعثنا كخير أمة أخرجت للناس أولى الناس
بالتآزر والتعاضد الاجتماعي مستمسكين بشريعتنا التي جعلتنا كالجسد الواحد إذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.