إعداد الدعاة في الحضارة الإسلامية (21)
دوام ذكر الله تعالى
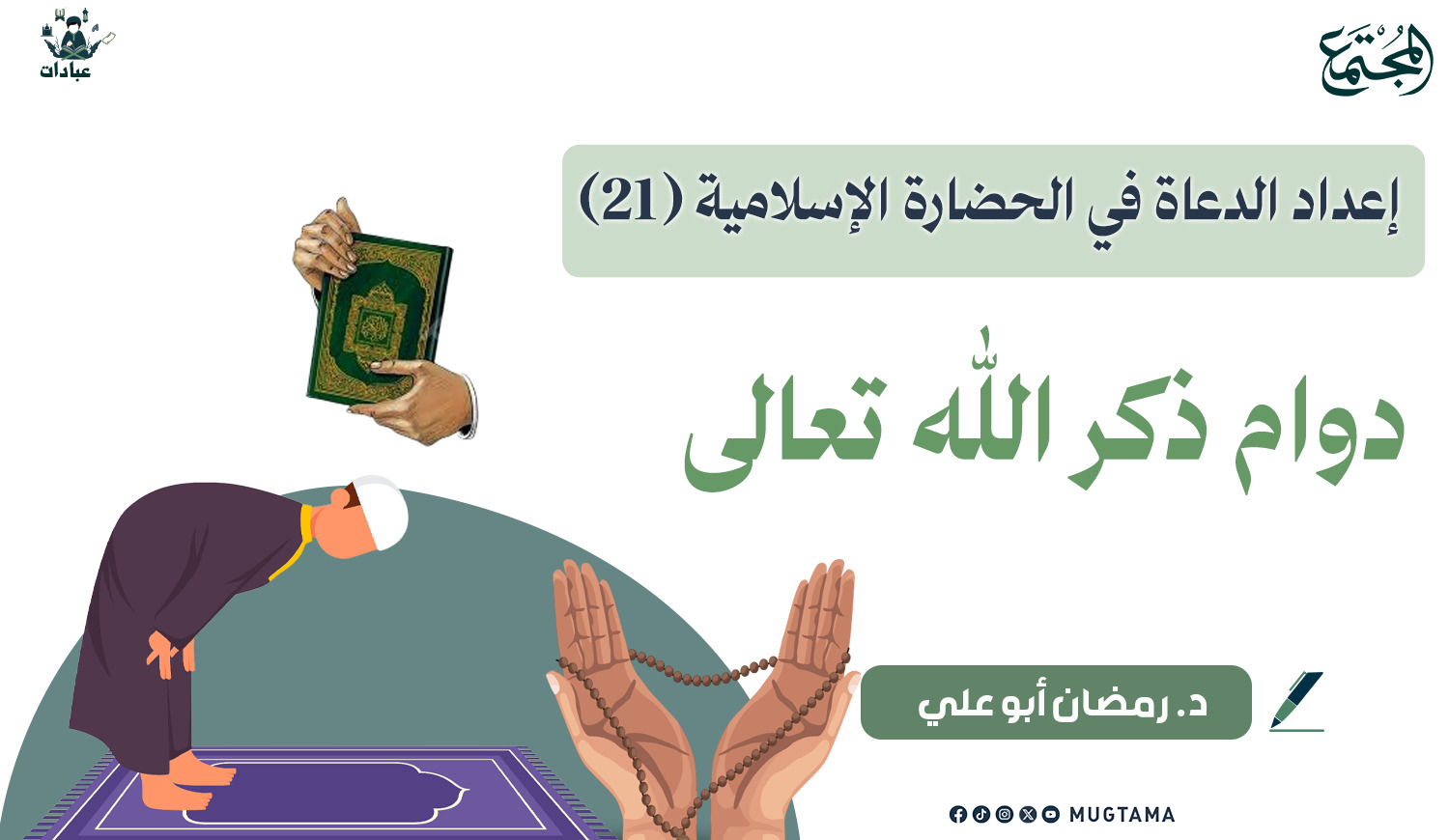
قال ابن عبّاس: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَى عِبَادِهِ فَرِيضَةً
إِلَّا جَعَلَ لَهَا حَدًّا مَعْلُومًا، ثُمَّ عَذَرَ أَهْلَهَا فِي حَالِ عُذْرٍ،
غَيْرَ الذِّكْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ،
وَلَمْ يَعْذُرْ أَحَدًا فِي تَرْكِهِ، إِلَّا مَغْلُوبًا عَلَى تَرْكِهِ،
فَقَالَ: (فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً
وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) (النِّسَاءِ: 103)، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَفِي السفر وَالْحَضَرِ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ،
وَالصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ، وَالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ(1).
من هذا المنطلق سارعت الحضارة الإسلامية إلى تربية الدعاة إلى الله تعالى
على الذكر الدائم لله في كل الأحوال.
مظاهر حرص الدعاة في الحضارة الإسلامية على دوام ذكر
الله:
1- الذكر في أوقات غفلة الناس:
كان الدعاة يحرصون على الذكر في أوقات وأماكن الغفلة، كالأسواق، ففي شعب
الإيمان عن الحسن قال: من ذكر الله في السوق كان له من الأجر بعدد كلّ فصيح فيها
وأعجميّ، فقال المبارك: الفصيح الإنسان والأعجم البهيمة، وفي مصنف ابن أبي شيبة
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: الْتَقَى رَجُلَانِ فِي السُّوقِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا
لِصَاحِبِهِ: يَا أَخِي، تَعَالَ نَدْعُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرْهُ فِي غَفْلَةِ
النَّاسِ لَعَلَّهُ يَغْفِرُ لَنَا، فَفَعَلَا، فَقَضَى لِأَحَدِهِمَا أَنَّهُ
مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَأَتَاهُ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ: يَا أَخِي، أَشْعَرْتَ
أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَنَا عَشِيَّةَ الْتَقَيْنَا فِي السُّوقِ.
2- استثمار الوقت في الذكر:
عن مُحَمَّد بْن أَبِي عَدِيٍّ قال: أَقْبَلَ عَلَيْنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي
هِنْدٍ فَقَالَ: يَا فِتْيَانُ، أُخْبِرُكُمْ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ
يَنْتَفِعَ بِهِ: كُنْتُ وَأَنَا غُلامٌ أَخْتَلِفُ إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا
انْقَلْبَتُ إِلَى الْبَيْتِ جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَى
مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ الْمَكَانَ جَعَلْتُ عَلَى
نَفْسِي أَنْ أَذكرَ اللَّهَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى آتِي
الْمَنْزِلَ(2).
3- التواصي بالذكر:
أورد ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالِ
الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قال: كنا نمشي مع معاذ بن جبل فقال لنا: اجْلِسُوا بِنَا
نُؤْمِنُ سَاعَةً يَعْنِي نَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى.
4- كثرة الذكر:
كان الدعاة يداومون على الذكر حتى أصبحت هذه حالهم المعروفة عنهم، حتى نقل
عنهم الناس في ذلك الكثير والكثير، فقد أورد الذهبي أَنَّ أبا هريرة كَانَ لَهُ خَيْطٌ،
فِيْهِ أَلْفَا عُقْدَةٍ، لَا يَنَامُ حَتَّى يُسَبِّحَ بِهِ(3)،
وعن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قُلْتُ لِمَعْرُوفِ بْنِ هَانِئٍ: أَرَى
لِسَانَكَ لَا يَفْتُرُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَكَمْ تُسَبِّحُ فِي
كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: مِائَتَيْ أَلْفَ مَرَّةٍ إِلَّا أَنْ تُخْطِئَ
الْأَصَابِعُ(4)؛ يعني أنَّه يَعُدُّ ذلك بأصابعه، وكان خالد بنُ معدان
يُسبِّحُ كلَّ يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، فلما مات وضع على
سريره ليغسل، فجعل يُشير بأصبعه يُحركها بالتسبيح(5)، وقد نام بعضُهم
عند إبراهيم بن أدهم فقال: كنتُ كلَّما استيقظتُ من الليل، وجدتُه يذكر الله،
فأغتمّ، ثم أُعزِّي نفسي بهذه الآية: (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ) (الجمعة: 4)(6).
5- الذكر على كل حال:
عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنَ الذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيراً حَتَّى يَذْكُرَ اللَّهَ قَائِماً وَقَاعِداً وَمُضْطَجِعاً(7).
6- تفضيل الذكر على غيره:
عن معاذ بن جبل قال: لأن أذكر الله تعالى من بكرة حتى الليل أحب إليَّ من أن
أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة حتى الليل(8)، وقَالَ
أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَأَنْ أُكَبِّرَ مِائَةَ مَرَّةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِينَارٍ(9)، وقَالَ أَبُو بُرْدَةَ
الْأَسْلَمِيُّ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً فِي حِجْرِهِ دَنَانِيرُ يُعْطِيهَا، وَآخَرَ
ذَاكِراً لِلَّهِ لَكَانَ الذَّاكِرُ أَفْضَلَ(10)، وعن أبي سليمان
الداراني قال: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِيَ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى
آخِرِهَا أُنْفِقُهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَأَنِّي أَغْفُلُ عَنِ اللَّهِ
طَرْفَةَ عَيْنٍ(11).
7- التعويض بالذكر عن بعض العبادات:
قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: إِنْ بَخِلْتُمْ بِالْمَالِ أَنْ تُنْفِقُوهُ،
وَجَبُنْتُمْ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ تُقَاتِلُوهُ وَأَعْظَمَكُمُ اللَّيْلُ أَنْ
تُسَاهِرُوهُ فَاسْتَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ؛
فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ هَذَا أَوْجَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَيْ ذَهَبٍ
وَفِضَّةٍ(12)، وقال أيضاً: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي
الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ
يُحِبُّ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ فَمَنْ خَافَ
الْعُدْوَانَ يُجَاهِدْهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ وَبَخِلَ
بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ
وَالتَّهْلِيلِ(13).
8- اعتبار الذكر سيد الأعمال:
قَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ: إِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ سَيِّداً مِنْ عَمَلِهِ،
وَإِنَّ سَيِّدَ عَمَلِي الذِّكْرُ(14).
9- اتخاذ الرفقاء المعينين على الذكر:
قال ذو النون: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح،
إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك(15).
10- الذكر في مجالس العلم:
معلوم أن مجالس الفقهاء والدعاة كانت تبدأ باسم الله وقراءة القرآن الكريم،
وتختتم بالدعاء والاستغفار، وكان الحسن البصري كثيراً ما يقول إذا لم يُحدث: سبحان
الله العظيم، فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة، فقال: إنَّ صاحبكم لفقيه(16).
دوافع حرص الدعاة في الحضارة الإسلامية على دوام ذكر
الله:
1- الذكر يمنح الطمأنينة:
قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ
قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (الرعد: 28)، وعند البيهقي عن أبي الدّرداء قال: لكلّ شيء جلاء،
وإنّ جلاء القلوب ذكر الله، وقال ابن تيمية: الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف
يكون حال السمك إذا فارق الماء(17).
2- الذكر يُلهم الحكمة:
روى البيهقي عن أبي بكر قال: ذهب الذّاكرون الله بالخير كلّه، وقال ميمون
ابن سياه: إذا أراد الله بعبده خيراً حبب إليه ذكره(18).
3- الاستئناس بالذكر والتلذذ بالنعيم:
قال مالك بن دينار: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى، وعن أبي
أسامة قال: قلت لمحمد بن النضر: كأنك تكره أن تزار؟ فقال: أجل، قلت: أما تستوحش؟
قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني(19).
4- الله يذكر من ذكره:
عن ثابت البناني عن رجل من العباد أنه قال يوماً لإخوانه: إني لأعلم متى يذكرني
ربي عز وجل، قال: ففزعوا من ذلك فقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم، قالوا:
متى؟ قال: إذا ذكرته ذكرني(20).
5- الذكر يرفع أهله:
أورد ابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ
لَيَرَوْنَ بُيُوتَ أَهْلِ الذِّكْرِ تُضِيءُ لَهُمْ كَمَا تُضِيءُ
الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.
6- الوقاية من الشيطان والمنع من المعصية:
أورد ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عبّاس قال: الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى
قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ
خَنَسَ، وقال سعيد بن جبير: الذِّكْرُ طَاعَةُ اللهِ، فَمَنْ أَطَاعَ اللهَ،
فَقَدْ ذَكَرَهُ، وَمَنْ لَمْ يُطِعْهُ، فَلَيْسَ بِذَاكِرٍ، وَإِنْ أَكْثَرَ
التَّسْبِيْحَ وَتِلَاوَةَ القُرْآنِ(21)، وعن ميمون بن مهران قال: كان
يقال الذكر ذكران؛ ذكر الله باللسان، وأفضل من ذلك أن تذكره عند المعصية إذا
أشرفت عليها(22).
7- البراءة من النفاق:
روى البيهقي أن كعباً بن مالك قال: من أكثر ذكر الله برأ من النّفاق.
8- سلاح الفزع:
أورد ابن أبي شيبة في مصنفه أن الْحَسَن الْبَصْرِيّ قَالَ: بَيْنَمَا
رَجُلٌ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ مُنَادِياً يُنَادِي فِي السَّمَاءِ: أَيُّهَا
النَّاسُ، خُذُوا سِلَاحَ فَزَعِكُمْ، فَعَمَدَ النَّاسُ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ
حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ وَمَا مَعَهُ إِلَّا عَصًا، فَنَادَى مُنَادٍ مِنَ
السَّمَاءِ: لَيْسَ هَذَا سِلَاحَ فَزَعِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَرْضِ: مَا
سِلَاحُ فَزَعِنَا؟، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
9- النجاة من العذاب:
في سنن ابن ماجة عن مُعَاذ بْن جَبَلٍ قال: مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى
لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ، قَالَ: الصَّوَاعِقُ تُصِيْبُ المُؤْمِنَ وَغَيْرَ المُؤْمِنِ، وَلَا
تُصِيْبُ الذَّاكِرَ(23)، وقال عون بن عبدالله: ذاكر الله في غفلة
الناس، كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، ولولا
من يذكر الله من غفلة الناس؛ هلك الناس(24).
10- مغفرة الذنوب:
قال ثابت البناني: إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله، وإن عليهم من
الآثام كأمثال الجبال، وإنهم ليقومون من ذكر الله عطلاً ما عليهم منها شيء(25).
______________________
(1) تفسير الطبري (9/ 164).
(2) حلية الأولياء (3/ 93).
(3) سير أعلام النبلاء (2/ 623).
(4) الزهد: أحمد بن حنبل، ص 138.
(5) حلية الأولياء (5/ 210).
(6) جامع العلوم والحكم (2/ 517).
(7) حلية الأولياء (3/ 283).
(8) المرجع السابق (1/ 235).
(9) الزهد: أحمد بن حنبل، ص 113.
(10) المرجع السابق، ص 153.
(11) الأولياء: ابن أبي الدنيا، ص 21.
(12) الزهد: أحمد بن حنبل، ص 307.
(13) المرجع السابق، ص 316.
(14) حلية الأولياء (4/ 241).
(15) صفة الصفوة (2/ 444).
(16) جامع العلوم والحكم (2/ 517).
(17) الوابل الصيب: ابن القيم، ص 42.
(18) حلية الأولياء (3/ 107).
(19) صفة الصفوة (2/ 162).
(20) المصدر السابق (2/ 154).
(21) سير أعلام النبلاء (4/ 326).
(22) حلية الأولياء (4/ 87).
(23) سير أعلام النبلاء (4/ 408).
(24) صفة الصفوة (2/ 57).
(25) حلية الأولياء (2/ 325).
















