شذرات من حكاية سيد طه «الضبع السوداني» بطل معركة «الفالوجة»
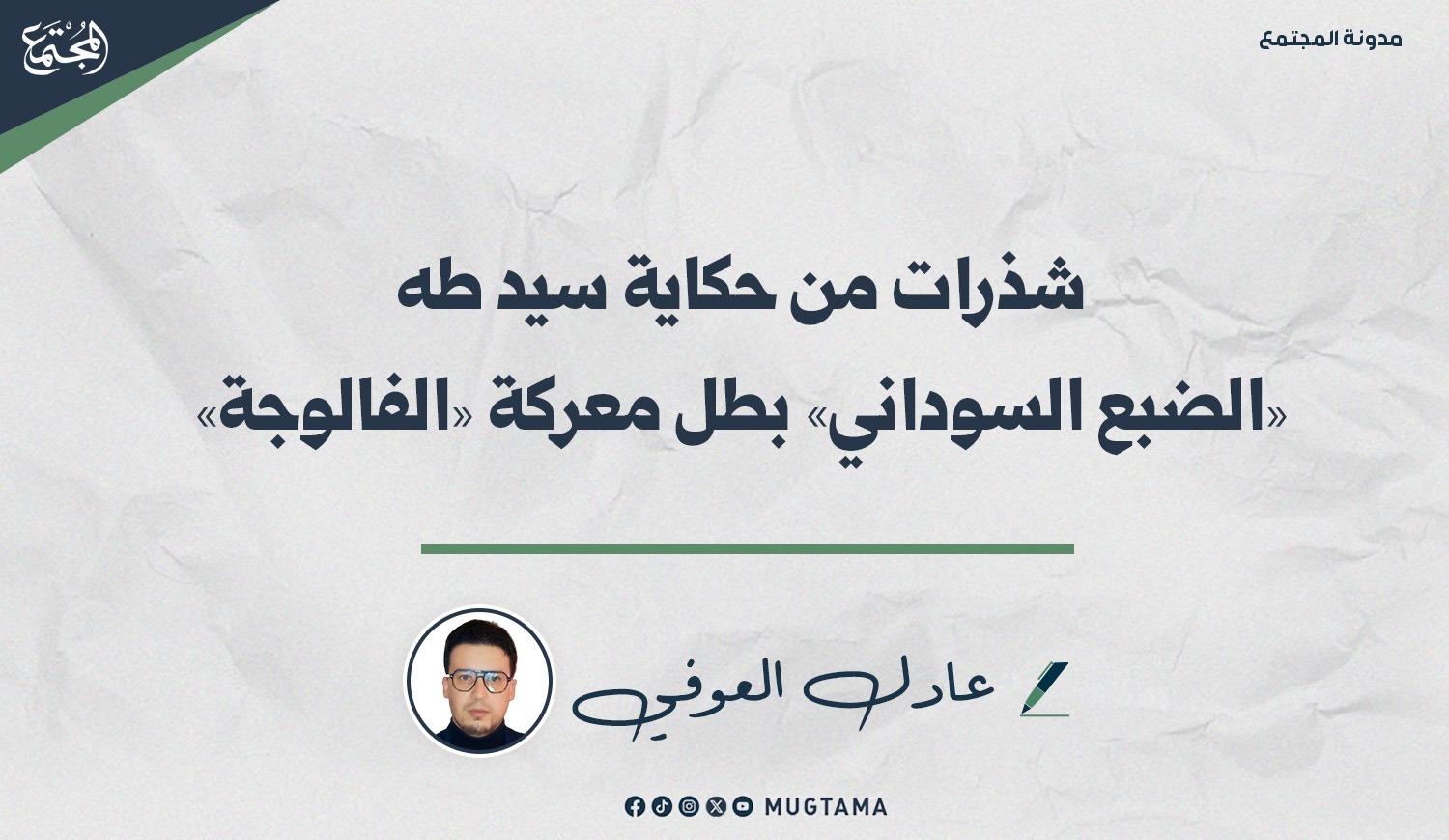
ليست عبارة «التاريخ يكتبه المنتصرون» صائبة في كل الأحوال، ولا تعكس الحقائق على أرض الواقع في العديد من المرات؛ من هذا المنطلق نمضي وننبش في سيرة بطل عربي غطت النتيجة النهائية للمعركة على ما خطه في ساحة الوغى من ثبات ورباطة جأش وشجاعة؛ فكل ما حفظته الكتب عن عام 1948م تختصره كلمة واحدة قاسية مرة مرارة الحنظل وهي «النكبة»، وما زلنا نعيش على وقعها التعيس وندفع فواتيرها الغالية؛ لكن عين الإنصاف تقتضي منا أيضاً وبالموازاة مع سرد معطيات الهزيمة أن نعطي كل ذي حق حقه، ومن هنا سنتحدث عن شخصية القائد السوداني الأصل المنضوي تحت لواء الجيش المصري حينها سيد طه الشهير بلقب اختاره الأعداء بعناية فائقة بعد أن أذاقهم الويلات وهو «الضيع الأسود».
نداء
فلسطين
كما هو معلوم،
في فجر 15 مايو 1948م، أنهت بريطانيا احتلالها لأرض فلسطين؛ فاندفع الجيش المصري
نحوها بمقتضى تعليمات تفيد بتطويق «تل أبيب» متجهة على الطريق الساحلي إلى أشدود،
ثم انحرفت شرقاً وسيطرت على خط المجدل، والفالوجة، وعراق المنشية، وبيت جرين، والخليل؛
لتفصل الشمال حيث يتمركز الصهاينة عن جنوب النقب لمحاصرة المستعمرات هناك.
لكن بعد الهدنة،
استغل الصهاينة نقطة ضعف خطوط مواصلات الجيش المصري، وهي طولها، حيث ظلت دون حماية
ولا حراسة، فنجحوا في تقطيعها ليحدثوا ارتباكاً واضحاً في القوات الأمامية لتضطر
القيادات إلى تقصير خطوطها وطالبت بخروج قواتها، بل وأمرت بانسحابها لتغادر بعض
القوات دون أوامر أو خطة مرسومة، وغياب أي تخطيط وتنسيق؛ ما أضعف الروح المعنوية
للجيش.
وبقيت قوة واحدة
لم تغادر موقعها المتواجد في موقع الفالوجة الإستراتيجي الفاصل شمال فلسطين عن
جنوبها، وكانت بقيادة الأميرالاي السوداني سيد طه، وقد وجب التوضيح أنه في تلك
الفترة كانت الوحدة قائمة بين مصر والسودان؛ لذلك يخدم السودانيون في الجيش المصري،
وكان الملك فاروق يحمل لقب «ملك مصر والسودان»، وقد كان من ضمن قوّات طه حينها البكباشي
جمال عبدالنّاصر، الذي عمل تحت إمرته وبقي معه طوال فترة الحصار هناك.
والفالوجة وبيت
جبرين وعراق المنشية مجموعة قرى تقع على مسافة متساوية بين الخليل وغزة، وكانت
السيطرة عليها ستؤدّي إلى عزل المستوطنات التي أقامها اليهود في جنوب النقب التي
تبعد أميالاً عن مركزهم الرّئيس في «تل أبيب» والساحل الفلسطيني؛ ما يمنع إمكانيّة
تأسيس «دولةٍ يهوديّةٍ» مترابطة تمتد إلى سواحل البحر الأحمر.
بقيت القرية آخر
معقل تحت سيادة العربية في الجزء المحتل من أرض فلسطين لتنسج قصة بطولية التحم
فيها نحو 6 آلاف فلسطيني، ومعهم 4 آلاف جندي مصري حوصروا حصاراً شديداً، ونسجوا
قصة وفاء ووحدة منقطعة النظير؛ حيث بعد انقطاع خطوط إمداد الجيش المصري وانسحاب
باقي القوات وتراجعها للجنوب الغربي، لم يعد أمام الفالوجة من خيار سوى رفع الراية
البيضاء والاستسلام أمام الواقع المر، فالكتيبة أضحت معزولة، والقصف اشتد، ولا أمل
يلوح في الأفق سوى تسليمها للعدو المتربص بها من كل جهة.
فرض الحصار على
القوات المصرية في 17 أكتوبر 1948م، لكن «الضبع السوداني» أشهر راية التحدي رافضاً
الإنصات لكل الناصحين، صادحاً أمام قواته: «لن نستسلم ما دام فيما عرق ينبض»، وأضاف
حين ظلت نداءات الانسحاب تصله بين الفينة والأخرى: «أنا مسلم وأبي فلاح ولا يمكن أن
أفرط في هذه الأرض الإسلامية، فإما النصر وإما الشهادة».
6
أشهر من الحصار الخانق
اعتمد الجنود
المصريون على ما تتوفر عليه القرية من حبوب وأغنام وأبقار، وكانوا يشترون من الأهالي
ويعطونهم أوراقاً تثبت لهم الثمن لاسترداد القيمة من مقر القيادة المصرية في مدينة
بيت لحم في الضفة الغربية؛ لتنفد كل الكميات الموجودة بالفالوجة، وبالتزامن مع ذلك
ظل القصف الصهيوني مستمراً من أجل إجبار السكان على الخروج منها.
لتستمر أيضاً
عروض الانسحاب تنهال على «البيه طه»، كما يلقب، لكنه مُصرّ على القتال حتى الرمق الأخير،
لدرجة أنه رفض أوامر قيادته من القاهرة تطلب منه المغادرة إلى غزة ثم لمصر.
ويروي أحد أهالي
القرية، في لقاء صحفي: في إحدى المرات، عاد «البيه طه» إلى البلدة بعد اجتماع مع
قيادة قوات الاحتلال بمستوطنة غريات غاد، وأبلغ الجيش والسكان بمهلة للانسحاب،
لكنه أمر جيشه بالاستعداد للمواجهة، وفي ساعة تجمُّع اليهود القادمين من تلك
المستوطنة القريبة للانقضاض على القرية، أعطى أوامره بإطلاق النار على الغزاة،
وأوقع المئات منهم بين قتلى وجرحى، ومضى أسبوع كامل حتى سمح لليهود بأخذ الجثث.
وفي ظل استمرار «الضبع
السوداني» وثباته على موقفه، تدخل غلوب باشا، القائد البريطاني للجيش الأردني،
واضعاً خطة لإنقاذ القوات المصرية المحاصرة، مفادها تولي القوات الأردنية إشغال
الصهاينة ومناوشتهم عند بيت جبرين، وحينها يقوم سيد طه ورجاله بتدمير أسلحتهم
الثقيلة والانسحاب، متسللين في طرق سرية، وسيتم ذلك تحت إشراف ضابط بريطاني اسمه «الميجور
لوكت».
وحين عرضوا
التفاصيل عليه رفضها جملة وتفصيلاً، بل وطرد المبعوثين البريطانيين، مُصراً على
مواصلة الصمود حتى آخر طلقة، ولن يمكّن الصهاينة من مرادهم.
وحول شجاعة «البيه
طه»، اعترف السفاح الصهيوني أرييل شارون وهو حينها كان قائداً لإحدى العصابات
بالقول: «كانت القوات المصرية التي قوامها 4 آلاف جندي تحت قيادة عميد سوداني يسمى
سيد طه بيه، وهو محارب قديم تلقى تدريبه في الجيش البريطاني، هذا السيد طه بيه كان
بطلاً حقيقياً، رفض الانسحاب وأن يجري مفاوضات مع أي من قادتنا، وبالرغم من
سيطرتنا التامة على ميدان المعركة، حاولنا كل ما نستطيع لكسر دفاعات سيد طه بيه.
ومنذ نهاية
أكتوبر، كان هجومنا، الواحد تلو الآخر، يُصَد مصحوباً بخسائر كبيرة، وأخيراً خططنا
بجهد عظيم لعملية كبرى في ليلة 27 سبتمبر 1948م، ففي عملية مزدوجة بقيت بعض من
قواتنا على قرية الفالوجة منشغلة بمناوشتها، بينما قامت كتيبة أخرى بهجوم شامل على
المنشية، غير أن النتيجة كانت كارثية، فعندما آن أوان انسحابنا فقدنا في هذه
المعركة 98 رجلاً من جملة 600 جندي.
نقطة
النهاية
بذل «الضبع
السوداني» كل ما بوسعه، وكافح وقاوم في ظل حصار خانق وغياب كلي للإمدادات، وظل
مرابطاً في جيب الفالوجة حتى أواخر فبراير 1949م، لتبرم الحكومة المصرية اتفاقاً
رسمياً للهدنة مع الكيان الصهيوني، تضمن انسحاب التام لقواتها المحاصرة بضمانة الأمم
المتحدة وبكامل عدتها وعتادها، وبتعهد من لدن الصهاينة بضمان سلامة أهالي الفالوجة
بعد مغادرة البيه طه وقواته؛ ولكن كالعادة انتهكوا الاتفاق لاحقاً وقاموا بتهجير
السكان.
عاد سيد طه
للمحروسة وسط احتفال كبير من مختلف الهيئات، حتى إن الملك فاروق أقام حفلاً كبيراً
له ولجنوده، لكن المثير للانتباه يكمن فيما حصل لاحقاً وتحديداً بعد أن انطفأت أنوار
الاحتفالات الرسمية والشعبية، حيث صدر قرار بنقل البيه طه إلى الصعيد وبالضبط في منقباد؛
وهو ما يصنف في عرف التقاليد العسكرية قراراً تأديبياً وعقابياً ولا يمت بصلة لكل
التهليل الذي صاحب عودته.
ظلت الأخبار
شحيحة بعد ذلك حول مصير البطل الهمام، وهناك من أكد عودته لوطنه السودان عقب قيام
ثورة يوليو بأوامر مباشرة من رجالها، لكنها تظل مصادر غير مؤكدة ولا يعتد بها، غير
أن المؤكد أن بطولات هذا الرجل مغيبة بفعل فاعل لصالح «تلميع» أسماء أخرى في تلك
الحقبة.
مع العلم أن سيد
طه خط مذكراته ونشرتها مجلة «آخر ساعة» التي يرأس تحريرها آنذاك كامل الشناوي، لكن
المريب أنها لم تطبع في كتاب خاص رغم ما تحتويه من أسرار ومعلومات مهمة للغاية عن
مرحلة نعيش عواقبها حتى اللحظة.
والسؤال هنا:
لماذا لا نرى أعمالاً فنية مستوحاة عن حياة هذا البطل الشهم في الوقت الذي تنفق
فيها الميزانيات الضخمة على توثيق بطولات وهمية وملاحم من ورق؟ أليس «الضبع
السوادني» أجدر وأحق بها، وأن نقدم للأجيال الجديدة نماذج مشرفة راقية يحتذى بها
في الوطنية والانتماء؟

















