ضعف تفاعل الطلاب.. أسباب وحلول لمواجهة التحدي الأكاديمي
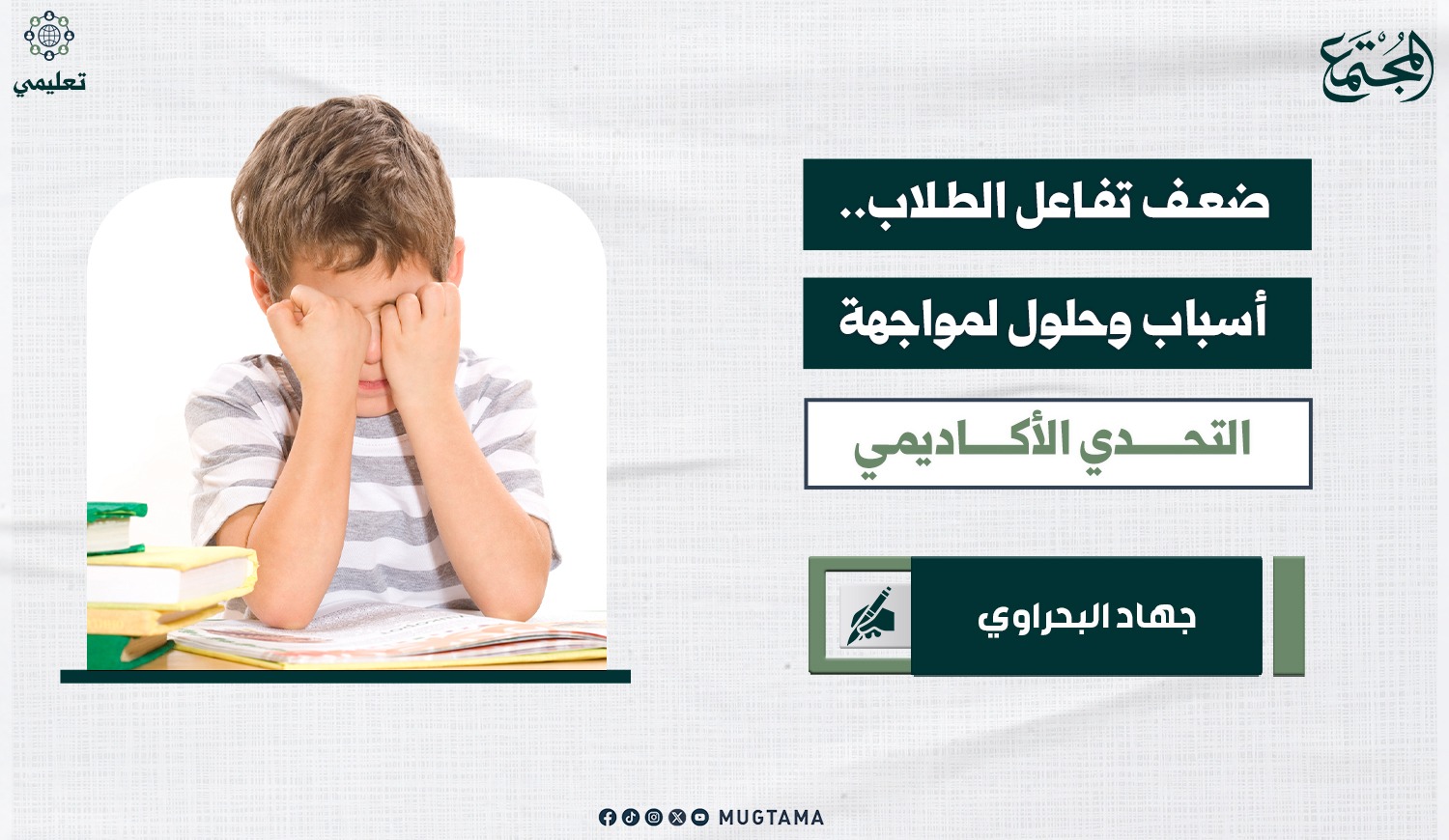
الجامعات مؤسسات
مؤثرة في إعداد الطالب ورقي المجتمعات، فهي توجه سلوكهم نحو التفاعل الإيجابي مع
المجتمع، وأي تطوير مجتمعي لا ينجح إلا بمشاركة الشباب الجامعي؛ لذا يجب على
الجامعة معالجة ضعف تفاعل الطلاب مع المحاضرات، لأنه مؤشر على خلل في العملية
التعليمية يستدعي دراسة أسبابه بدقة.
عوامل متعلقة بالطالب
الأول: السهر وقلة التفاعل مع محاضرات الصباح:
السهر يسبب نقص
النوم؛ فيضعف الحضور للمحاضرات المبكرة، ويقلل التفاعل بسبب الإرهاق، أما النوم
الكافي فيحافظ على الذاكرة، ويهيئ الطلاب للتعلم بحالة أفضل؛ ما يزيد من التفاعل
والأداء الأكاديمي.
السهر يضعف حضور المحاضرات المبكرة ويقلل
التفاعل بسبب الإرهاق أما النوم الكافي فيحافظ على الذاكرة
وقد يسهر الطلاب
لأسباب متعددة، مثل الدراسة أو السمر مع الأصدقاء أو استخدام الوسائل الإلكترونية
أو المشاركة في أنشطة طلابية، لكن هذا السهر ينعكس سلباً على الفهم والتفاعل في
المحاضرات، فيضعف بذلك الاستفادة الحقيقية من الدراسة.
الثاني: الكسل وعدم الاهتمام وانعدام الشغف:
الكسل يؤثر سلباً
على حضور الطلاب وتفاعلهم في المحاضرات، ويضعف من عزائمهم وتقديرهم لذواتهم حتى
يروا أنفسهم فاشلين بلا دافع للجد والاجتهاد، ومع غياب الحافز يقل اهتمامهم
بالدراسة ويتعطل تقدمهم الأكاديمي؛ ما يحرمهم من تعليم جيد يسهم في بناء شخصيتهم، كما
أن الإحباط واليأس من الفهم يزيدان من فقدان الشغف ويعمّقان مشكلة اللامبالاة
بالتعلم.
الثالث: الانشغال بالهاتف داخل المحاضرة أو التحدث بين الأصدقاء:
أصبح الهاتف آفة
العصر، يشتت تركيز الطلاب داخل قاعة المحاضرة؛ فبعضهم ينشغل بتصفح الفيديوهات أو
الرسائل، أو بالدردشة الجانبية مع الزملاء؛ ما يضعف التركيز ويقلل التفاعل مع
المحاضر، وغالباً ما يرجع ذلك إلى ضعف الفهم وقلة الاهتمام، وهو ما يقود بدوره إلى
اللامبالاة والانشغال بما لا يفيد.
.. والكسل يؤثر سلباً على حضور الطلاب
وتفاعلهم في المحاضرات ويضعف من عزائمهم وتقديرهم لذواتهم
الرابع: عدم التحضير للمحاضرة:
قلة من الطلاب
تجهز نفسها مسبقاً بقراءة الدرس أو البحث عن معلوماته قبل المحاضرة؛ ما يجعلهم
يواجهون المادة لأول مرة أثناء الشرح، فيصعب عليهم الفهم والمشاركة، وهذا يضعف
تفاعلهم بشكل كبير في الحصة الدراسية.
الخامس: كثرة الغياب المتكرر:
الغياب يُعد من
أبرز أسباب ضعف التفاعل؛ إذ إن المقررات الدراسية مترابطة، وكل محاضرة تمثل حلقة
تقود إلى الأخرى، فإذا فاتت الطالب حلقة اختل فهمه وتعذر عليه متابعة ما يليها؛ ما
يضعف تركيزه ويمنعه من التفاعل، كما أن الغياب لا يضر الطالب وحده، بل يشجع زملاءه
على التساهل فيه ويجعل الاعتذار عن عدم الحضور أمراً سهلاً، فتزداد المشكلة.
السادس: عدم إحساس الطالب بأهميته في قاعة الدرس:
التفاعل مسؤولية
مشتركة بين الطالب والمحاضِر؛ فالمحاضِر هو من يمنح الطالب شعور الأهمية داخل
القاعة عبر إشراكه بالأسئلة، وتكرار اسمه، والنظر إليه مباشرة لبناء صلة حقيقية
معه، أما عند غياب هذه المشاركة، فيتحول الطالب إلى مجرد متلقٍّ سلبي، فيسأم ويشعر
أن لا فرق بين المحاضرة المباشرة وغير المباشرة؛ ما يضعف دافعيته ويقلل من تفاعله
مع العملية التعليمية.
عوامل متعلقة بالمحاضر نفسه
التفاعل بين عضو
هيئة التدريس والطلبة شرط أساسي لضمان نجاح أي بيئة تعليمية وتحقيق أهدافها في
توصيل المعلومات والمهارات المطلوبة للطلبة، فكما أن الطالب مكون أساسي في هذه
العملية، فكذلك المحاضِر؛ حيث يُعد المحاضر من الأسباب الرئيسة للتحكم في تفاعل
الطالب مع المحاضرات من عدمه، وهذا يظهر في العوامل الآتية:
الأول: عدم مراعاة الفروق الفردية وطغيان المتفوقين على التفاعل:
على المحاضِر أن
يراعي مستويات الطلاب جميعاً، فيوازن بين المتميزين والضعفاء والمتوسطين، فلا
يُبنى الشرح على فهم قلة متميزة فقط، فالطالب يحتاج أن يشعر بالاهتمام، وإذا أُهمل
أو قوبل بالتحقير والمقارنة غير العادلة، ضعفت همته وكسل وغاب، والمقارنة بين
الطلاب قد تكون مفيدة للتشجيع، لكن إن لم تُراعَ الفروق الفردية؛ أدت إلى إحراج
البعض وتوبيخهم، فتكون النتيجة عكسية وتقلل من دافعيتهم للتعلم.
التفاعل مسؤولية بين الطالب والمحاضِر فالأخير
هو من يمنح الطالب الشعور بالأهمية عبر إشراكه بالأسئلة
الثاني: التعليم التقليدي التلقيني ودوره في عدم التفاعل:
الاعتماد على
أسلوب التلقين والتكرار يجعل الطالب مجرد متلقٍّ للمعلومة بدل أن يكون شريكاً في
بنائها؛ ما يقلل من فهمه وقدرته على التفكير النقدي والإبداع.
وقد أوضح كتاب «مكونات
العملية التعليمية» أن التعليم التقليدي يعتمد على المدرس كسلطة معرفية مطلقة،
تقدم المعرفة جاهزة للطالب الذي يكتفي بالحفظ والتقليد؛ ونتيجة لذلك، يفتقر الطالب
إلى المهارات المهنية والمنهجية والتواصلية والعملية؛ ما يجعله غير قادر على
مواجهة التحديات الحديثة أو التكيف مع متطلبات الواقع الجديد، إذ تبقى معارفه
نظرية مجردة تفتقد للتجريب والممارسة.
عوامل منهجية متعلقة بالبيئة والمواد الدراسية
الأول: عدم جاهزية قاعة المحاضرات لحاجات الطالب التعليمية:
1- درجة الإضاءة
في قاعة المحاضرات: فالإضاءة يمكن أن تؤدي أيضاً دوراً مهماً في مدى مشاركة الطالب
في عمليات التعلم، حيث وجدت العديد من الدراسات التربوية أن الطلاب الذين يتعلمون في بيئات مضاءة بشكل طبيعي يحققون عادة درجات أعلى بنسبة 25% من تلك الموجودة في
الفصول الدراسية ذات الإضاءة الخافتة ثبت أيضاً أنّ الضوء الطبيعي يعزز المزاج
بشكل فعال ويقلل من مشاعر التوتر والقلق.
2- درجة الحرارة
والهواء النقي: إن زيادة الهواء النقي وإزالة الملوثات تحسن الأداء الأكاديمي،
وتظهر الدراسات الخاضعة للرقابة أن الطلاب يؤدون العمل المدرسي بشكل أسرع مع زيادة
معدلات التهوية.
على المحاضِر أن يراعي مستويات الطلاب
جميعاً فيوازن في تعامله بين المتميزين والضعفاء والمتوسطين
3- ازدحام بعض
الفصول بالطلاب: فقد تمتلئ القاعة الواحدة بأكثر من 50 طالباً، وذلك لا يخفى
تأثيره السلبي على المحاضِر الذي لن يستطيع أن يلاحظ كل الطلاب، وكذلك الطالب الذي
يظن نفسه غير مرئي في ذلك الجمع الكبير، كما تزداد الفجوة في العلاقة بين الطالب
والمحاضِر في الازدحام وتزداد الرهبة من السؤال، ويقل الفهم؛ ومن ثَم التفاعل.
الثاني: عدم إرفاق المناهج الدراسية بصور الأنشطة المحفزة:
كتب المقررات
الجامعية تعاني من الجمود ونقص العناصر البصرية، رغم أن الصورة تُعد أداة تعليمية
فعّالة، فهي تسهّل إيصال المعلومة العلمية، وتؤثر وجدانياً في المتعلم، وتوضح
الأداء العملي للمهارات، كما تساعده على الاندماج مع محيطه الواقعي والتفاعل معه
بشكل إيجابي أو سلبي.
لقد أثبتت
الدراسات أن مرحلة الجامعة تمثل فترة نضج فكري تؤهل الطالب لفهم العلوم ومناهجها؛ ما
يجعل ضعف التفاعل خلالها خطراً على المسيرة التعليمية مستقبلاً، خصوصاً لمن يطمح
للدراسات العليا أو العمل، وتُعد ظاهرة ضعف التفاعل مع المحاضرات تحدياً معقداً،
تتداخل فيه عوامل تخص الطالب والمادة والبيئة التعليمية، بينما يؤدي الأستاذ
الجامعي دوراً أساسياً في الحد منها، ففهم الأسباب أول خطوة للعلاج.

















