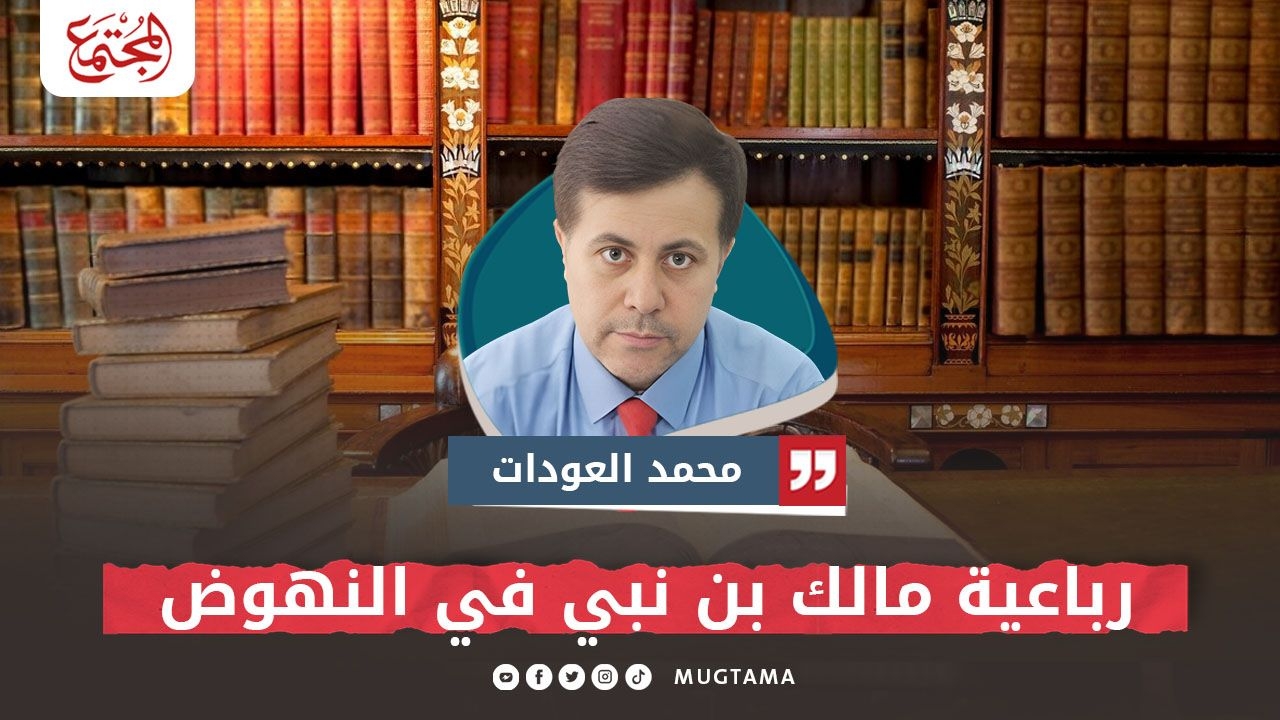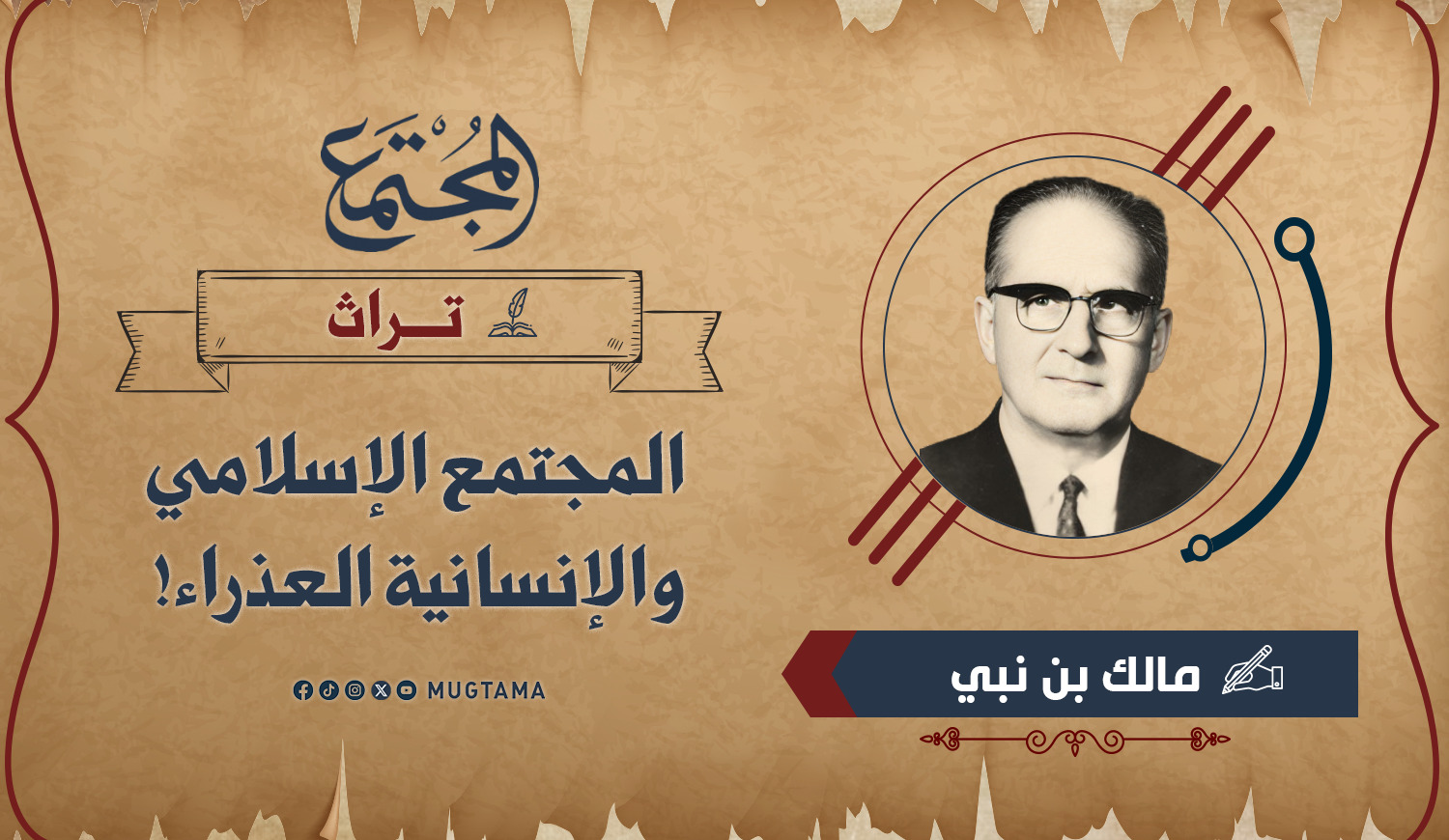كيف عالج مالك بن نبي «المسألة اليهودية»؟

لعل لا أحد قبل المفكر الجزائري مالك بن نبي
تناول المسألة اليهودية في العالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ذلك
أن «المسألة اليهودية» ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ الأوروبي المسيحي ولم تطرح
نفسها كإشكالية عربية أو إسلامية إلا في النصف الأول من القرن الماضي بعد نشأة «إسرائيل»
في فلسطين، حيث طرحت عربياً لكن من زاوية مختلفة تماماً عن تلك التي تنوولت بها في
الفكر المسيحي القديم والفكر الأوروبي الحديث، إذ طرحت هذه المرة من زاوية الظاهرة
الاستعمارية.
نشأة «المسألة اليهودية»
يمكن تعريف «المسألة اليهودية» أو «المشكلة
اليهودية» بأنها المجال البحثي الذي يدرس الوجود اليهودي في المجتمعات الأوروبية والمشكلات
التي كان اليهود يطرحونها على هذه المجتمعات خلال القرون الماضية، على الأصعدة الدينية
والثقافية والسياسية والاقتصادية، وإشكالية اندماجهم في هذه المجتمعات، وقضية التعايش
مع الأوروبيين المسيحيين، وطبيعة حياة اليهودية الانعزالية داخل المعازل السكنية أو
«الغيتوهات» على هوامش المدن الأوروبية.
ويعود أصل «المسألة اليهودية» إلى العصور
الوسطى الأوروبية؛ ففي القرن الثالث عشر انتشرت في بريطانيا ثم في عموم أوروبا أسطورة
تقول: إن هناك شاهداً على صلب المسيح لا يزال حياً ويعيش في بريطانيا، يدعى كارطافيلوس،
وإن هذا الشخص عندما كان المسيح يساق إلى الخشبة لصلبه اقترب منه ودفعه من ظهره وصرخ
فيه: «أسرع، لماذا تسير ببطء؟»، فرد عليه المسيح: «أنا سأذهب، ولكنك ستظل تنتظر عودتي»،
ومن هذه القصة الخرافية ظهرت أسطورة «اليهودي التائه» التي رافقت اليهود في أوروبا
طيلة القرون التالية.
ولكن إذا كانت المسألة اليهودية قد ظهرت في
العصور الوسطى، فإن خلفياتها الدينية والتاريخية تعود إلى حقبة صلب المسيح الإنجيلي،
عندما اتهم المسيحيون اليهودَ بكونهم مسؤولين عن تلك الجناية، وظلت تلك الجناية تعيش
في نفوس المسيحيين زمناً طويلاً، وبسببها انتشر العداء ضد اليهود في أوروبا المسيحية
وظهرت نزعة اللاسامية.
وقد عكست كتابات علماء الكنيسة الأوائل، مثل
القديس أوغسطين، هذه الكراهية لليهود بسبب اتهامهم بقتل إله النصارى، إذ كتب أوغسطين
عام 427م بأن اليهود «هم قتلة السيد المسيح، لأنهم رفضوا الإيمان به».
ويبدأ التحقيب الرسمي لظهور هذه المسألة في
أوروبا مع ظهور حركة معاداة اليهود في ألمانيا إبان القرن التاسع عشر، بعد أن نشر الصحفي
الألماني ويلهلم مار كتابه «مرآة اليهود» في ستينيات القرن الماضي، الذي وصف فيه اليهود
بأنهم «جذام العصور الحديثة»، لكن الحرب الفرنسية البروسية التي بدأت عام 1870م شغلت
الألمان عن هذه القضية، إلى أن عادت لتطرح نفسها بقوة بعد الحرب عام 1878م، في ظل مخلفات
الحرب الاجتماعية والاقتصادية، وتضخم الشعور بالانتماء القومي الألماني، والأزمة المالية،
فتم إلصاق هذه الأزمات باليهود وبدأت ظاهرة «مطاردة اليهود»، ومن ثم انتقلت الظاهرة
إلى النمسا وفرنسا وبلجيكا وبولونيا وروسيا ورومانيا وباقي أنحاء أوروبا.
ومع نشأة الدولة القومية الحديثة في أوروبا،
بدأت «المسألة اليهودية» تأخذ طابعاً جديداً، أساسه الاختلاف العرقي بين اليهود والأوروبيين،
فأخذ اليهود يتطلعون إلى إنشاء وطني قومي لهم على غرار النموذج الأوروبي كصيغة فريدة
لحل «المسألة اليهودية» بشكل نهائي، وخلال هذه الفترة ظهر ثيودور هرتزل الذي يعرف بأنه
«الأب الروحي للدولة اليهودية»؛ إذ نشر عام 1896م كتابه الشهير «الدولة اليهودية» الذي
اعتبر فيه أن الدولة اليهودية ضرورية للعالم، وقال: «إنني أرى أن المسألة اليهودية
ليست دينية ولا اجتماعية، بل قومية».
وقد ساعدت الأيديولوجيا النازية في ألمانيا
خلال ثلاثينيات القرن الماضي هذا النزوع القومي لليهود، فوجدت بريطانيا أن الحل ليس
في مشروع الحل النهائي الذي طرحته النازية بإبادتهم، وإنما في تجميع اليهود في فلسطين،
فكان صدور «وعد بلفور» الذي تعهدت بموجبه بريطانيا بمنح فلسطين لليهود.
لقد شغلت «المسألة اليهودية» عدداً كبيراً
من المفكرين والفلاسفة الأوروبيين، إذ نلاحظ صدور مئات الكتب خلال القرن التاسع عشر
وبداية القرن العشرين حولها؛ وكان أول من ألَّف في هذا الموضوع الفيلسوف واللاهوتي
الألماني برونو باور الذي نشر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كتابه «المسألة
اليهودية»، اقترح فيه تخلي اليهود عن ديانتهم من أجل الاندماج في المجتمع الألماني،
ثم رد عليه كارل ماركس في كتابه «عن المسألة اليهودية»، أكد فيه أن حل تلك المسألة
لا يكمن في تخلي اليهود عن دينهم، وإنما في مجتمع اشتراكي يزيل الطبقات الاجتماعية
والفكر اللاهوتي ويحقق وحدة الجنس البشري.
وبعد 4 عقود على صدور كتاب باور، وماركس،
صدر كتاب هرتزل الذي أحدث اختراقاً جديداً في المسألة اليهودية مقترحاً وطناً قومياً،
فظهرت الحركة الصهيونية كأيديولوجيا قومية لليهود لتنزيل المبادئ التي دعا إليها هرتزل.
وبالرغم من نشأة دولة «إسرائيل» في فلسطين،
بوصفها تجسيداً لدعوة هرتزل، فإن المسألة اليهودية ظلت تطرح نفسها باستمرار، فألَّف
عدد كبير من المفكرين الأوروبيين كتباً تحاول تفكيك هذه القضية في إطار الفكر الغربي
الحديث، أمثال جان بول سارتر، وحنا أرندت، وإدغار موران.. وغيرهم.
نقد الحضارة الغربية
تميز مالك بن نبي بكونه مفكراً عربياً يضع
قدماً في الفكر العربي الإسلامي وأخرى في الفكر الغربي؛ فقد تلقى تكوينه في فرنسا ونشر
جل كتبه في دور نشر فرنسية، وعالج مختلف القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي
تحت عنوان «مشكلات الحضارة»، فكان يسعى إلى تشريح الأزمات الحضارية التي يتخبط فيها
العرب والمسلمون، وفي الوقت نفسه تشريح الحضارة الغربية التي شكلت النموذج للمثقف العربي
خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومن هنا اجترح مفهومه الشهير «القابلية للاستعمار»
الذي كان بمثابة النموذج التفسيري الذي تبناه في نقد الوضع العربي والإسلامي.
في ظل هذا النقد المزدوج، تطرق بن نبي إلى
«المسألة اليهودية»، لكن ليس باعتبارها ظاهرة مستقلة تحتاج حلاً، كما حصل في الفكر
الأوروبي، بل كجزء من ممارسة النقد على الحضارة الغربية.
فقد رأى أن حضارة الغربية تعرضت لنوعين من
الانحراف؛ الأول: عندما اختارت التخلي عن المسيحية والرجوع إلى وثنية اليونان والرومان،
والثاني: عندما سلمت مفاتيحها إلى اليهود في العصر الحديث، وطرح سؤالاً جوهرياً لم
يسبق أن طُرح قبله: لماذا اختار اليهود بعد السبي البابلي وهدم الهيكل التوجه غرباً
ناحية أوروبا المسيحية لا شرقاً في اتجاه آسيا، بالرغم من عداء المسيحيين لليهود وتخلف
أوروبا في ذلك العصر؟
وقد وجد بن نبي الجواب عن ذلك السؤال في هجرة
القديس بولس من دمشق إلى أنطاكية للتبشير بالمسيحية بعد تخليه عن يهوديته، فرأى من
تم أن تلك الهجرة تشكل أول التقاء بين اليهود والحضارة الأوروبية الحديثة، حيث أصبحت
اليهودية جزءاً من الثقافة الأوروبية وتغلغلت في كامل مفاصلها، وبدأ اليهود يقبضون
على زمام الاقتصاد والتجارة والثقافة والإعلام؛ بل إن الحضارة الأوروبية الحديثة أصبحت
بيد الفئات اليهودية التي تتحكم فيها، حتى صار اليهود يفكرون وأوروبا هي التي تعمل،
بحسب تعبيره في كتابه «المسألة اليهودية».
لقد شكل انتقال اليهود إلى أوروبا المسيحية
والمراهنة عليها لتأكيد تميزهم الاجتماعي والديني والثقافي بداية ما سوف يحصل لهم خلال
القرون الماضية من اضطهاد وتنكيل وإبادة، لأن تلك الهجرة كانت قطيعة مع الشرق مهد الديانة
اليهودية والأكثر قرباً إلى المزاج الثقافي اليهودي، وهنا طرح بن نبي إشكالية جديرة
بالفحص: لماذا احتضن الغرب الجماعات اليهودية رغم كراهيتهم للمسيح والمسيحية وعدم اعترافهم
بالمسيح ومريم عليهما السلام، واتخذ موقفاً عدائياً من العرب والمسلمين رغم إيمانهم
بالسيد المسيح وأمه عليهما السلام؟
لقد وجد بن نبي التفسير في الانحراف الأول
الوثني الذي تعرضت له الحضارة الأوروبية بعد تخليها عن المسيحية، فمع الانتقال نحو
العلمانية والرأسمالية أصبحت الحضارة الغربية حضارة نفعية مادية، لذلك وجدت في الجماعات
اليهودية الحليف المناسب للهيمنة والتوسع؛ لأن اليهودي ليست لديه وراء علاقاته العائلية
والعنصرية مشاعر، وإنما هي أفكار وبرامج، فكان من الطبيعي أن يجد الغرب في اليهود الأداة
التي يوظفها من أجل مصالحه.
بيد أن بن نبي يرى أن العلاقة بين اليهود
والحضارة الغربية أكثر تعقيداً مما يبدو في الظاهر، فإذا كان الغرب ينطلق من رغبته
في توظيف اليهود لأغراضه فإن اليهود هم أيضاً يسعون إلى توظيف الغرب لتحقيق أهدافهم،
إذ يقول: إن «أوروبا بالنسبة لليهودي مجرد مرحلة ووسيلة ترمي إلى التطلعات البعيدة
للشعب المختار».
يقدم بن نبي في كتابه إطاراً تحليلياً لاتجاهات
الحضارة الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، بفعل خروج اليهود من العزلة التاريخية
في أوروبا وانتقالهم إلى صدارة المشهد.
فالنظر إلى التاريخ الحديث يمكنه أن يضيء
لنا هذه الاتجاهات التي عززت قيم العنف والصدام الحضاري، فقد نشبت الحرب العالمية الأولى
بهدف تفكيك الإمبراطورية العثمانية؛ ما نتج عنه صدور «وعد بلفور» وعزل فلسطين عن المنطقة
وتبلور فكرة الوطن القومي لليهود، ونشبت الحرب العالمية الثانية للدفاع عن اليهود في
وجه ألمانيا النازية؛ وهو ما أسفر بعد الحرب مباشرة عن قرار تقسيم فلسطين عام 1947م
وإعلان دولة «إسرائيل» في العام التالي.
ومن هنا يرى بن نبي أن المرحلة القادمة -وقد
ألَّف كتابه في بداية السبعينيات قبل وفاته بسنة واحدة 1973م- ستكون مرحلة الحروب بتأثير
من الفكر اليهودي الذي «سوف يجعل الحرب القادمة شاملة وتقع نتائجها على الغالب والمغلوب
معاً».
ولا يرى بن نبي أي حل للمسألة اليهودية في
إطار جميع الاقتراحات التي راجت في الفكر الأوروبي الحديث، سواء كانت النموذج القومي
أو النموذج الاشتراكي أو النموذج الديمقراطي الغربي، بل يرى أن الحل يكمن في نهضة العالم
الإسلامي وتبشير العالم بقيم جديدة تنشر السلام والأمن، ويقطع مع منطق الصراعات والحروب.