قراءة في سلسلة «المشروع الحضاري الإسلامي» للدكتور عطية عدلان (2)
منطلقات المشروع الإسلامي
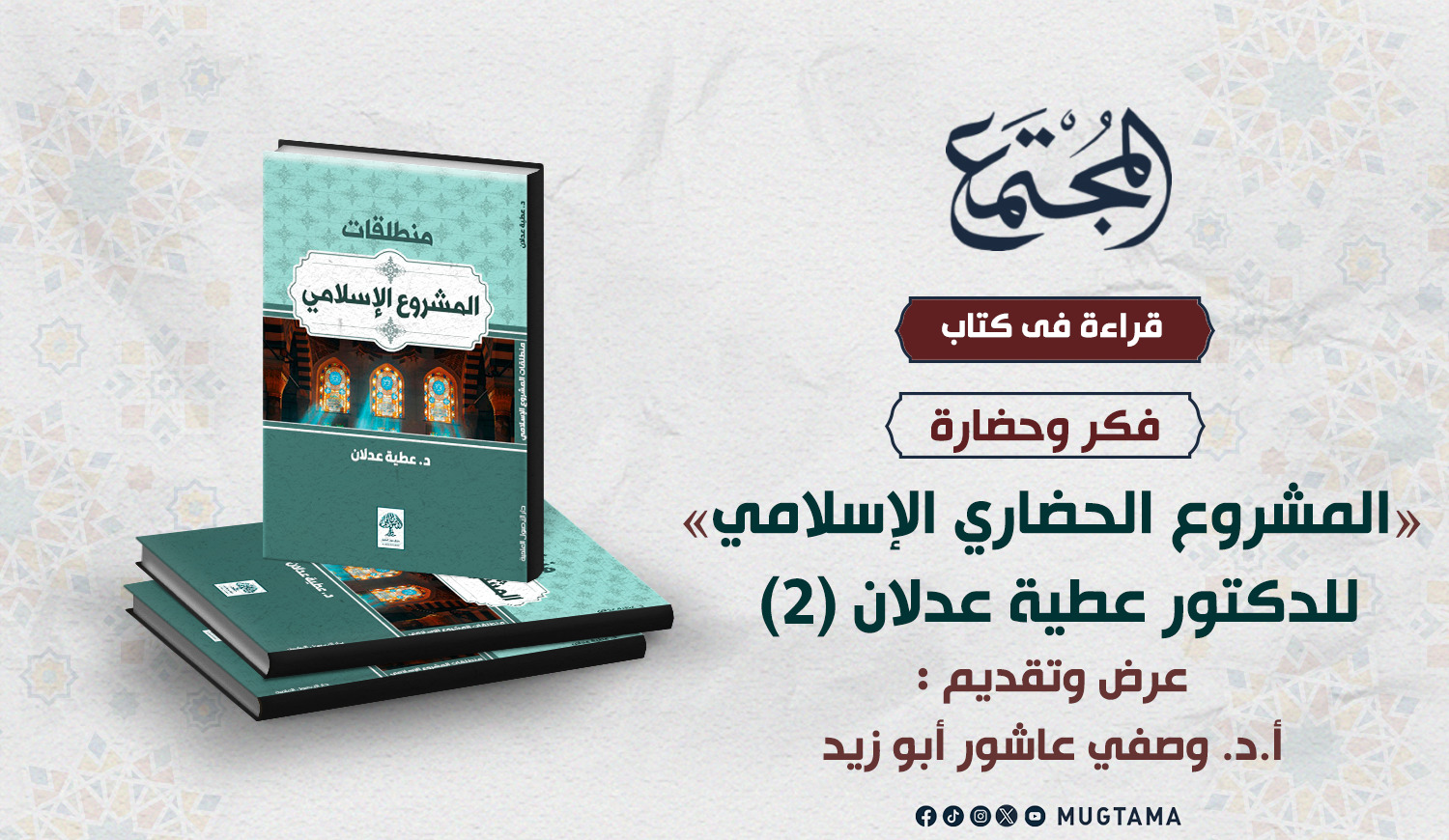
هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة المشروع الحضاري الإسلامي، وقد تحدثنا عن الكتاب الأول في المقال السابق بعنوان: "القيم الحاكمة للمشروع الحضاري الإسلامي"، وكتابنا في هذا العرض بعنوان: "منطلقات المشروع الإسلامي"، وقد صدر هذا الكتاب عن دار الأصول العلمية في اسطنبول، الطبعة الأولى. 2025م، وجاء في 203 صفحة.
حاجة الأمة لتحديد المنطلقات
يقرر المؤلف في مقدمته أننا بحاجة ماسة إلى تحديد المنطلقات الكبرى! التي ننطلق منها إلى ما نريد من نصرة أمتنا، وإعزاز ديننا، والتمكين للإسلام العظيم، ورفع المحنة عن المسلمين، ودفع الفتنة عن الخلق ليمتهد سبيل اهتدائهم للخالق، وغير ذلك من الأهداف والغايات والمقاصد التي يرمي إليها مشروعنا الإسلاميّ الكبير، وما أشد حاجتنا إلى التخلص والتحرر من المنطلقات الوافدة والمختلطة التي اضطربت بسببها خطانا مع كل حدث كبير مرت به أمتنا! آن الأوان بعد كل هذه الدروس الواقعية للعودة إلى منطلقاتنا الأصيلة.
ويؤكد أنّ أخطر ما تتعرض له الأمّة اليوم لا يتمثل في المجازر والأهوال التي تعصف بالمسلمين بقدر ما يتمثل في عمليات التجريف والتجفيف ومحاولات التحريف والتزييف، عمليات التجريف والتجفيف التي تقوم بها الأنظمة بما تملكه من أدوات الإكراه الغشوم، ومحاولات التحريف والتزييف التي تتولاها أقلام وأبواق ينتمي بعضها للعلمانية الصريحة وينتسب بعضها الآخر - كذبًا وزورًا - للتيار الإسلاميّ، فأمّا التجريف فيستهدف الرموز الراسخة بالقتل والسجن والتشريد، وأمّا التجفيف فيستهدف المنابع الصافية بالطمس والحجب والتغييب والاستبدال، وأمّا التحريف والتزييف فيستهدف المحكمات الشرعية والثوابت العقدية والمنهجية بالتأويل والتحوير وحرف المسار وتضليل البوصلة، وكل هذا بلا ريب يؤثر بشكل مباشر على المنطلقات التي يجب أن تنطلق منها مسيرة الأمة في مشروعها الإسلاميّ الكبير.
أهمية المنطلقات
الحقيقة الكبيرة الخطيرة هي أنّه ما لم تصح المنطلقات فلن نصل إلى شيء قط مهما بذلنا من جهد وأنفقنا من أموال ومهج؛ لأنّ هذا الدين العظيم الذي ندين به لله وِحدةٌ متجانسة آخذ بعضها برقاب بعض، ومن ثم فإنّ مشروع التمكين لهذا الدين شيء واحد متماسك من المبدأ إلى المنتهى، فغاياته وأهدافه الشرعية المتميزة لا تتحقق إلا عبر مجموعة من الوسائل الشرعية المتميزة، وهذه الوسائل الشرعية هي الأخرى لا يمكن أن توجد ولا أن يستقيم عملها إلا إذا صحت وسلمت المنطلقات؛ ولهذا فإن المنطلقات الصحيحة تُيَسِّرُ السير وتُسَرِّعُ الخطَى وتُقَرِّبُ الوصول للغاية، وهي قد تكون مادية، وقد تكون معنوية فكرية وعقدية وشرعية وواقعية وحركية.
إن المنطلقات على درجة من الخطورة لا يستهان بها، وإنّنا إنْ لم ننطلق منها فسيكون مصير مشروعنا أحد أمرين، إمّا التعثر ومن بعده الفشل، وإمّا الوصول إلى غاية ليست هي المقصودة، ولقد وقع للمسارات الدعوية والسياسية والجهادية انكسارات وانحرافات وإخفاقات، ولدى تَفَحّص الأسباب وُجِد أنّ فساد بعض المنطلقات هو السبب الأول والأكبر؛ لذلك فهي ضرورية لمشروعنا الإسلاميّ الذي نسعى لجمع كلمة المسلمين عليه.
أسئلة الكتاب
طرح د. عطية عدلان في مقدمة كتابه عددا من الأسئلة التي دعته للكتابة في المنطلقات المتعلقة بالمشروع الإسلامي، ومنها: ما هي المنطلقات الكبرى للمشروع الإسلامي؟ ما هي الثوابت العقدية والفكرية والشرعية والعملية والحركية والواقعية التي يجب أن يعتمدها القائمون على المشروع الإسلاميّ؛ لينطلقوا منها إلى إقامة المشروع وتنفيذه؟ فلا ريب أنَّ الأمة الإسلامية لها منطلقات في إقامة الدين وسياسة الدنيا به تختلف تمام الاختلاف عن منطلقات الأمم الجاهلية قديمة كانت أو حديثة، فالحداثة بما تحمله من أفكار، والعلمانية بما تنطوي عليه من أيديولوجيات وقوانين، والحضارة المعاصرة بما ورثته عن الرومان واليونان من نظم وأفكار وبما ابتدعته من توجهات إلحادية وانحرافات سلوكية، كل هذا وغيره لا يمكن أن ينتج لنا منطلقات نعتمدها في مشروعنا الحضاريّ الإسلاميّ، كل هذه الجهات لا يصح أن نتوجه إليها لنستمد منها نقاط الانطلاق وقوى الدفع التي ننطلق منها إلى تحقيق أهداف مشروعنا؛ فما هي منطلقاتنا؟
ماهية المنطلقات والفرق بينها وبين القيم الحاكمة
وإذا كان الكتاب الأول من هذه السلسلة المهمة قد تحدث عن القيم، وتم تعريفها هناك، فمن المناسب تعريف المنطلقات والتفريق بينها وبين القيم، فمنطلقات المشروع الإسلاميّ – بحسب المؤلف - هي: الأصول والثوابت والمحكمات العقدية والشرعية والمنهجية والعلمية والحركية والواقعية، التي ينطلق منها المشروع الإسلاميّ، ويستصحبها في كل مرحلة، وتظل من المبدأ إلى المنتهى هادية ومرشدة، والتي من شأنها أن تضبط المسار وتيسر الوصول لتحقيق أهداف المشروع.
وقد فرّق بين المنطلقات والقيم فقال: "والمنطلقات ليست هي القيم، وإن اشتركت معها في كون كل منهما أمورًا كلية أساسية؛ والفرق بينهما كالفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، فالأصولية ينطلق منها الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية التي يمكن أن يكون بعضها كلِّيًّا "قواعد وضوابط فقهية" وبعضها جزئيًّا "أحكام عملية جزئية"، وتمثل للبناء الفقهيّ قواعدَهُ التي تنغرس فيها قوائمُه، أمّا القواعد الفقهية فهي أحكام كليّة تنطوي تحتها وتدور في فلكها أحكام جزئية، وتعمل في جسم الشريعة عمل الغدد الصماء في جسم الإنسان، فمثلا: "الجمع بين فقه الشرع وفهم الواقع" أصل وأساس من أسس المشروع الإسلامي، و"الاستخلاف" كذلك أصل وأساس من أسس المشروع الإسلاميّ، لكنّ الأول منطلق والثاني قيمة عليا حاكمة، كلاهما له هيمنة وتأثير مستدام مستصحب، لكنّ الأول قاعدة تحتية ونقطة انطلاق جذرية، والثاني حاكم معياريّ علويّ، وقد يوجد شيء من التداخل في بعض المفردات في الجانبين، قد يكون سببه اشتراك المفردة من هذه المفردات الاستثنائية في الجانبين، مثلما تشترك قاعدة الاستصحاب فتكون تارة قاعدة أصولية، تمنع الانتقال عن القديم المستصحَب حتى يقوم دليل شرعيٌّ لحكم شرعيّ، وتكون تارة أخرى قاعدة حُكْمية تمنع الانتقال عن القديم المستصحَب حتى يقوم دليل ماديٌّ لحكم قضائيّ".
بعض هذه المنطلقات من المكونات العقدية وبعضها من الأحكام الشرعية الكبرى، وبعضها من الأصول المنهجية وطرق الاستدلال، وبعضها نشأ من تراكم الخبرات العملية الواقعية على مستوى الأجيال المسلمة، لكنّ السمة الجامعة لها أنّها إسلامية وأنّها على منهج أهل السنة، لا يصح تجاهل هذا الشرط الكبير؛ فإنّ تجاهله وإهماله يفضي إلى تكدير المنبع، وإذا تكدر المنبع بأخلاط من فِرَقِ البدعة والضلالة أو من مذاهب الحداثة والعلمنة أو من منابع الحضارة المعاصرة؛ فلن تصفو المنطلقات ولن يستقيم المسار ولن نصل بمشروعنا إلى غاية من غاياته، بل لن يستقيم لنا المشروع ذاته، لذلك فنحن أمام تحدٍّ مبكر من تحديات المشروع الإسلاميّ.
المنطلقات التي تناولها الكتاب
أما المنطلقات التي رآها المؤلف ضرورية للمشروع الإسلامي فقد عددها إلى (31) منطلقًا، واجبة الاعتبار، والتحديد والفهم، والصدور عنها والرجوع إليها، وجعلها حَكَمًا في الفكر والحركة، وهذه المنطلقات هي:
• الهوية: "لا حيدة عن الهوية الإسلامية العامّة الجامعة".
• المرجعية: "الوحيان (الكتاب والسنة) هما دستور الأمة الدائم".
• المنهجية: "منهج أهل السنة في التلقي وفي أصول الاعتقاد هو الأرض التي ينطلق منها التغيير".
• الوحدة: "الوحدة فريضة، ولا يلزم لتحققها في المراحل الأولى انصهار الجميع في كيان واحد.
• الأخوة: "الأخوة الإيمانية معتصم لا تنفصل عراه"
• "عالمية الإسلام وعموم الرسالة أصل ثابت لا يتغير".
• التفريق في التعامل مع الوافد بين ما كان من المبادئ وما كان من الأدوات منهج سديد رشيد.
• المفاصلة التامّة مع الفكر الحداثيّ العلمانيّ من صلب المنهج الإسلاميّ.
• المصطلحات الوافدة فخ يجب الحذر والاحتياط منه.
• قيام الحياة على أساس من رفض سلطان الله وسيادة شريعته هو عين الجاهلية.
• العهد النبوي مع الخلافة الراشدة يمثلان المرجعية للمشروع الحضاري الإسلامي.
• السنن الإلهية قوانين ونواميس تحكم الحياة ينبغي مراعاتها.
• الأحكام والمقاصد صنوان متعانقان لا يفترقان ولا يتعارضان.
• المرحلية والتدرج ضرورة حركية بشرط ألا تفضي للتسويف.
• حتمية المواجهة على وجه العموم مع عدم انتفاء الحلول السلمية.
• استبانة سبيل المجرمين وفهم واقع الصراع ركيزة أساسية للعمل الإسلاميّ.
• بناء التصورات على الجمع بين فقه الشرع وفهم الواقع هو المنهج الرشيد.
• العلم والعبادة والحركة خطوط متوازية من المبدأ إلى المنتهى.
• العمل الجماعي المنظم ضرورة لا تلغي المنصات الفردية وأهميتها.
• الشعوب ورقة لا يصح إهمالها كما لا يصح التعويل عليها تعويلا كاملًا.
• التعددية مقبولة ونافعة إذا لم تهدد الوحدة والاجتماع ولم تخرق المنهج والاتباع.
• التحالفات إذا احتيج لها، وصَحَّ المتحالف عليه، ولم يكن فيها ضرر؛ فهي مشروعة ونافعة.
• توسيع المشتركات والاستفادة منها في تقوية التحالفات صالح إذا لم يكن على حساب الحق.
• بلورة المحكمات واتخاذها ميثاقا عامًّا مع فن إدارة الاختلاف يتحقق بهما الحد الأدنى للوحدة.
• إذا تعلق وجوب الجهاد لأي سبب معتبر شرعًا بقي واجب الإعداد.
• الإعداد عملية تراكمية تبدأ من الدعوة والتربية وتنتهي بالقوة العسكرية.
• أهل الحل والعقد في الأمة هم أولو الأمر على الحقيقة والحكام نوابهم على الحكم.
• النظام العربيّ الحالي نظام منعدم الشرعية قائم على مضادة الشريعة وموالاة أعداء الإسلام.
• وسائل التغيير اجتهادية لا توقيفية، لا يشترط لها أن يأتي بها الشرع، لكن يشترط الا تصادمه.
• استيعاب المشروع الإسلاميّ لجميع أطياف أهل السنة دون غيرهم من المبتدعة كالرافضة.
• شمول وعموم المشروع الحضاري ينطلق من شمول وعموم الإسلام.
وقد استطاع المؤلف – وفقه الله – أن يصنف هذه المنطلقات، ويذهب إلى تحقيبها، ويضع كل طائفة منها تحت عنوان جامع، وقد يعمد إلى المنطلقات المفصلية فيبرزها ويدرج تحتها باقي المنطلقات، وكل هذا خاضع للاجتهاد.
وفي كل منطلق من هذه المنطلقات يبين معناه وحقيقته، ويذكر تأصيله الشرعي، ويضع شروطه وضوابطه، ويبين ما يندرج تحت كل منطلق من هذه المنطلقات من ثوابتَ ومُحْكَماتٍ، وما يترتب على الانطلاق منها من نجاحات، وما يترتب على مجانبتها من إخفاقات، وذكر نتائجَها مقارنًا إياها بالمنطلقات الفاسدة ونتائجِها.
ولم يدَّعِ المؤلف أنه استقصى كل المنطلقات بل أكد أن هذا الاستعراض ليس جامعًا مانعًا، فمن استطاع أن يُدخل فيه ما لم يُذكر هنا فليس عليه إلا أن ينجح في الاستدلال عليه بصورة مقنعة تورث العلم أو غلبة الظنّ بقوة، ومن استطاع كذلك أن يُخرج منه ما يراه غريبًا عنه فليس عليه إلا أن يبطل أطلة المنطلق المراد إخراجه، ويحبط مبرراته ومسوغاته، كل هذا مقبول، أمّا الذي لا يقبل فهو الجدل الفارغ، واللجاج الساقط، واتباع الهوى الجامح، ونسأل الله الثبات على الحق.

















