منهجية التقنين والشريعة الإسلامية
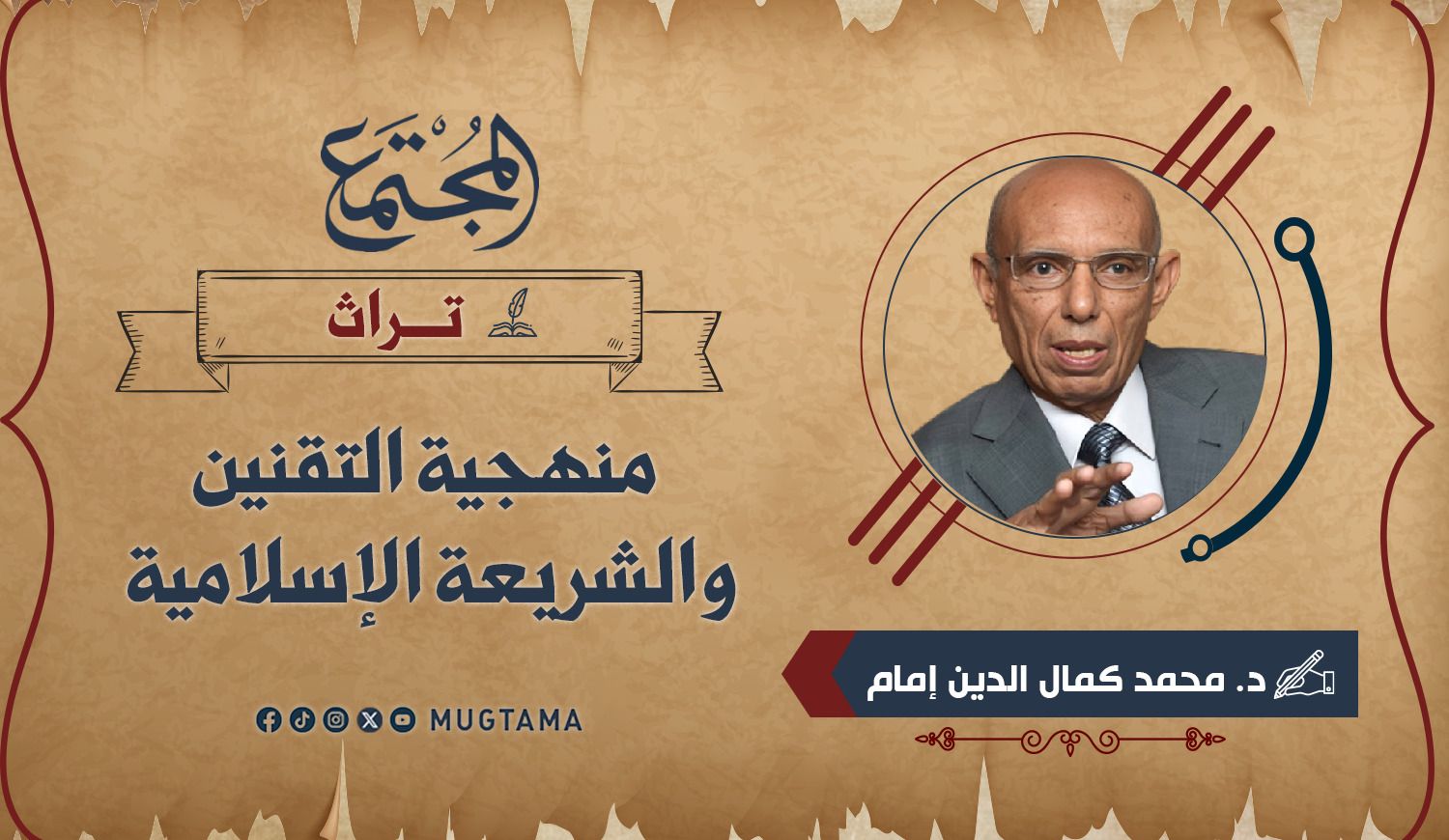
د. محمد كمال الدين إمام
مثلت فكرة التقنين في مفهومها الحديث جزءًا من مطالب رواد النهضة العربية الحديثة، فقد شغل بها ودعا إليها رفاعة الطهطاوي في «مناهج الألباب المصرية»، وخير الدين التونسي في «أقوم المسالك»، وعبدالرحمن الكواكبي في «أم القرى»، كما احتلت فكرة التقنين، مقوماتها وغاياتها، مساحة كبيرة في مدرسة الأستاذ الإمام محمد عبده رسم ملامحها الإمام في تقريره الشهير حول إصلاح المحاكم الشرعية في السنين الأخيرة من القرن التاسع عشر، واهتم بها تلاميذه تنظيرًا وتنفيذًا، وفي مقدمتهم محمد مصطفى المراغي، وطه حبيب، وأحمد إبراهيم، وفرج السنهوري.
بل إن عددًا من أساتذة مدرسة الحقوق السلطانية الفرنسيين في مصر شجع عليها وفي مقدمة هؤلاء إدوار لامبير الذي تولى إدارة هذه المدرسة لسنوات عدة، والاهتمام الواسع بالتقنين لرصيدنا من الفقه يؤكد أمرين:
الأول: أن شريعة الإسلام شريعة حية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، بما انطوت عليه من مرونة وحيوية وقابلية للتطور، يتعلق بتخريج أحكام لمستجدات الحياة على أصول الشرع الثابتة وكلياته ومقاصده، وهذا هو الفقه الواقعي المتحرك.
الثاني: أن الشريعة الإسلامية هي مصدر استقلالنا التشريعي وهو استقلال نعتبره ضروريًا للحفاظ على هوية الأمة وخصوصياتها الحضارية، ولا يكتمل استقلال أمة وقد استبدلت القوانين المستوردة بشريعتها الخالدة.
ولن يفلت العقل الفقهي الإسلامي من أزمته الراهنة إلا بقوارب نجاة ثلاثة، هي: التزام كامل بالنص الثابت (القطعي)، واستخدام متزايد للاجتهاد، واحترام واع بالواقع.
ويبدو أن لفظ التقنين جاء ملتبسًا منذ نشأته، فاختلف الكاتبون في مضمونه، واتجه بعض رجال الشريعة والقانون إلى العودة بإرهاصاته إلى رسالة الصحابة لعبدالله بن المقفع، وإلى محاولة الرشيد تعميم «موطأ» مالك باعتباره المرجع القضائي الملزم، ويرجعها العلامة أبو زهرة إلى عصر الخلفاء الراشدين، ويدلل على ذلك بكتاب القضاء الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري، والرأي عندي أن تدوين الراجح في أي مذهب بقصد الرجوع إليه من القاضي والمفتي والفقيه ولو تم إدراجه في مواد لا يعد تقنينًا، إن التقنين ليس مجرد تبويب وترقيم واختصار، إنه علم وصياغة وإلزام.
إنه علم ينظر علماؤه إلى الفقه الإسلامي في مجموعه، أو من خلال المذهب السائد جغرافيًا في دولة معينة، وفي هذا العنصر يتحرك العقل الفقهي من أجل الوصول إلى أنسب الأحكام لحماية المصالح محل الرعاية، بآلية اختيار تعتمد على قوة الدليل ورجحان البرهان، دون أن تتجاهل ظروف الواقع والأوان، وهنا تتسع دائرة أهل الاختصاص لتستوعب مع رجال الفقه علماء ثقات في الاجتماع والسياسة والاقتصاد؛ لأن الخطاب التشريعي يتحرك في كل هذه المجالات، ويتم تصنيف المادة الفقهية على كل فروع القانون، وهو أيضًا صياغة؛ لأن التشريع الإسلامي غايته –مثل كل بناء تشريعي سديد– حماية مجموعة من المصالح التي يقوم عليها أمر المجتمع، وتحتكم إلى قواعدها حركة الحياة.
وكل نص تشريعي –أيًا كان مصدره– هو في حقيقته خطاب للعقلاء ينطوي على قسمين قسم يأمر وينهى، وهو شق الحكم في القاعدة التشريعية، وشق يضبط ويحاسب هو شق الجزاء في القاعدة ذاتها، والخطاب التشريعي وهو يعبر عن المجتمع المنظم أو النظام في المجتمع يجب أن يصاغ في قالب من الألفاظ يقرؤها المخاطب أو يسمعها فيفهم ما يراد له ومنه دون نقص أو زيادة، والصياغة على هذا النحو فن له قواعده ومناهجه الدقيقة، لأن كتاب التشريع هو دنيا الناس في جوانبها الأخلاقية والاقتصادية والسياسية، والخطاب التشريعي نصوص تتناهى، لتحكم الوقائع التي لا تتناهى، وصياغة النص التشريعي هي الأداة الرئيسة إلى حسن فهمه وتفسيره، وبالتالي إلى إمكانية تفعيله وتنزيله.
وأخيرًا، إن التقنين إلزام؛ لأن القاعدة التشريعية لا يكتمل وجودها إلا بعنصر الإجبار الذي يجعل الامتثال إلى حكمها لا يكتفي بالتراضي، بل يستدعي فرضه بالتقاضي، والإلزام هنا صاعد ونازل، صاعد بمعنى أنه يلزم سلطة التشريع بأمرين:
الأول: ألا تبدل قواطع الشرع، وألا تأتي بما لم يأذن به الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الثاني: ألا تتناقض المصالح القطعية والضرورية الكلية للجماعة؛ لأن تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية.
ونازل بمعنى أنه قاعدة ملزمة لكل المخاطبين به، بغض النظر عن تعدد الآراء الفقهية وتنوع الانتقاءات المذهبية، فاختيار ولي الأمر يرفع الخلاف.
فالتقنين، إذن، هو اختيار الأحكام الشرعية في المعاملات في مكان معين وزمان معين مع تصنيفها في فروع، وترقيمها في مواد، وإصدارها من السلطة المختصة تشريعًا يلتزم به القاضي ويحتكم إليه المتقاضي، وإنتاج النص في داخل التقنين القائم على المرجعية الإسلامية، لا يتحرك في الفضاء العقلي المتغير، بل إنه مقيد باعتقاد فردي وجماعي حاسم الأحكام فيه على نوعين:
الأول: أحكام دائمة مصدرها النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، وسلطة التشريع إزاء هذه الأحكام لا صلة لها بشق الأمر والنهي، ولا بشق الرد والجزاء، وإنما دورها يستوعب الصياغة التي لا تغير الحكم، والتصنيف الذي يفصل المدني عن التجاري عن الجنائي إلى آخره، بل إن سلطة التشريع في الغالب لا تلتزم جوهر الحكم فحسب، بل قد تلتزم بألفاظه ومصطلحاته كما وردت في نصوص الكتاب والسُّنة، ولا تمنع قطعية النصوص من مرونة الجانب الإجرائي الذي يتسع لتنوع درجات التقاضي، ولا يضيق بضوابط واقعية تكفل تنزيل النص المجرد على الواقعة المعينة عند التطابق، وهو جهد دقيق يبدأ بوصف الواقع وينتهي بقيده في دائرة النص الملائم لينزل القاضي حكمه، وهي عملية لا ينبغي أن نخلط فيها بين يقين القاضي الذي هو بالضرورة نسبي، وقطعية النص الدائم الذي هو بطبيعته مطلق.
الثاني: الأحكام الاجتهادية وجوهرها إمكانية التغير، سواء كانت اختيارًا من تراثنا عبر اجتهادات العقل المسلم في عصوره المختلفة، أو كانت اجتهادًا يتجاوز اختيار الحكم إلى استنباطه من مصادره، وهذه العملية في عصرنا بل وفي كل العصور مزلة أقدام وأفهام، ويحسن فيها الاجتهاد الجماعي، وهي في كل الأحوال لا تتحرك خارج النسق الإسلامي الثابت، بمصادره المحددة، ومقاصده الكلية، وقواعده الضابطة لذهن الفقيه.
وهنا يحسن الإشارة إلى الفارق الذي نراه بين التجديد الذي يتم في النظم والأنساق، ويشارك فيه أهل الاختصاص من كل علم، والاجتهاد الذي هو بذل الوسع والطاقة للوصول إلى حكم عملي ظني، والاجتهاد لا يصدر إلا من أهله حتى ينزل في محله، وهي مسؤولية الفقيه وولي الأمر وحدهما وعليهما واجب الشورى الاجتماعية؛ لأن للمجتمع دوره في تحديد المصالح، والوصف الدقيق للوقائع الذي لا يستغني عنه الفقيه وهو يستنبط، ولا يستغني عنه ولي الأمر وهو يختار ويلزم، والرقابة عليهما في هذا المجال مزدوجة؛ رقابة ضمير تجعلهما أهلاً لحراسة الدين، ورقابة أمة تجعلهما أهلاً لسياسة الدنيا.
__________________________
المصدر: ورقة مقدمة إلى ندوة تطور العلوم الفقهية، التي عُقِدَت بسلطنة عمان (مسقط)، 5 – 8 أبريل عام 2008م.

















