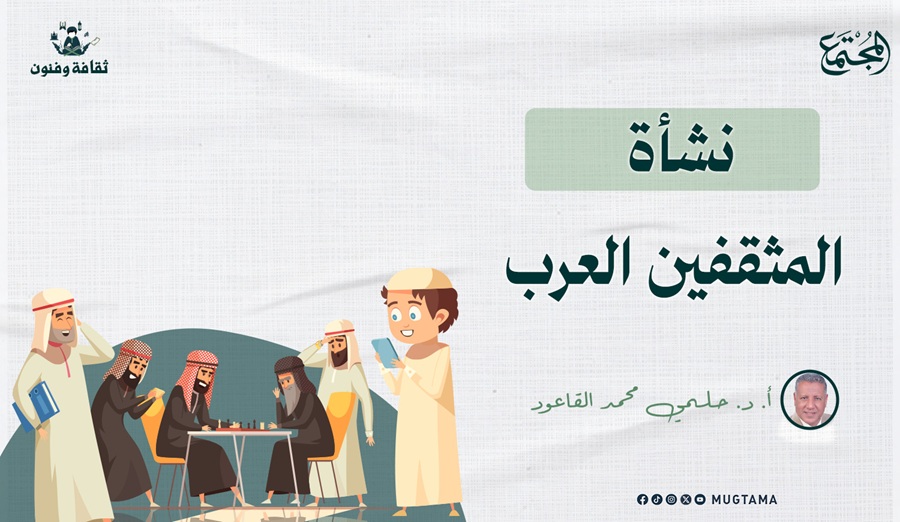من هو المثقف؟
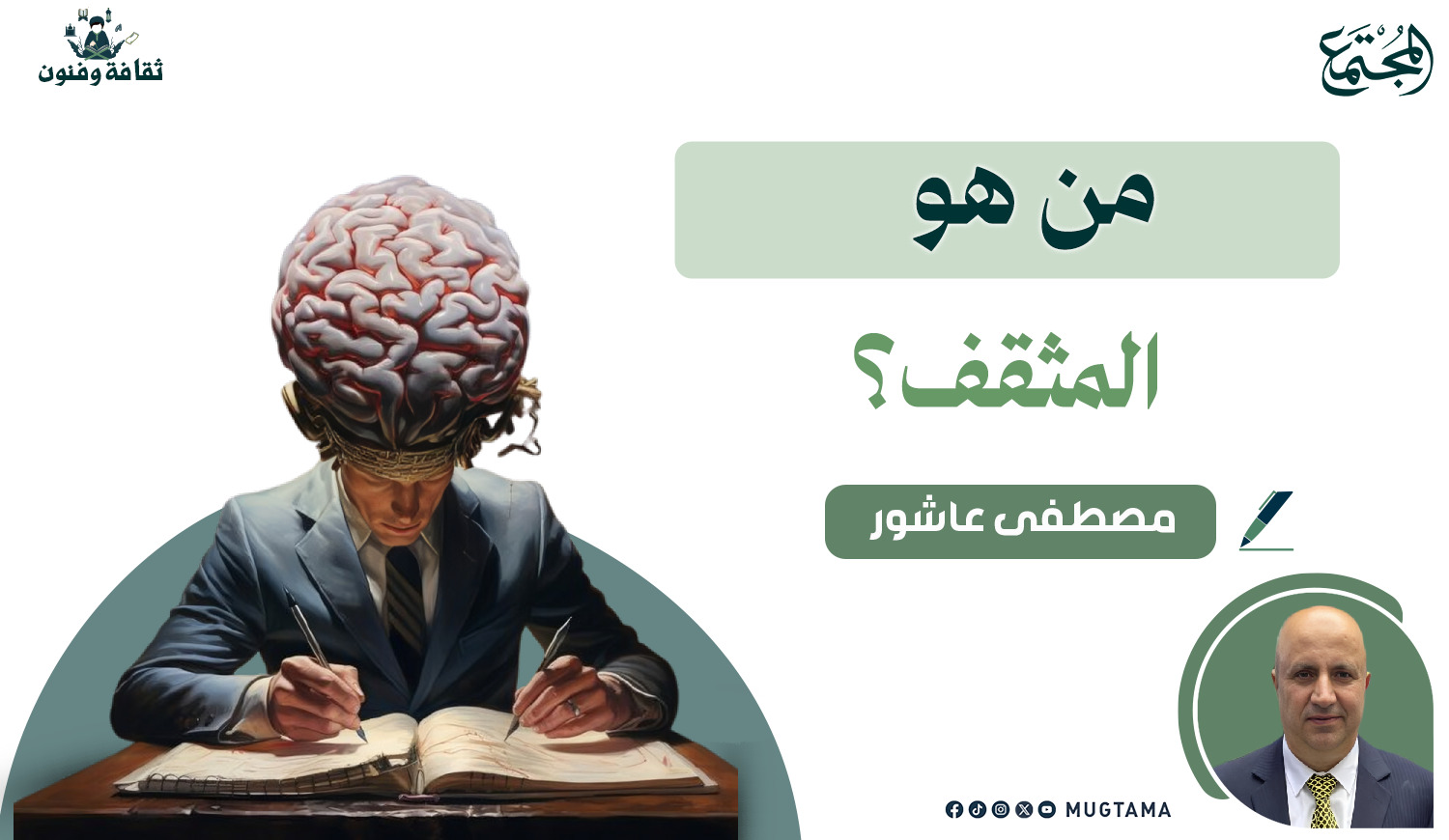
«اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبذلها بالإقتار
فنسترزق أهل رزقك ونسأل شرار خلقك، فنبتلى بحمد من أعطى، وذم من منع، وأنت من دونهم
ولي الإعطاء، وبيدك خزائن الأرض والسماء، يا ذا الجلال والإكرام».
هذا دعاء الفيلسوف الأديب أبو حيان التوحيدي
(ت 400هـ) يشكو قلة المال، ويطلب من الله أن يغنيه، وكان يؤلمه أن يتخذ من علمه وأدبه
وسيلة لتحصيل الثروة أو رغد العيش أو حتى الحصول على ما يحتاجه، ومع تلك المحنة قرر
في نهاية حياته أن يضع نهاية لكتبه فحرق الكثير منها.
تكاد أزمة المثقف من قديم وحتى الآن تكون
واحدة، فهو واقع بين خيارات صعبة؛ إما أن تكون كلمته هي صوت عقله وضميره وعلمه وقضيته
ومجتمعه، وإما أن يكون هو ذاته صوت السلطة أو المال أو القوى المسيطرة، ولعل هذا ما
جعل أزمة المثقف شبه دائمة، وجعل من تحديد معنى المثقف موضع اختلاف دائم رغم تغير أسئلة
العصر وضروراته.
تعريف المثقف
هنا تطرح أسئلة كبرى: هل المثقف في عصرنا
الحالي هو من يمتلك المعرفة والمعلومة، التي صارت في أغلبها تقنية أو إدارية أو علمية
في تخصصات الطب والهندسة والكيمياء والمعلومات وغيرها، أم أن المثقف هو صاحب القضية
التي تمثل مجتمعه، وصاحب الفكرة التي يكافح عنها، وصاحب المسؤولية التي لا يتخلى عنها؟
في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، رأى
الفيلسوف الإيطالي الماركسي أنطونيو جرامشي الذي عانى من السجن قرابة 10 سنوات إبان
الفاشية، أن وظيفة المثقف في المجتمع لا يقوم بها كل الناس، وهي إشارة إلى نخبوية الثقافة،
أما جوليان بندا، مؤلف كتاب «خيانة المثقفين» الذي يعد أهم كتاب حول تعريف المثقف ودوره
المجتمعي، فقد وضع للمثقف صورة مثالية تجمع بين الأخلاق العظيمة والمعرفة الواسعة ليكون
ضمير البشرية.
لكن بندا ألقى تحذيراً عام 1927م سبق به عصره،
فحذر أن يتحول المثقف ليكون إحدى أدوات السلطة في تنظيم المجتمع وضبطه أو تبرير سياسات
معينة، أو حتى تلطيف الخطاب السلطوي الخشن إلى خطاب يمكن قبوله مجتمعياً، على اعتبار
أن المثقف نظراً لمعرفته وقدراته الكتابية والبلاغية قادر على التبرير.
والحقيقة أن المثقف في العقود الماضية أصبح
يؤدي وظائف محددة قد تتصل بالثقافة والإعلام والتعليم، وبخاصة في مجالات إنتاج المعرفة
ونشرها، كما أن العصر الرقمي فتح الباب للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ليدخلوا
في زمرة المثقفين؛ ما زاد الأمر تعقيداً وارتباكاً.
ومع هذا التوسع في إطلاق صفة المثقف في العصر
الرقمي، يُلاحظ تواري مفهوم الرسالية والمسؤولية للمثقف، ربما لانصراف انشغال هؤلاء
المؤثرين للحصول على أعداد ضخمة من المتابعين وتحصيل الإعجابات.
رسالة المثقف
في كتاب المفكر الراحل إدوارد سعيد «عن المثقفين،»،
أورد حكاية ذات مغزى على لسان المفكر الروسي إشعيا برلين قال فيها:
إن الكُتَّاب الروس في القرن التاسع عشر، كانت جماهير
قرائهم تشعر أن الكاتب منهم يقِف على المسرح ليُدلي بشهادته علنًا على الملأ؛ لأن كلمات
هذا الكاتب امتلأت بمواقفه وآرائه، فكان يتمثلها في كل ما يقول ويبدع.
والواقع أن أي مجتمع لا ينهض ويتقدم إلا بوجود
مثقفين ذوي رسالة ورؤية، وهؤلاء مثقفون يسبقون مجتمعهم بأفكارهم ليحققوا تلك النقلة
الكبيرة في حياة الناس، وهذا يفرض أن يكون المثقف في تكوينه منطلق الفكر، غير مقيد
بأغلال تجذبه للواقع الراكد أو الكئيب أو المتردي، وأن يكون مثقفاً قادراً على مواجهة
التقاليد البالية، وقادراً على أن يقبر تلك الأفكار الميتة التي تعيق المجتمعات عن
القيام بدورها الحضاري؛ وهو ما يعني أن يمتلك المثقف روحاً ثورية حالمة، وضميراً يناصر
القيم العليا والأفكار الكبيرة، وأن يقتنع أنه لا مثقف بلا تضحية، فالحكمة الباردة
قد تحقق المتعة لكنها لا تغير شيئاً.
ورحلة المثقف في بنائه للعقل والوعي، لا بد
أن يصاحبها جهود لتغيير الواقع، ولعل أهم صفة يجب أن يتحلى بها المثقف هي إيمانه الراسخ
بأن دوره تغييري وليس تنظيرياً فقط، دوره أن يسهل نزول المعرفة والفكر في الواقع لتغييره،
وليس الانعزال بعيداً ورؤية المجتمع من وراء حجاب، ولذلك كتب د. عبدالوهاب المسيري
في سيرته الذاتية أن المثقف الذي لا يترجم فكره إلى فعل لا يستحق لقب المثقف.
أما المفكر العراقي علي الوردي، فميز في كتابه
«خوارق اللاشعور بين المثقف والمتعلم»، ورأى أن المثقف يتميز بمرونة رأيه واستعداده
لتلقي كل فكرة جديدة والتأمل فيها ملياً ليتبين له وجه الصواب منها، أما المتعلم -بحسب
رأيه- فإن العلم والتعليم لم يزده إلا تعصباً وانغلاقاً، فإذا آمن برأي من الآراء أو
مذهب من المذاهب فأخذ يسعى وراء المعلومات التي تؤيده في رأيه وتحرّضه على الكفاح في
سبيله.
وتلك فكرة نبه إليها أرسطو من قديم، في سمات
المثقف فقال: من مزايا العقل المثقف أنه قادر على التأمل في فكرة من الأفكار من غير
أن يقبلها، وكذلك الأديب الإنجليزي شكسبير بقوله: وحده المثقف يعيد النظر في نفسه كل
يوم، ويعيد النظر في علاقته مع العالم ومع الأشياء كلما تغير شيء في حياته.
ولعل من أهم السمات التي يجب أن يتحلى بها
المثقف في تكوينه التواضع، وهذا التواضع ناتج عن الإحساس بالمسؤولية، فهو مثل الطبيب
الذي يمتلك الرحمة والعلم لعلاج مرضاه، وإذا تعالى المثقف على مجتمعه فإنه يفقد القاعدة
التي يفترض أن يتجه إلى تغييرها أو إصلاحها، لذلك كان الأديب الروسي الشهير تشيخوف
يعتبر التواضع من الشروط التي يجب توافرها في المثقف، أما الرؤية الإسلامية فقد تنبهت
إلى تلك السمة من قديم، حيث كانت تدعو المثقف إلى احترام العامة والنظر إلى ما فيهم
من خير وقوة ونفع، لذلك كان بعض السلف يقول: لا تسبوا الغوغاء، فإنهم يطفئون الحريق،
ويخرجون الغريق، ويسدون البثوق (البثوق هي الشوق الناتجة عن اندفاع مياه النهر).