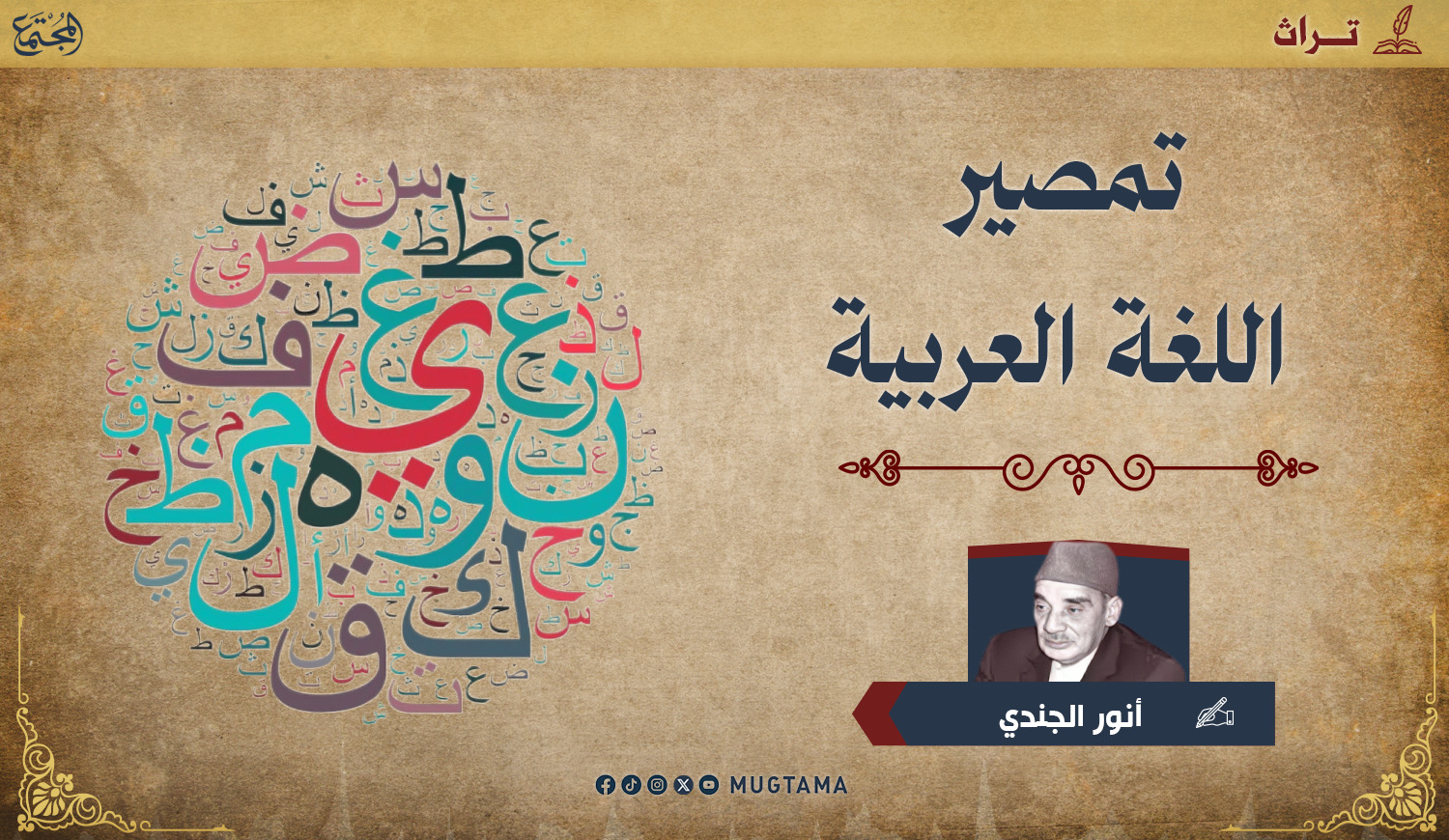هدم اللغة العربية الفصحى!
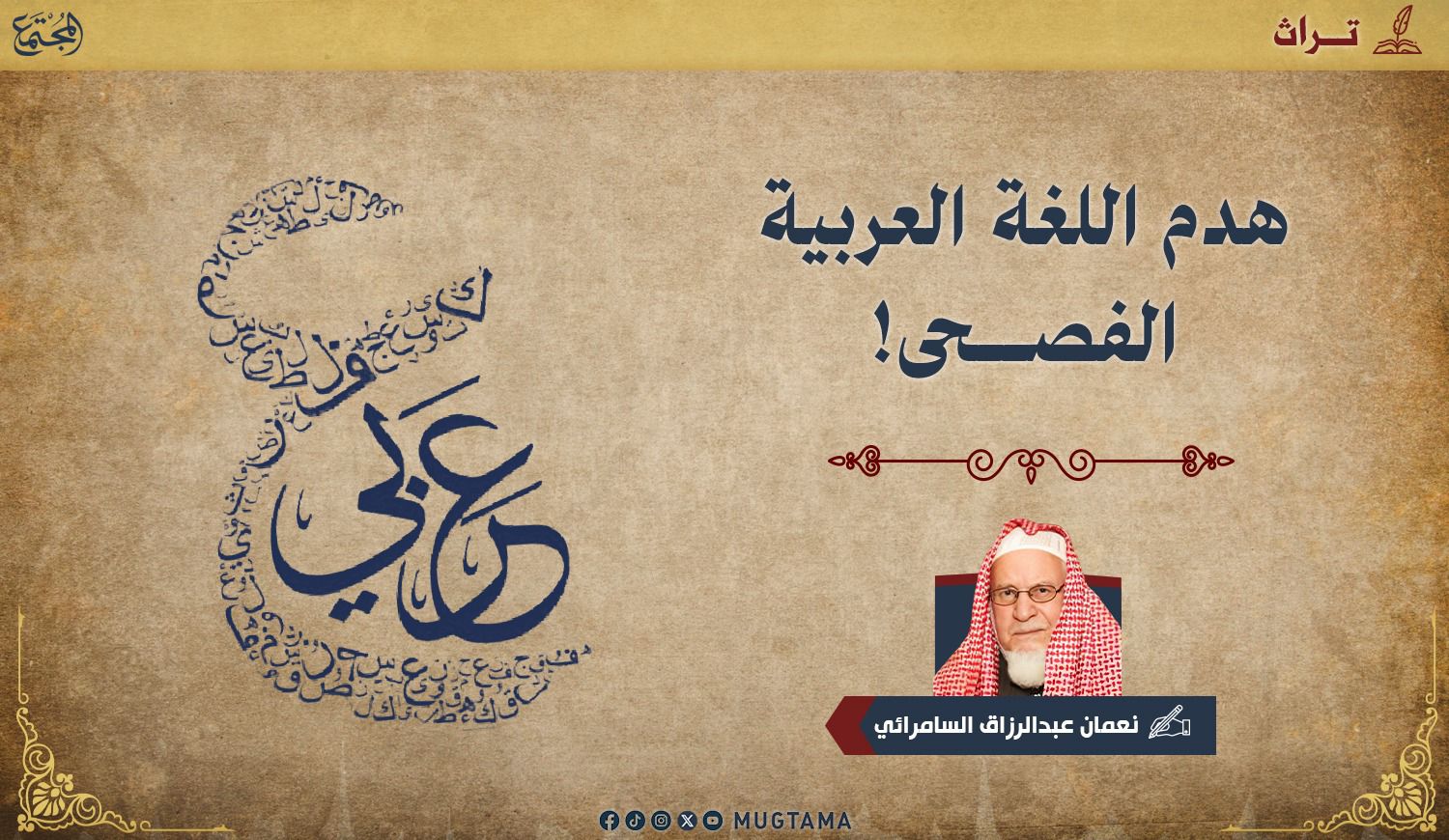
الدكتور
نعمان عبد الرزاق السامرائي
ما
يزال الاستشراق وتلاميذه يشنون حملة مسعورة على اللغة العربية الفصحى، ويتهمونها
بالجمود والقصور وعدم التطور. ومن أوائل المستشرقين "ولهلم سبيتا» الألماني
الذي كان مديرًا لدار الكتب المصرية في القرن التاسع عشر، وقد حاول وضع قواعد
للعامية المصرية، مشيرًا إلى أن الفصحى دخيلة، جاءت مع الفتح الإسلامي. وقام
القاضي الإنجليزي بول، الذي كان من قضاة المحكمة الأهلية بالقاهرة، بالدعوة إلى
تبني اللهجة العامية، وكذلك فيلوث الأستاذ في كامبرج وكلكتا للغات الشرقية، قام هو
وبول بوضع كتاب اسمياه المقتضب في عربية مصر.
أما
المستشرق وليم ويلكوكس الذي كان مهندسًا للري في القاهرة فكان الأكثر حماسًا لذلك.
ومن نكد الدنيا أن هذا المستشرق الحاقد كان يتولى تحرير مجلة الأزهر عام 1883م.
أما
ماسنيون وأمثاله فطالبوا بترك الحرف العربي واستبدال الحرف اللاتيني به، وجاء
أمثال سلامة موسى ليكملوا هذه المشاريع. ثم هدأت الهجمة وعادت اليوم مجددًا، لكن
أي مستشرق أو تلميذ له – غير نجيب – لم نسمع لهم صوتًا ينتقد لغة أخرى، فهذه
التركية بعد تبني الحرف اللاتيني صارت مضحكة، فكلمة حامد وخامد وهامد كلها تكتب (Hamid)
ثم تقلب كل دال فتصير (تاء) حتى إن نور الدين تصبح – بقدرة قادر – نور التين.
واليابانية
تحوي (850) بين حرف وصورة، ولا أحد يتكلم.
وهذا
تلميذ للمستشرقين، مستغرب حتى العظم يقول: «كما بقي الفلاح يستعمل المحراث العتيق،
كذلك بقيت العربية محافظة على تعابير دينية، ونتف من الفقه، والنحو، والأدب،
منفصلة عن المعاجم العلمية الثرية... ولم تزل إلى الآن منفصلة عن المعجم العقلاني
العلمي، الذي أحدثه الفلاسفة، لأن الفلسفة سرعان ما أصبحت ملعونة مطرودة...». إن
جريمة العربية الفصحى أنها تحوي (تعابير دينية ونتفًا من الفقه)، وبتركها نستريح
من كل ذلك، ونهجر القرآن وكتب التراث. فإذا سألنا – أستاذ السوربون – ماذا تحوي
اللغة العربية؟ لم نجد جوابًا.
لقد
(نبش) اليهود القبور، ثم أخرجوا لغة عمرها آلاف السنين، وراحوا يستعملونها، فلماذا
يخاف أمثال أركون من الحديث عنها، وعن الجوائز التي تمنح لكل من يكتب عن خرافة من
خرافات التوراة؟!
إن
اللغة تحيا وتتقدم أو تموت بفعل أهلها، فهم الذين يطورونها. وقد بقيت الجيوش
العربية عشرات السنين تستعمل المصطلحات التركية ثم الغربية، ثم قامت جامعة الدول
العربية فعربت المصطلحات كافة، دون استحالة أو عجز، فالعجز في الإنسان وليس في
اللغة.
وقد
ترجمنا وعربنا معارف اليونان والفرس، وبعض علوم الهند، ولم تعجز العربية عن
استيعاب ذلك كله، حين وجدت الرغبة ووجد المترجم الجاد.
ويتساءل
الدكتور هشام شرابي – وهو عربي من عكا، أمريكي العقل والقلب واللسان، وعلماني حتى
العظم – فيقول: «هناك سؤال في غاية الأهمية: هل يمكن الدخول في الحداثة بواسطة لغة
غير حديثة، لغة ما زالت في مرحلة ما قبل الحداثة، بمفاهيمها ومصطلحاتها وأطرها
الفكرية؟».
والجواب في اللغة العبرية واليابانية!
يتحدث
الدكتور شرابي بعد هذا النقد عن صراع خفي بين حركة النقد العلمانية، وبين العربية
الفصحى فيقول: «... في هذا يكمن الصراع الخفي العنيف، الذي تخوضه حركة النقد
العلمانية في الوطن العربي، صراع بين فكر يرمي إلى تجاوز اللغة التقليدية ونظامها،
ولغة ترمي إلى لجم هذا الفكر وتقييده ضمن حدود الذوقية والأخلاقية والمصرفية، وهذا
الصراع ضد لغة تأبى النقد وتصر على مدلولاتها الغامضة، فيتجسد في هذا التوتر
الداخلي الذي يجيز الفكر العلماني الناقد، فكر يفكر بلغة أجنبية، ويكتب بلغة عربية
فصحى.
شئنا
أم أبينا، يستمد هذا الفكر العلماني الناقد مفاهيمه ومصطلحاته وأبعاده من التجربة
الأوروبية للحداثة بمفهومها الشامل».
والسؤال:
هل هناك لغة تأبى النقد وتصر على مدلولاتها الغامضة؟ الذي نعرفه أن أهل اللغة
يفعلون ذلك، أما أن يكون هذا من نصيب العربية وحدها، فعلم ذلك عند أهل العلمانية
والحداثة.
يتحدث
شرابي – وهو أستاذ تاريخ الفكر الأوروبي – كيف قامت ونهضت التجربة الأوروبية
للحداثة، فيرى أنها اتخذت موقفين:
1. موقف تجاه
الماضي ومحاولة الاسترجاع بالعودة للنموذجين اليوناني والروماني.
2. موقف تجاه المستقبل
يقوم على العلوم وحتمية التقدم الإنساني (فلسفة التنوير).
فإذا
انتقل إلينا تنكر لهذا قائلًا: «يتجسد معنى الحداثة بالنسبة إلينا في اتجاهين
مترابطين:
أ – الاتجاه العقلاني.
ب – الاتجاه العلماني، أي عقلنة
الحضارة وعلمنة المجتمع، فالحديث هو الطلائعي الجديد، بمعنى المغامرة نحو
المستقبل، والانفلات من قيود الحاضر وماضيه».
الحداثة
في الغرب – باعتراف الكاتب – سارت باتجاهين، استذكار واسترجاع النموذجين اليوناني
والروماني وتبني العلوم والتقدم، فلما انتقل إلى حداثتنا ترك ذلك أو تناساه ليتحدث
عن اتجاهين عقلاني وعلماني، عقلنة الحضارة وعلمنة المجتمع!
لماذا
هذا التهرب؟ لأن الأستاذ لا يريد لنا العودة إلى ماضينا، فهو هارب منه بل قرفان،
ولا يريد أن يعود إليه، كما فعل السادة.
لكن..
الأستاذ يعترف بأن تجار الحداثة والعلمانية، يظهرون دومًا كباحثين أجانب مما أدى
إلى تبعية فكرية فيقول: «... لكن كثيرًا ما ينسى المثقفون العلمانيون تجربتهم
الذاتية في كتاباتهم، فتظهر وكأنها أبحاث يقوم بها باحثون أجانب، تتصف بالتجريد
الأكاديمي، وينطوي على هذا الموقف نتائج في غاية الأهمية، إذ أن مقاربة الذات من
موقع لآخر (وبأسلوب موقع الباحث الأجنبي وأسلوبه) تؤدي بالضرورة إلى تبعية فكرية
يصعب التغلب عليها».
وهذا
هو المستنقع الذي سقط فيه العلمانيون الحداثيون. والأغرب من ذلك أن الكاتب يقر بكل
ذلك إذ يقول: «الأطروحة الرئيسة التي تقدمها الحركة النقدية العربية الجديدة هي أن
المعرفة.. المنقولة أو المستوردة – والتي تنشئ الوعي المنقول أو المستورد – لا
يمكن أن تحرر الفكر، أو أن تطلق قوى الإبداع في الفرد أو في المجتمع، بل هي تعمل
في أعمق المستويات على تعزيز علاقات.. التبعية الثقافية والفكرية والاجتماعية».
فإذا كان الأمر كذلك فلماذا جلد الذات واتهام اللغة؟!
ومن العجائب أيضًا أن الأستاذ شرابي يقرر بكل
وضوح أن معارفنا وأساليب البحث عندنا في العلوم الاجتماعية كلها غربية فيقول: «لنذكر
هنا أن أنظمة المعرفة وأساليب البحث العلمي في العلوم الإنسانية، والاجتماعية، هي
أنظمة وأساليب غربية في أشكالها كافة، وإن معرفتنا لذاتنا ولتاريخنا ومجتمعنا في
القرن العشرين هي معرفة غربية في صميمها، فالعلوم الإنسانية والاجتماعية في العالم
الثالث كلها في العصر الحديث مستمدة من الغرب، وهي إضافة لذلك تنتج وتعيد إنتاج
المعرفة الغربية محليًّا، من هنا يمكننا تفهم أسباب الرفض المطلق للغرب عند
الأصوليين وإصرارهم على العودة إلى الدين والتراث، لاستعادة الهوية الأصلية، من
خلال معرفة تراثية مستقلة، عن كل الأطر والمفاهيم الأجنبية».
أليس
غريبًا أن يدرك شرابي قضية بهذا الوضوح، ثم يعود لينساها أو يتناساها، ثم يدعو إلى
عقلنة الحضارة وعلمنة المجتمع، وينتهي كل شيء!
الهروب
من الماضي والحاضر معًا؛ ويقرر أمورًا بالنسبة لأوروبا ثم يتجاهلها، وبالنسبة
للحداثة وما تجره من تغريب ثم يتناسى ذلك كله، فما السبب؟
وما
دمنا في التغريب فهذه شهادة صريحة للمؤرخ البريطاني توينبي أعجبتني صراحته، فهو
يقول: (... ها هم الأتراك يحاولون إقامة صورة.. طبق الأصل لدولة غربية، وشعب غربي،
وعندما ندرك هدفهم نتساءل بحيرة: هل يبرر هذا الهدف حقًّا الجهد الذي بذلوه في
صراعهم لبلوغه؟ إننا لم نكن نحب التركي التقليدي المسلم المتحمس... لقد استطعنا
أخيرًا أن نحطم سلامه النفسي، لقد حرضناه على القيام بهذه... الثورة المقلدة التي
استهلكها الآن أمام أعيننا، والآن وبعد أن تغير التركي بتحريضنا ورقابتنا، وبعد أن
أصبح يفتش عن كل وسيلة لجعل نفسه مماثلًا لنا وللشعوب الغربية، الآن نشعر بالضيق
والحرج، بل نميل إلى الحنق والسخط، وبإمكان التركي أن يجيبنا بأن مهما فعل فهو
مخطئ في نظرنا، وهو قادر على ترديد مقطع من كتابنا المقدس: نفخنا معكم في القرب
فلم ترقصوا، وحزنا معكم فلم ترضوا...».
ما
الذي سيكسبه التراث الحضاري في حالة عدم ذهاب جهود الأتراك سدى؟ وفي حالة نجاحهم –
فرضًا – النجاح المرجو؟!!
إن
هذه النقطة تكشف في حركة المقلدين عن ضعفين فيها:
1. إن الحركة المقلدة متبعة وليست مبدعة، وفي
حالة نجاحها – جدلًا – فلن تزيد إلا في كمية المصنوعات التي تنتجها الآلة، بدلًا
أن تطلق شيئًا من الطاقة المبدعة في النفس البشرية.
2. في حالة النجاح الباهت المفترض، وهو أقصى ما
يمكن للمقلدين تحقيقه والوصول إليه، سيكون هناك خلاص، نعم مجرد خلاص، لأقلية
ضئيلة، في أي مجتمع تبنى طريق التقليد...
نعم
هذا هو الحيز المحدود الذي يمكن أن يشغله المقلد، ولو حاول أن يتعدى ذلك فهناك
كوابح وحواجز تمنع. نعم يا توينبي ما زلنا ننفخ في القرب حتى هلكنا في النفخ، وما
زلنا في مكاننا نراوح.
هذه
أوروبا تقبل الدول الأوروبية كافة في سوقها، وتمنع تركيا من ذلك، فلماذا؟!
وقبل
الختام أريد أن يقرأ الدكتور شرابي الذي تأمرك فنسي قضيته وأهله، وراح يتلهى
بالحداثة والعلمانية، أريد أن يقرأ ما قاله مارشال بيرمان عن الحداثة، وأنقل النص
عن كتاب الدكتور شرابي نفسه البنية البطريركية: «الحداثة قضية أوروبية صرفة، فهي
ظاهرة وجدت هناك، وتفاعلت تاريخيًّا، فهي غربية المنشأ والهدف والمحتوى، وعلامة
فارقة للغرب عن غيره» فما رأي الدكتور شرابي بهذا؟
وهذا
هشام جعيط – وهو كاتب يساري مغربي – يتحدث عن الحداثة والإسلام فيقول: «... من جهة
أخرى لو تصفحنا ما في الحداثة من شرور الفردية والعزلة والاستغلال والمادية
الاقتصادية، والبؤس النفسي، لصار من الممكن التفكير بأن الإسلام كقوة روحية قادر
على أن يبث رسالة تجديدية لإنسان القرن الواحد والعشرين».
هذه
هي الحداثة بوجهها الكالح كما يرسمها كاتب يساري.
فلماذا
تهاجم العربية الفصحى دون سواها، ومن المستشرقين وتلاميذهم دون سواهم؟!
ومتى
كان المستشرق حريصًا على خيرنا وتقدمنا، وهو المستشار في كل أذى يدبر لنا، وكل حرب
تعلن ضدنا، اللهم إلا قلة نادرة تتصف بالموضوعية والاعتدال.
________________________________________
المصدر:
مجلة الأدب الإسلامي/ المجلد الأول/ العدد الرابع/ ربيع الثاني (1415هـ)، ص27-29.