كفارة اليمين وحد الحرابة مثالان..
«أو» بين التخيير والترتيب وبراعة الاستنباط الفقهي
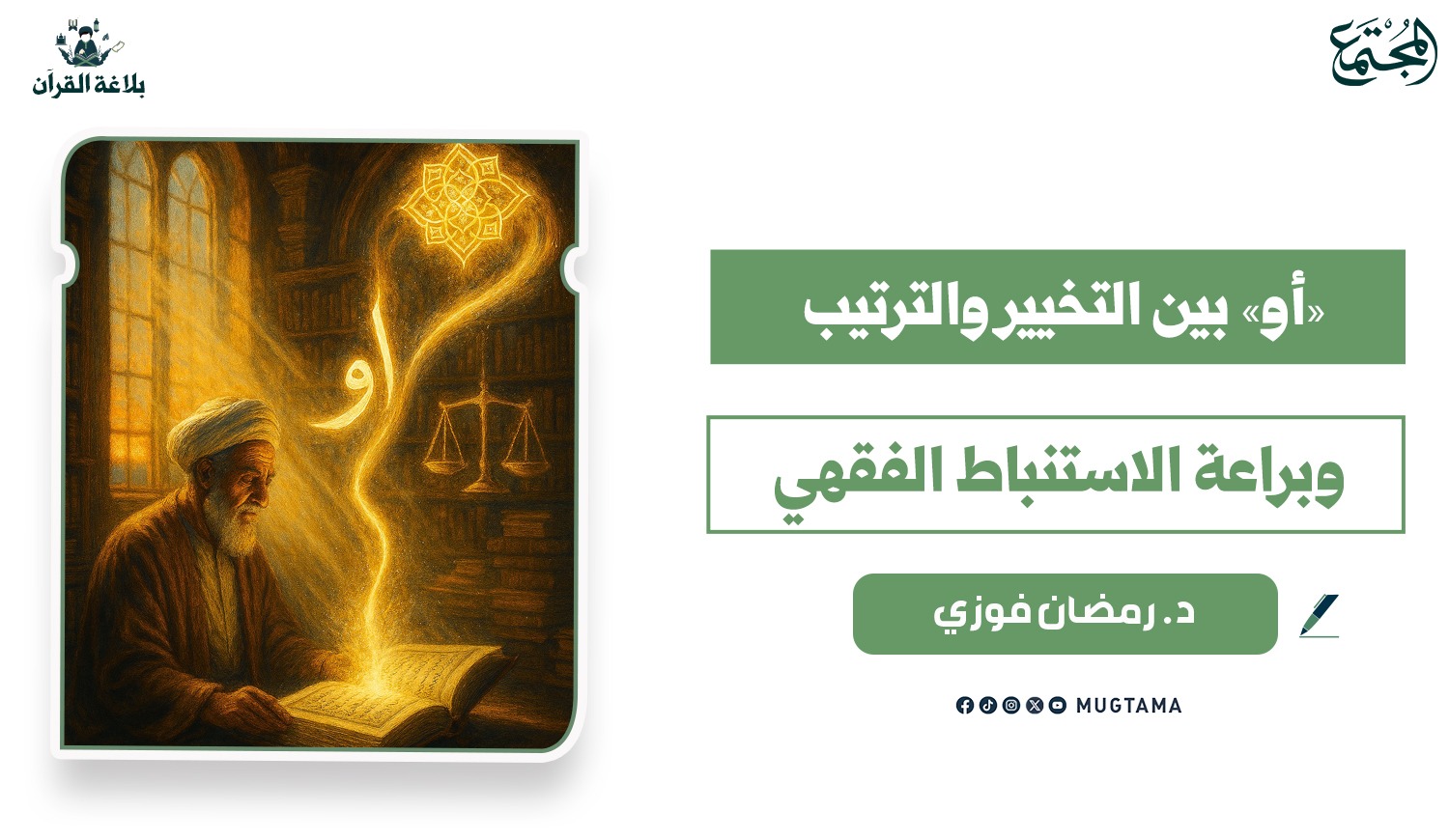
«أو» من حروف
العطف، مذهب الجمهور أنه يُشرك في الإعراب، لا في المعنى؛ لأنك إذا قلت: قام زيد
أو عمرو؛ فالفعل واقع من أحدهما، وذهب ابن مالك إلى أنه يُشرك في الإعراب والمعنى؛
لأن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي جيء بها لأجله؛ ألا ترى أن كل واحد
منهما مشكوك في قيامه.
أما معانيه فقد
ذكر له ابن هشام اثني عشر معنى، والمعنى الأكثر تداولاً وشهرة منها أنه تفيد
التخيير؛ فحينما أقول لك: «افعل هذا أو ذاك»؛ فأنت مخير بين فعل أي منهما، لكن عند
التطبيق الفقهي لبعض مواضع «أو» خالف بعض الفقهاء هذا المسلك، وجعلوا «أو» تفيد
الترتيب وليس التخيير، وذلك مراعاة لمقتضى سياقي آخر، أو تحقيقاً لمصلحة اجتماعية،
كما سيتضح في المسألتين التاليتين اللتين اختلف الفقهاء في توجيه «أو» فيهما.. هل
هو التخيير أم الترتيب؟ وهما:
الأولى: كفارة اليمين.. ومراعاة الواقع الاجتماعي:
ذهب جمهور
الفقهاء إلى تخيير الحانث في يمينه بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير
رقبة، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، اعتباراً لمعنى التخيير في «أو» في قول الله
تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُّؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ
الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ) (المائدة: 89)، وهذه الآية جمعت بين التخيير والترتيب؛
فالتخيير في أول ثلاثة والترتيب بينها وبين الأخير.
لكن هناك لفتة
مهمة من بعض الفقهاء، راعوا فيها معنى الترتيب في «أو» في الآية السابقة؛ حيث يرى
بعضهم أنه من الأفضل أن نبدأ بما بدأ به الله وهو الإطعام، وهذا على سبيل الأفضلية
وليس الوجوب.
وهذا الرأي
الفقهي فيه دلالة على عظمة التشريع الإسلامي، ومراعاته للواقع الاجتماعي للناس؛
فقد نُقل عن ابن العربي تعليله الرائع لهذا الأمر؛ حيث يقول: «والذي عندي أنها
تكون بحسب الحال، فإن علمت محتاجاً فالطعام أفضل؛ لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم،
وزدت محتاجاً حادي عشر إليهم، وكذلك الكسوة تليه، ولما علم الله الحاجة بدأ
بالمقدَّم والمهم».
فكلام ابن
العربي في هذا السياق كلام معتبر فيه مراعاة للواقع الاجتماعي، ويحقق المقاصد
السامية من الكفارة؛ بحيث تكون حلاً لمشكلة الفقراء المحتاجين، وليست سبباً في
زيادة عددهم وتفاقم مشكلتهم.
وتتجلى عظمة
اللغة هنا في مرونتها التي تسع كل هذه الاستنباطات الفقهية التي هي مظهر من مظاهر
روعة التشريع الإسلامي الذي تكمن بعض مظاهر الرحمة فيه في الاختلافات التي تراعي
حال الناس وواقعهم.
الثانية: حد الحرابة ومراعاة أنسب العقوبات للجرم:
حددت الآية
الكريمة: (إِنَّمَا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن
يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ
خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ) (المائدة: 33) أربع عقوبات للحرابة: القتل،
التصليب، قطع الأيدي والأرجل من خلاف، النفي من الأرض.
وقد اختلف
الفقهاء في معنى «أو» في هذه الآية؛ هل يفيد التخيير أم الترتيب؟ وعليه هل وجبت
هذه العقوبات على طريق التخيير في أن يفعل الإمام منها ما رآه صلاحاً، أم وجبت على
طريق الترتيب؛ فتكون كل عقوبة منها في مقابلة ذنب لا يتعداه إلى غيره؟
ذهب سعيد بن
المسيب، ومجاهد، وعطاء، والنخعي، ومالك وداود وأهل الظاهر إلى أنها على سبيل
التخيير، يفعل الإمام منها ما يشاء.
لكن الشافعي،
وأبا حنيفة، ذهبا إلى أنها وجبت على طريق الترتيب، وروي أيضاً هذا عن علي، وابن
عباس، والنخعي، وابن جبير.
وحجة القائلين
بالترتيب ثلاثة أمور:
أحدها: أن
اختلاف العقوبات يوجب اختلاف أسبابها.
وثانيها: أن
التخيير مفضٍ إلى أن يعاقب من قلَّ جرمه بأغلظ العقوبات، ومن كثر جرمه بأخف
العقوبات، والترتيب يمنع من هذا التناقض؛ لأنه يعاقب في أقل الجرم بأخف العقوبات،
وفي كثرة الجرم بأغلظها؛ فكان أولى.
وثالثها: أنه
لما بُدئ فيها بالأغلظ، وجب أن يكون على ترتيب، مثل كفارة القتل والظهار، ولو كانت
على التخيير لبُدئ فيها بالأخف من كفارة اليمين.
ويرى هؤلاء أن
قطع الطريق أربعة أنواع: إما أن يكون بأخذ المال لا غير، وإما أن يكون بالقتل لا
غير، وإما أن يكون بهما جميعا، وإما أن يكون بالتخويف من غير أخذ ولا قتْل.
فمن أخذ المال
ولم يقتل قُطعت يده ورجله من خلاف.
ومن قَتل ولم
يأخذ المال قُتل.
ومن أخاف ولم
يأخذ مالاً ولا قتل نفساً يُنفى.
ومن أخذ المال
وقَتل قال أبو حنيفة: «الإمام بالخيار إن شاء قطع يده ورجله ثم قتله أو صلبه، وإن
شاء لم يقطعه وقتله أو صلبه»، وقيل: إن تفسير الجمع بين القطع والقتل عند أبي
حنيفة هو أن يقطعه الإمام ولا يحسم موضع القطع، بل يتركه حتى يموت وعندهما يُقتل
ولا يُقطع.
وعلى رأي أبي
حنيفة بالجمع بين القطع والقتل فتكون «أو» بمعنى «الواو».
وهكذا نجد
الاتساع الدلالي للغة يساعد في مراعاة البعد الواقعي والاجتماعي في الحكم على من
ارتكب هذه الجريمة؛ حيث تختلف الجريمة قسوة وبشاعة في المجتمع؛ وهو ما يقتضي
مراعاة هذا الاختلاف في الحكم، بناء على البناء اللغوي للآية الكريمة.
















