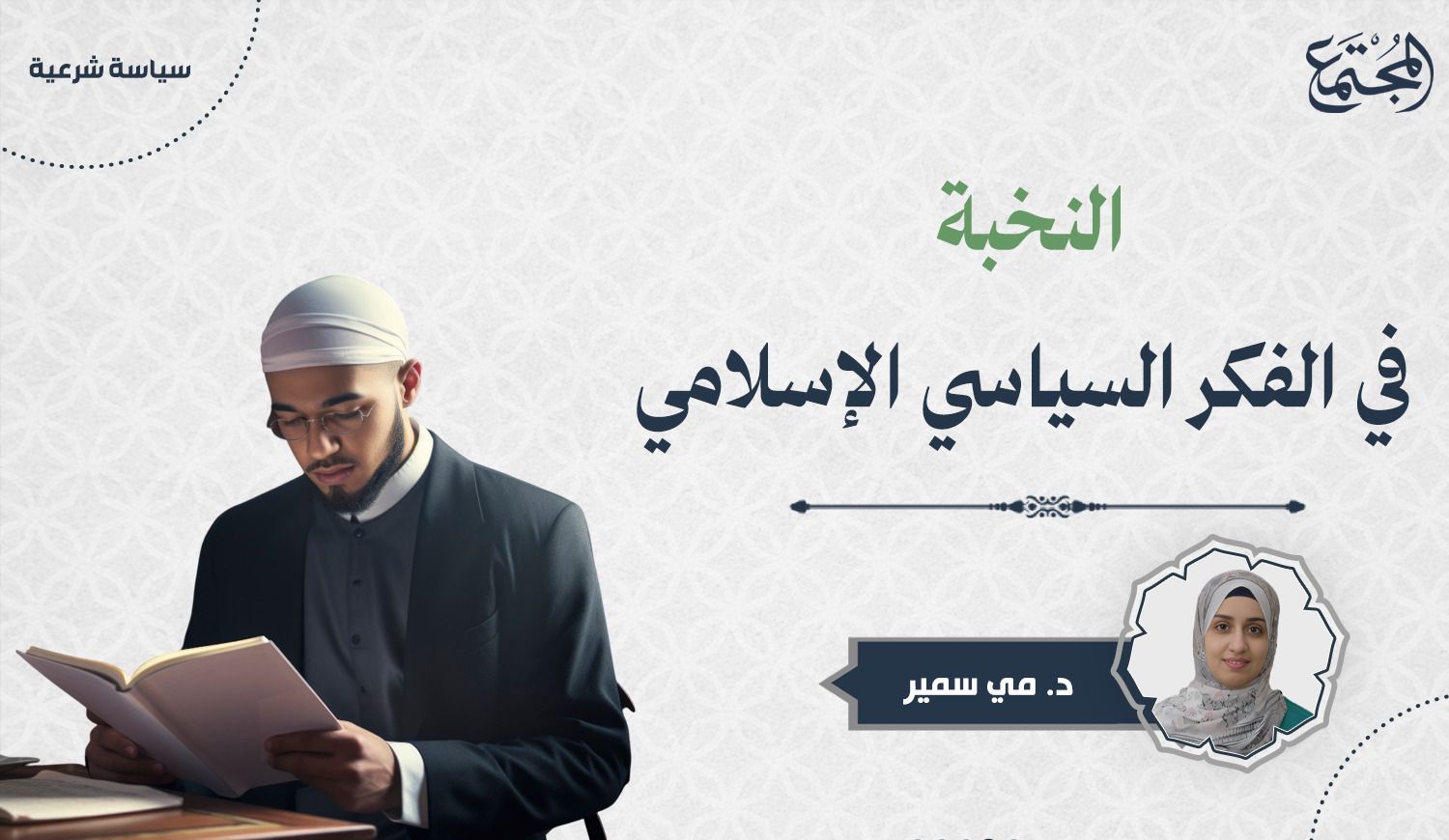«النخبة والصفوة».. كيف تناول القرآن المجتمع النخبوي؟

منذ
أن عرف الإنسان الاستقرار وكوّن مجتمعه الأول ظهرت الطبقية بين أفراد المجتمع، حيث
تمايز الناس بين غني، وفقير وشريف ووضيع.
ومع
حالة التطور المجتمعي صار بين كل طبقة تقاطعات ومصالح حملها على الحفاظ على
امتيازاتها وأن ما تراه هو الأصلح للمجتمع وما يخالفه فهو الجريمة؛ التي يجب
العقاب عليها، فصار ما يعرف بين الناس بالنخبة، وإن تباينت أسماؤها على مر العصور.
وقد
عرف الإغريق النظام الارستقراطي النخبوي وطبقوه، ولكنه كان يتحول في بعض الأحيان
إلى حكم فاسد، وذلك عندما تسيطر أقلية على الحكم، ويتحول لحكم
"الأوليجاركية"، أي الأقلية. (1)
وعندما
جاء الإسلام ظهر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فكانوا في مقدمة الناس،
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار ما يعرف بأهل الحل والعقد الذين يرجع
الناس إليهم في قطع الأمور.
لكن
القرآن كان أسبق وأوسع في الحديث عن مجتمع النخبة والتي لم يذكرها بلفظها المباشر
"النخبة" لكنه عبّر عنها بعدة ألفاظ أخرى منها:
الأمة:
الأمة
في التعريف الإسلامي: هي مجموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين
لقيادة واحدة.
وقد
جاءت في عدة مواضع في القرآن: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ
أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران:104)،
فالقرآن هنا يطالب النخبة المؤمنة أن تبادر وتتحرك وتؤثِّر في المجتمع من أجل
التغيير المنشود.
كما
أثنى القرآن الكريم على النخبة الواعية من الشباب قائلاً: (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى).
وأثنى
الله على نبيه إبراهيم عليه السلام (إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً)، ولكنه كان في نظر خصومه (سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ).
فبقدر العطاء والإصلاح يكون التقدم والحضور النخبوي، وليس بمقاييس النخبة الفاسدة التي تعتبر العمل الإصلاحي من فعل الفتيان أو الصبيان.
الصفوة:
أيضا
استخدم القرآن الكريم لفظا آخر في تعبيره عن النخبة وهو "الاصطفاء"، حيث
قال تعالى: (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا
مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ
الْعَالَمِينَ) (آل عمران:42).
وقال تعالى: (وَاذْكُرْ
عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي
وَالْأَبْصَارِ * إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ * وَإِنَّهُمْ
عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ) (ص:45-47).
والحقيقة
أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتها كانت قائمة على هذا الجوهر وهو
الاصطفاء، وإذا تتبعنا من اصطفاهم النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته نجد أنهم
كانوا هم النخبة من بعده في الصلاح والإصلاح والقيادة.
الملأ (النخبة) في القرآن الكريم:
لكن
أكثر ما تعامل القرآن وتحدث عن مصطلح النخبة كان في حديثه عنها بلفظ
"الملأ" الذي كان يوجه دائما في الخطاب إلى عِلْية القوم ووجهائهم.
وكثير
من الآيات جاءت في حوار بين الأنبياء ونخب مجتمعاتهم حينما كان يوجه النبي دعوته
فتأتي الإجابة من النخبة: (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ).. (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ)..
وهكذا في معظم حوارات الأنبياء مع نخب قومهم.
وكما
وصف القرآن نخبة السابقين من الأمم بالملأ وصف أيضا مجتمع قريش بالنخبة (وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا
عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ)، فالملأ من قريش- النخبة- يحثّون بعضهم بعضا في مواجهة
تحدي الرسالة الجديدة التي ستقضي على مصالحهم وجاههم الشخصي.
ولم
تكن النخبة فاسدة على طول الخط لكن هناك مواضع في القرآن تشير إلى مجتمع نخبوي
متشاور يتعامل بأريحية في مجالسه مثلما حدث مع ملكة سبأ والنخبة من قومها : (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ
كِتَابٌ كَرِيمٌ) حتى وصلت إلى رأي سديد مع نخبتها- الذين كانوا يقدرون
بثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، كل رجل منهم على عشرة آلاف- بإرسال هدية مخافة ما
يفعله الملوك في حالة استيلائهم على ممالك غيرهم، ولحصافة رأيها أقرّها القرآن على
سداد رأيها بحضرة الملأ ( وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ) أي
أنهم حقا يجعلون أعزة أهلها أذلة.(2)
كما
ثمّن القرآن مشورة نبي الله سليمان لأهل مشورته الملأ أو النخبة حينما أراد أن يرد
على ملكة سبأ: (قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ).
وفي
قصة يوسف عليه السلام حينما رأى الملك رؤياه وأراد أن يقصّها ليأتوا له بتأويلها
قال: (يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ).
فنحن
أمام حديث وواسع وشامل عن النخبة يكشف لنا مجموعة من الحقائق، منها:
1-
النخبة في أكثر الأحيان فاسدة ومتسلطة غير قابلة لتغيير موروثها ومكتسباتها
المجتمعية كما ذكر في جدالهم وتعنتهم مع أنبيائهم.
2-
توجد نخبة مستنيرة في بعض الأحيان تشير وتنصح وتمتثل للأصلح.
3- هناك فرق بين الصفوة والنخبة، فالصفوة أشخاص يصنعون على عين الله، أما النخبة فأشخاص أو مؤسسات تصنع من قبل البشر.
خطورة النخبة الفاسدة:
1- إفساد الفطرة البشرية:
فدائما
سلاحها التهديد والوعيد بالإخراج لمخالفيهم أو سجنهم أو قتلهم، ومن يعش تحت سطوتهم
يتعرض لفساد فطرته.
لقد
كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ينظر بنور الله، فيرى حقيقة تركيب النفس البشرية
وطبيعتها وهو يقول لعماله على الأمصار موصياً لهم بالناس: «ولا تضربوا أبشارهم
فتذلوهم».. كان يعلم أن ضرب البشرة يذلّ الناس. (3)
2- النخبة معوقة لقبول الوعي:
فدائما
يصفون من يقبل الحق أو ينحاز إلى مصلحة الأمة بأنهم "أراذل" وضعفاء وغير
مجرّبين يقبلون كل شيء بدون رويّة.
وقد كشف القرآن طبيعة هذه النخبة كما حدث مع قوم
نوح تجاه أتباعه فوصفوهم: ( مَا نَرَاكَ إِلَّا
بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا
بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ).
فقد
تعجبوا أن يكون بشرا رسولا وتنقصوا بمن اتبعه ورأوهم أراذلهم، وقولهم: "بادي
الرأي" أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا رويّة وهذا الذي رموهم
به هو عين ما يمدحون بسببه، فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى رويّة ولا فكر ولا نظر
بل يجب الانقياد له متى ظهر.(4)
وكان
هذا من ذكاء ملك الروم هرقل حينما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه
وسلم: "فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم
ينقصون؟ قال: بل يزيدون"، فقال له: هكذا أتباع الرسل، وأنهم يزيدون، فهذا أمر
الإيمان حتى يتم.(5)
3- النخبة دائما تنحاز إلى الترف:
وهو
ما يميز المتقدمين لأمر الناس فإذا كان حالهم يصب في مصالحهم دنيا ودينا فهم من
الصفوة، أما إذا كانوا تحت أي مسمى يتخذون الناس لأجل الحفاظ على مكانتهم
ووجاهتهم، فهم من "المترفين"، والترف حالة مرفوضة في القرآن وهي ضد دعوة
الأنبياء.
وكان
الفاروق عمر عبقريا في ضبط جماح النخبة وضرورة تقويمها حالة انحرافها فقال: أيها
الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه ـ فقام له رجل وقال: والله لو رأينا فيك
اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فقال: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج
عمر بسيفه؟
************************
المصادر
والمراجع:
1-
د. أبو اليسر فرح: مقدمة في تاريخ اليونان.
2-
محمد بن أحمد القرطبي: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن).
3-
سيد قطب: في ظلال القرآن.
4-
ابن كثير: البداية والنهاية.
5-
البيهقي: دلائل النبوة.