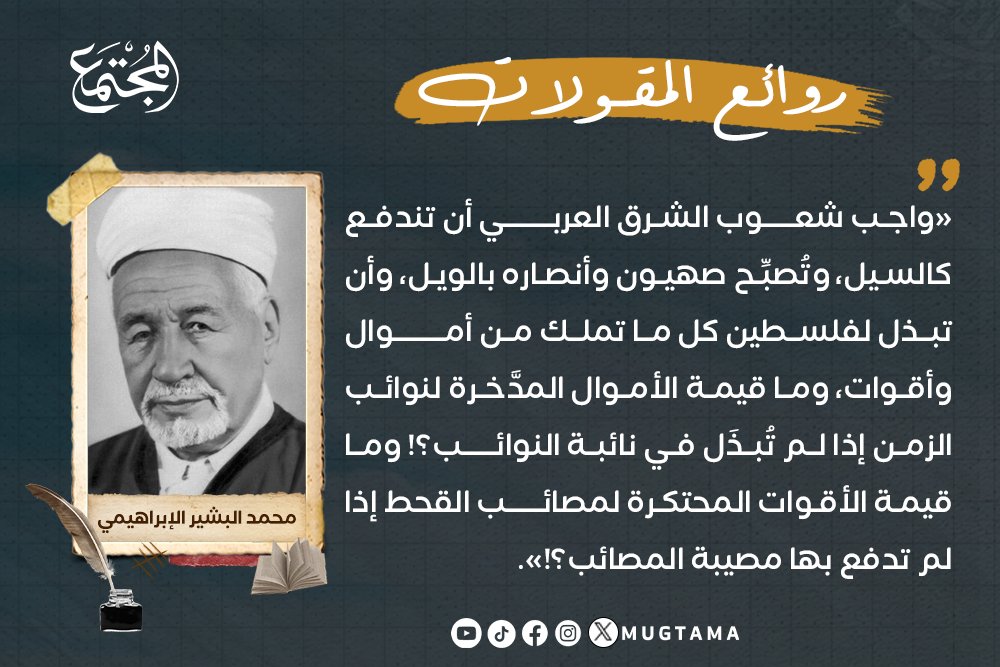الكتاب عنوان من عناوين الحضارة، ورمز من رموز مساهمة الأمم في الفكر الإنساني عمومًا.
وليس كل ما يكتب نافعًا مفيدًا، لكن الكتابة تبقى أكثر مما تبقى الكلمة المنقولة مشافهة؛ يقول أبو الفرج بن الجوزي: «رأيت من الرأي القويم أنَّ نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة؛ لأني أشافه في عمري عددًا من المتعلمين، وأشافه بتصنيفي خلقًا لا تحصى ما خلقوا بعد، ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم»(1).
ورغم ذلك فإنه في بلدي الجزائر يلاحظ أن هناك عزوفًا عن الكتابة والتقييد من العلماء رغم كثرتهم وتمكنُّهم من علومهم، وقد حاولت تلمُّس أسباب ذلك:
– فرأيت أن في طبيعة علماء الجزائر من التواضع ما يصل إلى حد غمط النفس، وفيهم من رفع الوافد عليهم -وخصوصًا المشارقة- ما قد يصل إلى حد وضع النفس.
– ورأيتهم ينظرون إلى أعمالهم بعين النقص فلا يرغبون في نشرها، وفاتهم أن الكمال في حق البشر مستحيل، وكأنهم لم يقفوا يومًا عند قول القاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابه في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جلة البشر»(2).
– ورأيت أنهم يرون أنهم ما زالوا طلابًا للعلم، ولا يحق لطالب العلم أن يتجرأ على التصنيف؛ حتى يتمكن من أدواته، ومن يقول هذا هم من الحاصلين على شهادات الدكتوراة، والذين شهد لهم العلماء العدول الأثبات بأهليتهم، وكونهم قد تمت إجازة رسائلهم العلمية، ولا يحاولون نشر رسائلهم العلمية على نفاستها.
– ورأيت أن الأساتذة في جامعاتهم لا يميلون لفرض كتبهم على تلاميذهم، رغم أن الجامعة لا تمنع ذلك، وقد يظل الأستاذ يشرح مادته عشرين عامًا لطلابه دون تفكير في إخراج ما يقوله ويشرحه في كتاب.
– وهذا العزوف متغلغل في معظم طبقة النخبة المثقفة؛ ففي الحركة الإسلامية بالجزائر علماء وكتَّاب وباحثون كبار، ورغم ذلك لم يجمعوا تراث مؤسسي الحركة، ولم يخرجوه في كتاب أو موقع إلى اليوم رغم مرور سنوات على وفاة المؤسسين، ثم إنهم لم يؤرّخوا للحركة حتى الآن، ولم يكتبوا كيف نشأت وتطورت، حتى إن كبارهم لا يكتبون مذكراتهم وسيرتهم الذاتية، فلا نفيد من تجاربهم، ولا هم قوَّموا وراجعوا نهجهم وخطهم السياسي والدعوي، ولا عرف الناشئة تاريخ حركتهم إلا تاريخًا شفويًّا سرديًّا.
وكذا الحال مع علماء جمعية علماء المسلمين أمثال الشيخ عبداللطيف سلطاني، والشيخ عمر العرباوي، وغيرهم من العلماء أمثال الشيخ مصباح حويذق، والشيخ أحمد سحنون، والشيخ الأطرش السنوسي، والشيخ الطيب المهاجي.. إلخ.
– ورأيت أن الإعلام مقصر في صناعة الرموز، وإبرازهم، والتعريف بهم، وهذا الضعف الإعلامي له أعظم الأثر في بقاء ذكر هؤلاء العلماء محصورًا داخل الجزائر، وإذا عرفنا بعضهم فنعرفهم عندما يسلط إعلام آخر الضوء عليهم.
– ورأيت أن قلة دور النشر في بلدي له عامل كبير في ضعف الإقبال على النشر، رغم أن القوة الشرائية لنا كبيرة، لكنها يفوز بها الناشرون من الخارج الذين يأتون بثمرات ما يطبعونه ويبيعونه بالجزائر.
– ورأيت أن هناك بعض الأثرة عند بعض الأسر العلمية التي تحتفظ بالمخطوطات العلمية لآبائها وأجدادها، ولا تسعى لنشرها، بل قد تضيع لعدم وجود التقنيات التي تحافظ على المخطوطات، وفي بعض الأحيان يتم فقدها في بعض الحرائق التي تلتهمها، فتضيع فائدتها.
وهذه أمور أغلبية، وإلا فهناك شخصيات لها جهدها المشكور في النشر والتأليف والتحقيق.
وفي التكوين النفسي لعلماء الجزائر قد يلاحظ عدم اهتمامهم بالتأليف رغم رسوخ علمائهم، إلا أنهم خطباء بلغاء مفوهون بالفطرة، يستوي في ذلك منهم ذكرهم وأنثاهم كبيرهم وصغيرهم؛ فهم كأجدادهم العرب الأوائل يميلون للخطابة أكثر من ميلهم للكتابة.
وهذا التكوين النفسي ليس حديثًا في الشخصية الجزائرية، بل هو قديم لاحظه ابن خلدون في أهل المغرب العربي عمومًا، وحاول تحليل أسبابه، فقال: «اعلم أنَّ سند تعليم العلم لهذا العهد قد كاد ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانه وتناقص الدُّول فيه، وما يحدث عن ذلك من نقص الصَّنائع وفقدانها؛ وذلك أنَّ القيروان وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب والأندلس واستبحر عمرانهما وكان فيهما للعلوم والصَّنائع أسواق نافقة وبحور زاخرة، ورسخ فيهما التَّعليم لامتداد عصورهما، وما كان فيهما من الحضارة، فلمَّا خربتا انقطع التَّعليم من المغرب إلاَّ قليلاً كان في دولة الموحِّدين بمراكش مستفادًا منها، ولم ترسخ الحضارة بمراكش لبداوة الدَّولة الموحِّديَّة في أوَّلها وقرب عهد انقراضها بمبدئها فلم تتَّصل أحوال الحضارة فيها إلاَّ في الأقلِّ.
ثمّ ارتحل من زواوة في آخر المائة السّابعة أبو عليّ ناصر الدّين المشداليّ وأدرك تلميذ أبي عمرو بن الحاجب وأخذ عنهم ولقّن تعليمهم، وقرأ مع شهاب الدّين القرافيّ في مجالس واحدة وحذق في العقليّات والنّقليّات. ورجع إلى المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد، ونزل ببجاية واتّصل سند تعليمه في طلبتها، وربما انتقل إلى تلمسان عمران المشداليّ من تلميذه وأوطنها وبثّ طريقته فيها، وتلميذه لهذا العهد ببجاية وتلمسان قليل أو أقلّ من القليل.
وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلوًّا من حسن التّعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ولم يتّصل سند التّعليم فيهم فعسر عليهم حصول الملكة والحذق في العلوم.
ثمّ بعد تحصيل من يرى منهم أنَّه قد حصَّل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علَّم، وما أتاهم القصور إلاَّ من قبل التَّعليم وانقطاع سنده، وإلاَّ فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدّة عنايتهم به، وظنّهم أنَّه المقصود من الملكة العلميَّة وليس كذلك.
وأمّا المشرق فلم ينقطع سند التّعليم فيه بل أسواقه نافقة وبحوره زاخرة لاتّصال العمران الموفور واتّصال السّند فيه؛ فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم، بل وفي سائر الصّنائع، حتّى إنّه ليظنّ كثير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أنّ عقولهم على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب وأنّهم أشدّ نباهة وأعظم كيسًا لما يرون من كيسهم في العلوم والصّنائع وليس كذلك»(3).
ويبقى أن الدولة عليها أن تؤسس لصناعة الكتاب، من خلال إقامة المؤسسات الثقافية التي ترعى الأعمال الجادة، وتعمل على نشرها بأثمان رخيصة؛ لتكون في متناول اليد، وإجزال العطاء للمؤلفين لتشجيعهم على الكتابة والتأليف والتحقيق.
________________________
(1) صيد الخاطر، ص 241.
(2) كشف الظنون (1/ 14).
(3) تاريخ ابن خلدون (1/ 544) وما بعدها باختصار.