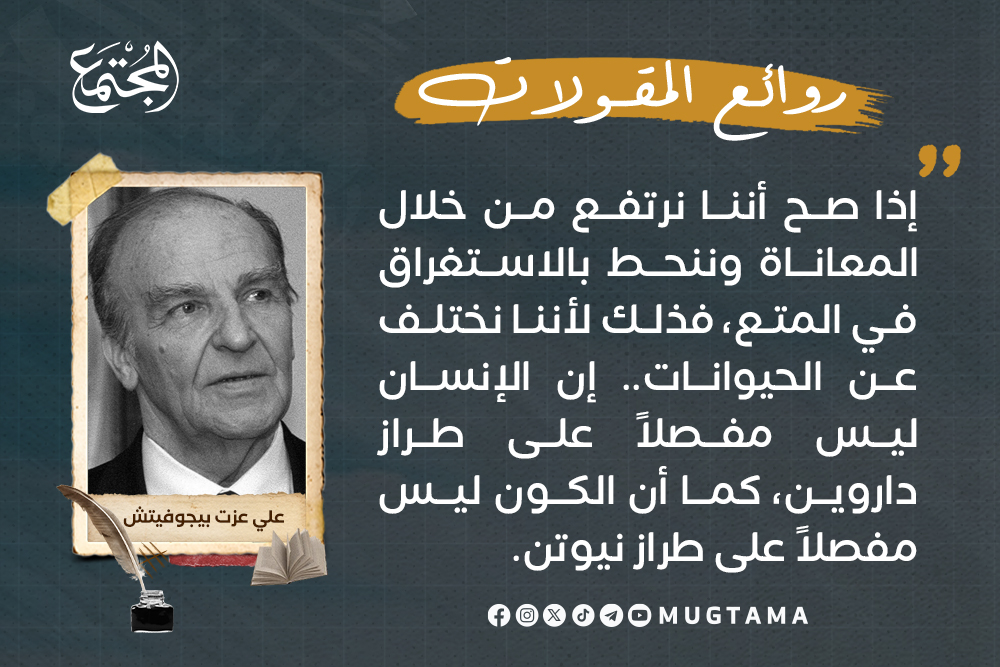إن أفراد الأمة ولا شك يحتاجون إلى قدوة، والقدوة تحتاج إلى رمز أو رموز متكاملة المكانة كبيرة الوزن والقيمة والمقام، ولمثل ذلك قال الله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 71)، وقال تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {11} وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) (التحريم).
وهكذا شدد القرآن الكثير على أهمية وجود القدوة الصالحة في حياة الأمم، فقال تعالى عن الأنبياء والرسل: (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ) (الأنعام: 90)، (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) (الأحزاب: 21).
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مربي الأمة الأول والأعظم الذي يحرص على صناعة رموزها وقدواتها، يصنعهم على عينه ويهيئهم تهيئة تليق بأن يجعلهم قدوات لأمته، وهذا فعله مع السادة الصحابة الكبار أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، وأبي عبيدة بن الجراح.. وغيرهم من كبار الصحابة، وكذلك مع سعد بن معاذ، أحد سادة الأنصار.
وفي سبيل ذلك، لم يرضَ النبي صلى الله عليه وسلم أن تشوب صحابته الكبار قدوات الأمة المسلمة شائبة، ففي «عيون الأثر» لابن سيد الناس: «كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِيَدِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَلَمَّا مَرَّ بِهَا عَلَى أَبِي سُفَيْانَ، وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ سَعْدٌ، إِذْ نَظَرَ إِلَيْهِ: الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ، الْيَوْمَ أَذَلَّ اللَّهُ قُرَيْشًا، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَةِ الأَنْصَارِ، حَتَّى إِذَا حَاذَى أَبَا سُفْيَانَ، نَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُمِرْتَ بِقَتْلِ قَوْمِكَ؟ فَإِنَّهُ زَعَمَ سَعْدٌ وَمَنْ مَعَهُ، حِينَ مَرَّ بِنَا أَنَّهُ قَاتِلُنَا، أَنْشُدُكَ اللَّهَ فِي قَوْمِكَ، فَأَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَرْحَمُهُمْ، وَأَوْصَلُهُمْ.
وَقَالَ عُثْمَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لا نَأْمَنُ سَعْدًا أَنْ تَكُونَ مِنْهُ فِي قُرَيْشٍ صَوْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ، الْيَوْمَ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ قُرَيْشًا».
إن حامل الراية في جيش النبي صلى الله عليه وسلم هو منصب يوليه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بحقه، فهو رئيس قوم ومتحدث باسمهم وصاحب الكلمة فيهم، فينبغي أن يدقق في كلماته فهي محسوبة على المسلمين ككل لا عليه وحده، ومن هنا جاءت شكاية أبي سفيان من كونه حاملاً للراية.
وكان لا بد من قرار لعزل سعد عن قيادة قبيلته وحمل رايتهم لا لعيب فيه، ولكن خشية من تصرف قد يتسبب في وقوع حرب لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها وخاصة لوجود ثأر شخصي بينه وبينهم حينما أمسك به أهل مكة وعذبوه.
ولم يكن هناك إلا بديل واحد –من بين عشرة آلاف رجل– هو من يصلح لأن يكون حاملاً للراية مكان سعد، فاختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع إليه الراية بعد أن أمر مناديه أن ينادي في الجيش للبحث عنه؛ إنه الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة، فهو الصحابي الوحيد في الجيش الذي لن يعترض عليه سعد، ولن تُستثار حفيظته عليه، بل سيفرح؛ لأن الراية لم تخرج منه إلا إليه! وكان قيس رجلاً معروفاً بكياسته وسكونه وعدم تسرعه حتى قيل عنه: إنه كان من أحد أدهى العرب الذي تنسب له كلمة «لولا الإسلام، لمكرت مكراً لا تطيقه العرب»(1).
هكذا كانت تُصنع الرموز ويتم انتقائها وتصويبها ومراجعتها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وهكذا يجب أن يكون الرمز المسلم نقياً من كل شائبة تطعن في دينه أو خلقه أو عرضه أو أمانته، أو تسبب في ضرر وحقد وضغينة بين ذلك الرمز المسلم والناس.
وأن يُعزل فور أن يهفو هفوة بشرية، وهو الأمر الذي يكرره النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد بعد «فتح مكة» من ولاية ثم عزل واستبدال!
فحين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح إلى بعض قبائل العرب القريبة من مكة، وقال له: «إني أبعثك داعياً لا مقاتلاً».
غلبه سيفه على أمره ودفعه إلى دور المقاتل، متخلياً عن دور الداعي الذي أوصاه به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ مما جعله عليه السلام ينتفض جزعاً وألماً حين بلغه صنيع خالد، وقام مستقبلاً القبلة، رافعاً يديه، ومعتذراً إلى الله بقوله: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»، ثم أرسل عليّاً فودى لهم دماءهم وأموالهم(2).
أما موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد بن حارثة وهو الحِب بن الحب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: «إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقاً بالإمارة»، فلقد روى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقتُ أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكفَّ عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لي: «يا أسامة، أقتلْتَه بعدما قال لا إله إلا الله؟»، قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذًا، قال: فقال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟»، قال: فما زال يُكرِّرها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، وفي رواية لمسلم: قال أسامة: قلتُ: يا رسول الله: إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: «أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا»، فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بحساسية شديدة مع القتل، فيحقن الدماء ويعفو عن المسيئين بعد كل بادرة للتوبة والإنابة، ويأمر أصحابه بتجنب حرمة الدماء الحرام.
_____________________________
(1) يحيى البوليني، 24 رمضان 1433هـ، الحكمة الإدارية العليا في فتح مكة، موقع «المسلم نت».
(2) خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ج1، ص 225.