تنمية الروح الاجتماعية لدى الأبناء
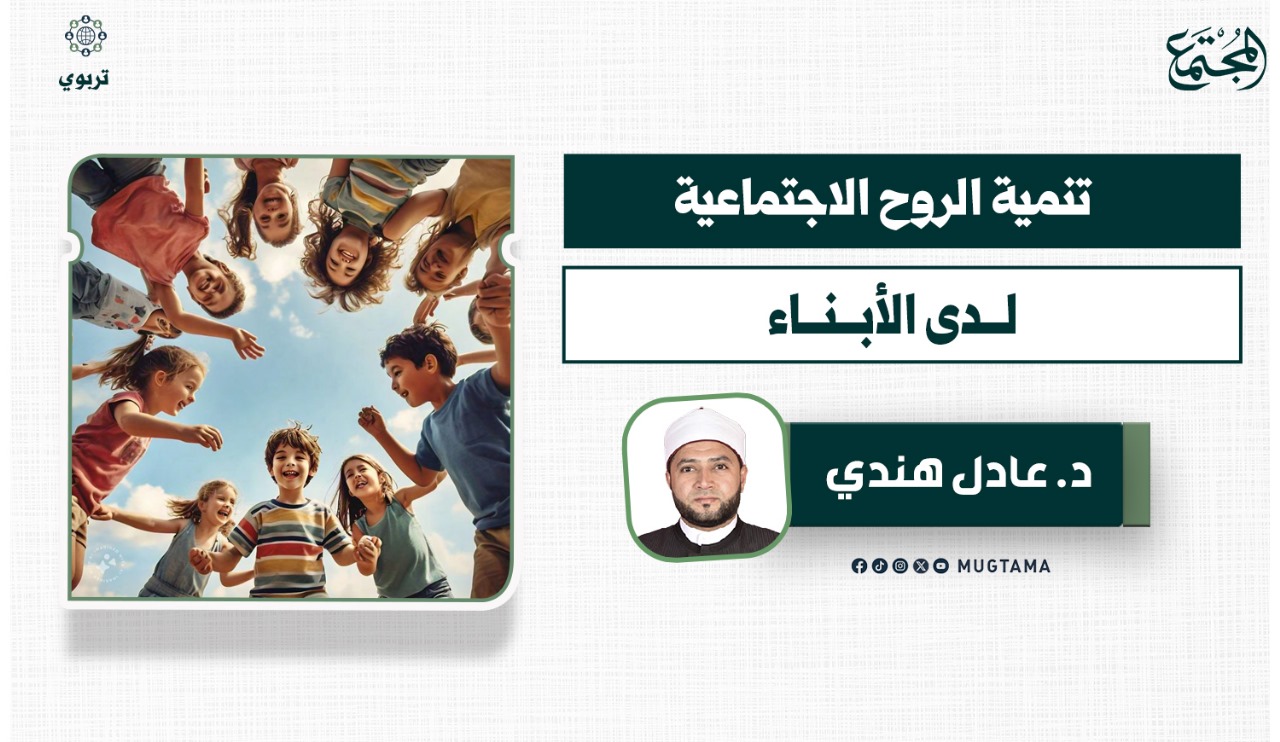
بعد أن تأملنا
في المقال السابق أهمية العدل والمساواة بين الأبناء، ورأينا كيف أن غرس هذا
الأساس في البيت يشيع الطمأنينة بين الإخوة، ويطفئ نار الحسد، ويقوي الأواصر
الأسرية، فإننا اليوم ننتقل إلى أساس آخر من أسس التربية النبوية لا يقل عنه
أثرًا، بل هو ثمرة من ثماره، وهو تنمية الروح الاجتماعية في نفوس الأبناء.
فمن نشأ على
العدل داخل بيته، وأحس بالمساواة بينه وبين إخوته، يسهل عليه أن يحمل هذا الإحساس
معه إلى خارج البيت، إلى مجتمعه ومحيطه، متفاعلًا مع الناس، ممارسًا لصور البر
والإحسان والمواساة.
إنه الانتقال
الطبيعي من العدل في الأسرة إلى الاندماج الإيجابي في المجتمع.
والإنسان
اجتماعيّ بالفطرة، ويأنس إلى الآخرين، لكن أُنسَ الإنسان إلى البشـر يأتي بالتربية
والتعوّد من الصغر على هذا، ولذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلن يحفّز همم الأبناء
نحو التواصل الاجتماعي مع الآخرين بحضور الأفراح وتقديم التعازي ومشاركة الغير
فيما فيه الخير.
وللدلالة على
ذلك تأتي الأمثلة التالية:
1- مشاركته صلى
الله عليه وسلم شخصيًّا مع أصحابه في بناء المسجد النبوي الشـريف؛ فعمل فيه النبي
صلى الله عليه وسلم ليرغّب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار،
ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين:
لئن قعدنا
والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل
وارتجز المسلمون
وهم يبنونه يقولون:
لا عيش إلا عيش
الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة(1)
كما شارك النبيّ
صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق يوم «الأحزاب»، فها هم أبناء الأُمّة يروْن
القائد العظيم سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم يتحرّك بنفسه ويشارك في أعمال
المجتمع ولا يتأخر.
2- التوجيه
المباشر بالمشاركات المجتمعية وأنها جزء من الإيمان، وأنّ المؤمن الحق هو الذي
يُخالط الآخرين ويصبر على ما يصدر منهم من أذى؛ ففي الحديث: «المؤمن الذي يُخالط
الناس ويصبر على أذاهم أَعظمُ أَجرًا من الذي لا يُخالطهم ولا يصبر على أذاهم»(2)،
ولا شك أنّ في ذلك دعوةً للمخالطات الاجتماعية والمشاركات الإنسانية؛ تنمية للثقة
بالنفس، وإيقاظًا للإحساس البشري.
3- ترغيب
تلامذته وأتباعه ومن سار على هديهم في بذل ما فيه منفعة عامة للبشـر ولغير البشـر،
فمن خلال سُنّته الشـريفة يُلاحَظ أنه قد وجّه صراحة إلى بذل المعروف والخير،
وأكّد صلى الله عليه وسلم أنّ من زرع زرعًا، أو رسم بسمة على شفاه حُرِمَت منها،
أو شارك في إسعاد غيره، أو فتح باب خير للغير فإنّه يثاب ويأخذ أَجْرَه بكل يقين.
ففي الحديث:
«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ
طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»(3)،
وفي لفظ مسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ
مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ،
وَلَا يَرْزَؤُهُ -يأخذ منه- أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»(4).
وفي ذلك رسالة
للمربين إلى ضرورة تنمية الانتماء لدى الشباب نحو مجتمعاتهم وبلدانهم، وذلك من
خلال الحثّ على مشاركة المجتمع في كل ما يعود على المجتمع بالنفع.
4- التربية على
مواساة الآخرين إذا أهمّتهم مصيبة: كما فعل مع أسرة سيدنا جعفر بن أبي طالب حين
استُشهد يوم «مؤتة»؛ ففي الحديث الذي يحكيه عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، يقول:
لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُتِلَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
«اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ أمْرٌ يَشْغَلُهُمْ، أَوْ
أتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ»(5).
فإنّ صبيًّا
نُشِّئ على معاني المواساة والإحساس بالآخرين لن يظلم غيره يومًا، وسيشعر بهموم
الناس إذا أهمّتهم الأمور وضاقت بهم الأحوال، وكل هذه الأمثلة لها أكبر الأثر في
نفسية جيل الشباب الناشئ؛ حيث تعمل على تنمية المسؤولية نحو مجتمعهم وأوطانهم، كما
أنّ لها أعظم الأثر في إعداد جيل يحب الخير للغير، لا سيما في زمن باتت الأنانية
فيه تطغى على نفوس الكثيرين من البشـر اليوم.
وإذا كنا قد
تناولنا في هذا المقال كيف نُنمّي في أبنائنا روح المبادرة الاجتماعية، والانخراط
النبيل في شؤون الناس، فلا بد أن نقف بعد ذلك عند العقبات الكبرى التي قد تُعيق كل
هذه الجهود التربوية، وتُفسد على الأسرة مسارها، وعلى الأبناء شخصياتهم.
ولذا سيكون
حديثنا القادم -بمشيئة الله- عن الابتعاد عن مُدَمِّرات العملية التربوية، وهي
تلك الأخطاء والممارسات التربوية التي
تهدم ما نبنيه، وتقتل في الطفل الثقة والحب، وتمحو آثار القدوة والتوجيه.
اقرأ
أيضاً:
مراعاة الفروق
الفردية بين الأبناء
____________________
(1) ينظر: الروض
الأنف في شرح السيرة النبوية: أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي (ت
581هـ)، ج4، ص234، ط1/ 1412هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، والبداية
والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774هـ)،
ج3، ص216، ط، دار الفكر، 1407هـ/ 1986م.
(2) مسند أحمد:
ومن مسند بني هاشم، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (5022) وقال عنه
الشيخ شاكر: إسناده صحيح.
(3) صحيح
البخاري: كتاب المُزارَعة، بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ
(2320).
(4) صحيح مسلم:
كتاب المساقاة، بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ (1552).
(5) مسند أحمد: مُسْنَدُ أَهْلِ الْبَيْتِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمِ أَجْمَعِينَ، حَدِيثُ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (1751)، وقال الشيخ أحمد شاكر في التحقيق: إسناده حسن.

















