نشر الفضائح الإلكترونية.. بين كشف الفساد وانتهاك الحرمات
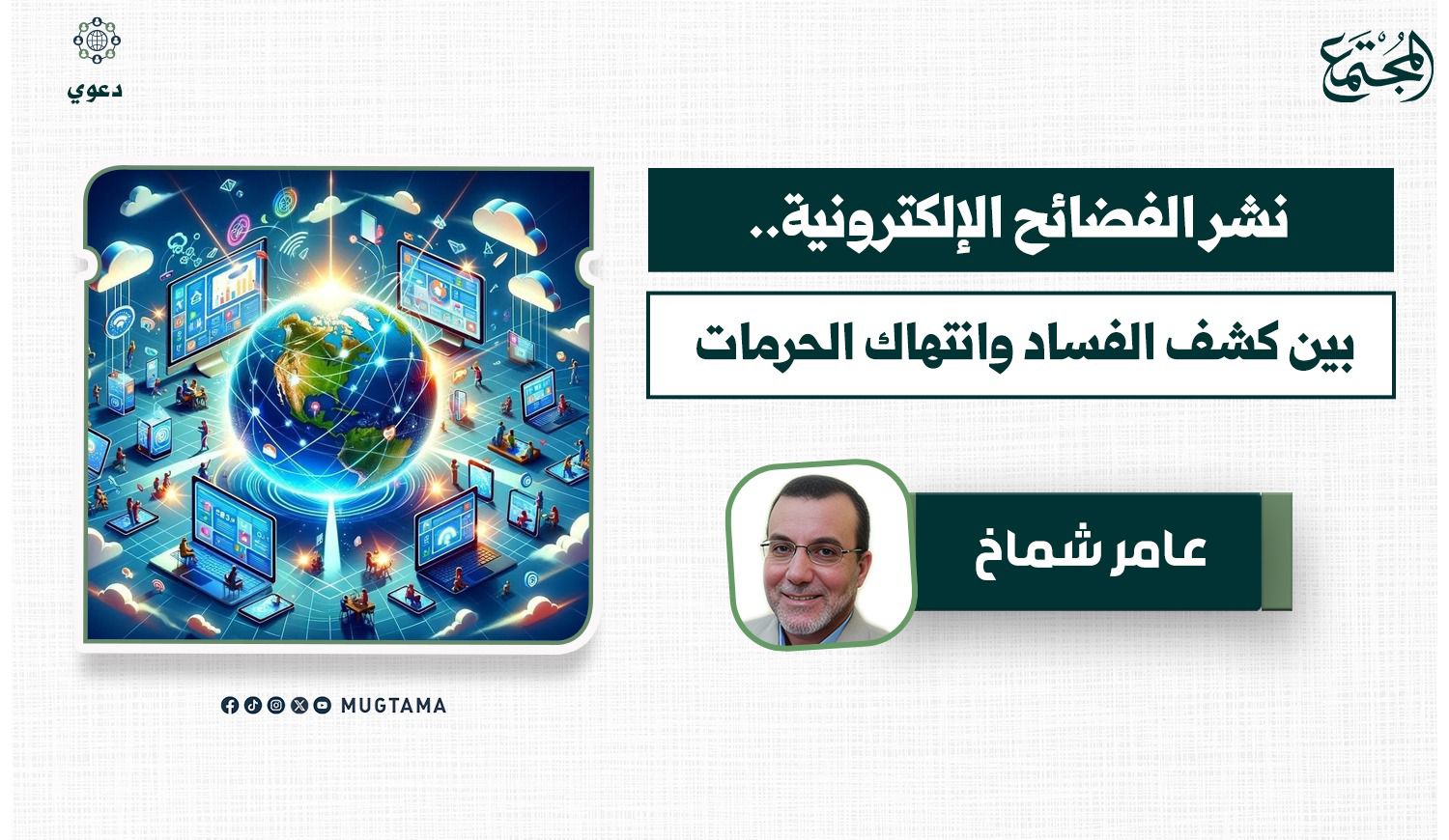
اليوم، وبضغطةِ
زرٍّ، يمكن لأي شخص أن يدمِّر مستقبل آخرين، ويجعلهم حديث الملايين، بنشر خطأ شخصي
أو تصرف عابر على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد نسفت الثورة الرقمية مفهوم
الخصوصية، وحوّلت كل من يملك هاتفًا ذكيًّا إلى مراقب متجوّل، يمكنه نشر ما تلتقطه
كاميرا هذا الهاتف؛ لتنزلق المجتمعات إلى فوضى أخلاقية، تهدر الحرمات، وتشرعن
التشهير، ويتحول الجمهور إلى قاضٍ وجلّاد في آن واحد، يصدر أحكامه عبر التعليقات
والإعجابات والمشاركات.
إننا أمام مشهد
رقمي تتشابك فيه الرغبة في الشهرة وتحصيل المكاسب المادية مع الافتقار إلى المسؤولية،
فـ«الفضيحة الإلكترونية» ليست مجرد خبر يتم نشره، وإنما انعكاس لأزمة أخلاقية
وثقافية عميقة، لقد دأبت المنصات الرقمية على السعي لجذب أكبر عدد من المتابعين
والمشاهدات، فبالغت في نشر هذه الفضائح المثيرة، مثل قضايا الفساد، أو الخيانة، أو
السلوكيات غير الأخلاقية؛ ومن أجل تضخيمها عمدت إلى التكرار المفرط، أو الانتقائية
في عرض المعلومة، واجتزاء الصور والمقاطع، والاعتماد على مصادر غير موثوقة.
الفضيحة كأداة لكشف الفساد
متى يكون نشر
الفضيحة أداة لكشف الفساد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن يُطرح في هذا السياق؛
هل الهدف هو الإصلاح بالفعل، أم الانتقام والتشفِّي وتحقيق السبق الرقمي؟ لقد شهد
العالم خلال السنوات الأخيرة عشرات الأمثلة التي غيّرت مسار الأحداث بفضل تسريبات
خرجت من فضاء الإنترنت، مثل تسريبات «ويكيليكس» وغيرها من تسجيلات التجاوزات
المالية والإدارية، وفضائح الرشوة، ومقاطع الاستغلال والعنف.. إلخ، كان يمكن أن
تبقى طي الكتمان.
وهذه الحالات
رغم قسوتها، فإنها مثّلت صرخة حق في وجه باطل مستتر، ونافذة يطل منها المجتمع على
ما ووري عن أعين القانون، وهنا يصبح النشر عملًا رقابيًّا، ما التزم حدوده
الأخلاقية؛ حيث لم تعد الشفافية خيارًا، بل صارت قوة ضغط جماهيرية يصعب تجاهلها.
وإذا كانت
الشفافية مطلوبة، فلا بد أن يكون ذلك في حدود، دون أن تتحول إلى فضول مرضي، أو
انتهاك متعمّد للحرمات، فالغاية النبيلة لا تبرر الوسيلة الفاسدة، وفضح الفساد لا
ينبغي أن يتم على حساب كرامة الإنسان، وللنشر المسؤول ضوابط، من حيث الدقة والتحقق
من المعلومة، وتجنب نشر الشائعات، وعرض الوقائع دون تحيز، والإفصاح عن مصدر
المعلومة، والاعتراف بالخطأ وتصحيحه فور اكتشافه، واحترام حقوق الملكية الفكرية..
إلخ، هذه الضوابط الأخلاقية المتعلقة بالنشر الإلكتروني.
خطورة التشهير الإلكتروني
تجرّم معظم
التشريعات العربية نشر الصور أو المقاطع الخاصة دون إذن، حتى لو كان الهدف التنبيه
أو التحذير، فالقانون لا يعترف بالنية الحسنة إذا ترتب على الفعل ضرر بالآخرين،
وهناك فارق جوهري بين «كشف الفساد»، و«كشف الأعراض»، ومساءلة السلطة والتشهير
بالأشخاص، والمجتمعات تُبنى على الستر والإصلاح لا على الفضح والتشهير، وفي زحمة
اللهاث وراء «الترند» يترصد بعض مستخدمي المنصات الرقمية عثرات الآخرين، ويحوّلون
أي زلّة إلى مادة جاذبة، قد تدمّر سمعة الشخص، وحياته الشخصية، وكرامته الإنسانية.
وفي كثير من
الحالات لا يتوقف الجاني عند التشهير فقط، الذي ينتهك الخصوصية ويضر بسمعة الضحية،
بل يستخدمه كأداة للابتزاز ووسيلة للضغط من أجل الإكراه على القيام بفعل معين، أو
الحصول على المال أو المنفعة الشخصية، أو التحكم والسيطرة؛ ما يلحق الضرر النفسي
بالضحية، فيكون عُرضة للقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية.
الموازنة بين حق المعرفة وحق الخصوصية
إذا كان الحق في
المعرفة أحد أعمدة المجتمعات الديمقراطية، فإن المسؤولية المهنية تقتضي التساؤل
حول: هل المعلومة المعروضة تخدم المصلحة العامة؟ وهل تضر بأشخاص أبرياء؟ وهل تم
التحقق من صحتها؟ وهل يمكن عرضها دون المساس بالخصوصيات؟ ذلك أن الخط الفاصل بين
الحقيقة والفضيحة أدق من الشعرة، من يقتحمه دون وعي أو ضمير يسيء للآخرين.
النشر المسؤول
يقوم على حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية في الوقت ذاته، بحيث تُمارس حرية
النشر بما يخدم الحقيقة، ويهدف إلى الصالح العام، ويحترم كرامة الآخرين
وخصوصياتهم، ويُراعى فيه الأثر الاجتماعي، بعيدًا عن التضليل والإثارة، أو إثارة
الجدل، وألا يخالف المحتوى النظام العام، أو الآداب العامة.
نحو وعي رقمي أخلاقي
نحن بحاجة اليوم
إلى ثقافة رقمية راشدة، تؤكد أن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية، وأن الحق في
الشفافية وكشف الفساد لا يعني الحق في الإيذاء، وهذه الثقافة يجب أن تُغرس في
المدرسة، وعبر وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والقانونية؛ ليعرف الناس حدودهم في
الفضاء العام، وفي المقابل لا يجوز أن تُتخذ حماية الخصوصية ذريعة لإخفاء الحقائق
وتكميم الأفواه.
ومما نخلص إليه؛
أن نشر «الفضائح الإلكترونية» لا يعد وسيلة مشروعة لكشف الفساد، والطريق المشروع
هو تبليغ الجهات المسؤولة، أو استعمال وسائل إصلاحية لا تنتهك حرمات الناس.
أما إذا كان الفساد علنيًّا عامًّا يؤذي الأمة، فيجوز التحذير منه بضوابط، مثل أن يكون صحيحًا موثوقًا، ويُراعي المصلحة والمفسدة، وألا يُشهِّر بأشخاص بعينهم؛ فإنه لا يُتوصَّل إلى الحق بالباطل.
اقرأ
أيضاً:
قراءة الغزالي
في فضيحة «إبستاين»
















