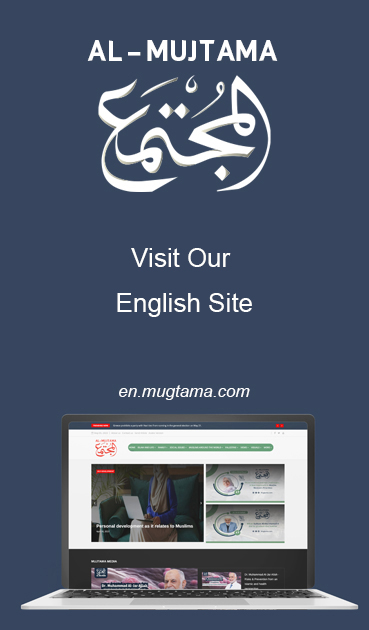منبر الصباح المفقود.. كيف كانت الإذاعة المدرسية تصنع الهوية؟

الإذاعة المدرسية لم تكن يوماً مجرد
فقرات تقليدية تؤدى على عجل، بل كانت مسرحاً صغيراً يختبر فيه الطالب صوته ولغته
وثقته بنفسه، وكانت أشبه ببوابة أولى يدخل منها إلى عالم الكلمة المؤثرة.
كنا نرى زملاءنا يتسابقون في إعداد
الفقرات، أحدهم يتلو القرآن بصوت ندي يوقظ الأرواح مع إشراقة الصباح، وآخر يقرأ
حديثاً شريفاً يفتح لنا أفقاً أخلاقياً، ثم ينشد ثالث نشيداً تختلط فيه الحماسة
بالعاطفة، فيوقظ فينا شعور الانتماء ويغرس فينا القيم، تلك اللحظات، على بساطتها،
صنعت جيلاً يعرف كيف ينصت وكيف يتكلم، كيف يواجه الجمهور وكيف يصوغ أفكاره في جملة
وعبارة ومقطع شعري.
كم كان بريق الصباح يزداد جمالاً حين
يرتفع صوت زميل لنا يتلو القرآن بخشوع، فنشعر أن اليوم كله يفتح أبوابه على بركة
ونور، لم تكن مجرد تلاوة عابرة، بل كانت لحظة تهزّ القلوب الصغيرة وتزرع فينا حب
الترتيل والإنصات، وتفتح أمامنا أبواب البلاغة القرآنية.
كنتُ مأخوذاً على الدوام بصوت الشيخ أحمد
العجمي، فإذا سمعته يتلو ارتجف داخلي بخشوع واطمأنت نفسي، وكنت أرى في مدرستي
أصدقاء يحاولون تقليده، كلٌّ منهم يبحث عن نبرة تشبهه، حتى تحوّلت الإذاعة
الصباحية إلى مدرسة غير مكتوبة في تربية الذوق القرآني، وتهذيب الأذن، وتعويد اللسان
على العربية في أصفى صورها.
أما الأناشيد الصباحية فكانت بساتين
متجددة، كل نشيد منها يزرع معنى جديداً في القلب، أناشيد عن الوطن، عن فلسطين، عن
قيم الصدق والشجاعة، عن الأمل والتفاؤل، نرددها جماعة بأصوات متحمسة، فنشعر أن
المدرسة كلها قلب واحد ولسان واحد، كانت كلمات بسيطة، لكنها مشحونة بالمعاني،
تعلّمنا كيف يمكن للصوت الجماعي أن يبني شعوراً بالوحدة والانتماء، وكيف يمكن للحن
عفوي أن يرفع المعنويات ويمدّنا بطاقة تكفينا لبقية اليوم، لم تكن مجرد ألحان
للترفيه، بل كانت دروساً في الروح، نتذوق فيها قيمة أن نهتف معاً، ونغني معاً،
ونحمل هماً أكبر من حدود صفوفنا الصغيرة.
ولأن الإذاعة المدرسية ضمّت الخطابة والشعر والسرد القصصي وتلخيص الكتب، فقد صنعت من بيننا أقلاماً وأصواتاً ستكبر
لاحقاً لتصبح خطباء، وأدباء، وإعلاميين، ومعلمين، فالطالب الذي يقف ليخطب عن قيمة
الصدق، أو يلقي قصيدة عن الأم، أو يروي قصة قصيرة بحماس، أو يلخص كتاباً قرأه في
المكتبة المدرسية، ذلك الطالب كان يتشكل داخله كيان أكبر بكثير من حدود المدرسة،
كان يتعلم كيف يختصر الفكرة، وكيف يبني حجته، وكيف يواجه الخوف من أعين الناس،
وكيف يحوّل القراءة من فعل فردي صامت إلى مشروع حياة يشاركه مع الآخرين.
اليوم حين ننظر إلى واقع مدارسنا، نشعر
أن تلك المنابر بدأت تفقد بريقها، فالإذاعة في بعض الأماكن أصبحت فقرة مكررة لا
يتنافس فيها الطلاب ولا يشعرون بقيمتها، وضعف الاهتمام بالخطابة وبالأناشيد
وبالتلاوة جعل أبناءنا أقل ارتباطاً باللغة وأضعف حضوراً في مواجهة الجمهور، ومع
سيطرة الوسائط السريعة والمقاطع المختصرة، فقدت الكلمة العميقة مساحتها، وصار من
السهل أن نجد طالباً يجيد التصوير أو المونتاج أكثر مما يجيد إلقاء بيت من الشعر
أو آية بترتيل صحيح.
لكن الحقيقة أن استعادة تلك اللحظات ليست
صعبة، بل تحتاج إلى وعي بأن الإذاعة المدرسية ليست ترفاً، وإنما صناعة للهوية،
وبأن اختيار أصوات التلاوة الجميلة والأناشيد المعبرة جزء من بناء الشخصية، نحتاج
أن نعيد للمدرسة صباحها المختلف، حيث يخرج الطالب من بيته وهو يعلم أنه سيستمع
لصوت يلامس قلبه، أو قصيدة توقظ مشاعره، أو نشيد يرفع همته، حينها فقط يمكن أن
نصنع جيلاً جديداً، قوياً بلغته وفصاحته، جيلاً يعي أن الكلمة إذا صدرت من قلب
صادق ومن لسان فصيح فإنها تصنع أثراً أبقى من أي وسيلة أخرى.