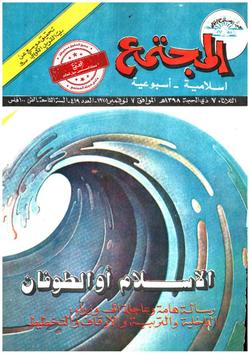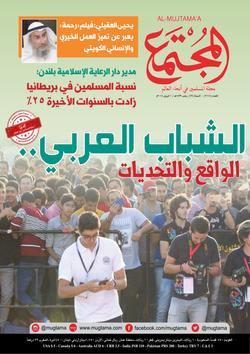العنوان التشكيك في إسلام جارودي.. ما حقيقته؟
الكاتب عمر علي غفور
تاريخ النشر الثلاثاء 03-مارس-1998
مشاهدات 33
نشر في العدد 1291
نشر في الصفحة 46
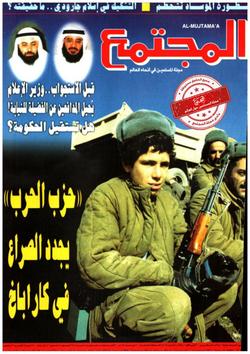
الثلاثاء 03-مارس-1998
تردد في الآونة الأخيرة أن المفكر الفرنسي المعروف «روجيه جارودي» الذي أعلن إسلامه في أوائل الثمانينيات وتسمي بـ«رجاء جارودي» قد تخلى عن الإسلام مجددًا، وذلك اعتمادًا على تصريحات لجارودي تناقلتها بعض الصحف والمجلات وعلى الأخص مجلة «المجلة» العدد (۸۳۹) التي نشرت مقابلة لمراسل المجلة مع جارودي يعرض فيها أفكارًا تبدو غريبة من الوجهة الإسلامية، ومجلة الإصلاح في العدد (۳۳۲).
ومن التصريحات التي نسبت إلى جارودي بهذا الخصوص ما قيل إنه لم يتخل عن الماركسية بدخوله الإسلام، وأنه كما جاء في نص مقابلة «المجلة» «ويدعو المسلمين إلى التخلي عن السنة النبوية كمصدر للتشريع بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ وليس مشرع، وإذا حدث أن شرع شيئًا فيكون صالحًا لعصره فقط، ولا يكون صالحًا لعصرنا، وأنه لا يوجد في الدين شيء ثابت إلا أصل الدين أما التطبيقات سواء ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات فقابلة للتطور، ومن هنا يعتبر الصلوات الخمس مجرد حركات رياضية، فهو لا يصلي في اليوم خمس مرات، وإنما يصلي (٢٤ ساعة)، لكن الصلاة عنده ليست حركات رياضية لكنها تفكير عميق في الذات الإلهية، وكلما تذكرت الله، يقول جارودي وأمعنت التفكير في ذاته فأنا أصلي ويطرح آراء أخرى حول تجديد الفقه ليكون صالحًا للقرن الحادي والعشرين، والذي يعتزم جارودي وضعه».
لا أريد هنا أن أدافع عن جارودي وأستلصقه جبرًا بالإسلام إذا كان هو نفسه قد قرر التخلي عنه، وليس من المستغرب أن يتخلى هو أو غيره من العلماء والمفكرين الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام، فالانتقال من فكر إلى فكر، ومن دين إلى آخر قد أصبح عادة متبعة في المجتمعات الغربية في ظل الفراغ الروحي والتدهور الخلقي الذي تعيشه تلك المجتمعات، وقد تكون نسبة «ترك الإسلام» ضئيلة مقارنة بنسبة ترك الأفكار والأديان الأخرى.
فإذا كان واحدنا واثقًا ومطمئنًا إلى دينه السماوي ذي الجذور الراسخة، فسيكون مقتنعًا تمامًا بأن اعتناق جارودي أو غيره من المفكرين الغربيين للإسلام، يشكل إنجازًا تاريخيًا له، حيث وصل عن طريق منطقه الفكري إلى الدين الحق، قبل أن يكون انتصارًا للإسلام، فلم يكن الإسلام منهزمًا مهمشًا قبل انضمامه، ولا دخل مرحلة جديدة بهذا الانضمام حتى يصاب بالانتكاس إذا ما أعلن هو خروجه من الإسلام، لذلك إذا صح أن تخلى جارودي فعلًا عن إسلامه، فهذا التخلي يكون بمثابة انتكاسة فكرية له قبل كل شيء.
لكن الموضوعية والإنصاف توجب علينا بالمقابل تسجيل عدة ملاحظات حول فحوى الاتهامات التي وجهت إلى فكر جارودي فيما يتعلق بإسلامه.
إن جارودي مفكر غربي المنشأ والتعليم، ذو خلفية فكرية مادية عمومًا هذه السابقة غطت أكثر من خمسين عامًا من عمره قضى معظمها في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي، يعمل فيلسوفا للحزب ومنظره الفكري، يدافع عن الأسس والمبادئ والرؤى الماركسية الغارقة في المادية، ولكنه كان يعتقد دومًا كما صرح بذلك في مقابلة صحفية أوردها رامي كلاوي في كتابه «روجيه جارودي من الإلحاد إلى الإيمان» بضرورة وجود قيم معنوية لدى الإنسان تعطي للحياة معنى، لذلك كان يبحث عن فكرة روحية صوفية يضيفها إلى الفكر الماركسي لكي تكون من التقائهما عقيدة وبرنامج سماوي أرضي أي بمعنى قلبي حياتي، روحي اجتماعي... فهو يقول: آخر دين قبل إسلامه في كتابه «البديل» الذي ألفه قبل إسلامه:
«إن انفجار المسيحية التقليدية والماركسية التقليدية يتيح إمكانية لقاء جديد بين الثورة والإيمان» قال هذا بعد أن فصل من الحزب الشيوعي بسبب الانتقادات التي وجهها إلى الفكر الماركسي ومواقف الحزب، ودخل بذلك مرحلة حوار الحضارات، وتناول بالدراسة مختلف الأديان بحثًا عن الدين المنشود.
فعندما جاء إلى الإسلام كدين روحي اجتماعي، صوفي ثوري، جاء بهذه الكومة الهائلة من المخزون الثقافي، وما تتركه في وعيه الباطن من خطوط وتأثيرات، فلا عجب والحالة هذه أن تتبلور لديه نتيجة لتأثيرات تلك الخلفية آراء وأفكار تخالف ما اجتمع عليه الفكر الإسلامي الذي أنتجه علماء المسلمون، أو ما هو من الدين بالضرورة.
الخلفيات الثقافية
وليس هذا شأن جارودي وحده، فمعظم المفكرين الغربيين الذين يدخلون الإسلام، يعانون من تأثيرات خلفياتهم الثقافية الغربية فالدكتور مراد هوفمان سفير ألمانيا في الرباط الذي أسلم في الثمانينيات، يدافع في كتابه المشهور «الإسلام كبديل» عن فكرة عدم تحريم الإسلام لـ«الربا» لماذا؟ لأن الربا يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الرأسمالي، وقد أصبحت مسألة استثمار الأموال عن طريق الربا من بديهيات الأمور في تصور الفرد الغربي، لذلك يبدو للدكتور هوفمان أن إثبات حقيقة تحريم الربا في الدين الإسلامي تشكل فجوة كبيرة يقلل من أهميته وحقيقته من هنا يبادر إلى طرح مختلف التأويلات والتفسيرات لكي يملأ هذه الفجوة بنظره بإثبات أن الإسلام لا ينص على التحريم المطلق للربا.
حتى إن علي عزت بيجوفيتش رغم أنه كما يقول محمد يوسف عدس في مقدمة الترجمة العربية لكتابه «الإسلام بين الشرق والغرب» مسلم حتى النخاع ، ورغم ثقافته الإسلامية الواسعة، إلا أنه نظرًا لنشأته وتعليمه الأوروبيين له آراء في تناول بعض المسائل تختلف كليًا عن آراء نظرائه في العالم الإسلامي، وذلك مثل الدلالة التي يعطيها لكلمة «الدين» حيث يطلق عليه ما يطلقه الفكر الغربي، ونظرته إلى اليهودية وشخصية موسى عليه السلام، وحتى إذا اقتنعنا بما يقوله محمد يوسف عدس، من أن هذه الرؤية لا تمثل بالضرورة عقيدة بيجوفيتش في تلك الأمور، بل إنه يتحدث فيها من واقع الصورة التي تعكسها الكتابات المصدرية التي اعتمدها أصحاب الديانتين أنفسهم، إلا أنه من المحتم بالمقابل أنه لم يكن ليتناول الأمور بهذه الرؤية لولا أوروبية منشئه وتعليمه.
من هنا أقول إن تقييم أفكار جارودي الأخيرة إذا ثبت نسبتها إليه لابد أن يتم في إطار هذا الفهم، أي بقراءتها في إطار الوسط الفكري والثقافي الذي ولدت في أحضانه، خصوصًا، إذا صح ما ذهب إليه الدكتور يوسف القرضاوي في معرض رده على بعض أقوال جارودي في «المجلة المذكورة» من أن جارودي قد عرف الإسلام عن طريق «محيي الدين بن عربي» الصوفي المعروف الذي أثنى عليه جارودي كثيرًا، كما يقول الدكتور القرضاوي هذا وقد سبق أن سمع الدكتور القرضاوي من يقول: «إن جارودي أخذ الإسلام فكرًا لا تعبدًا وسلوكًا، إلا أنه يقول إنني رددت على ذلك لأنني قد رأيته أي جارودي مرة يصلي معنا صلاة الجماعة».
يبدو لي أن بعضًا من تلك الاتهامات التي وجهت إلى إسلام جارودي جاءت نتيجة استنتاج تابع عن عدم استيعاب فكر جارودي الواسع والغائر في العمق، وكذلك عدم الدراية بتصريحات سابقة له من هذه الاتهامات التي تبدو لي غير صائبة . فهم قوله بأنه لم يتخل عن الماركسية، فهمًا خاطئًا، حيث استنتج من هذا القول أنه لا يزال ملحدًا ويحتفظ بولائه الكامل للماركسية «جملة» كأيديولوجية متكاملة تغطي جميع جوانب حياة الإنسان دون استثناء.
هذا في حين أن رؤية الرجل لـ« الماركسية» التي يقصدها مختلفة عن هذه الرؤية، فالأفكار لها صورة كلية وصور جزئية تفصيلية تتشكل من تركيب تلك الأجزاء على نسق منطقي الصورة الكلية للنظام الفكري المعلن صحيح أن هناك علاقة عضوية بين أجزاء التركيبة العامة، لكن ليس من المحتم أن يكون كل كيان جزئي داخل جسد الكيان الكلي، يشكل بالضرورة نسخة طبق الأصل للكيان الكلي من حيث الطبيعة والجوهر. بحيث لا يسمح بتفكيك ذلك الكيان إلى أجزاء مفردة، ومن ثم الاستفادة من تلك الأجزاء ككيانات مستقلة.
من هنا نحن نرفض الفكر الماركسي كمجمل أو كيان كلي متكامل الأجزاء، لأنه يقوم على رؤية مادية أحادية للحياة ولا يستوعب جميع أبعاد وعناصر ومستويات الوجود والحياة، لكن ليس محظورًا علنيًا لا بدافع من الدين أو بسبب من طبيعة الفكر الماركسي نفسه أن نستفيد من بعض الآليات والأساليب التي تطرحها الفلسفة الماركسية لتناول ومعالجة بعض المسائل العملية الجزئية ذات الطابع المادي في الحياة دون أن يعني ذلك أننا نتبنى رؤيتها المادية الإلحادية فيما يتعلق بفلسفة الوجود.
الرؤية الماركسية
من هذه الزاوية، واعتمادًا على تصريحات سابقة لجارودي حول موقفه من الماركسية، يبدو لي أن قصد جارودي بعدم تخليه عن الماركسية لا يتجاوز استمراره في الاستفادة من بعض الأساليب الماركسية لتناول بعض الأمور، ولا يدل قوله هذا على أنه لا يزال متمسكًا بالرؤية الإلحادية للفلسفة الماركسية.
أولًا: أنه وكما ينقل عنه رامي كلاوي في كتابه المذكور، لم يكن في يوم من الأيام ملحدًا، يقول جارودي: «ويقول البعض اليوم بأنني اكتشفت الدين متأخرًا، ليس هذا صحيحًا، الدين كان حاضرًا في وعيي منذ البداية، الدين كإيمان جوهري، لا كنصوص حرفية وطقوس محددة، لقد لازمني هذا الإيمان في أشد مراحل التزامي الماركسية» ص ۱۲۲ «بالنسبة لي لا يعتبر الأمر أي حدث إسلامه، تحولًا من الإلحاد إلى الإيمان، فلم أكن في يوم من الأيام ملحدًا»، ويقول في كتابه «البديل»، الذي ألفه قبل إسلامه: «وإن البديل الحقيقي عن دين أفيون للشعب ليس إلحادًا وضعي النزعة، لأن الوضعية ليست في العالم بدون الله فحسب، بل أيضًا العالم بدون الإنسان».
فكيف يقال بعد هذا أنه عاد إلى الإلحاد؟ لم يكن ملحدًا ونصف العالم يتبنى الإلحاد رسميًا، فكيف يتبنى الإلحاد، والفكر الإلحادي أنهار في هذا النصف من العالم؟
فقوله بأنه «لم يتخل عن الماركسية» ليس جديدًا، فقد جاء في كتاب «رامي كلاوي» على لسان جارودي وهو يسأل عن أسباب ودوافع إسلامه «وأحب أن أؤكد بأنني لم أدر ظهري للماركسية على الإطلاق» ص ۱۸۹ لكن أي ماركسي هو يا ترى؟
يقول جارودي في ص ۱۷۸ - ۱۷۹ من نفس الكتاب: «وإن المطلوب من كونك ماركسيًا هو استعمال الأسلوب الماركسي لحل مشاكلنا، إن ما قام به «ماركس» هو تحليل علمي، أن تكون ماركسيًا «تعني» أن تستعمل أسلوب ماركس، في حل مشاكل عصرنا كما حل هو مشاكل عصره» أي أن ماركسية جارودي هي انتهاجه الأسلوب العلمي المنطقي في تحليل ودراسة الأمور والمشاكل التي تعترض سبيل المجتمع وإيجاد السبل الكفيلة بتطوره من دون أن يرتكن هذا النهج على أساس إلحادي، فمعالجة الأمور الحياتية معالجة علمية موضوعية لا تعني في كل الأحوال إلحادًا، فالإلحاد موقف فكري وجداني، بينما الأسلوب، والآلية ميكانيزم توظيف طبيعي للإمكانات والقوانين المودعة في طبيعة الذات والموضوع من أجل تطوير الحياة.
جارودي والسنة
ومعالجة المشاكل وتفسير الظواهر من هنا، فإن تصريح جارودي عن عدم تخليه عن الماركسية كأسلوب، لا يطعن في إسلامه، أما عن دعوته المسلمين للتخلي عن السنة بدعوى كونها تشريعات خاصة بمرحلة تاريخية معينة فليس واضحًا معالمها، لأن حجته لرفض السنة منصبة على الجانب التشريعي للسنة في حين أن السنة «وهي التطبيق العملي للقرآن والمصدر الثاني للإسلام» لا تنحصر في النصوص التي تعالج المشاكل الحياتية العملية، وإنما فيها أمور عقائدية وإشارات علمية ومعالجات طبية، وتنبؤات تاريخية لا تدخل ضمن المتغيرات فإذا كان ثمة مبرر جدلًا لحذف ما يتعلق منها بحل المشاكل الحياتية اليومية المطبوعة بطابع عصرها، فما الموقف من البعض الآخر وليس واضحًا إذا كان رفض جارودي . إذا صح أنه قال بذلك السنة، هو رفض مطلق أو جزئي؟
وقد نشر جارودي بعد إثارة تلك الإشاعات ردًا ينفي فيه هذا الاتهام أما رأيه في الصلوات الخمس ووصفها بأنها حركات رياضية أكثر من أي شيء آخر، وأن الصلاة عنده في التأمل في الذات الإلهية، أي عبادة فكرية تأملية لا حركية، إذا صح أنه كذلك، فأرى أنه خطأ فادح وغلطة فكرية غارقة في السذاجة ومحدودية الإحساس وجاهلة بطبيعة الصلاة الحقيقية المتعددة الأبعاد والتأثيرات، وهذا ليس بمستغرب لكون جارودي مفكرًا عميق التفكير واسع الثقافة، فتفكيره مطبوع بقيم الحضارة التي ينشأ في ظلها، ومن نافذتها ينظر إلى العالم، وهي قيم لا تستطيع لغتها- واللغة تنطق الفكر- أن تستوعب كثيرًا من المفاهيم الإسلامية المتعدد الأبعاد، بينما الثقافة الغربية وأحادية الرؤية لا تعطي للمدلولات الفكرية بعدها المادي، كبعد أوحد.
يقول محمد يوسف عدس في مقدمته لترجمة كتاب بيجوفيتش المذكور «إن الغرب يعجز عن فهم الإسلام لسببين جوهريين وهما طبيعة العقل الأوروبي «أحادي النظرة» وإلى قصور اللغات الأوروبية عن استيعاب المصطلحات الإسلامية التي أورد بيجوفيتش مجموعة منها مثل الصلاة،
والزكاة، والوضوء، والخلافة، والأمة، حيث لا يوجد ما يقابلها في المعنى في اللغات الأوروبية» فالمصطلحات الإسلامية كالإسلام، تنطوي على «وحدة ثنائية القطب» مما جعل العقل الأوروبي عاجزًا عن فهمها (1)
فجارودي ومن يشاطره الرأي في ذلك لا يفهم من الصلاة إلا التأمل الروحي الصوفي في الفكر والوجدان، ولا يستسيغ عقله أن تكون لها أبعاد أخرى فلسفية اجتماعية سياسية هذا بالإضافة إلى أنه قد غاب عن باله أن التأمل في قدرة الله وذكر الله بالفكر والقلب واستحضار هيبته في جميع الأحوال قد أعطيت له في الإسلام أهمية كبيرة، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، حيث وسع في إطار هذا الجانب من النشاط الإنساني التأملي حتی ملأ به جميع لحظات وأحوال الإنسان الواعية ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران:١٩١)
لا أريد أن أوسع هنا في شرح معاني صلاتنا، واكتفي بالقول إن جارودي لكونه مفكرًا، قد صب جل اهتمامه على التفكير كوسيلة وحيدة لنيل الصفاء والسمو والرفعة الروحية، ولا يحس بتأثير حركات الجوارح في الصلاة وأبعادها الحياتية المختلفة، فالسمو الروحي لا يجب أن ينحصر داخل الذات كحالة روحية شخصية لا تترك آثارها على الخارج وإنما يجب أن يبرهن السمو على وجوده بتجسده في حركات سلوكية، فالصلاة في ظاهرها حركات رياضية، لكن هذه الحركات مجرد شكل وإطار للنشاطات الروحية الكامنة فيها، إضافة إلى أن لها دلالات قيمة ففي الصلاة صلة بالله حينما يكور المرء جسمه ساجدًا لله واضعًا أعلى وأعلى ما يملك «وهو رأسه» على الأرض، يعلن بذلك موت القيم الرذيلة وخضوع المادة للروح، وخضوع الحركة للقيم، وخضوع الدنيا للآخرة. وتلازم الإيمان والعمل والفكر والسلوك، إضافة إلى تأثيرات الصلاة في بعض مستوياتها الأخرى.
النقطة الأخيرة والتي تشكل فيما يبدو شهادة تزكية لجارودي هي أن جارودي قد أعلن في رسالة له نشرت في القاهرة وغيرها تبرئة عن كثير
من الاتهامات التي لصقت به وبالأخص ما نشرته مجلة «المجلة».
في هذه الرسالة ينفي الاتهامات التي أسندت إليه، ويعرب عن أسفه من بعض المواقف العربية تجاهه، في حين أنه يواجه ضغوطًا شديدة من قبل قوة الضغط اليهودية في العالم، خصوصًا في فرنسا بسبب إصداره لكتابه الخرافات التأسيسية للسياسة الإسرائيلية ومن الطريف أن إثارة تلك الشائعات قد تزامنت تقريبًا مع صدور كتابه المذكور والضغوط التي يواجهها الكاتب بتهمة معاداة السامية .
---------------------------------------
الهوامش
(1) فمثلاً كلمة «أجر» ليس لها في الفكر الغربي إلا مدلول واحد، وهو المدلول الاقتصادي «أي المردود المالي للعمل»، بينما في القرآن لها بعد مادي وبعد معنوي، أما عن المدلول المادي فيقول تعالى ﴿ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ ﴾. (القصص:٢٥) ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾. (الكهف:٧٧) ، فالأجر هنا أجر اقتصادي، أما في قوله تعالى ولأجر الآخرة أكبر ..... فالأجر أجر معنوي أخروي، كذلك الحال بالنسبة لكلمة «التجارة» لها في الفكر الغربي البعد الاقتصادي كبعد أو حد، بينما في القرآن لها بعدان مادي ومعنوي المادي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ﴾. النساء:٢٩). ، وعن البعد المعنوي في﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾. (الصف:١٠) فالفكر الغربي لا يفهم هذه المفردات بدلالاتها الإسلامية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل